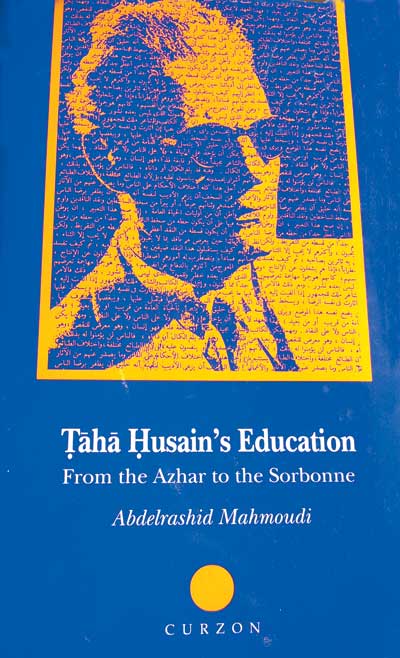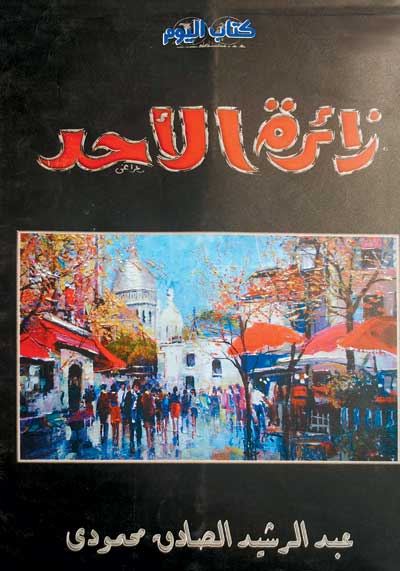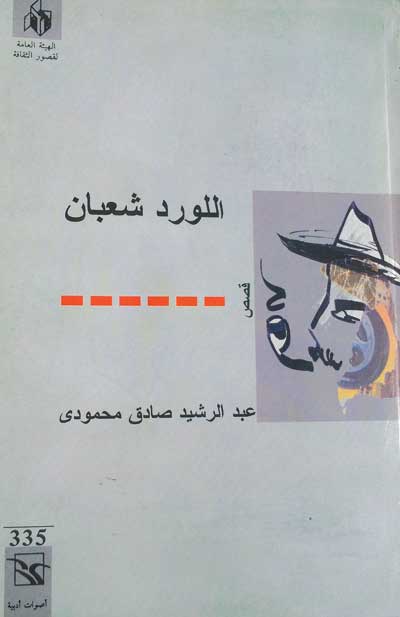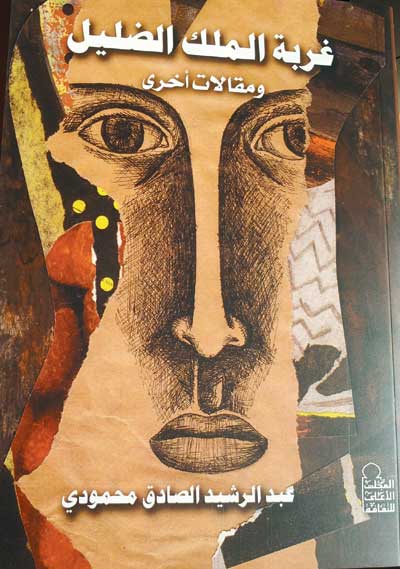د. عبدالرشيد الصادق محمودي ومصطفى عبدالله.. (عام طه حسين)
|
تتبعتُ معجزة طه حسين من الأزهر إلى السوربون
بعد نصف قرن من الترحال بين لندن وباريس وفيينا وجنيف وروما وغيرها من عواصم الغرب ومدنه الكبيرة التي اختلف إليها الدكتور عبدالرشيد الصادق محمودي طلبًا للعلم، أو العمل في منظمات الأمم المتحدة، عاد إلى مصر ليستقر ويكمل مشروعه الثقافي كمترجم وروائي وقاص وشاعر. وما إن جلس إلى مكتبه حتى بدأت أسأله:
- الكاتب - في رأيي - ليس هو الحكم الأفضل على مؤلفاته ومنجزاته، وينبغي أن يترك الحكم في ذلك للقراء والنقاد. فمن الصعب - إن لم يكن من المستحيل - أن يكون الكاتب موضوعيًا في الحكم على أعماله. وفي حالتي الخاصة ألاحظ أنني أتعرض لحالات أو لدرجات مختلفة من الرضا والاستياء حتى بالنسبة للعمل الواحد. يحدث هذا بصفة خاصة أثناء عملية التأليف وبالقرب منها. قد أشعر بالرضا - كل الرضا - في الليل. فإذا لاح الفجر أو جاء الصباح تكشفت في نظري العيوب وأوجه القصور والثغرات وهرعت إلى العمل كي أعدله. ثم تهدأ الأمور بعد إرسال العمل إلى الناشر وبعد وضعه بين أيدي القراء، وابتعاده عني. عندئذ يتراجع العمل - يصبح في ذمة التاريخ كما يقال - وتستقر الأمور؛ وعندئذ أكون سعيدًا لأنني تخلصت من أعبائه، فلم يعد هناك ما يمكن أن أفعله بشأنه.. فقد قضي الأمر. إلا أن الكاتب لا يكف تمامًا عن التقلب إزاء العمل الذي ألفه حتى بعد نشره. أنا في بعض الأحيان أشعر بالدهشة وأتعجب كيف كتبته، لأنه يبدو لي غريبًا عني وكأنه من صنع شخص آخر؛ وقد أعتز به لأنني فيما أرى أبليت بلاءً حسنًا؛ وقد أجده قريبًا من نفسي لأنه ارتبط بلحظة أو أخرى من حياتي، وأشعر بالعطف مثلًا على الكاتب الشاب الذي ألفه. وبطبيعة الحال قد يحدث عكس ذلك. وقد حدث مرارًا أن أعدمت بعض ما كتبت لأنه لا يستحق النشر في نظري. وأستطيع القول بصفة عامة إنني غير راضٍ عما تحقق حتى الآن لأنه أدنى مما أريد. فلا تزال هناك أعمال كثيرة لم تنجز، ومستويات من الجودة لم أبلغها، وقصائد لم تكتمل، ولغات تعلمتها ونسيتها ولا أدري ما إذا كان يمكنني استرجاعها، وميادين لم أقتحمها بعد. وأنا بهذا المعنى مازلت شابًا لأنني مازلت أحلم وأتطلع نحو المستقبل. ولكنني من ناحية أخرى أدرك أن الزمن يمر – بل ويجري بسرعة متزايدة - وأخشى أن يصلصل الناقوس الذي ينذر بأن الموعد المخصص للامتحان قد انقضى. وكم أتمنى أن يتاح لي من الوقت ما أحقق فيه أحلامي. ولكم أتمنى أن ينساني الزمن، خمسين سنة على سبيل المثال، فيتركني وشأني بين القراءة والتأليف، هذه اللعبة البديعة، والاستماع إلى الموسيقى.
- حدث ذلك في فترة مبكرة من حياتي، كنت لا أزال طفلًا عندما أخذت أردد أنني أريد أن أسافر إلى فرنسا للدراسة مثل طه حسين.
- نعم.. فقد لفتني عندما قرأت كتابه «الأيام» في تلك الفترة المبكرة من حياتي. ثم توالت القراءات التي تدفع في ذلك الاتجاه، ومن بينها كتابات طه حسين الأخرى مثل «رحلة الربيع» و«رحلة الصيف» وما إلى ذلك؛ وكتابات توفيق الحكيم: «زهرة العمر» و«راقصة المعبد»؛ وبعض كتابات أحمد الصاوي محمد، والدكاترة زكي مبارك وهلم جرا. وقد غرست تلك الكتابات في نفسي أفكارًا وقيمًا مثل الثقافة الرفيعة والحرية. وفي هذا السياق لابد أن أذكر بعض المجلات الثقافية الممتازة مثل «الكاتب المصري» التي كان يرأس تحريرها طه حسين، و«الرسالة» التي كان يرأس تحريرها أحمد حسن الزيات، و«الكاتب» التي كان يرأس تحريرها الشاعر محمد عبدالغني حسن. وتأكد هذا الاتجاه في الجامعة عندما درست الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة. كان معظم الأساتذة قد درسوا في فرنسا: يوسف مراد (علم النفس)؛ وعثمان أمين (الفلسفة الحديثة)، ونجيب بلدي (فلسفة العصور الوسطى)، ومصطفى حلمي (التصوف)، وزكي نجيب محمود الذي درس في إنجلترا. وفي الفترة الأخيرة من الدراسة توثقت علاقاتي بعثمان أمين، وكان من أشد الأساتذة تحمسًا لفكرة الدراسة في فرنسا. وأذكر هنا حادثة طريفة، فعندما اعتزمت السفر إلى فرنسا بعد التخرج ولم يكن لدي من الموارد المالية شيء يذكر، وكان عثمان أمين هو المحرض على السفر رغم الصعوبات. ذات يوم، سرت معه من الجامعة في اتجاه منزله، وكنا نناقش هذا الموضوع، فقال ما معناه إنني ينبغي ألا أكترث لموضوع الموارد المالية، فيمكنني عند بلوغ باريس أن أجد عملًا لبعض الوقت أو في أثناء الإجازات كما يفعل كثير من الطلاب الفرنسيين أنفسهم. وأخبرني أنني قد أستطيع الحصول على منحة أو نصف منحة من الجامعة، ووعدني بأن يخاطب بشأني المستشرق الفرنسي ماسينيون عند أول زيارة له لمصر لحضور دورة المجمع اللغوي لكي يساعدني في الحصول على المنحة. واشتد الحماس بالأستاذ، فإذا به يتوقف عند محطة الأتوبيس ويفاجئني بكتابة طلب التحاقي بالسوربون لدراسة دكتوراه الدولة في الفلسفة. وبالفعل جاء رد الجامعة بالقبول؛ كان التعليم في السوربون بالمجان، ولعله لايزال كذلك؛ ولم تكن هناك أي صعوبات في الحصول على التأشيرة؛ ولم تكن القنصلية الفرنسية في القاهرة آنذاك بحاجة إلى سؤال عن موارد الزائر المالية وما إلى ذلك من قيود وتعقيدات نراها اليوم. وتهيأت للسفر وفقا لنصائح الأستاذ.
- شاءت المقادير مسارًا آخر؛ فقد فزت ببعثة لدراسة الفلسفة في إنجلترا؛ والواقع أنني كنت مهيأ تمامًا من الناحية اللغوية للسفر إلى الغرب. ففي القاهرة كنت أجدت القراءة بالإنجليزية والفرنسية، ومارست الترجمة عنهما، بل وتعلمت مبادئ الألمانية تحسبًا لاحتمال السفر إلى ألمانيا.. من يدري؟ ومن الناحية النفسية كنت مهيأ تمامًا للسفر بسبب إقامتي في القاهرة، التي كانت في ذلك الوقت معبرًا عظيمًا نحو أوربا؛ بل كانت بمعنى من المعاني هي أوربا ذاتها، فكانت مركزًا حضاريًا بكل المعايير؛ العمران، والجمال، وتوافر سبل العلم والثقافة. وقد تُدهش إذا قلت لك إنني لم أُصب بالصدمة الحضارية عندما وصلت إلى لندن، فشعرت عندئذ بأن القاهرة لا تقل عنها حضارة وجمالًا إن لم تفقها في بعض النواحي، وبخاصة العمارة الإسلامية. ويمكن أن أعترف بأنني أصبت بهذه الصدمة الحضارية عندما جئت، لأول مرة، من قريتي في محافظة الشرقية إلى القاهرة، بهرتني المدينة وخلبت لُبي واقتضت مني قدرًا كبيرًا من التكيف. ومن المؤسف أن القاهرة تشوهت وافتقرت، ولم تعد، كما كانت، أحب العواصم إلى نفسي.
- لم يكن لأحد فضل في ذلك، فالفضل يرجع إلى الحظ الحسن. كنت أعيش في لندن، وسمعت، عن طريق المصادفة، أن منظمة اليونسكو أعلنت عن مسابقة لاختيار مترجمين للتوظف فيها، كان ذلك يوم أحد، وموعد وصول الطلبات لمقر المنظمة في باريس قد انتهى؛ ومع ذلك لم يتسرب إلي اليأس، وهرعت إلى مكتب البريد الوحيد الذي يعمل أيام الآحاد في لندن، وهو الموجود في ميدان «الطرف الأغر» وأرسلت الطلب، ولكم كانت دهشتي عندما تلقيت من «اليونسكو» ردًا إيجابيًا يدعوني لحضور الامتحان، وبعد أن أديته، ومرت فترة طويلة تقترب من العام، كنت قد نسيت خلالها الموضوع برمته؛ جاءت المفاجأة الكبرى، في برقية تعلن قبولي؛ وتعرض علي العمل في المنظمة لمدة شهر، وكانت تلك هي نقطة البداية للعمل بصفة دائمة. ولم تكن المفاجأة نجاحي في الامتحان فقط، بل الإقامة في باريس- ذلك الحلم الذي لم يفارقني طيلة مدة إقامتي في لندن، أو لنقل فرصة الجمع بين «المدينتين» - وهي فرصة نادرة لا يحظى بها إلا قلة.
- هذا أيضًا حدث بفضل المصادفة؛ فبينما كنت أقرأ رواية أندريه جيد «السيمفونية الريفية» التي أشرف طه حسين على نقلها إلى العربية ونشرها ضمن مطبوعات مجلة «الكاتب المصري»، وقعت أثناء القراءة على حاشية للمحقق يشير فيها إلى مقالة لطه حسين بالفرنسية عن أندريه جيد، فسعيت إلى هذا النص لأترجمه وأنشره. عندئذ؛ خُيل إليّ أنني بصدد حالة فريدة، ولكن تبين لي في ما بعد أن لطه حسين مقالات أخرى ألفها بالفرنسية وظلت في معظمها غير معروفة للقراء العرب، فقررت أن أجمعها، وأترجمها، وأنشرها بين دفتي كتاب واحد، ومن ثم كان هذا الكتاب الذي تسألني عنه «من الشاطئ الآخر».
- توقفت عند الإشارة لبرهة ثم ضربت عنها صفحًا. ولكن تلك الوقفة كانت بداية لأيام طويلة من الشقاء وأيام أخرى حافلة بالسعادة؛ وكأنما قدر لي منذئذ أن أكون مترجم طه حسين إلى اللغة العربية.
- بلا شك، فهي قيمة كبيرة في حد ذاتها، وأنا لا أزال حتى الآن أسعى إلى الوصول إلى تلك النصوص التي أبدعها عميد الأدب العربي بالفرنسية ولم تصل بعد إلى أيدينا، فنحن لا نزال نجهل أن لطه حسين كتابات يعتد بها بالفرنسية. وتلك ظاهرة غريبة لأن الإشارات إلى هذه الكتابات تتكاثر فيما ألف طه حسين وفيما كتب عنه بالعربية؛ فلكأننا نتجاهلها ولا نجد ما يدفعنا للتعرف عليها. ولست أعني بالضرورة الرسالة التي أعدها طه حسين في السوربون عن ابن خلدون والتي ترجمها محمد عبدالله عنان. ولا أعني الدراسة الشهيرة التي ألفها العميد عن «البيان العربي من الجاحظ إلى عبدالقاهر» والتي ترجمها عبدالحميد العبادي تحت إشراف طه حسين نفسه. وإنما أعني - على سبيل المثال لا الحصر - مذكرة قدمها طه حسين إلى لجنة المحفوظات ونشر النصوص التابعة لمؤتمر العلوم التاريخية الذي انعقد في بروكسل عام 1923. وقد كتب طه حسين عن هذه المذكرة يقول: «وفي هذه اللجنة قدمت مذكرتي... وكان موضوعها «نص معاهدة دفاعية هجومية» عقدت سنة 692 للهجرة (1292 للميلاد) بين الملك الأشرف خليل قلاوون وابن جايم الثاني ملك أراجون وأخويه وصهريه وكلهم ملوك لإسبانيا المسيحية». وروى طه حسين أنه وجد النص العربي لهذه المعاهدة في «صبح الأعشى» للقلقشندي (الجزء 14) وأنه اكتشف النص الإسباني اللاتيني منها واستطاع بالاستناد إلى هذا النص أن يزيل ما في نص القلقشندي من اضطراب وتحريف وأن يثبت صحته من الوجهة التاريخية. كما نقرأ في مقال عنوانه «دين» أن طه حسين ألقى في لبنان محاضرة بالفرنسية عن أثر الحضارة العربية في الحضارة الفرنسية: «ويأتي موعد المحاضرة الموعودة. فسل ما شئت عن رفق الحكومة «اللبنانية» وظرفها ورقتها وعن كريم عنايتها وحسن رعايتها، وسل ما شئت عن تهافت الناس على البطاقات واستباقهم إلى الأماكن وازدحامهم في القاعة وما حولها حتى أمسى المستمعون لا يحصون بالمئات وإنما يحصون بالألوف». وعن المناسبة نفسها كتبت السيدة سوزان طه حسين تقول: «وفي عام 1948، في أثناء المؤتمر العام لـ «اليونسكو»، أجلسوه على المنصة عندما كان عليه أن يلقي خطابه. وعندما رأيت زوجي على هذه المنصة العالية أكثر عزلة من أي وقت مضى، بعيدا عني في مواجهة جمهور غفير، لا يملك إمكان الخروج من هذا الموقع بنفسه، يستعد للكلام من دون أي مذكرات، فقد أصبت بهلع حقيقي...». وما كان للسيدة أن تجزع؛ فقد أبلى طه في تلك المناسبة كغيرها من المناسبات العصيبة بلاءً حسنًا. واستطاع في نهاية المطاف أن يكسر حواجز العزلة وأن يصل إلى جمهوره ويبهره. وأقول في نهاية المطاف لأن طه حسين كان يتهيب الخطابة بالفرنسية؛ وأحسبه قد أصابه الوجل للحظة حتى بلغ تلك الينابيع الخفية التي كانت تجود عليه ثم أخذ يتدفق. كتب سامي الكيالي حول تلك الخطبة فقال إن طه حسين «وقف قرابة الساعتين يتكلم بفرنسية عالية، مما أثار دهشة وإعجاب أمم العالم وقد خرجوا جميعًا وهم مؤمنون بعبقرية هذا الرجل...».
- لتذهب أينما ألقت بها الرياح؛ فنحن قوم لا نبالي ولا ندهش مهما تعددت الشواهد والإشارات. نقرأ ولعلنا نتوقف قليلًا ثم نستأنف القراءة ثم نطوي الكتاب وننسى. ويستمر هذا الجهل والتجاهل حتى عندما نقرأ للأستاذ عبدالعاطي جلال ترجمة لمقالة لطه حسين عن المتنبي، أو عندما نقرأ للأستاذ فؤاد دوارة ترجمة لمقالة أخرى عنوانها «دور الكاتب في المجتمع الحديث». وليس أدل على هذه الظاهرة الغريبة من أن أشمل وأدق قائمة ببليوغرافية نشرت عن طه حسين لا تتضمن أي إشارة تدل على أن له إنتاجا بالفرنسية.
- الكتاب الأول صدر عن دار الشروق في عام 2002، والثاني جاء بعده بعام عن المجلس الأعلى للثقافة، وهو دراسة مفصلة عن تعليم عميد الأدب العربي في الأزهر والجامعة المصرية في أول نشأتها (1908) وفي السوربون، وهو محاولة لاستكشاف تلك الأعماق المضطربة. فهو يتقصى مسيرة طه التعليمية، غير أن الكتاب رغم ضيق نطاقه يرتاد ويمهد الطرق المؤدية إلى الغاية القصوى. فهو يتجاوز في عدة مواضع حدود التعليم النظامي الذي تلقاه طه في مصر وفرنسا، ويتناول خبرته الحياتية أو لنقل موقفه الأساسي من الحياة؛ كما يتطرق إلى محاولاته التي استمر يبذلها في مراحل نضجه لمصارعة التناقضات الناجمة عن التزامه بالوضعية والحداثة في فترة شبابه. أما الكتاب الثالث فقد صدر عن دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية عام 2005 وكان في الأصل مجموعة مقالات ودراسات كتبت على نحو متفرق. وعندما رأيت أنني أنجزت ما فيه الكفاية عن طه حسين وأديت الواجب نحوه، انتقلت إلى نشر مؤلفاتي: ثلاث مجموعات قصصية، وروايتان، ومجموعة شعرية، ومجموعات من المقالات.
- في بداية الأمر اتصلت بمؤنس طه حسين، الذي كان يعمل في «اليونسكو»، فكنت ألمحه كثيرًا؛ وكان يلمحني، ولكنني لم أجرؤ على الاقتراب منه حتى قررت أن أقدم له نفسى طالبًا الإذن لي في ترجمة ونشر مقالة أبيه عن أندريه جيد، فأذن بذلك دون تردد. وبعد ذلك طلبت معونته في مشروع جمع وترجمة الكتابات الفرنسية لطه حسين، فساعدني بقدر طاقته، وعرفني بالدكتور محمد حسن الزيات، زوج شقيقته أمينة، الذي كان وزيرًا لخارجية مصر في وقت سابق، فقد كانت لدى الزيات بعض هذه الكتابات الفرنسية، فأعطاني بعضها، في مقابل بعض ما عندي مما كان ينقصه، ثم قرأ ترجمتي لهذه المقالات وأجرى بعض التصويبات عليها. وعلى الرغم من ذلك، فلا يمكنني القول بأن علاقتي به توثقت، فقد كانت لقاءاتنا قليلة وعلى عجل وتقتصر على موضوع الكتابات الفرنسية؛ فلم أكن أطلب مساعدته إلا في هذا المجال، أما مؤنس، فكانت إقامته في باريس تتيح لي فرصة الاتصال به كلما أردت، والواقع أنني أنست إليه منذ البداية، وزاد تقديري له مع تكرار الاتصالات واللقاءات. كان رجلا مهذبا رقيق الحاشية رفيع الثقافة وشاعرا وإنسانا رائعا؛ وكان صوته يذكرني بصوت أبيه. وانعقدت بيني وبينه صداقة أعتز بها وكم آسف لانتهائها برحيله. وإن لم يسعدني الحظ بلقاء شقيقته السيدة أمينة طه حسين، ولا التعرف إلى زوجته السيدة ليلى العلايلي حفيدة أمير الشعراء أحمد شوقي، وإن كنت قد رأيتها عدة مرات بصحبة زوجها في فترة الوجل من الاقتراب منه، وكانت بدورها رفيعة الثقافة؛ تجيد الإيطالية وتترجم عنها. وأخيرًا أسعدني الحظ بالتعرف إلى أمينة ابنة مؤنس التي تقيم في باريس. وأنت إذا رأيت أمينة هذه فلابد أن ترى ليلى، ولابد أن ترى مؤنس، ولابد أن ترى من خلفهم طه، فقد امتد إليهم جميعا تأثيره، تكاد تراه على وجوههم وفي حركاتهم وسكناتهم؛ فتدرك على الفور أنهم أهل حسب ونسب. ينبغي أن أذكر أنني كنت حريصا على نشر الأصل الفرنسي لمذكرات سوزان طه حسين لاقتناعي بقيمته من الناحية الموضوعية، ولم أكن أعلم على وجه اليقين الأسباب التي تدفع مؤنس إلى الامتناع عن النشر، ولكنه كان يقول إن إتيامبل - الناقد الشهير الذي كان مستشارا لدى «جاليمار» - لم يوافق على نشره. وحتى إذا كان ذلك هو السبب فإنني لم أقتنع به. فقد كنت وما زلت أعتقد أن رأي إتيامبل قد عفى عليه الزمن. وأصبح النقاد وجمهور القراء يهتمون بالأدب النسوي، وكتاب سوزان طه حسين أنموذج جيد من هذا النوع، فضلا عن أنه وثيقة مهمة في التأريخ لحياة عميد الأدب العربي؛ وطه حسين معروف في فرنسا؛ و«جاليمار» نشرت الترجمة الفرنسية لكتاب «الأيام» تحت رعاية أندريه جيد؛ ومذكرات سوزان طه حسين لا بد أن تكون جذابة من الناحية التجارية. وكان ذلك مدخلي في إقناع «جاليمار» وإغراء المسئولين فيها بنشر الكتاب. وخيل إليّ أنهم اقتنعوا وأبدوا- كما قلت- استعدادًا لدراسة الموضوع. وخيل إلي أنني أستطيع بهذه الطريقة أن أتغلب على اعتراضات مؤنس، وأن «ألوي ذراعه» برفق، ولكن محاولتي لم تفلح.
- من المؤسف أن هذه الرسائل لن ترى النور. طرحت السؤال ذات يوم على مؤنس، فأخبرني بأن والدته أعطته قبل وفاتها رسائل زوجها إليها، وأوصته يإعدامها لأنها في ما يبدو لم تجرؤ على حرقها من بين ما أحرقت من أوراق. وأخبرني مؤنس أنه نفذ الوصية. وأذكر أنني عاتبته على ذلك، ولعلي قلت: «لو كنت مكانك، لما أطعت والدتي. فرسائل طه ليست ملكا لأحد سوى تاريخ الأدب». وعندئذ كان في ذهني أن رسائل طه العاشق جديرة بأن تحتل مكانها المهم في سياق كتابة سيرته، ولكنني أعود فأتذكر أنني أبالغ في إعلاء قيمة تاريخ الأدب على أي اعتبار آخر. فمن حق الناس جميعا - بما فيهم الأدباء - الاحتفاظ ببعض أسرارهم حتى عندما يكتبون اعترافاتهم، وقد كتب طه سيرته الذاتية في «الأيام»، ومن المؤكد أنه حجب كثيرا من المعلومات عن نفسه وعن أهله وانتقى ما هو مناسب من وجهة نظره ووفقا لخطته الأدبية؛ وكان ذلك من حقه. وربما رأت السيدة سوزان أن في الرسائل المذكورة بعض المعلومات التي تمس أسرار الحياة الزوجية الحميمة، فأرادت أن تحتفظ بها لنفسها، وكان ذلك من حقها أيضا. فلنقنع إذن بما أتيح لنا من معلومات.
- ذكرت من قبل أنني لم أواجه صدمة حضارية عندما سافرت إلى لندن لأول مرة. فكنت أشعر بأن إقامتي فيها هي بمعنى من المعاني امتداد لحياتي في القاهرة. كانت القاهرة بما أتاحته لنا من تعليم وثقافة، ومن معالم المدنية بصفة عامة جسرًا ممتدًا وممهدًا إلى أوربا. ومع ذلك، فقد كانت الحياة في إنجلترا وفرنسا، وكانت زيارة بلدان أوربية أخرى مصدرًا لتجارب جديدة ومثرية. وليس بمستطاعي أن أقطع بأن كل تلك التجارب كانت حلوة، أو بأن تلك الحياة كانت جميعها وردية، فقد كانت هناك فترات عصيبة وأزمات حادة، ولكن قد ينبغي أن أعزو ذلك إلى أخطائي وعيوبي. ومع ذلك، فإني أعتقد أن الحياة لا يمكن أن تخلو من صراع وعراك، وأنه على الإنسان أن يتعلم من خلال المعركة الدائرة. وأحسب أنني تعلمت، وتعلمت الكثير. وما زلت أطلب المزيد من التجارب، والأسفار. ويؤسفني أنني أتذكر في نومي ويقظتي كل تلك المدن التي أحلم برؤيتها، وكل تلك المدن التي لن أراها بسب ضيق الوقت، وقصر العمر. وأنا أعشق السفر برًا وبحرًا وجوًا، فكلما تحرك بي قطار أو سفينة أو طائرة، تفتحت نفسي، وتنبه عقلي، وتذكرت قول الشاعر العربي القديم: «وسالت بأعناق المطي الأباطح».. لماذا؟ لأن السفر يجعل الحياة التي سكنت وتجمدت «تسيل» وتتموج فتصبح موضوعًا ممكنًا للكتابة. فلا كتابة ولا إبداع قبل أن تدب الحياة في أوصال الحياة، فتسيل وتتدفق.
- أوافقك تماما. ولنبدأ بالفلسفة. أنا عندما أنظم الشعر أو أكتب القصة لا أتعمد، بأي حال من الأحوال، أن أضفي على ما أكتب صبغة فلسفية أو أن أعالج أي مشكلة من تلك المشكلات التي توصف بأنها ميتافيزيقية أو وجودية. ولكني أترك كل ذلك للظروف. والظروف التي أعنيها تتعلق بتلك الأحداث أو المفاجآت التي أشرت إليها. فيكفي أن تنفتح على الواقع العادي وتستقبله وهو يسيل فتتكشف الأشياء فورًا أو في ذاكرتك في وقت لاحق عن أبعاد أخرى ما كنت لتتوقعها. ماذا أسميها؟ أسطورية؟ سحرية؟ لا أدري. ولكنها أبعاد ذات دلالات عميقة. وهي تثير في نفس الكاتب ترددات وأصداء بعيدة المدى. ومثل هذه الترددات والأصداء قد توجه الكاتب نحو أعمال غير عادية كالغناء (في الشعر وفي القصة أيضا) أو اكتشاف الصراع والدراما والمأساة والكوميديا (في القصة والرواية). أما الترجمة، فهي في رأيي معطل كبير للإبداع، وهي مضيعة لوقت المبدع. لا أنكر قيمتها ونفعها وضرورتها، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بترجمة الأعمال الممتازة في الأدب والفلسفة والعلوم. بل أعتقد اعتقادًا جازمًا أن بعض الترجمات أعمال إبداعية. ولكني أعتقد على وجه الإجمال أن الترجمة ليست من شأن الفنان.
- لأنها تعني بصفة عامة الحرص على أمانة النقل، والخضوع لمقتضيات اللغة المنقول عنها، والامتثال لرغبات المؤلف الأصلي، والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة. هذا بينما يحتاج الإبداع إلى الحرية والتحليق فوق التفاصيل والاستماع لصوت الذات. وأنا عندما أترجم أجد صعوبة في الانتقال إلى الكتابة. فأنا عندئذ أكون منهكًا وفي حاجة إلى الراحة والنسيان قبل الانخراط في العمل الذي أحبه.
- أثناء إقامتي في لندن استأنفت النشاط الإذاعي الذي بدأته في القاهرة، فأخذت أسهم من الخارج في بعض برامج القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية. وهناك تعرفت إلى الطيب صالح. كان يعمل مخرجًا ثم أصبح رئيسًا للدراما في القسم العربي. وكان معه مخرجان مصريان آخران هما عبدالرحيم الرفاعي وأنور شتا. ويبدو أن تعاوني في مجال الدراما بدأ بكتابة اسكتشات فكاهية في نطاق برنامج يسمى «في الإطار». ثم كان التعاون في مجال التمثيل. والحقيقة أن الطيب لم يكتشفني كممثل، بل كان هو وغيره يعهدون إليّ بأدوار ثانوية، وكنت أستمتع بذلك على سبيل الطرافة. فقد أدركت منذ البداية أنني قليل الموهبة في مجال التمثيل. ولكن في ما يتعلق بالطيب، فينبغي أن أذكر أن تلك الفترة شهدت ازدهاره كمخرج إذاعي وكروائي. فقد كتب حينذاك رواية «موسم الهجرة إلى الشمال»، وهي الرواية التي ملأت بشهرته الآفاق. أما من حيث الإخراج الإذاعي، فقد تمكن الطيب بفضل مواهبه وشخصيته من اجتذاب عدد كبير من ممثلي المسرح والسينما المصريين. في البداية استعان بعدد من المواهب المحلية مثل المخرجين المسرحيين المصريين أحمد عبدالحليم وأحمد زكي اللذين كانا يدرسان المسرح في لندن، وفاروق الدمرداش الذي أتى إلى لندن بعد أن أتم الدراسة في فرنسا. ثم وفد إلى القسم العربي بفضل الطيب صالح عدد من كبار الممثلين أذكر منهم - على سبيل المثال لا الحصر - سميحة أيوب، ويوسف وهبي، ومحمود المليجي، وصلاح منصور، وعماد حمدي. إذن كيف يمكن أن أصف نفسي كممثل بالمقارنة مع هؤلاء؟ اشتركت مع بعضهم في أدوار ثانوية كما قلت، وكانوا أناسًا طيبين فتقبلوا بسماحة جهدي المتواضع. وفي تلك الفترة بلغت الدراما الإذعية العربية أوجها عبر أثير الإذاعة البريطانية بفضل الطيب صالح. ولا بد أن أذكر في هذا السياق وفود عبدالرحمن الأبنودي مع الوافدين. فهو عندما ظهر اهتزت أسلاك الاتصال بين السوداني والصعيدي، وامتدت حبال الصداقة والحب. ثم طويت تلك الصفحة كما طويت صفحات أخرى. تقاعد الطيب وغيره من المخرجين، واضمحل شأن الدراما الإذاعية العربية إلى أن اختفت تماما.
- كانت الطبعة العربية مثل زميلاتها من طبعات «رسالة اليونسكو» باللغات الأخرى تطبع في باريس وفي مقر «اليونسكو» على وجه التحديد. فـ «اليونسكو»، لمن لا يعلم، كانت دار نشر كبرى. وأعتقد أن مشكلة الطبعة العربية بدأت عندما نقل طبعها وإصدارها إلى القاهرة بناء على طلب من مصر. وكانت لذلك الطلب بعض المبررات، أو ما بدا كذلك، ولكن الانتقال أدى إلى تأخير الصدور، وقلة الظهور وضعف التوزيع، بالإضافة إلى انخفاض المستوى من حيث الشكل بما في ذلك الألوان والتغليف وما إلى ذلك. وهو ما أدى أيضا إلى انتهاء دوري في المجلة. ومن حسن الحظ أنني نقلت إلى قطاع الثقافة حيث شغلت منصبًا أفضل، وهو الإشراف على إصدار طبعة عربية من عمل علمي كبير من ستة مجلدات عن مختلف جوانب الثقافة الإسلامية. وكان ذلك يقتضي الإشراف على تحرير وترجمة وإصدار أجزاء ذلك العمل الذي اشترك في تأليفه علماء من بلدان عديدة ومن تخصصات مختلفة في مجال الثقافة الإسلامية. وكانت تلك أسعد فترة من فترات عملي في «اليونسكو»، فقد أتاحت لي هذه الوظيفة أن أتعرف إلى أولئك الأساتذة الكبار وأن أناقشهم في ما كتبوا وأعرض عليهم اقتراحاتي وأبحث معهم وأتعلم منهم. وتركت «رسالة اليونسكو» إذن، ومن المؤسف أن المجلة توقفت عن الصدور في جميع طبعاتها. ويرجع ذلك إلى أن المنظمة رأت في تلك الفترة أن تتخفف بسبب قيود الميزانية من عدد من البرامج. وشمل هذا القرار مجال المطبوعات بصفة عامة، فتوقف عدد من الأعمال الجليلة عن الصدور مثل سلسلة الروائع الإنسانية.
- من المجالات الجديدة التي قررت اقتحامها في «ليالي الأنس» مجال الموسيقى، والموسيقى الكلاسيكية بصفة خاصة. وذلك موضوع تناوله كتاب غربيون هم أقدر مني على الكتابة فيه. ولكنني اخترت إلى الموضوع منفذًا لا يمكن أن أؤاخذ عليه، لأني لا أكتب عن موسيقار، بل أكتب عن رجل هاوٍ يتعلم ألف باء الموسيقى، فأخذت أصف تجربته كمبتدئ في سن الخامسة والأربعين، وأبرز الصعوبات التي يواجهها، وأبين تعثره وتخبطه، وتأرجحه بين نشواته وكآباته، وكل ذلك في سياق قصصي حي من فشل في الزواج، وبحث عن الحب، وصراع بين دوافع الرغبة والحرص على الوفاء؛ وكل ذلك عبر مشاهد تتراوح بين الهزل والجد، أو بين الكوميديا والمأساة. وليست الموسيقى في ما أرجو عنصرًا دخيلًا أو نابيًا في الرواية. وهي تمثل خيطًا رئيسيًا في ذلك النسيج المتشابك، خطًا يمتد من أغنية أسمهان «ليالي الأنس في فيينا» إلى موتسارت وبتهوفن وشوبرت.
- أنا أتقبل كل أنواع الموسيقى. تروق لي الموسيقى الشرقية – موسيقى الطرب – والموسيقى الغربية في أشكالها المتنوعة طالما كانت جيدة: البوب، والجاز، والموسيقى الكلاسيكية، بل وتعجبني أحيانا الموسيقى الهندية واليابانية القديمتين. والأمر يتوقف على الحالة النفسية. فللموسيقى في حياتي مراحل ومواسم تتغير فيها اهتماماتي من حال إلى حال. وأنا في الوقت الحاضر لا أسعى إلى الموسيقى المصحوبة بالغناء أو الرقص أو المؤلفة لهذه الأغراض. وإنما أسعى عند وجود الرغبة في الإصغاء والقدرة عليه إلى الموسيقى الخالصة المجردة. فهذه الموسيقى ليست في حاجة إلى رقص أو كلام، لأنها لغة في حد ذاتها، إلا أنها لغة من نوع خاص، فهي تتكلم وتحرك الفكر كما يحركه الأدب والفن وتطالب المستمع بأن يفهم، وإن كنا لا نفهم على وجه التحديد ماذا تقول. ولكن تلك هي طبيعة الموسيقى: تقول أشياء كثيرة لا حصر لها، وتفتح آفاقًا للفهم لا نهاية لها. وهي بذلك ترفض أن يحدها مدلول واحد أو معنى واحد، ولكن لذلك حديثا آخر. |
|
مؤلف المحمودي بالفرنسية طه حسين من الأزهر إلى السوربون
«زائرة الأحد» من روايات عبدالرشيد الصادق المحمودي
من مؤلفات المحمودي
من مؤلفات المحمودي
من مؤلفات المحمودي من مؤلفات المحمودي |