الكلفة الباهظة لعودة الإنسان إلى نفسه
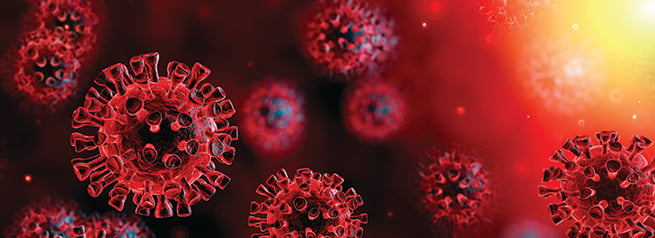
لشهور قليلة خلت، لم يكن ليخطر في بال أحد من المليارات السبعة، الذين يعيشون على ظهر هذا الكوكب الصغير، أن يصل الأمر بهم، إلى ما وصل إليه من هلع وارتباك وبؤس كارثي. صحيح أن الإنسان منذ هبط إلى الأرض، بفعل إثمه التأسيسي وخطيئته الأصلية، لم يجد فيها ما يعوّضه عن الفردوس الأول الذي تم خسرانه، ولكن ما عُرض عليه خلال إقامته المؤقتة على سطحها، هو على قلّته وشحّه ليس مطابقًا لمواصفات الجحيم، ولا يحتفظ في المقابل بسمات الجنة، بل هو يأخذ من كل منهما بمقدار، ويقع بشكل أو بآخر في منزلة بين المنزلتين.
هكذا كان على الأرض أن تشهد فترات مترعة بالرخاء والازدهار والأمان حينًا، وأن تقع تحت غائلة الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية، حينًا آخر. وما يحدث الآن لهذه الكرة التائهة في الخلاء الكوني ليس جديدًا بأيّ حال، ما دام التاريخ الذي تناهت إلينا بعض فصوله، حافلًا بالأهوال، وبلحظات كارثية غيّرت معالم الجغرافيا وخرائط الدول، وحوّلت الكثير من الحضارات إلى أطلال دارسة، كما هي حال عاد وثمود وطسم وجديس وإرم الغائصة تحت ركام الأزمنة، أو حال طوفان نوح الذي أطاح سكان المعمورة، ولم يترك من أجناسها وكائناتها الحية سوى ما يمنع تلك الأجناس من الانقراض.
ولطالما كانت علاقة الإنسان بالطبيعة محكومة بالكثير من المفارقات الصعبة والمحيرة. وقد بدت تلك المفارقة جليّة وملموسة منذ أقدم العصور، حيث كانت الكهوف هي المأوى النموذجي الذي يوفر للبشر التائهين في أدغال القلق والخوف، ما يحتاجونه من الدفء والأمان.
وهو ما يجعل العلاقة بين الطرفين شبيهة بالعلاقة بين الأم وطفلها، الباحث عبر هذه الكهوف عن سبيل رمزي للعودة إلى الرحم، حيث السكينة المطلقة والمياه الأصلية للتكوين. إلا أن للطبيعة - رغم ذلك - وجهها الآخر الذي لم يكن محصورًا بالأمان والألفة الوادعة، بل كان ينقلب على نفسه بين حين وآخر، متخذًا هيئة الأعاصير والصواعق والبراكين والسيول والزلازل، وغير ذلك من الكوارث الأبوكاليبسية التي تطيح حيوات ملايين البشر السادرين في غفلتهم، دون سابق إنذار. كما أن الأمراض والأوبئة الفتاكة، لم تقصّر من جهتها في تقليص مساحات الأمان المتاحة لسكان الأرض، وفي زهق أرواح الملايين منهم، بما يشبه المجازر المروعة أو أحكام الإعدام الجماعية.
إلا أن الأجيال التي تتقاسم الكرة الأرضية في هذه الحقبة من الزمن، لم يسبق لها أن اختبرت تجربة مروّعة كهذه التجربة، أو شهدت جائحة كتلك التي تحدث الآن وتودي بملايين المصابين إلى الهلاك.
صحيح أن عهد البشر بالأوبئة ليس بعيدًا جدًا، بل هو يعود إلى مئة عام خلت، حيث وقع عشرات الملايين من الأبرياء فريسة سائغة للإنفلونزا الإسبانية، لكنّ التطور الهائل للعلوم الطبية واللّقاحات المتنوعة، جعلنا نشعر أننا بتنا بعيدين جدًا عن متناول ذلك النوع من الكوارث، التي تبدو بالنسبة لنا قادمة من عصور أخرى لا سبيل إلى عودتها، شأنها في ذلك شأن ظواهر أخرى كالرسالات السماوية والمعجزات، والنذر الكارثية التي تسبق النبوات أو تليها.
عدو من نوع آخر
هكذا، وفي أوج غفلتنا وصراعاتنا القومية والإثنية والاجتماعية، وجدنا أنفسنا فجأة أمام عدو من نوع آخر، يجعلنا متساوين في مصيرنا الكالح، دون أن يميّز بين جبروت الجلادين وهشاشة الضحايا، بين المرابين الجشعين من أصحاب الثروات المكدسة، وبين الفقراء المعوزين. كما لا يميز بين النخب الأكثر ثقافة ومعرفة، وبين الجموع الغارقة في جهلها المطبق.
إن الهلع الذي يثيره الوباء الجديد في دواخل البشر، متأتٍ من إحساس الجميع بأنهم يخوضون حربًا غير عادلة مع المجهول واللامرئي والمتناهي الصغر. فأنت في حالة استنفار قصوى ضد لا شيء تقريبًا. لكن هذا اللاشيء قد يكون قادمًا من جهة ابنك أو أبيك أو أمك أو حبيبتك، بحيث يتحول الناس الألصق بقلبك إلى مجرد فزّاعات ناقلة لقُبل الموت أو مصافحات الرعب أو أنفاس الهلاك. وهذا اللاشيء جاهز كل لحظة للإطاحة بك قبل أن تصحو من ذهولك السادر، وقبل أن تجد المسوغ الأخلاقي و«القانوني» الذي يودي بك إلى مقصلة الإعدام. وإذا كانت الحياة تقلد الأدب في الكثير من وجوهها، فنحن جميعًا شبيهون ببطل كافكا في رواية «القضية»، الذي يُساق إلى محاكمة غامضة دون أن يعرف السبب، وتُلفق ضده تهم مختلفة لا علاقة له بها، وبمؤازرة شهود لم يسبق له أن عرفهم أو التقى بهم. ثم يتلقى وهو في حالة من الحيرة المطلقة، الحكم بإعدامه، دون أن يرتكب أي ذنب، سوى انتمائه إلى الجنس البشري. ثمة شعور بانعدام الجدوى ينتابنا جميعًا في هذه الفترة من تاريخ المعمورة، حيث الوجود نفسه لزج وسائل وقابل للتبخر في أية لحظة، وحيث كل شيء يفتقر إلى الصلابة والثبات اللازمين لقياس الموجودات والمفاهيم، كما لاختبار المشاعر.
وباء مشؤوم
إنها خفة الكائنات التي لا تُحتمل، على حدّ ميلان كونديرا. لا بمعنى الخفة الإيجابية والأثيرية التي تمنحنا - دون مقدمات - شعورًا غامرًا بالسعادة، ولا تلك المتولدة عن الإيمان والغبطة الروحية، ولا تلك التي نحسّها حين ننصت إلى صوت فيروز الملائكي، على سبيل المثال لا الحصر، بل هي تلك المتأتية عن الشعور بالهشاشة وانسداد الأفق، وصولًا إلى فساد النطف التكوينية المقذوفة باتجاه قدرها المأسوي، والتي ما تزال تسدد إلى ما لا نهاية «الفواتير» الباهظة المترتبة على الخطيئة الأصلية. إنها الهشاشة المتصلة بعبثية المصائر، حيث كل مجد باطل، وكل حقيقة تنقصها البراهين، وكل يقين مثلومٌ بالشكوك. فما قيمة أن يعثر الفقير على لقمة العيش، ويعثر المتبطّل على فرصة عمل، ويعثر التاجر على صفقة رابحة، والسياسي على منصب رفيع، إذا كان كل واحد من هؤلاء يشعر بأن هذا الوباء المشؤوم يكمن له عند كل خطوة أو منعطف، ويقوده خلال أيام إلى حتفه المحتوم. ومع ذلك فقد شرع «كوفيد 19» العلاقات الإنسانية على العديد من المفارقات الضدية، سواء تعلّق الأمر بالأفراد أم بالدول والجماعات. فالدول المتقدمة يتنافس بعضها مع الآخر، ليس فقط من أجل حماية أبنائها ومواطنيها، أو من إنقاذ الجنس البشري من التهلكة، بل من أجل الربح المادي الهائل الذي يحققه اقتصادها الوطني من جهة، ومن أجل تسجيل المزيد من نقاط التفوق على الآخرين في مجال الكشوف العلمية المتقدمة، من جهة أخرى.
نسخة معدّلة
بهذا يتواجه فوق ساحة واحدة الجشع مع الإيثار، والتضحية مع الأنانية، والشوفيني مع الإنساني. وما يصح على الجماعات يصح على الأفراد. فالآخر هو جحيم الأنا، فيما يخص انتقال العدوى، والصراع من أجل البقاء، والعثور على أفضلية ما في غرف العناية الفائقة.
ولكن الآخر أيضًا، وخصوصًا الذي يعمل في مجال التمريض والبحوث العلمية والجرثومية وأمراض المناعة، هو السند والظهير والباعث على الرجاء. تبدو الأرض من هذه الزاوية وكأنها نسخة جديدة ومعدّلة عن الـ «تايتانيك»، التي لا يملك ركابها الكثر سوى دفع الصراعات الإثنية والأيديولوجية والطبقية إلى الخلف، وجعل مهمة إنقاذها من الغرق الأولوية القصوى التي لا تُصيب هدفها إلا باستنفار كل ما يملكونه من معارف ومهارات وسبل للنجاة.
إلا أن للوباء الفتّاك، على خطورته، وجوهًا أخرى لا تخلو من الفائدة، شأنه في ذلك شأن كل مأساة مماثلة، حيث الحقيقة نسبية وحمّالة أوجه. ولعل من بين هذه الوجوه، بل وعلى رأسها، هو أن «كوفيد 19» كان الصدمة المباغتة التي أيقظت الإنسان الحديث والممعن في ثمله بإنجازاته العلمية والتقنية، من براثن الجبروت والزهو والصلف الطاووسي، وأوقفه على أرض الحقيقة الصادمة التي تعيده إلى حجمه الطبيعي، وتبيّن له مكامن ضعفه البشري.
هكذا تستعيد مقولة سقراط الشهيرة «اعرف نفسك» الكثير من وهجها وصوابيتها، بوصفها التحدي الأكبر الذي يواجه الإنسان في مسيرته الصعبة، والمفتاح الإلزامي الذي ينبغي امتلاكه للولوج إلى معرفة الوجود واكتناه ألغازه المحيرة. ففي ظل انتصار البيوت على الشوارع، والداخل على الخارج، أمكن للناس أن يستردوا ما خسروه من علاقاتهم الأسرية الحميمة، وأن يرفدوا الخلية الاجتماعية الصغرى بما يلزمها من أسباب التعاضد والحوار البنّاء وكسر الجليد بين الأجيال. وهو ما لم يكن ليتوفر تحت ضغط العمل الوظيفي والبحث عن لقمة العيش، أو الانهماك النرجسي بإرضاء الذات. وربما أدّى الانكفاء باتجاه البيوت إلى نتائج عكسية، تتمثل في اصطدام الإرادات والأمزجة بين أفراد الأسرة الواحدة الذين لم يسبق لهم أن عاشوا تجربة مماثلة من المساكنة الاضطرارية والروتين اليومي.
عزلة قسرية
لكن الوجه الأهم للصورة يتمثّل في أن العزلة القسرية قد وفرّت للبشر فرصة للقاء مع ذواتهم، كانت قد حرمتهم الأزمنة الحديثة من تحققها، بما يلازمها من ضجيج هائل ووتيرة متسارعة، ومن مفاهيم مادية بحتة، تضع الربح والمنفعة وحمّى الاستهلاك في رأس أولوياتها. ولا يعني ذلك بأي حال تخلّي البشر الآلي والتلقائي عن مثل هذه المفاهيم، بقدر ما يعني افتضاحها وانكشاف وهنها إزاء الأسئلة المتصلة بجوهر الوجود ومعنى الحياة الحقيقي. وإذا كنت في مناسبة سابقة قد حدست بانفجار إبداعي غير مسبوق، لا بدّ أن ينتج عن إخلاد الكتاب والمبدعين إلى عزلتهم الاضطرارية بفعل الوباء، فإنّ ملامح هذا الانفجار قد ظهرت طلائعها بالفعل في العالم العربي، ولا بدّ أن تتجه في الآونة اللاحقة إلى مزيد من التبلور، وهو ما بدأ يظهر جليًا في مجالَي الرواية والشعر على نحو خاص. وإذا كانت «الأولى» تتقدم على «الثاني»، من حيث غزارة الإصدارات التي ضخّتها دور النشر العربية في الفترة المنصرمة، مقابل قلة الإصدارات الشعرية، فالأمر عائد - في رأيي - إلى طبيعة الأدب الروائي نفسه، الذي تتسع دائرته لكل تفاصيل العيش ووقائعه ونثرياته الصغيرة، كما يمكن له أن يفيد من الفنون كلها، بما فيها الشعر والمسرح والرسم والمقالة والريبورتاج الصحفي والحكاية والقصة القصيرة، بما يجعله مرآة العصر وملحمته في آن واحد.
تناول سطحي
لا بدّ أن أشير، أخيرًا، إلى أن الأعمال السردية القليلة التي تصدت لجائحة كورونا على نحوٍ مباشر، بدت محكومة بالتسرع والخفة والتناول السطحي، كما هو شأن رواية «هي وكورونا» للكاتبة الفلسطينية إيمان الناطور، أو رواية «الوباء» للكاتب المصري محمد عبدالكريم. في حين أن الأعمال السردية الأكثر توهجًا وعمقًا، هي التي لم تجعل الوباء موضوعًا لها، بل توغّلت، بتأثير من العزلة الإلزامية المفروضة على كتابها، في الأحشاء القاتمة للواقع العربي الممعن في تأزمه، حيث لاذ الناس بمنازلهم تحت وطأة الشعور بالخوف وانسداد الأفق وانعدام اليقين، وحيث عادت السلطات السياسية العربية، أو البعض منها، لتُحكم قبضتها الصارمة مرة أخرى على رقاب البلاد والعباد، بذريعة الحرص على الأمن الصحي لرعاياها الخائفين على مصيرهم.
ومع ذلك فإنّ الواقع السوريالي الاستثنائي الذي نعيشه بفعل الوباء القاتل، لا بدّ أن يتمخض عمّا هو استثنائي في الأدب واللغة والفن، ونحن نأمل تبعًا لذلك ألّا يتأخر كثيرًا الوقت الذي يطالعنا فيه الكتّاب العرب بتحف أدبية مماثلة لتلك التي أنتجها كتّاب العالم الكبار في ظروف مماثلة، كما هو شأن «الطاعون» لألبير كامو، و«نهاية العالم» لستيفن كينغ، و«الحب في زمن الكوليرا» لماركيز، و«العمى» لساراماغو، وما يعادل ذلك في الشعر والمسرح والفنون
الأخرى ■


