جوزف صايغ بين أُصولية القوالب وحداثة الرؤى

في الخامس من نوفمبر 2020، رحل في باريس عن 90 عامًا الشاعر اللبناني جوزف صايغ، بعد إصابته بفيروس كورونا، فتحقّقت برحيله نبوءة أطلقها، ذات حوارٍ، أجرته معه جريدة الجـــريــــدة الكويتيــة، في 12 / 3 / 2008، بأنّه سيموت في الغربة. ويشغر في قلوب أصدقائه وعارفيه حيِّزٌ هو وقفٌ عليه. بين ولادته في زحلة عام 1930، ورحيله في باريس العام الماضي، تسعون عامًا، أمضاها في حركة دائمة بين المدينتين، مسقط الرأس ومسقط الأحلام. وكانت حركة فيها بَرَكة. استطاع فيها أن يجمع في شخصه ونتاجه بين الشرق والغرب، وتَوَزَّعَ نشاطه خلالها على الشعر والنثر والدّراسة والمحاضرة والصحافة والتعليم والدبلوماسية وغيرها، وتمخّضت عن غلالٍ طيّبة في هذه الحقول، المعرفية والعملية، المختلفة.
في مقاربة الغلال التي تراكمت على بيدر جوزف صايغ، طوال نيِّفٍ وسبعة عقود، هي عمر نتاجه الإبداعي والفكري، نُحصي ستّ عشرة مجموعة شعرية، أُولاها «قصور في الطفولة» الصادرة عام 1964، وآخرُها «شموع» الصادرة عام 2020. ونَرصد في النثر ثمانية كتب، تخوض في حقول النقد الأدبي، والذكريات، والانطباعات، والخواطر المرسَلة، والحوار الفكري، والمقالة الصحفية، والسيرة الذاتية، وغيرها، أوّلها «سعيد عقل وأشياء الجمال» الصادر عام 1955، وآخرها «يوميّات بلا أيّام» الصادر عام 2020. ونُورد في الدراسة والمحاضرة اثنتي عشرة دراسة ومحاضرة، باللغتين العربية والفرنسية، أُولاها «في صدد يارا» عام 1965، وآخرها «التمثّلات المتناقضة لتجلّيات التصوّر الديني» عام 1995.
حقول العمل
في الحقول العملية، عمل صايغ في الصحافة والتعليم والدبلوماسية؛ ففي الحقل الأوّل، تنقّل بين جريدة النهار والملحق الأدبي لجريدة الأنوار، ومجلة الجديد، ومجلّة النهار العربي والدولي، وتراوح عمله في هذه المطبوعات بين الكتابة والتحرير والإدارة.
وفي الحقل الثاني، مارس التعليم الثانوي في بعض الثانويات اللبنانية الخاصّة، والتعليم الجامعي، أستاذًا أو محاضرًا زائرًا، في عدد من الجامعات اللبنانية، والفرنسية، والأميركية، والصينية. وفي الحقل الثالث، تقلّب صايغ بين ملحقٍ ثقافي، ومستشارٍ تنموي، وسفيرٍ رديف، وعضوٍ في وفدٍ دبلوماسي. وإذا كانت الأعمال تنطوي بانطواء صفحة صاحبها، فإنّ ما يبقى، بعد انطواء الصفحة، هو الصفحات التي يدبّجها شعرًا ونثرًا، مما يشكّل موضوع مقاربتنا في هذه العجالة.
جوزف صايغ شاعرًا
على الرّغم من الحقول المعرفية التي أنتج فيها، والحقول العملية التي عمل فيها، فإنّ الشاعر فيه طغى على ما عداه من ألقاب. وهو المولود في زحلة، مدينة الشعر والشعراء. على أنّ علاقته بالشعر والفن والجمال تعود إلى مرحلة مبكّرة من العمر، وهو يسمّي مجموعته الشعرية الأولى «قصور في الطفولة»، ويربط بين الشعر والطفولة، بقوله:
طفولتي الشِّعرُ، ما إلاّهُ لي نَسَبٌ
في أبحرِ الشِّعرِ هبّي يا صَبا سُفُني
وتربطه علاقة جدلية بالجمال، تقوم على التفاعل والتكامل، فالجمال، بنوعيه الطبيعي والبشري، يلهم الشاعر، فيضمّه إلى قصيده، والجمال يستكمله ويعيده:
لا يُضاهي انتشاءَتي منْهُ إلّا
أنْ أضُمَّ الجمالَ طَيَّ قصيدي
مِثْلما لم يُضَمَّ صُنْعٌ، وأغوى
ربَّ صُنْعٍ مُسْتَكْمِلي، وَمُعيدي
والشاعر يُنتِجُ الجمال، بدوره، ويطمح أن يُذيقه الآخرين، ويبنيه قصورًا في الطفولة، وبيوتًا في سائر المراحل العمرية:
بيتي الجمالُ، طموحي أن أُذوِّقَهُ
من لم يَذُقْهُ، الألى هانوا، ولم أهِنِ
ولعلّ نشأةَ صايغ في زحلة، وتشبّعَه بجمال وادي العرايش، وَرُنُوَّه إلى وجوه الزحليّات الجميلات، وإقامتَه في باريس، وتمتّعَه بأناقة المدينة وعراقتها، واختلاطَه بالباريسيات الأنيقات، ناهيك باستعداداته الفطرية، هو ما جعله نِتاجَ الجمال ومُنتِجَهُ في آن، وهو ينظِم نفسه حين ينظِم الشعر اللذيذ:
أنظِمُني، فيما أنا أنظِمُ
صياغةً بلفظةٍ تَنْغِمُ
وعلى الرّغم من توافر الظروف الموضوعية والاستعدادات الذاتية لولادة الشاعر ونموّه في جوزف صايغ، فإنّ عمليّة النظم عنده محفوفةٌ بالصعوبة. وهي نوعٌ من تقصيب الماس، وهندسة الفوضى، وضبط العواطف المضطرمة. وبهذا المعنى، يكون مُقَصّبَ ألماس، وَمُهَنْدِسًا شعريًّا، وَضابطَ إيقاعٍ عاطفي. لذلك، يجتنب السهولة في شعره، ويؤثر الصعوبة، ويعبّر عن مذهبه الشعري بالقول:
أُحبُّهُ صعبًا، صَدوفًا، كما
يُقَصَّبُ الألماسُ، أو يُثْلِمُ
مهندسًا فوضايَ، أو ضابطًا
ما هيَّجَتْ عواطفٌ ضُرَّمُ
لعلّ هذه التقنيات هي ما يجعل شعره أقرب إلى الصّنعة منه إلى الطبع، سواءٌ على مستوى المفردة أو التركيب؛ فعلى المستوى الأوّل، يختار الفصيح، والأنيق من المفردات، ويشتقُّ الجديد من جذور اللغة، غير أنّنا لا نُعْدَم أن نرى في قصائده كلمات معجمية، غريبة.
وإذا كانت ممارسة الحرية في الاشتقاق تعكس نزوعًا حداثويًّا، فإنّ استخدام الكلمات المعجميّة يعكس أصوليّة لغوية واضحة، تُضاف إلى أصوليّته الوزنية، والأصوليّتان كلتاهما لم تؤثّر فيهما إقامتُه الباريسية الطويلة. وعلى المستوى الثاني، يُيَمِّمُ صايغ شطر التراكيب الصعبة، ويُنوّع في صِيَغِ الكلام، ويستخدم التقديم والتأخير، وينزاح بالمفردات داخل التراكيب عن مواضعها النحوية، محقّقًا بذلك شعرية الشكل، وينزاح بها عن معانيها المعجمية محقّقًا شعرية المضمون.
في الشكل، تتوزّع الأعمال الشعرية على قصيدة الوزن، والمسرحية الشعرية الأسطورية، والثُّلاثيّات، والنثر الشعري، والقصيدة المحكية. على أنّ هذه الأشكال الشعرية تتفاوت فيما بينها كمًّا ونوعًا؛ فتستأثر قصيدة الوزن بثلاث عشرة مجموعة شعرية، تُشكّل المسرحية الشعرية «قيلولة الصل» جزءًا من إحداها.
وتشغل «الثُّلاثيّات» المشتملة على مئة واثنتي عشرة ثلاثيّة إحدى هذه المجموعات. ويُفرِد الشاعر لقصائده المحكية مجموعة «شموع»، وهي الأخيرة في نتاجه الشعري. أمّا نثره الشعري، فَيُفرد له كتابين اثنين، هما «آن كولين» و«أرْز». ومع أنّ صايغ لم يكتب قصيدة النثر، ولم يكن من أنصارها، فقد أدرج الكتابين المذكورين ضمن أعماله الشعرية. وهو القائل في مقدّمة «الأرض الثانية»: «ليس الشعر نثرًا شعريًّا ولا هو بشعر منثور». لعلّ ذلك يعود إلى أنّ درجة الشعرية فيهما لا تقلّ عنها في قصائده الموزونة إن لم تتخطّاها في بعض الأحيان.
المرأة
في المضمون، تخوض الأعمال في موضوعات المرأة، والوطن، والعلاقة بين الشرق والغرب، وغيرها. وهذه الموضوعات تتفاوت حضورًا فيها. تستأثر المرأة، بما هي مخلوق جميل يعكس قدرة الخالق على الخلق، بالحيّز الأكبر من أعمال صايغ الشعرية. وينخرط معها في علاقة جدلية تقوم على الخلق المتبادل. هي تُوقظ خياله وتُذكي مشاعره، وهو يُغنّيها بشعره:
لقدْ أيقظْتِ للدنيا خيالي
فلم يلمحْ سواكِ بكلِّ حُسْنِ
وأذكيْتِ المشاعرَ في فؤادي
فغنّى فيكِ باللّحن الأغنِّ
والمرأة في شعره الموزون متعدّدة، وعصرية، وجسدية من لحمٍ ودم. تنتمي إلى الواقع بقدر انتمائها إلى خيال الشاعر. بينما نراها في نثره الشعري، في كتاب «آن كولين»، امرأة أثيرية، مثالية، تنتمي إلى عالم المثل والغيب والماوراء. والمفارِق أنّ هذا الكتاب النثر- شعري الذي لا يُعْتَبَر شعرًا، من منظور الشاعر نفسه، هو الأكثر ارتباطًا بصاحبه، دون سواه من الأعمال الأخرى، فما إن يُذكَر صايغ حتى يقترن به «آن كولين».
الشرق والغرب
الموضوع الثاني الذي يلي المرأة في الاستئثار بشعر صايغ هو العلاقة بين الشرق والغرب. وقد أفرد له «قصائد من الشمال» التي ذيّل بها مجموعته الشعرية الأولى «قصور في الطفولة»، ومجموعَتَيِ «القصيدة باريس» و«الديوان الغربي».
فالشاعر الآتي من شرقٍ يُكبّل أبناءه بالقيود، ويحدّ من قدرة الشاعر على التعبير، يصطدم بالجمال الغربي الباريسي، على أنواعه، البشري والعمراني والحضاري، ويترتّب على هذا الاصطدام الكثير من التردّدات الشعرية الجميلة التي يجمع فيها الشاعر بين القوالب العربية الأصيلة والرؤى الغربية الحديثة. والمفارِق أنّ صايغ عاش في الشرق غربة روحية، وعاش في الغرب غربة جسدية، فهو شاعر الغربتين، بامتياز. والمفارَقة الأخرى هي أنّه رغم إقامته في باريس منذ عام 1954 لم يتقدّم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية إلّا في عام 2012، أي بعد حوالي ستّة عقود على تلك الإقامة. لقد بقي لبنان نقطة ضعفه الأولى والأخيرة، وبقي ينازعه الحنين إلى منزله الأوّل، وقبر أمّه، ومدينته الأولى. وَحَسْبُنا الإشارة، في هذا السِّياق، إلى أنّه أوصى أسرته، في حال موته في الغربة، كما تنبّأ ذات مقابلة، أن يتمّ نقل رفاته إلى لبنان.
الوطن
من هنا، يُشكّل الوطن الموضوع الثالث الذي يستأثر بشعر الشاعر. وهو يتناوله بقصيدة الوزن من خلال مجموعة «زحلة القصيدة» التي يتغنّى فيها بالمدينة، ويبثّها لواعج الحنين من باريس، ومن خلال قصائد متفرّقة في المجموعات المختلفة. ويتناوله بالنثر الشعري من خلال كتابه «أرز» الذي ينحو فيه منحًى إنشاديًّا في تمجيد رمز الوطن، ويحتفي بعراقته التاريخية، وجماله الحاضر، وخلوده المستقبلي.
إلى ذلك، ثمّة موضوعات أخرى كثيرة تُشكّل أجزاء من همّ صايغ الشعري. فهو يطرح أسئلة الإنسان، والوجود، والكون، والحياة، والموت، والحق، والحقيقة، وغيرها، ممّا لا يتّسع المقام لذكرها.
صايغ ناثرًا
وبعد، إذا كان لقب الشاعر قد طغى على صايغ، فإنّ هذا اللقب، على جماله وكثرة الراغبين فيه، لم يكن ليستوعب الرجل. لذلك، لم يقتصر فِعْلُ وجوده على الشعر، وهو الذي برع فيه وحاذى كبار الشعراء، وعشق الجمال وصاغ أجمل المنحوتات الشعرية.
صايغ تعدّى الشعر إلى النثر الفني، والنقد الأدبي، والذكريات، والانطباعات، والخواطر المرسَلة، والحوار الفكري، والمقالة الصحفية، والسيرة الذاتية، وسواها من الحقول المعرفية المتنوّعة التي خاض فيها خوض قديرٍ محترف، وعاد منها بما يبقى في الأرض وينفع الناس، ولا يذهب جفاءً كالزبد، على حدّ تعبير الآية القرآنية الكريمة. وهو، فيها جميعًا، يتحرّك بين مجموعةٍ من الثنائيات، ويحافظ على التوازن بينها ببراعة واقتدار. وفي هذه الثُّنائيّات: الشرق / الغرب، لبنان / فرنسا، زحلة / باريس، الأوزان العربية / الرؤى الغربية، اللغة الأصيلة / الصور المبتكرة، الشكل / المضمون، وغيرها.
- في نثره الفنّي، كما يتمظهر في «آن كولين» و«أرْز»، هو شاعر بامتياز. يرتقي بالنثر إلى مصاف الشعر، ويتجاوزه في أحيانٍ كثيرة.
- في نقده الأدبي، كما يتمظهر في «سعيد عقل وأشياء الجمال»، ينحو منحًى إنسانيًّا جماليًّا، ويعيد إنتاج النصّ المنقود، على طريقته، وفي ضوء مقتضيات الفن والجمال.
- في خواطره المرسلة، في «مجرّة الحروف»، هو جامعٌ مانع، طارحُ أسئلة، ومُنْتِجُ أفكار. في ذكرياته وانطباعاته، في «معيار وجنون»، هو باريسيٌّ بامتياز.
- في «حوار مع الفكر الغربي»، هو مُحاوِرٌ بارعٌ من موقع النَّدِّ للنَّد، دون عُقَدِ نقصٍ أو خوفٍ أو انبهارٍ بالآخر الغربي. ولا يحولُ عُلُوُّ مقام الضَّيف المحاوَر دون مساجلته، ومخالفته الرأي، إذا دعَتِ الحاجة.
- في مقالاته، في «الوطن المستحيل»، هو مُساجِلٌ، مُسايِفٌ، غاضب. وفي يوميّاته الفكرية، في «يوميّات بلا أيّام» تُطِلُّ جوانبُ من سيرتِهِ الذاتيّة الفكريّة، الغنيّة والمتنوّعة.
وعودٌ على بدء، جوزف صايغ شاعرٌ كبير، جمع في شخصه بين الشرق والغرب، وواءم في شعره بين القوالب الأصولية والرؤى الحديثة، وحوّل الجمال، بنوعيه الطبيعي والبشري، إلى جمالٍ لُغَوي، اسمه الشعر. وهو، إن رحل منه الجسد، يحيا في شعره، ويقيم فيه، مصداقًا لقوله
في الشِّعْرِ أحْيا
أنا بيتي هوَ الشِّعْرُ
كَما بِمَسْحورِ بِلَّوْرِ الرُّؤى السِّحْرُ ■

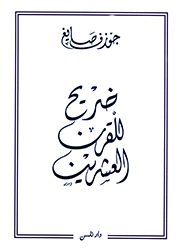


تمثال جوزف صايغ في حديقة الشعراء - زحلة

