كينونة الأمة كينونةُ ثقافتها
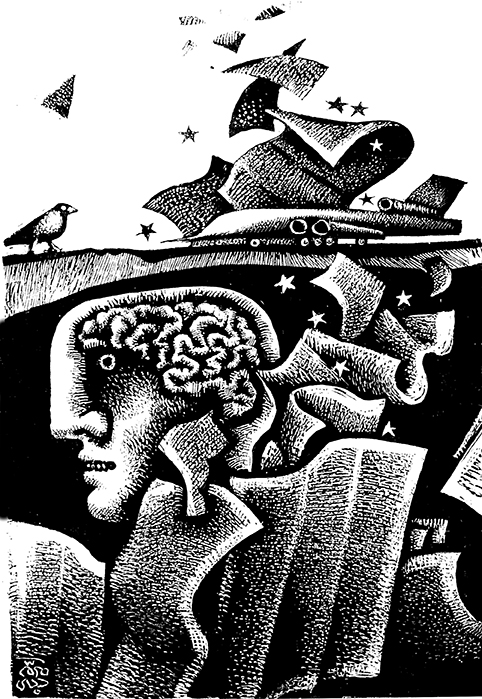
الثقافة في أيّة أمة من الأمم هي فكرها المتحوِّل سلوكًا، وهذا السلوك يتحوّل تراثًا تتميّز به الأمة عن الأمم الأخرى، ويبقى هذا التراث علامة وجود هذه الأمة. ومن مراقبة سلوك الأمة خلال مسيرتها التاريخية تتوضحُ معالمُ ثقافتها المتراكمة عبر تجربتها التاريخية، وقتَها تستطيع من خلال السلوك المتراكم تاريخيًا أن تحدّد شخصية الأمة وسلوكها، وتكون ثقافتها تعبيرًا عن حقيقتها كلّما مرّت الأمة خلال تاريخها الطويل بنكسات وصعوبات ومَآلات سياسية قاسية، قد تمسُّ سلوكها. لكن أصالة ثقافتها وارتكازها الأبعد في عمق وجودها التاريخي تصحح ما اعوجّ من سلوك التجربة التاريخية الصعبة.
لا تستطيع الثقافة تصحيح سلوك أمة إلّا إذا كانت ثقافة تقدمية وإبداعية في آنٍ. وتقدمية الثقافة تعني صيرورتها التصاعدية باستمرار، وعدم ركودها في معطيات تجاوزتها تجربة الأمة من خلال احتكاكها بالواقع المتجدد باستمرار.
إنّ قدرة الثقافة على تصحيح مسيرة أمةٍ تعني أنّ هذه الأمة جديرة بالبقاء، وجديرة بالانتماء لمعطيات الزمن غير المتنافرة مع كينونتها الأولى، وبهذا المنظار سأحاول في هذه الدراسة تقييم تجربة أمتنا العربية عبر تاريخها الطويل.
كينونة عميقة
قبل كلّ شيء أريد أن أؤكد حقيقة لا يستطيع أحد التنكرَ لها مهما كانت ميوله ومشاربه الثقافية، وهذه الحقيقة هي أنّ أمتنا استطاعت المحافظة على كينونتها الثقافية والوجودية وسلوكها في أزمنة تعرّضت فيها لمحاولات مَحْوِها، وتعرّضت لأبشع أشكال الاستعمار الوافد إلى جغرافيّتها ووجودها من جغرافيات غير عربية، نعم، تراخى كثيرٌ من الحكام وزُمَرُهم أمام الغزاة، ومرَّ على تجربة الأمة الحضارية ساقطون وخَوَنة، أمثال أبي رغال وابن العلقمي، وارتبطوا بالاستعمار الوافد، لكنّ الكينونة العميقة لهذه الأمة ظلت متمركزة في الوجدان الجمعي وغير قابلة للنسخ والتحول إلى الأدنى، وسبب ذلك أصالةُ ثقافةِ الأمة العربية وحمْلُها القيم الكبرى التي تؤكد إنسانية الإنسان.
إنّ أخلاقية الثقافة العربية هي التي حَمَتْ أمتنا من الانهيار، وأخلاقية الثقافة شرطٌ أساسيٌّ لبقاء الأمة، وتتحوّل الأخلاقية الثقافية مع الأيام إلى رسالة تحافظ عليها الأجيال المتعاقبة، وتصبح أخلاقية الثقافة ذات عمرٍ مديد، وتدخل في تركيبة الفرد والجماعة على السواء.
وحين تفقد الثقافة أخلاقيتها تتحول معيقًا لمسيرة الأمة وانتمائها إلى الإنتاج الحضاري، الذي تساهم في إيجاده مع الأمم الأخرى.
لقد مرّ في جغرافية هذه الأمة، لا في وجدانها، أحباش مع فِيَلَتِهم، ومرَّ فرسٌ وسلاجقة وبويهيون ومغول وعثمانيون واستعمار غربي واستيطانٌ استعماري صهيوني، ورغم كل ذلك ما زال الطفل الفلسطيني يحمل بيده اليسرى مصاصة الحليب، وبيده اليمنى حجرًا يقذف به الدبابة الصهيونية الغازية، لأنّه سليل ثقافة مقاوِمة تناهت إليه كابرًا عن كابر، وثائرًا عن ثائر.
ولو تأملنا بدقّة عملية «سلفيت» التي قام بها الفتى عمر أبو ليلى ببطولة خارقة، لعرفنا معنى أخلاقية ما ورث عن أهله وشعبه الأصيل الذي جعل المقاومة ثقافته، ولأدركنا معنى كلمات أمّه في رثائه حين أعطت للأمومة مفهومًا فلسطينيًا أعجزَ أعداءَ الأمة عن فهمه واستيعابه.
والأمثلة لا تُحصى لأنّها كانت تعبيرًا عن حركة الأمة المنبجسة والنابعة من ثقافتها الأخلاقية الإبداعية المتقدمة باستمرار إلى الأمام، والمرتبطة بالقيم الإنسانية العليا، بالحرية والعيش الكريم والانتماء إلى الإنسان.
لم تستطع القرون الطويلة التي تعرّضت فيها أمّتنا لأبشع محاولات الإلغاء أن تمحو ثقافة هذه الأمة، وهذا يعني أنّها لم تستطع إلغاء وجود هذه الأمة وحضورها التاريخي. فما هي عناصر قوة هذه الثقافة التي صانت وجود الأمة وحمَتْها من الامِّحاء؟
أخلاقية الثقافة العربية
إنّ أخلاقية الثقافة العربية هي التي حفظت وجودها، وهذه الأخلاقية تحوّلت إلى سمات ومفاهيم فكرية وسلوكية، وقد صدق أحمد شوقي حين قال:
وإنّما الأمم الأخلاق ما بقيتْ
فإنْ هُمُ ذهبتْ أخلاقُهمْ ذهبوا
ومن أبرز سِمات شخصية الأمة العربية الأخلاقية الإيمان بالحرية أولًا، وامتزجت الحرية في الوجدان العربي بالتجربة النضالية التي كانت سياجًا لحماية الأمة من الزوال. وكانت الشهادة ثمن الذوْد عنها، وهذه السمة العظيمة المتجسدة بالحرية فكرًا وسلوكًا جعلت العرب يذودون عن ديارهم وقيمهم منذ العصور التي سبقت مجيء الرسالة الإسلامية. أي منذ ما نسمّيه خطأ «العصر الجاهلي». ومن أبرز الأدلة على إيمانهم بالحرية والدفاع عن الوطن معركة «ذي قار».
في هذه المعركة دافع العرب عن أرضهم وعِرضهم، ولعل الشاعر الشيباني عبَّر بعمق عن معنى ورمزية معركة ذي قار حين قال مخاطبًا الفتاة العربية التي استقبلت المنتصرين في هذه المعركة:
إنْ كنتِ ساقيةً يومًا على كرَمٍ
فاسقي فوارسَ من ذُهْلِ بنِ شَيْبانا
واسقي فوارسَ حامَوْا عن ديارِهِمُ
واعلي مفارقَهمْ راحًا وريحانا
كانت معركة ذي قار دفاعًا عن الأرض والعِرض، وفيها قال الرسولُ العربي : «هذا أولُ يومٍ انتصفَ فيه العربُ من العجم». وكان قائد المعركة هانئ بن مسعود الشيباني قد نصبَ خيمته في أرض المعركة، وقال كلمته الشهيرة: «واللهِ لن أهربَ حتى تهربَ هذه الخيمة».
كان العرب يقتتلون فيما بينهم، فإذا دهمَهم خطر أجنبي قاتلوا تحت راية واحدة. ونقرأ في التاريخ أن قبيلة تغلب النصرانية قاتلت مع خالد بن الوليد في معركة اليرموك ضدَّ الروم أبناء دينهم. لقد انتصروا لعروبتهم أولًا وأخيرًا.
لقد كان إيمان العربي بحريته مفضَّلًا على الحياة نفسها، ومعروفٌ أنّ عنترة بن شداد لم يصبح فارس قومه إلّا بعد أن نال حريّته، وقد كان أبوه يراهُ عبدًا لأنّ أمّه كانت أَمَةً سوداء، وحين غزا بنو طيّ قبيلة عبس، انهزم بنو عبس وتعرّضت محارمهم للسّبي، ونادى شداد ابنه عنترة، وهو يعلم مدى شجاعته، وقال له: يا عنتر كُرَّ، أي اهجم على العدو وانصر قومك، فقال له عنترة مبيِّنا لأبيه أنّ الحرية وحدها هي التي تهبه قوّة الانتصار، لأنّ العبيد لا ينتصرون، فردّ على أبيه وقال له: «إنّ العبدَ لا يُحسنُ الكَرّ، وإنما يُحسِنُ الحَلبَ والصرّ» فقال له أبوه: «كُرَّ، وأنت حُرّ» فكَرَّ على أعداء قومه وقلب الهزيمة نصرًا حين صار حُرًّا.
ثقافة مجتمع
كانت ثقافة العرب الموروثة تدعو باستماتة للدفاع عن العرض، لأنّ أعراضهم هي امتدادٌ لحرياتهم، ولأنّ صون العرض في ثقافتهم كان شرفًا لا يمكن المساسَ به، وكان يعني امتداد القيم التي تغطي مساحة النفس والأرض في آن.
وكان الدفاع عن المحارم أغلى وأعلى من الحرص على الحياة نفسها، كان العرب في معاركهم يضعون نساءهم خلفهم، وكان هذا يعني أنّهم إذا انهزموا فستكون نساؤهم سبايا في يد المنتصر.
وقتها لا يستطيع العربي أن يرفع رأسه لأنّه أصيب بمهانة عرضه. كان فقدُ المحارم في الحرب يعني هزيمة النفس أمام التراث المحافظ على الشرف، وكان يعني سقوطًا لا يمكن الاستواء بعده. وكان الالتزام بالذود عن المحارم ثقافة المجتمع العربي كلّه، وقد استطاع العربي أن يحوّل هذه الثقافة التراثية إلى سلوك مستمر بتعاقب العصور والأجيال. العِرض كان يعدل الحياة نفسها عند الإنسان العربي، بل ويفوقها، يقول عمرو بن كلثوم في معلّقته الشهيرة:
على آثارنا بيضٌ حِسانٌ
نُحاذرُ أنْ تُقَسَّمَ أو تهونا
يَقِتْنَ جيادَنا ويقُلن لستمْ
بعولتنا إذا لم تمنعونا
إذا لم نَحْمِهنَّ فلا بقينا
لشيءٍ بعدَهنَّ ولا حَيينا
ومعروف أنّ عمرو بن كلثوم التغلبي قتل ملك المناذرة عمرو بن هند، لأنّ أمّه قد أهانت أمّ الشاعر، وفي ذلك يقول في القصيدة نفسها:
أبا هندٍ فلا تعجلْ علينا
وأنْظِرْنا نُخَبِّرْكَ اليقينا
تهدّدُنا وتوعِدنا رويدًا
متى كنّا لأمِّك مقتوينا؟
ولعلّ نداء امرأةٍ قرشية من أقاصي الأناضول، ومن «زبطرة» في بلاد الروم، وهي تستصرخ الخليفة العباسي المعتصم في بغداد: «وامعتصماه»، نعم كان هذا النداء محرّكَ ومسبّبَ معركة عمورية الشهيرة التي قال فيها أبو تمام رائعته:
السيفُ أصدقُ أنباءً من الكتُبِ
في حدِّهِ الحدُّ بين الجِدِّ واللعبِ
آلة الحياة الكريمة
كانت الشجاعة هي آلة العيش في حياة العرب الصعبة، وكانت ثقافتهم السلوكية، وبها صانوا حريّاتهم وأعراضهم، فلن يسلم الشرف من الهِنات والأذى «حتى يُراقَ على جوانبه الدمُ» كما يقول المتنبي. نعم كانت الشجاعة آلة الحياة الكريمة في الوجود العربي ثقافة وسلوكًا، وكان الجبن نقيضَ الشجاعة، وكان يعني امِّحاء شخصية الإنسان، وتعرّضه للتلاشي، وكان الجبن ضد الثقافة العربية، وضد سلوك العرب، وكانوا يرون الحياة في الإقدام، ولا معنى لحياةٍ آلتها الجبن والتخاذل، وكانوا يعتبرون الموت حياةً حين يكون الموت ترجمة لسلوك تستحقه الحياة، ومن روائع كلامهم في هذا المجال قول الشاعر:
تأخرتُ أستبقي الحياةَ فلم أجدْ
لنفسي حياةً مثلَ أن أتقدّما
هذا البيت شاهد على أنّ الموت حياة إذا كان في سبيل القيم العليا، فالشاعر في هذا البيت الخالد فكّرَ بالهرب ليصون حياته ويستبقيها، لكن ثقافته الموروثة من حياة شعبه أقنعته برفض فكرة الهرب، وأقنعته أن يتقدم ليجد حياته الحقيقية، فطلب الموت لتوهبَ له الحياة. وكان بفطرته مؤمنًا بحتمية الموت، ولا مفرّ من مواجهته، وإذا لم يكن هناك مجال لتجنّب الموت «فمن العار أن تموت جبانا»، وكان عنترة يلوم مَن كانت تخوّفه من الموت، وكان يجيبها بقوله وفعله:
بَكَرتْ تُخَوِّفُني الحتوفَ كأنني
أصبحتُ عن غرَضِ الحتوفِ بمعزلِ
فأجبتُها: إنّ المنيةَ منهلٌ
لا بدّ أن أسقى بكأس المنهل
فاقنَي حياءك لا أبًا لك واعلمي
أني امرؤٌ سأموتُ إن لم أقتَلِ
ولهذا الإدراك العميق لحتمية الموت كانوا يستعينون عليه بالصبر والمجاهدة وإقناع الذات الواقفة في مجال الموت، والمؤمنة بحتميته، وعدم القدرة على اقتراض يوم واحدٍ لإطالة الحياة وتجنّب الموت، ولأنّ ذلك أمر غير مستطاع، فلا بدّ من موت يعدل الحياة نفسها، ولا مجال سوى مجابهة الحقيقة بالحقيقة الكبرى، كما يقول قطري بن الفجاءة:
فإنّكِ لو سألتِ بقاءَ يومٍ
من الأجلِ الذي لك لم تُطاعي
فصبرًا في مجال الموت صبرًا
فما نيلُ الخلودِ بمُستطاعِ
صحيح أن مواجهة الموت صعبة، لكن بالمراس ومغالبة الدوافع الآمرة بالنكوص تثبتُ النفوس وتستعيد قدرتها على المواجهة، ويهدأ روعها، فالحياة عادة تمارسها النفس وكأنها كائن مفصول عن الجسد في ساعة المواجهة، وبالعناد الملتزم تستطيع الاتفاق معها، وبهذا تكون الشجاعة من أعلى مسالك الثقافة العربية وأصعبها إتقانًا، وهي لصيقة بالخوف في كثير من مراحل نشوئها، وقد تبلغ القلوب الحناجر في مواجهة الموت، لكن بإدمان الشجاعة حين يمارسها المرء تصبح تعبيرًا مقبولًا في داخل الذات الإنسانية، وتصبح هدفًا مطلوبًا لحفظ ما لا يُحفظ إلا بالإقدام وخوض غمار تجربة الحياة والموت في آنٍ. ولنستمع معًا للمغزى العميق النابع من قول الشاعر، وهو يخاطب نفسه في المعركة، وقد هيمن عليها الموت:
وقوْلي كلّما جَشَأتْ وجاشتْ
مكانَكِ تُحْمَدي أو تستريحي
الثبات هنا هو الخيار الرائع والمؤدي إمّا إلى راحةٍ بالموت أو حمدٍ بالحياة. وهما ثنتان لا بدّ من قبول إحداهما، وحين تستبد أخلاقية الثقافة بالموقف الإنساني يستطيع الإنسان أن يكفل الخلود للقيم التي يؤمن بها، والتي استُشهِد في سبيل صونها. ومن أعمق المعاني التي تعانيها النفس أثناء المعركة ما قاله أبو تمّام في قصيدة يرثي بها محمد بن حميد الطوسي، الذي آثر الموت على الفرار في المعركة، يقول أبو تمام:
فتىً مات بين الطعنِ والضربِ ميتةً
تقومُ مقام النصرِ إنْ فاته النصرُ
وقد كان فوتُ الموتِ سهلًا فرَدّهُ
إليهِ الحفاظُ المرُّ والخلُقُ الوعْرُ
وأثبتَ في مستنقع الموتِ رجله
وقال لها من تحتِ أخمصِكِ الحشرُ
تَرَدَّى ثيابَ الموتِ حمرًا فما دجا
لها الليل إلّا وهي من سُنْدسٍ خضرُ
نعم، «ما مات من رُثِيَ بمثل هذا الشعر»، هذا ما قاله من دخل في أسرار هذه الأبيات ورمزيّتها، وكما رأينا، فأبو تمام في هذا الرثاء يربط بين الشهادة والإيمان، كما يتجلى في البيت الأخير من الأبيات التي ذكرناها، ففي الجنة ثيابه «من سندس خُضرُ».
كانت الشجاعة في الثقافة العربية محاولة لإلغاء الموت، ونحن ما زلنا نذكر أولئك الذين ماتوا دفاعًا عن الحق والقيم العليا.
الشهامة
كان من أعلى صفات الشجاعة العربية وأخلاقيتها الشهامة، والشهامة تعني حُسن القول وحسن السلوك، وعدم التجني على حقائق الآخرين، ولو كانوا خصومًا، فلم يكن العربي يحتقر خصمه لأنه خصم، ولم يكن يُلصق به الصفات المنحدرة، وهذا طبعًا مرتبط بأخلاقية التكوين وجَعْلهِ سلوكًا.
كان عنترة مثلًا يصف بطولة خصمه ونبله وكرامته، وفي هذا إكبار لعنترة نفسه، فقد انتصر على فارس شجاع، وليس بجبان رعديد، فهو في معلّقته يصف بطولة خصمه وتفرّده ونبله، فيقول:
ومدجَّجٍ كرهَ الكُماةُ نزالَهُ
لا مُمْعنٍ هربًا ولا مُستسلِمِ
فشككْتُ بالرمحِ الأصمِّ ثيابَهُ
ليس الكريمُ على القنا بمُحَرَّمِ
عنترة يصف شجاعة خصمه، فالفرسان يخشون منازلته، وهو لم يهرب مرّة واحدة في حياته، ولم يستسلم أبدًا، وهو إنسان كريم «ليس الكريمُ على القنا بمحرّمِ».
والشاعر عباس بن مرداس يصف خصوم قومه، ويعترف بأنهم أشدُّ ثباتًا في المعركة من قومه، وفي شهادته تتكشف أصالته وأصالة قومه، يقول في خصوم قبيلته:
سقيناهمُ كأسًا سقوْنا بمثلها
ولكنّهم كانوا على الموت أصبرا
إنّ هذه الصفة التي تنصف الخصم، وتعلي قدره تحمل بُعدًا أخلاقيًا قلَّ نظيرُه عند كثيرين، ولا يتحلى بها إلّا شعبٌ ذو خلق عظيم.
أعلى صفات الإنسان
وقد اتصف العرب بالكرم، رغم جفاف معطيات الحياة التي يعانونها في جغرافية فقيرة الموارد، ورغم هذا كله فقد اشتُهِرَ العرب بالكرم إلى حدِّ الإيثار، ولو كان بهم خصاصة.
فقد اعتز العرب جميعًا بحاتم الطائي بسبب كرمه، وقصصه كثيرة في مجال الكرم الذي يُجمع العرب على جعله من أعلى صفات الإنسان. كان حاتم الطائي يقول لعبده في الليلة القارسة:
أوقدْ فإنَّ الليلَ ليلٌ قَرُّ/ عسى يرى نارك من يمرُّ/ إنْ جلبتْ ضيفًا فأنت حرُّ
وأحبّ العرب جميعًا حاتم الطائي، لأنه كان يحمل الصفة التي يفتخرون بها، ويعتبرونها فضيلة متقدمة، وقد أطلق الرسول الكريم سراح ابنة حاتم الطائي إكرامًا لسُمعة أبيها، وقال للمسلمين "خلّوا سبيلها، إنّ أباها كان يحب مكارم الأخلاق". وقصيدة الحطيئة مشهورة في وصف البدوي المعدَم الذي جاءه ضيفٌ، ولا طعام عند هذا البدوي لإطعام ضيفه، ونستمع لابن هذا البدوي وهو يقول لأبيه:
وقال ابنُهُ لمّا رآهُ بحيرَةٍ
أيا أبتي اذبحْني ويَسِّرْ له طعما
فروّى قليلًا ثمّ أحجمَ برهةً
وإنْ هو لم يذبحْ فتاهُ فقد هَمّا
لاميّة العرب
اتصف العربي في صحرائه بالعفّة وعزّة النفس والتسامي على الدنايا، وقد أحب الرسول العربي محمد بن عبدالله هذه الصفات في الإنسان العربي، وكان يتمثَّل بقول عنترة الشاعر الجاهلي:
ولقد أبيتُ على الطوى وأظلُّه
حتى أنالَ به كريمَ المأكلِ
وكان الشاعر الصعلوك الجاهلي، الشنفرى، يماطل الجوع حين يستبدُّ به، ويستفُّ التراب حين يجوع، ولا يطلب معروفًا من أحد لكيلا يكون ذليلًا، وكان يقول في لاميّته الشهيرة، التي سُمِّيتْ لاميّة العرب:
أُديمُ مِطالَ الجوعِ حتى أميتَهُ
وأضربُ عنه الذكرَ صفحًا فأذهلُ
وأستفُّ تُرْبَ الأرض كي لا يُرى له
عليَّ من الطَوْلِ امرؤٌ متطوِّلُ
«اقتُلْ أسيركَ»
إغاثة الملهوف ومنَعة المستجير، كان العرب يضعون حياتهم صونًا لعهودهم ووفاءً لمن وثق بهم، كانت إغاثة الملهوف تكلّفهم حيواتٍ كثيرة، وهذا معروف في أخلاق العرب وسلوكهم.
لقد كان طرفة بن العبد يرى أنّ نجدة المستجير إحدى غايات حياته ومبررات وجوده، وكان لا يحفل متى قام عوَّدُهُ لولا خصاله العالية، وأهمّها نجدة المستغيث:
وكرّي إذا نادى المضافُ محنَّبًا
كسِيدِ الغضا ذي السَوْرةِ المتورد
وكان شاعر آخر يقول متباهيًا بنجدة قومه من استجار بهم:
إني لمنْ معشرٍ أفنى أوائلَهمْ
قيلُ الكماةِ ألا أين المحامونا
وقصة السموأل بن عادياء مشهورة حين طلب منه الحارث بن ظالم دروع امرئ القيس، وإلّا قتل ابنه الأسير بين يديه، ولم يتنازل السموأل، وقال للحارث بن ظالم: «اقتلْ أسيركَ إنّي مانعٌ جاري».
لقد ركّزنا على الشعر في تسجيل مكارم العرب وأخلاقهم، لأنّ الشعر كان ديوان العرب، وكان تاريخهم، وكان وسائل إعلامهم، وبالشعر كانوا يسجلون مآثرهم، وكانوا يحبّون الشعر حبًا جمًا. ولهذا لجأنا إلى الشعر شاهدًا على أخلاق العرب، فالكلمة عندهم كان لها قدسية لا تُدانى، والذي يحترم الكلمة يكون مُجبرًا على تحويلها سلوكًا ■

