بوادئُ الكتابة
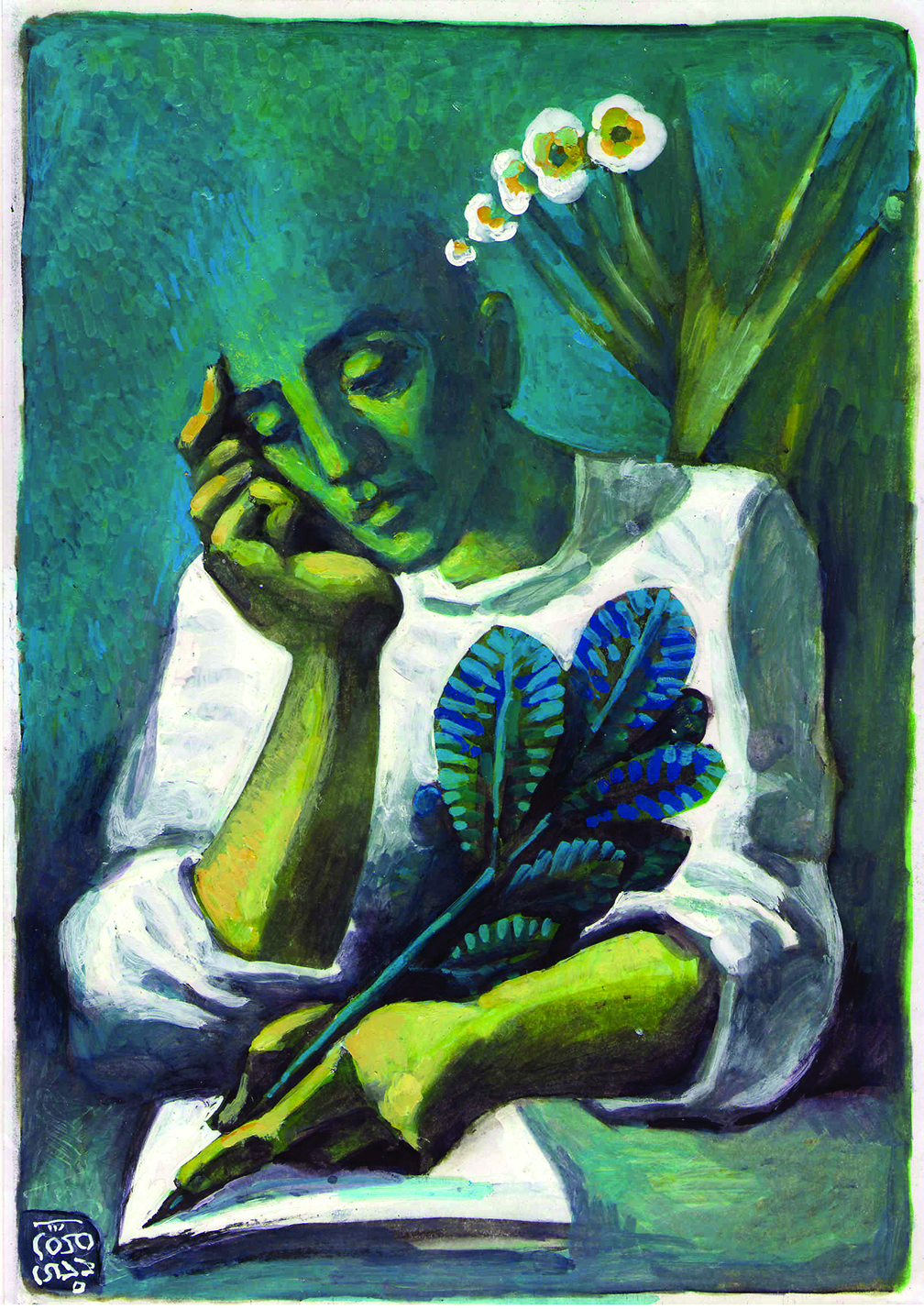
لا أعرف متى سعيتُ إلى أن أكتُب على وجه التحديد، ربما كان أول ما يلمع في ذهني بعد كل هذه السنوات البعيدة، هو أنني كنتُ أميلُ إلى الكتابة القصصية، وربما كان ذلك بسبب الحكايات التي كنتُ أسمعها من جدتي. ويبدو أن كل جدّاتنا قد علمننا القص على نحوٍ أو غيره. وأقول هذا بعد أن تذكرتُ على الفور ما كتبته أُستاذتي الدكتورة سهير القلماوي من حكايات قصَّتها عليها جدتها، وظلت في ذاكرتها حتى وجدت دفعها إلى كتابة عملها الأدبي الأول بعنوان: «أحاديث جدتي». والحق أنني بعد أن قرأتُ هذا العنوان أخذتُ أفكر فيه، وأدرك أن أكثرنا قد استمع إلى القص من أحاديث جدته.
هذا هو ما حدث لي شخصيًّا، فأنا أُشبه سهير القلماوي في هذا الجانب وتعلمتُ مثلها من القص الذي كانت تحكيه جدتي. ولحسن الحظ جاء بعد ذلك ما شدَّني إلى القص، وكان عملًا إذاعيًّا رائعًا بعنوان «ألف ليلة وليلة». أقصد إلى المسلسل الإذاعي الشهير الذي أحاله الإذاعي الرائد طاهر أبو فاشا إلى حلقات إذاعية كانت تُذاع في شهر رمضان المبارك، فنجتمع نحن الأطفال حول الراديو فورًا، بعد أن نسمع المقدمة الموسيقية المأخوذة من سيمفونية «شهر زاد» للموسيقي الروسي العظيم نيكولاي كورساكوف، الذي عاش في الفترة من سنة 1844 وحتى سنة 1908، وقد كتب موسيقاه متأثرًا بـ «ألف ليلة وليلة» وسحرها. وكنا نحن الأطفال نهرع إلى أجهزة الراديو بعد أن نستمع إلى هذا اللحن، ونجتمع حول الجهاز الخشبي العتيق الذي كان موجودًا في بيتنا، لكي نستمع إلى أحداث مسلسل «ألف ليلة وليلة»، التي كانت تأخذنا إلى عوالمها الساحرة، وتنسينا ما حولنا تمامًا. واستمرت رحلتي مع «ألف ليلة وليلة» إلى أن بلغتُ من النضج بما لا يبعدني عنها بالقراءة، خصوصًا حين وجدتُ نسخة قديمة من «ألف ليلة وليلة» في منزلنا فأخذتها وبدأتُ أقرأ فيها مسحورًا هذه المرة بسحر الكلمات، لكني لم أنسَ نغمات «كورساكوف» في «شهر زاد»، فقد ظلت هذه النغمات ملازمة لسِحر القص الذي وجدته في الكتاب، والذي لا أزال أتذكره إلى اليوم.
وانتقلتُ من سحر تمثيلية «ألف ليلة وليلة» إلى سحر الروايات والسِّير المُشابهة لها، وظللتُ مُغرمًا بالقص السماعي والكتابي في تاريخ الملاحم إلى أن اقترب دخولي الجامعة، ومن ثم انتقالي إلى مرحلة أخرى. لكن الذي لا يفوتني ذِكره هو أني كنتُ أسكن في شارعٍ رئيسي من شوارع المحلة الكبرى. وكان يقع في هذا الشارع الكبير محلات كبرى وعدد هائل من الباعة الجائلين يزدحم بهم الطريق، وباعة لكل أنواع الخضراوات والفواكه. وأغلب محلات هذا الشارع كانت وكالات تبيع الخضراوات والفاكهة بالجملة، ويعمل فيها عمّال وحمّالون في حركة تشتد في الصباح الباكر على وجه الخصوص، حين تمتلئ الوكالات بالباعة (السَّريحة) الذين يبيعون على عربات يدفعونها بأيديهم، أو بباعة التجزئة الذين هم في مرتبة أعلى، ثم أصحاب الوكالات الذين يبيعون الفواكه والخضراوات في سوق تُنصب في الصباح الباكر لباعة (نصف الجملة) والباعة السريحة على السواء. وكان يفتنني دائمًا منظر الباعة والعمال والعاملات الذين كانوا يبدأون نشاطهم منذ أول إشراق النور إلى نهايته. ويبدو أن اللاوعي عندي قد أخذ يربط بين حكاياتهم التي كنتُ أسمعها شفاهة على المقاهي المحيطة ببيتي وأرى أحداثها في شخصيات العمال والعاملات والباعة والبائعات الذين كنتُ مُحاطًا بهم في غُدوِّي الباكر كل صباحٍ إلى المدرسة. وعندما كنتُ أعود منها، كنتُ أرى من كان يبقى منهم مسترخيًا على المقهى، مستمتعًا بأكواب الشاي أو منفردًا بنفسه ليدخن «الجوزة»، وينفث من منخاريه دخانها الكثيف.
وقائع حقيقية
هكذا بدأتُ أقرن القص بصور هؤلاء العمال والعاملات الذين كنتُ أراهم تجسيدًا واقعيًّا لشخصيات «ألف ليلة وليلة». ومع مُضي الأيام كبرت الصور الخيالية وتحوَّلت إلى وقائع حقيقية وشخصيات حية أعيش بينها. ومضيتُ في الدراسة وانتقلت إلى المرحلة الابتدائية ثم منها إلى المرحلة الإعدادية، وكنتُ قد عرفت معنى الكتابة، ومعنى أن أخط بالأحرف حيوات الأشخاص. هكذا وجدتني منجذبًا إلى المشاهد التي كنتُ أعيش فيها ومحاطًا بها وأكتب عنها لوحات قلمية كانت أقرب إلى القص البدائي،
ولا أزال أذكر أسماء بعض الشخصيات التي كتبتُ عنها بعض هذه اللوحات التي أعطيتُها لمدرس اللغة العربية فشجعني على المضي فيها، قائلًا: «استمر في الكتابة يا بني، ففي داخلك إحساس كاتب قصة قد يكون كبيرًا في يوم من الأيام». وظلت كلماته ترن في أذني وتدفعني إلى الكتابة عن الشخصيات التي أراها، محاكيًا بعض أساليب نجيب محفوظ التي قرأتها في رواياته الأولى مثل «خان الخليلي» و«القاهرة الجديدة» و«زقاق المدق». وهكذا وجدتُ نفسي أبدأ وعيي الأدبي بالقصة وليس بالشعر كما هو المُتعارف عليه. والحق أن أحاديث أمي كانت هي بداية القصص التي سمعتُها قبل أحاديث «جدتي». وكان الباعة والبائعات الذين كنت أراهم في السوق حول بيتي - كما سبق أن ذكرتُ - هم الشخصيات التي سعيتُ إلى الكتابة عنها في ذلك الوقت البعيد.
ولم أعرف الشعر إلا في المدرسة الإعدادية، عبر قصائد الكتب المختصة بتدريس النصوص الأدبية التي كانت تُقررها علينا وزارة التربية والتعليم، وكانت هذه القصائد مختارات لعدد من الشعراء تختلف عصورهم ما بين العصر الجاهلي إلى الوقت المعاصر، وظل الأمر على هذا الوضع إلى أن انتقلتُ من المدرسة الإعدادية إلى المدرسة الثانوية ومنها إلى الجامعة، وربما كان هذا الجانب الأدبي الذي انطويتُ عليه هو الذي دفعني إلى كلية الآداب، خصوصًا بعد أن عثرتُ وأنا في المرحلة الإعدادية على كتاب «الأيام» لطه حسين في مكتبة من مكتبات المحلة الكبرى، أغلب الظن أنها مكتبة «البلدية». وقد فُتنتُ بهذا الكتاب فتنة باهرة، وظللتُ مُتعلقًا به منطويًا عليه، مُكرِّرًا قراءته مرات ومرات حتى أني كدتُ أحفظ صفحات منه، وجعلتُه نبراسًا لحياتي في المرحلة الأولى منها، وكان سِحر الكتاب دافعًا لى إلى أن أكون مثل طه حسين الذي كتب هذا الكلام البديع وهذه السيرة الذاتية الساحرة، وهى السيرة التي لا أزال أظنها حددت مجرى حياتي كما حكيتُ في كتابات أخرى عديدة. وانتهى الأمر بي إلى أن أدخل قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهناك أكملتُ دراسة الأدب العربي ابتداء من الشعر الجاهلي في السنة الأولى، مرورًا بالشعر الإسلامي في السنة الثانية، والشعر العباسي في السنة الثالثة. وما إن جئنا إلى الشعر الحديث حتى بدأنا من شِعر البارودي ومضينا إلى الشعر المعاصر حتى وصلنا إلى أحمد عبدالمعطي حجازي وصلاح عبدالصبور. وقد عرفتُ في القسم من زملائي أن عبدالصبور قد تخرج من القسم نفسه الذي أنا فيه، وأنه سبقني في التخرج بحوالي خمسة عشر عامًا. وكان من الطبيعي أن أُتابع شعره مع شعر رفيقه أحمد حجازي، لكن عبدالصبور كان أقرب إلى نفسي وأكثر تأثيرًا في وجداني.
وهكذا وجدتني أتحول تدريجيًّا من مَيلي للقص وأحاديث «جدتي» إلى الدخول في دنيا الشعر الجديد، مفتونًا بها مُنجذبًا إلى إنجازاته. ومن المؤكد أن أكثر هذه الإنجازات تأثيرًا في وجداني كان شعر صلاح عبدالصبور، خصوصًا في ديوانه الثالث: «أحلام الفارس القديم»، فقد كدتُ أحفظ قصائد هذا الديوان عن ظهر قلب. ولا أزال إلى اليوم أحفظ بعضًا من قصائده دون أن أنساها، وأُمليها على الطلاب من الذاكرة حين أُريد أن أستخدم بعضها في دروس النقد التطبيقي، أو اتجاهات الشعر المعاصر المختلفة. ولا أزال منطويًا على فتنةٍ خاصة بهذا الديوان، أعني «أحلام الفارس القديم»، فقد اتحدتُ بشخصية هذا الفارس، وانطويتُ على بُعديه الاجتماعي والميتافيزيقي في داخلي، فوجدتُ نفسي أُحاكيه في كتابة الشعر الذي كنتُ قد حاولتُه مرارًا وتكرارًا. ولستُ أدري أين ذهبت مخطوطات هذه المحاولات، فمن الأرجح أنني قد رميتُها أو ضاعت منِّي أثناء رحلة الحياة الطويلة التي عانيتُها بكل أفراحها وأحزانها، لكني لا أدري لماذا ظلت ذاكرتي محتفظة بآخر قصيدة كتبتُها، وعندما أراجع أوراقي القديمة وأعاود النظر إلى مخطوطة هذه القصيدة، أجدني منجذبًا إليها واقفًا أمامها مسترجعًا المفارقات التي تنطوي عليها في ذاكرتي. وهي مفارقات لافتة؛ منها أنني كنتُ أبدأ حياتي الأدبية بالميل إلى القص وليس الشعر، وأنني بدأتُ الكتابة بما يشبه القصص القصيرة أو اللوحات القلمية (حوالي عشرين لوحة قلمية) التي سبق أن كتبتُ عنها منذ زمنٍ بعيد في أحد أعداد مجلة العربي. أما القصيدة نفسها فقد ضمَّنتُها مقالًا نُشر في هذه المجلة بعنوان: «أوائل الكتابة» واسمحوا لي أن أُعاود معكم استرجاع هذه القصيدة لمكانتها الحميمة لديّ، ولمن يهتمون بالأوزان على وجه خاص أُنبِّههم من الآن - قبل قراءتها - إلى تداخل ثلاثة أبحر أو أوزان في نسيجها، هي وزن المتدارك، ووزن الوافر، ووزن الرجز، وربما كان هذا التداخل لتقارب نغمة هذه التفاعيل، أما القصيدة نفسها فهي تدل على فتنتي بصلاح عبدالصبور، وحكمة «الحلاج» وصوته المائز. والمؤكد أنني ما كتبتُ ما كتبتُ من شعرٍ إلا تأثرًا بهما، وتقليدًا غير مباشر لهما، وقد كانت تعجبني فيهما نبرة التفلسف، والوصل الناجح بين الحكمة والشعر، والتكرار الدائم لفعل المساءلة؛ أعني مُساءلة العالم والذات. وهو الفعل الذي لا أتوقف إلى اليوم عن ممارسته في كل ما يعِنُّ لي أو يطرأ على ذهني من أفكار.
وكل ما أرجوه من القارئ أن يتذكر أنني لم أكن قد وصلت إلى العشرين من العمر حين كتبتُ هذه الكلمات التالية، وأن فتنتي بصلاح عبدالصبور لم يكن لها حد، وإعجابي به لا يزال قائمًا, ونتيجة هذا الإعجاب كتبتُ منذ ما يقربُ من نصفِ قرنٍ قصيدة «الأرض والله» التي تمضي على النحو التالي:
أرض عفنة
شقَّ جوانبها الجدبُ
والدود الملعون
من بين جوانبها يبدو
بَشِمًا بعد شبع
كانت أرضًا مزدهرة
كانت جنة
حصباها مرجان
وثَراها مِسك أزفر
نبتت في تُربتها أزهار الحكمة
هبطت فيها كلمات الرب
وَهَبت عيسى ومحمد أزهارًا لسلام
وبداية نورٍ في الدنيا
لكنَّ الأمطار انقطعت عنها
لم يأتِ الغيث
صمدت أرضي أعوامًا تنتظر الغيث
ماتت فيها الثمرات
وانتشرت فيها الديدان
وانقلب الـــــــعِطر عفن
ولذا أسأل:
لِم كفَّت أمــطارك عنــــها وانقطع الغيث؟
لم يا ربِّ إني لا أفهم؟
....
وهأنذا محمومٌ عُذِّبتْ
لو قلتُ سؤالًا للرب لَجدَّفتْ
هذا ما قال شيوخي.
لكنى منبوذٌ أُخرِست
ظمئت روحي من طول جفاف
وثُغاء شيوخي لغوٌ طائش
لا يشفى الغل
....
لو هطلت أمطارك
لانقشعت أفكاري المحمومة
ووجدتُ الري■

د. سهير القلماوي في مكتبها

