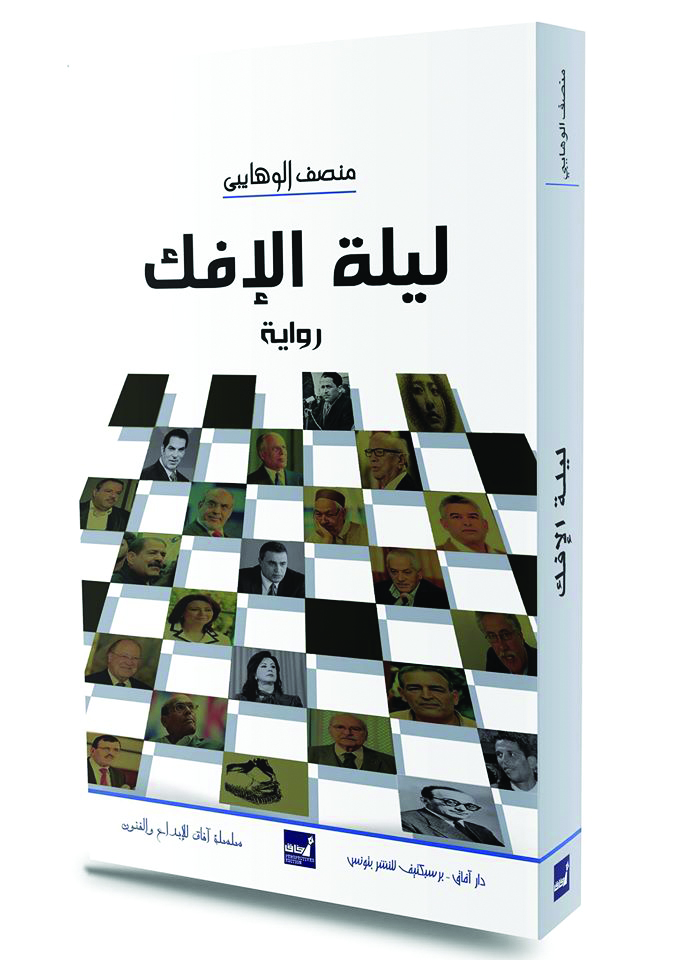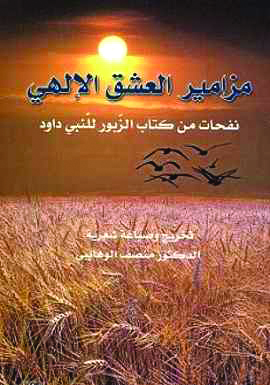الشاعر التونسي منصف الوهايبي: الكتابة الإبداعيّة مرجَلٌ يغلي ولا يتلاشى بُخارُه

«يداه إلى الغيم مبسوطتان... وعيناه للبرق... هذا الفتى التونسي الذي تورق العربية بين يديه»، هي أبيات لشاعر اليمن الكبير د. عبدالعزيز المقالح في كتابه «الأصدقاء» منذ عشرين عامًا، يصف شاعر تونس الكبير د. منصف الوهايبي. وما تزال «العربية» تورق على يد الفتى السبعيني الوهايبي، في تمثُّلات متعددة، شعرًا ونقدًا ورواية وفيلمًا تسجيليًا، ويبقى الشعر تَوَرُّقُه الأكبر، في شجرة إبداع، جذورها متأصلة في «القيروان»، المدينة التي تبدأ وتنتهي عندها كل حكاية عربية في بلاد المغرب العربي.
إنه حوار مؤجل منذ زمن مع الشاعر التونسي منصف الوهايبي، وكأنّه كان ينتظر لحظة تتويج عربية فخمة ومستحقة، وقد حدث، إنها جائزة الشيخ زايد للإبداع العربي فرع الآداب، لهذا العام 2020م ، عن ديوانه ابالكأس ما قبل الأخيرةب، وفي ما يلي نص الحوار.
حاجب العيون
• بالرغم من أن تكوينك الثقافي والأدبي العربي تأسس فيها، وكانت مركز تفتُّح وعيك الكوني، فإنه لم يرد اسمها العربي في أي قصائدك، واستعضت عنها بالاسم الروماني ماسكيليان. احكِ لنا عن حاجب العيون؟
- الحقّ أنا ابن ريف حاجب العيون، ومن أسرة فلاحيّة، كانت تمتهن غراسة الأشجار، وتحديدًا الزيتون واللوز، وزراعة الحبوب، وتربية الماشية. وكانت طفولتي الأولى بهذا الريف حيث نشأت ودرجت، ثمّ بحاجب العيون عام 1955، عندما ألحقني والدي، يرحمه الله، بمدرستها الابتدائيّة الوحيدة، مع عمّي وهو أخوه الأصغر، وابن عمّتي، وأجّر لنا ما يشبه المستودع الصغير؛ وكنّا نسمّيه االحانوتب حيث أقمنا؛ نعدّ كلّ شيء بأنفسنا من طبخ على الوابور وغسيل. وخلال هذه الفترة اكتشفت حاجب العيون، وأحببتها، وقد كانت واحة جميلة جدًّا: عيون ماء وبساتين كأنّها اشِعب بوّانب في قصيدة المتنبّي الشهيرة. على أنّي لم أذكرها بالاسم إلّا في بيت واحد أدرته على نوع من اللَّعب اللغوي (الحاجب/ العيون)، وهي تقع في هضبة تحيط بها من كلّ أطرافها، وتحجب عيون الماء التي تجري في أسفلها:
كلّما قلتُ أوغرتني ظنوني
كنت يا حاجبَ العيونِ، عيوني
وقد استعضت منذ ديواني أو كتابي الشعري امخطوط تمبكتوب، بالاسم الروماني القديم امسكليانيب أو امسكيلنيايب أو امازوفياناب كما يقول البعض. وهي أسماء ذهب بها الزمان، وطواها فيما طوى، منذ أن استقرّ بها العرب الفاتحون عام 27هـ /647م، أي بعد أن سيطروا على مدينة سبيطلة اسفيطلةب الرومانيّة، بقيادة عبدالله بن أبي سرح. أملت عودتي إلى الاسم الروماني جملة عوامل، من أظهرها سياق الديوان امخطوط تمبكتوب، فمداره على مدن تونسيّة مثل اتكاباسب (قابس)، وارسبيناب (المنستير) واهيبوزاريتب (بنزرت)، حيث يحضر المكان أو االفضاء المدينيب في علاقته الملتبسة بالماضي والحاضر معًا، أي االحالب، كما كان يسمّيه نحاة العرب، وليس في سياق الزمنيّة الخطيّة التي لا تناسب الزمنيّة الشعريّة؛ وهي في هذا الديوان، كما في كتبي الشعريّة الأخرى، حاضر أبديّ. إنّ إعادة قراءة تاريخ المتوسّط، توقفنا على أنّ هذا الماءَ المِلْحَ الذي يصل بين الضفّتين؛ هو شيء آخر غير سفر رحلات أوليس. إنّه باختصار المكان الذي يمكن أن نتعهّد فيه مستقبلنا جميعًا، على نحو ما تعهّده تونسيّ لا أحد يذكره اليوم، ويدين له المسرح الروماني الشعريّ بنشأته، هو طيرنسيوس، الكاتب المسرحي، أو تيرنس، كما ينطقه الفرنسيّون، وقد تأثّره موليار، وتأثّر به في بعض مسرحيّاته. وهو صاحب المقولة التي اشتُهِرتْ أكثر منه: اأنا إنسان، ولا شيء ممّا هو إنسانيّ، بغريب عنّيب. ثمّ طوى النسيان هذا الاسم، كما يطوي أشياء كثيرة لا تنتظم في سلك مشاغلنا، ولا نحن نرصد لها أوقاتنا.
القيروان
• «زمان أكثر من ما هي مكان»، هكذا وصفت القيروان. لمدينة التي يتجلى فيها العمق التونسي، وأنت تتحدث بمتحف محمود درويش في رام الله... ماذا فعل الزمن القيرواني بقصيدتك؟
- منذ ستّين سنة وأنا أقيم بالقيروان، دون أن أقطع صلتي بحاجب العيون وريفها؛ وأنا أكاديمي، ولكنّي افلاّحب أيضًا، ولم أفرّط في إرث والدي من الأرض، بل أنا أسعى اليوم إلى الاستقرار بالريف. القيروان مثل كلّ المدن التي كانت ذات يوم سُرّةَ العالم، وهي المدينة الأولى التي بناها العرب في الشمال الإفريقي، وكانت عاصمتهم الدينيّة والأدبيّة والعلميّة. على أنّي أكاد أقول إنّ الكلام على مدينة كالقيروان، لا يمكن أن يحسنه ويجوّد أداءه، إلّا فنّان تشكيلي، حتى يعدو النصّ مجرّد الحمل إلى اتحقيقب المدينة واتخريجهاب، أي جعل المرئي مرئيًا، كما يقول بول كلي الذي زار القيروان في بدايات القرن العشرين، وتحديدًا عام 1914. وقد وظّفت بعض لوحاته وخاصّة اعند أبواب القيروانب في بعض قصائدي، وفي شريط سينمائي قصير عنوانه امدينة تشبهنيب، وكتبت السيناريو بالاشتراك مع المخرج هشام الجربي، ومثّلت فيه.
لكأنّ القيروان - وأقصد تلك التي عرفت في طفولتي ثم في أوّل عهدي بها - على وشيحة عجيبة بفنّ االتّوريقب العربي (الأرابيسك).
وأقدّر أنّ أكثر قصائدي التي تمثّل فيها القيروان صورة من مقولة ابن عربي، حيث المكان زمن متجمّد، والزمان مكان سائل. ولذا قلت ما قلت عنها وأنا في متحف محمود درويش برام الله عام 2013، حيث تمّ تكريمي، ولا أزال أقول ذلك. بل فصّلت فيه القول في محاولاتي الروائيّة الثلاث اعشيقة آدمب واهل كان بورقيبة يخشى حقّا معيزفة بنت الضاوي؟ب، واليلة الإفكب. وأفعل الشيء نفسه في محاولتي الروائيّة الرابعة التي لا تزال قيد الكتابة اجمهوريّة جربةب، حيث أصوّر هذه الجزيرة التونسيّة اجزيرة الأحلامب كما يقال عنها، وقد انساحت في البحر؛ وأخذت تقترب من مالطة.
وقفة تاريخية
• «أنت إذًا... ربما أنت أيتها التونسية بنت الأمازيغ والعرب الفاتحين»، هكذا تصف القيروان في قصيدتك... لماذا القيروان قادرة ثقافيًا على أن تقدم الإجابة الصحيحة حول جدل الأمازيغية والعروبة في البلاد المغاربية في شمال إفريقيا؟
- هذه العبارة هي صورة تزاوج بين المرأة والمدينة. وتونس كلّها محصّلة تاريخ، كما هو الشأن في بلدان عربيّة وغير عربيّة كثيرة. وأنا أحبّ هذا التنوّع فيها؛ وهو مصدر غنى ثقافي لها. والحقّ أنه لا بدّ هنا من وقفة تاريخيّة، توضّح خصوصيّة الثقافة المغاربيّة، فقد كان الاصطلاح القديم هو إطلاق موريتانيا على المغرب الأقصى، ونوميديا على الجزائر، وزوجيتان على تونس، وكان بين المغرب والجزائر قطر صغير يسمى املفاب وبينها وتونس قطر يسمى اتوسكاب. أما يرقة فتسمّى مرنيكا وينطاليوليس أي المدن الخمس.
أما قارة إفريقيا فكان اسمها ليبيا، وإفريقيا تطلق على تونس وطرابلس، وهذا الاصطلاح يوناني قبل الرومان بكثير. وذكر الأستاذ ميكيل طارديل في بحثه اعصر الفنيقيين بالمغربب أنّ المدن ليبكسوس وقادس وأوتيكاهي أقدم المؤسسات في غرب البحر الأبيض المتوسط.
وهذا من شأنه أن يسوق إلى التريّث والحيطة، حتى لا يتمّ تعميم االنموذج القبائليب على مجمل مناطق المغرب العربي؛ أو الوقوع في أحابيل اتعدّديّةب لغويّة في الآداب المغاربيّة؛ لا ينهض لها سند علميّ، من تاريخ هذه البلاد المغاربيّة ومن ثقافتها؛ وشعراء المغرب العربي وكتّابه يكتبون بإحدى اللغتين: العربيّة أو الفرنسيّة أو بهما معًا. ومهما يكن عدد هؤلاء الذين يحتفظون بهوّيّتهم الأصليّة أو بلهجاتهم، فإنّهم يظلّون أقلّ بكثير من الناطقين بالعربيّة أو اللهجات العربيّة المحلّيّة. وبلاد المغرب عرفت تاريخيًّا عمليّة تعريب بطيئة؛ والأقرب إلى الحقّ أنّها تمّت مع الغزو الهلالي في القرن الخامس للهجرة (11م).
وهو ما يعزّز من وجاهة الرأي القائل بأنّ الأغلبيّة من الناطقين بالعربيّة اليوم هم عرب واأمازيغ معرّبونب كان أجدادهم في بلاد المغرب والصحراء يتكلّمون الأمازيغيّة، ثمّ تحوّلوا إلى العربيّة لأسباب لغويّة وثقافيّة معيشيّة أيضًا، وليست دينيّة فحسب، كما يقع في الظنّ عادة. ويذكر سالم شاكر، وهو عالم لسانيّات، أنّ البونيقيّة وهي لغة ساميّة من أخوات العربيّة، قد تكون من العوامل التي ساعدت على ترسيخ العربيّة في منطقتين من بلاد المغرب هما تونس والشمال القسطنطيني. فالعربيّة لم تحلّ دائمًا محلّ الأمازيغيّة، بل محلّ البونيقيّة. وهذه أطروحة كان لها شأن في الخمسينيات من القرن الماضي عند علماء من أمثال قزال وغوتيي، وكانت مثار جدال بين االأمازيغاويّينب واالبونيقاويّينب، بالرغم من أنّ كورتوا ينبّه إلى أنّ مصطلح ابونيقيب كان يستعمل مرادفًا لـ اأهليب أو امحلّيب مقارنة بـ الاتيني/ رومانيب. وهذا قد يفيد بأنّ كلمة ابونيقيب إنّما كان يُقصد بها اأمازيغيب.
وهذه مسألة يصعب أن نقطع فيها برأي؛ خاصّة أنّ الحجج المقدّمة تخدم الأطروحتين المتدافعتين كلتيهما، وتصلح لهما معًا. ويوضّح سالم شاكر أنّه من المستبعد، بل من غير المحتمل أن يكون العرب الفاتحون قد وجدوا عند دخولهم إفريقيّة (تونس) وبلاد المغرب عامّة أنّ االبونيقيّة هي لغة القوم هناكب دون أن يذكروا ذلك في مصنّفاتهم العديدة الدقيقة حول بلاد المغربب. ولا شيء في المصادر العربيّة القديمة وهي التي تُعنى بشتّى تفاصيل بلاد المغرب وشواردها؛ يجيز لنا القول بأنّه كان هناك في الشمال الإفريقي واقع لغويّ آخر غير الأمازيغيّة، على نحو ما كانت اللاتينيّة في العالم الحضري الروماني والمسيحي. ومن اللافت حقًّا أن يشير الباحث إلى القرابة اللغويّة البعيدة االملتبسةب (والنعت لنا) بين الأمازيغيّة والعربيّة؛ حيث الموازنات البنائيّة بين اللغتين قد تكون من العوامل التي مهّدت السبيل لعمليّة التعريب اومن وجهة نظر لسانيّة محضة، كان من السهل على الأمازيغي أن ينتقل من لغته إلى العربيّة، وليس من لغته إلى اللاتينيّةب.
ونعرف أيضًا أنّ اللاتينيّة لم تتمكّن من الانتشار إلّا في بقايا هند أوربيّة، في حين أنّ العربيّة لم تنتشر إلّا في المناطق الساميّة أو الساميّة - الحاميّة. وهذا ممّا يعزّز من وجاهة الفرضيّة التي ساقها الباحث. على أنّ هناك عوامل أخرى حافظت على االتنوّع اللغويب في بلاد المغرب، وهي جغرافيّة (عزلة المناطق الجبليّة) وديمغرافيّة (الكثافة السكانيّة) واقتصاديّة (عوامل نظام الإنتاج وامتلاك الأرض).
• القيروان... لوحة الأحد الكبيرة، قصيدة أصلها لوحة تشكيلية... كيف حدث ذلك؟
- لوحة الأحد الكبيرة هي لوحة شهيرة لجورج سيرا (1891/ 1958)، واسمها اذات أحد بعد الظهر في جزيرة لاغراند جاتب. وكانت حافزًا لي في كتابة هذه القصيدة المركّبة، إذ أذكت في ذاكرتي عالم القيروان القديم والجديد؛ أي هي كانت من بواعث الكتابة لا غير. وكلّ ما حاولته هو أن أقيم عالمًا شعريًا موازيًا لعالم الرسم. وليس بالمستغرب أن نلحق الشعر بالرسم، والصوت بالعين. وهما يتحدّران من أرومة واحدة هي الكتابة (الخطّ)؛ بل ينضويان على جنس واحد جماعُه الكلمة والعين، خاصّة الإيقاع مسموعًا مرئيًّا، حتى أنّ البعض يشبّه الرسم بالموسيقى.
سؤال الشعر
• إذا كان الشعر ليس تهويمات استعارية كما تقول... فماذا يكون؟
- الشعر في كلّ الثقافات أو جلّها هو فنّ رمزيّ اكنائيب مداره على ملامسة العالم وأشيائه ومفرداته، باللغة. وهو قائم على التداخل، منشدّ إلى نفسه مثلما هو منشدّ إلى سابقه، بل إلى لاحقه؛ إذ هو ينشأ اقرائيّا أي وهو يَقْرأ موادّه وخاماتِه وكلّ ما يدور في فضائه، بحسب ما تمليه عليه طبيعة جنسه، وبحسب ما يستعيره من عناصر من الأجناس الأخرى، مثل الملحمة والدراما خاصّة. ومادام الشعر يتّسع لهذه الظواهر أو الأجناس، سواء تعلّقت بشعريّة الدال أو بشعريّة المدلول، فلا ضير أن يصل الشاعر بعضها ببعض ما دام منبتها الأصلي هو الشعر نفسه. أحاول كلّما تعلّق الأمر بالشعر وتلقّيه، أن أميّز بين نظامين في الكتابة يكشفان عن خطّتي تلفّظ مختلفتين: كتابة متجرّدة من كلّ جسمانيّة، سواء أكانت أيقونيّة أم قوليّة كلـّما جرت المسموعات من الأسماع مجرى المرئيّات من البصر بعبارة حازم القرطاجنّي. وهذا ليس مخصوصًا بالقديم أو اقصيدة البيتب أواالقصيدة العموديّةب وهي تسمية غير دقيقة، وإنّما يشمل أيضًا هذه القصيدة المعاصرة التي أستعير لها هذه الكناية اللطيفة اباب بدفّتينب، وقد تلقّفتها من محمود درويش في لقاء بالقاهرة؛ وهو يسألني عن شاعر صديق عاد بقوّة إلى قصيدة الشطرين: صدر وعَجُز. وأكثرها تهويمات استعاريّة أو انسج على منوالب. وأنا أشاطر هنري ميشونيك في أنّ هذا اتشعيرب وليس شعرًا.
هذا النمط هو في تقديري أقرب ما يكون إلى االبيكتوغرامب أو االتصويريّةب، حيث يمكن فصل الكلمة عن الصورة، ويتحقّق االاختلاق الإمكانيب أو الخيال التصّوري، ويكون للـ االحقائقب أصل في الأعيان وسند من الواقع. فلا غرابة في أن قام التصوير في الشعر على ما قام عليه عمود الشّعـر، أي على ركنين لا غنى عنهما، هما الإصابة في الوصف والمقاربة في التّشبيه؛ إذ يحتفظ االشّيءب في هذين الأسلوبين بوضوحه وتمايزه أو بانتسابه إلى عالَم الأشياء. وما انشداده إلى االمرئيّب حيث الكلمة لا تحجب عن الشّيء، بل تجلوه وتفصح عنه، إلّا دلالة على ماديّة الصّورة من جهة، وعلى نظريّة في الإدراك من جهة أخرى، تقوم على التمثّـل؛ أي أن ندرك هو أن نسمّي الأشياء أو نعرّفها. وهذه الأشياء أو شبحها هو ما كان االنـّقد العموديّب المخصوص بالشعر - إن جاز أن نسمّيه هكذا - ينشده في الصّورة ويظفر به أو يتهيّأ له ذلك.
حتّى إذا أخذت الصّورة تتحوّل من امسموعب إلى امكتوبب، ولم يعد العالم هو نفسه إذ لم يعد له نفس الفضاء؛ بدأنا نشهد ولادة نوع من الكتابة تُعالج فيها الإشارة بمعزل عن وظيفتها الدّلاليّة التـّواضعيّة أو المرجعيّة أو التـّوصيليّة. فهي دليل لغويّ ينبتُّ عن الصّورة، بالمعنى الذي استتبّ لها عند المتقبّلين عامّة، ويخون رابطة العقد بين المنشئ - الكاتب والسّامع/ القارئ. على أنّه دليل فاعل في نسيج النصّ المكتوب، الأمر الذي يجعله أشبه بـ االباب الدوّارب أو بـ االإيديوغرامب (رسم الفكرة)، فالرّمز فيه متحرّك غير ثابت؛ بحيث يصعب أن نحدّه استئناسًا بمدلوله، كما هو الشّأن في الكلمة التي هي تمثّل قبل كلّ شيء، وإنّما في ظهوره المباشر الذي يَنشدُ إحداث أثر ما، يمكن أن نسمّيه اأثر الرّمزب، كما هو الشّأن في االأيقونةب التي تتميّز بطابعها الذي يجعل منها دالًّا، حتّى إن كان موضوعه غير موجود؛ أي بالقدرة على استدعاء حقيقة غير متوقّعة.
إنّ الكتابة من حيث هي تسجيل للكلام أو تقييد، اتصلّبب الكلمة، شأنها شأن كلّ كلمة خطـّية، وتخصّها بوضع مستقـلّ، وتقـيّد الزّمن في هذا الدّال اشعرب الذي يندّ عن الحدّ ويستعصي عليه. ويتوضّح ذلك في قصائد غير قليلة، من حيث هي عدول من جهة، ومن حيث هي تعاقد، من جهة أخرى.
أمّا الذي هو عدول فغير نظاميّ ولا نسقيّ، أو هو غير معياريّ أي لا يُقاس عليه. وهو مباغت يحدّ من التوقّع إن لم يخيّبه. وأمّا الذي هو تعاقد، فنظاميّ نسقيّ غير مباغت، وحصوله منتظر. ومردّ ذلك إلى أسباب قد يكون أهمّها تدارك عوز اللّغة، وغايات قد يكون هدم نظام الخطاب الشّعريّ القائم قادحها. ونعني به النّظام العموديّ المنشدّ إلى رواسم متعاودة ونماذج جاهزة؛ فلا غرابة أن يكون الخطاب محكومًا، في جانب لافت منه، بالوظيفة التّنبيهيّة التي تستجلب مزايا الشّفهيّ في أشكالها الأشدّ تراخيًا في القدم، والأكثر اطّرادًا في الاستعمال. ولعلّها محاولة من الذّات للظـّفر بـــ اهويّـتهاب وبيان موقعها.
وهذه الوظيفة هي التي تثبّت الاتّصال. وأكثر الوظائف الأخرى - على ما يبدو - تنهض لها وتعزّزها. وقد يقع في الظنّ أنّ في هذا ملتقى البابين: باب الدفّتين والباب الدوّار أو اقصيدة النثرب، وطبعًا هناك استثناءات وهي قليلة جدًّا؛ وأنا نفسي جرّبتها في كتابي اميتافيزيقا وردة الرملب (حاصل على جائزة أبي القاسم الشابي). على أنّ جماليّة االدوّارب الرّاجعة إلى الشّكل المستحدث أي هذا الشعر الذي لم يكن للعرب به سابق عهد، من شأنها أن تجلب الانتباه وتشدّه. وهي من ثمّة تعالق وظيفة أخرى حافـّة تشبُّع اذاتيّةب الشاعر أو اأناهب، فيستغرقه التجريب الاستعاري، وينسى أنّ الشعر تلفّظ حيّ، وأنّ له مرجعيّته حتى إن لم يستجب للتـّوقّعات، أو كان بابًا دوّارًا، لا ننفذ منه ولا نجوز إلى داخل؛ إلّا بعنتٍ وصعوبة.
تجاوز الشابي
• ألم تخشَ العواقب عندما صرّحت بأن شعراء تونس تجاوزوا الشابي؟ وما هي حيثيات هذا التجاوز؟
- عام 1996 عندما شاركت في مهرجان القاهرة الشعري، وقد اختيرت اعاصمةب للثقافة العربيّة، وقرأت في الأمسية الأولى مع شعراء مشهورين من أمثال أحمد عبدالمعطي حجازي ومحمود درويش وسعدي يوسف وسامي مهدي وعبداللطيف اللعبي... وكان لقصيدتي صدى، فقد كتب عنّي الراحل الكبير فاروق شوشة مقالًا في الأهرام االوهايبي... شاعريّة ما بعد الشابيب، ونبّه إلى أنّ هناك شعرًا في المغرب العربي يُعتدّ به. وحتى أكون امنصفًاب لا يفوتني أن أشير إلى أنّ للشابي أثرًا بعيدًا في الشعريّة العربية الحديثة االرومنطيقيّةب لا يمكن إنكاره. وفي سياق هذه الشعريّة يمكن أن نقرأه حقًا، فلم تكن للشابي صلة تُذكر بالشعر التونسي في الثلث الأول من القرن الماضي، وإنّما علاقات بأفراد يقاسمونه رؤيته بنسبة أو بأخرى. وأقربهم إليه وهو محمد الحليوي (وهو، يرحمه الله، من أساتذتي الذين أدين لهم بالكثير في الثانوي؛ فهو الذي أطلعنا على شعراء المهجر خاصة... بل على نزار قباني والسيّاب أيضًا وآخرين)، كان مثقفًا وناقدًا جرّب الشعر، ولكنّه سرعان ما انقطع عنه، ولعلّه أدرك أنّه فنّ صعب ليس بميسور واحد مثله أنه يطاول فيه الشابي أو يجاذبه مكانته الشعرية.
كان الشابي إذن شاعرًا عربيًا بالمعنى الثقافي العميق للكلمة، وليس بالمعنى السياسي أو القومي الذي لم يكن يعنيه في شيء. وخير دليل لذلك أعماله الشعرية والنثرية. فكتابه اأغاني الحياةب، وأنا أصرّ على كلمة اكتابب بدل اديوانب، عمل شعريّ يقوم على علاقة حميمة بين الرؤية والتصوّر، وليس مجرّد قصائد متناثرة لا رابط بينها، كما هو الشأن في أكثر مجاميع الشعر عندنا.
وأقدّر أنّ الشابي أدرك هذا الجانب بكثير من الوضوح. ولذلك ربط تجربته بالتجارب الشعرية الرائدة في عصره: تجربة شعراء المهجر وجبران تحديدًا، على حين ظل معاصروه من التونسيين يكتبون بلغة انيّئةب لم تمسسها نار العصر. ولعل كتابه االخيال الشعري عند العربب يضمر ردًّا على هؤلاء الذين تعقّلوا الشعر تعقّل العقول المنتظمة بحسب المتعارف أو المأثور في نظريّة العمود الشعري.
ربّما لم يكن الشابي جريئًا، فلم يذكرهم بالأسماء، ولكن يكاد لا يساورني شكّ في أنّه كان يعنيهم. وممّا يؤكّد ذلك مقدّمته لديوان المصري أحمد زكي أبو شادي االينبوعب، بطلب منه؛ ونصّ آخر للشابي قلّما تنبّه إليه الدارسون وهو محاضرته عن اشعراء المغرب الأقصىب. وهذه المحاضرة تعزّز رأيًا لي ذكرته منذ سنوات، وهو يتعلّق باطّلاع الشابي على الشعر الذي كان يُنشر بالجزائر خاصّة. والصلة بينه وبين الجزائري رمضان حمّود (1906 - 1923) صاحب كتاب ابذور الحياةب لا تخفى عن القارئ البصير.
أعدّ الشابي محاضرته هذه، في ضوء قراءته لكتاب محمد بلعبّاس القبّاج االأدب العربي في المغرب الأقصىب الصادر عام 1929، وأشاحَ عن تقديم الجزء الأوّل من هذا الكتاب المخصوص بـ اطائفة من شيوخ المغرب الأقصىب، وكأنّه كان يشيح عن شيوخ الشعر التونسيّين في عصره، لأنّه كان ينشد االعظمة الشعرية المنتجة التي لا ترضى بغير العالم مقعدًا، وبغير الإنسانيّة أتباعًاب بعبارته. وكتب اسأتحدّث عن هذا الجزء الثاني من الكتاب، هذا الجزء الذي لا يفيض إلا بنزعات الشبيبة وأحلامها، هذا الجزء الذي يمثّل لنا الحياة المغربية الحاضرة بما لها من مطامح وآمال ورغبات ونوازع، هذا الجزء الذي لا يضمّ إلّا أشعار الشباب المغربي الطموح: هو الذي أريد أن أتكلّم عنه الليلة بما أستطيع، لأنّ أغاني الشباب وأحلامه هي عنوان حياة الشعوبب.
حقًا تبقى من الشابي أسئلته الحارقة. ومنها أتعلّم شخصيًا، ولي كتاب سيصدر عنه قريبًا وسمته بـ احياة الأغانيب وجمعت فيه قصائد الشابي النثريّ؛ كيف تنعقد الآصرة بين االلهبب أو النظام الصّادر عن فوضى الأشياء واالبلّورب أو النظام المنظم ذاتيًّا. فربّما كان هذا هو الميزان الذي حفظ لشعر الشابي شعريّته! ربّما.
دلالة المحبة
• لماذا لم تحضر المرأة غزلًا في قصيدتك؟
- الكتابة في الحبّ تنطوي على قَدْرٍ هائل من اللَّبْسِ، هو عينه القدر الذي تنطوي عليه القراءة في الحبّ؛ وهو لبس مأتاه التّعميم الذي قد يشوب مفردة الحبّ، حيث تُحمل في معنى عامّ على دلالة مطلق الرّغبة في هذا الشّيء أو ذاك، أو على دلالة المحبّة بما هي توادد بين البشر.
والحبّ عاطفة يتداخل فيها النّفسيّ والجسديّ في منحى يخفّف من المغالاة في روحنة الحبّ، وهو يتجلّى في ما أسمّيه االحبّ الحضريب وفي التّعفّف عن شهوانيّة الجسد، في ما أسمّيه االحبّ البدويّب، حيث التغنّي بالجسد في بعض نصوص الشّعر العذريّ وتكثيف الاستعارة بشأن بعض أعضائه، مناسبة لكشف شوق يغلب على النّفس، أكثر ممّا يغلب على ميول الجسد، فكأنّما نحن بصدد أيروتيكا روحيّة، تصاحبها عطالة جنسيّة أكثر منها أيروتيكا جسديّة. ولكنّه يحاول أيضًا أن يحدّ من شطط الغلمة في عماها الغريزيّ، دونما توجيه أتيقيّ أو من الاحتفاء الشّبقيّ بالجسد، ومقايسة جماليّته بمقياس طواعيّته للممارسة الحسيّة دون سواه، وما إلى ذلك ممّا يجدر أن تتعلّق به همّة الباحث في شؤون البلاغة، سعيًا إلى ترسُّم ملامح االتّحويل البلاغيب التي تسم كلّ ضرب مستجدّ من ضروب الأدب أو الفنّ، حيث القوانين التي تحكم فعل الإبداع لا تعدو أن تكون غير قوانين االمعاودة والاختلافب، إذا ما تمثّلنا بمفاهيم جيل دولوز. وفي هذا الحيّز يمثل الحبّ في أكثر من قصيدة لي، موصولًا بالمكان واليومي والمعيش، وايتضايفب فيه كلّ ما ذكرته من حالات النفس في علاقتنا بالمرأة.
• «مخطوط تمبكتو»... لماذا تمبكتو؟ وماذا دوّنت في مخطوطها؟
- تخيّرت تمبكتو، لأسباب تاريخيّة شتّى، واتخذتها امعادلًا موضوعيًاب للقيروان. هي لا تمثّل في هذا الديوان، وإنّما طيفها ممتزجًا بالقيروان، أي الفضاء الإفريقي وهو فضاؤنا أيضًا. وهي مثل القيروان بوّابة إفريقيّة قديمة، وملتقى القوافل البريّة القادمة من الصحراء، وعالَم التجارة وخاصّة تجارة الملح. والحقّ هي فسحت لي مجال القول الشعري على نحو غير معهود عندي، وربّما عند غيري.
سؤال النقد
• «أبناء قوس قزح»... كتابك الذي فرّقت فيه بين شعر القصائد وشعر التجارب، وأنت تتحدث عن الشعر التونسي المعاصر... حدّد لنا علَامَ ارتكزت في هذا التفريق.
- اأبناء قوس قزحب هو كتاب لي صدر باليمن عام 2014، وكان بطلب من الأستاذ الشاعر الكبير عبدالعزيز المقالح، ليكون إحدى مفردات الاحتفال بصنعاء اعاصمة للثقافة العربيّةب. وهو متخيّر يضمّ حوالي ثلاثين شاعرًا تونسيًا. وقد سوّغت اختياري بجملة دواع مثل التمييز بين شاعر التجربة وشاعر القصيدة، استئناسًا بنصوص هؤلاء. وهي ككل شعر تتفاوت من حيث الشعريّة أو القيمة. وهي سواء انضوت إلى قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر، على قلق التسميتين، تتفاوت، فمدار بعضها على توصيل موضوع وجداني في لغة مأنوسة؛ في حين يتخلّى بعضها عن الموضوع ويُحلّ محلّه بناءً لغويًا خاصًا، أو هو يقوّض االمعنى المنطقيب الذي ينهض على قاعدة الفهم، ويستخدم لغة المعيش واليومي، ويستولد صورًا تذكّر بالسرياليّين.
صحيح أنّ االتّهجينب ضرورة حداثيّة في الكتابة الشعريّة، وصحيح أنّ التّراشح بين الخطابات والأجناس يوفّر دفقًا تجديديًا لها؛ إلّا أنّ ذلك لا يعني، بالمقابل، انتفاء تخوم الأجناس أو الاتجاهات، وإنّما يعني ارسمهاب على نحو رخْوٍ مرِنٍ هو في الواقع، أمارة قوّتها لا ضعفها. والكتابة ورشة كبرى مُشرعة على موارد شتَّى، وتجسيد لأجناس وأنواع مختلفة وتشبيك بين نصوص متباينة الأزمنة والأنساب تتعالق في ما بينها على نحْو ملتبس؛ فهي متماهية من حيث هي، في الوقت نفسه، متجاورة؛ من حيث هي، في الوقت ذاته أيضًا، متحَاورة. ومن حيث هي في الوقت ذاته تتفاصلُ ليتجاوز بعضها بعضًا. إذن أقول إنّ الكتابة الإبداعيّة مرجل يغلي لا غطاء له ولا يتلاشى بُخاره. ولكنّي أقف إلى جانب شعراء التجارب أو أصحاب المشروع الشعري.
• أبو تمام موضوعك الذي اشتغلت عليه في دكتوراه الدولة، وأدونيس في دكتوراه الحلقة، هل فرّط أدونيس - كما يُقال - في إرث أبو تمام؟
- إنّ تأسيس علميّة ابويطولوجياب في شعر أدونيس دون غيره من شعراء العربيّة المعاصرين، أمر ممكن جدًّا؛ بل ضرورة علميّة تقتضيها أيّ محاولة لإعادة ترتيب علاقتنا بالشعر العربي، منذ أن برح مألوف مداراته في الثلث الأوّل من القرن العشرين. والحقّ أنّنا لا نأتي بدعة بتأسيس عِلم بشعريّة أدونيس، فقد استحدث العرب منذ القرن الثالث للهجرة (التاسع الميلادي) هذا العلم في كلامهم على أبي تمّام امذهب الطائيب وما سمّيته االطّائيّةب في رسالتي دكتوراه الدولة؛ وقد شدّهم ما ينطوي عليه من غريب يحسر الفكر ويكدّ الذّهن، فحاولوا أنصارًا وخصومًا أن يوطّئوا السّبيل إليه، وأن يفسحوا مساربه ومضايقه. ولسنا نعرف، في شعرنا القديم، أشدّ منها عنتًا وضيقًا حيث يقع شعره في خسوف ذاك االقديمب الغابر.
اكان الشعر قبلَه قدرة على التّعوّد والألفة، فصار بعدَه قدرة على التغرّب والمفاجأة...ب بعبارة أدونيس، وكأنّه يتحدّث عن تجربته هو أيضًا.
واستحدث هذا العلم في ما يخصّ أكثر من شاعر في بلاد الغرب. ويكفي في هذا المقام أن نستحضر هولدرلين، وكيف خصّه النّقد الألمانيّ بنظريّة علميّة في الشّعر.
سؤال الحداثة
• وصفت الحداثة الغربية بوحيد القرن... وأنت ترصد لهجومها علي الأدب العربي منذ بدايات القرن الماضي... ماذا فعل وحيد القرن بمسار النقد العربي؟
- الانتقال من القصيدة إلى االعملب الشعري، هو في ما يقرّره المعاصرون؛ وفي كلامهم مقدار كبير من الصواب، أحد أظهر إبدالات الحداثة وملامحها. وليست الحداثة مفهومًا كما يقع في ظن كثير أو قليل منّا، بل ليس لها قوانين ولا نظريّة إذ لو كانت كذلك لأصبح بإمكان أيّ منّا أن يكون حديثًا، بمجرد الاحتكام إلى جملة من القواعد والأحكام أو القوانين.
وتاريخ الفن يعلّمنا أنّ الاحتكام إلى نظرية لا ينجم عنه سوى االغرق في الفن الميكانيكيب. إنّما الحداثة سمات وملامح ومنطق. وأقدّر أنّ مسألة الذاتيّة تظلّ شرط إمكان المشاركة في كونيّة الشعر أي حداثته، باعتبارها مشاركة تقتضي إسهامًا معرفيًا، وقد أشرنا إلى أنّ الذات حدّ معرفيّ. على أنّ المعرفة في السياق الذي نحن به مذوّبة في خطاب شعريّ، أو هي متمثّلة على نحو جماليّ، حتّى لا ينحرف الفهم إلى اعتبار الخطاب الشعري في اإرادة الحياةب، مجرّد قناع لمضمون معرفيّ أو فلسفي، أو فلنكنّ عن حضور المعرفة شعريًا في قصيدة أبي القاسم، بالنّسغ الطريّ الذي يملأ شرايينها.
إنّنا نستعمل مقولة االكونيّةب ضدّ مقولة االعولمةب. فالأولى في تقديرنا أفقٌ محمودٌ يجدر بالشاعر أن ينخرط فيه، والكونيّة قيمة إنسانيّة تتناسب وثراء الوجود الإنساني أو غناه؛ لأنّها لا تلغي الاختلاف والتعدّد، بل تسعى إلى إدماجهما في سياق من التناغم، في حين أن العولمة، على نحو ما يصرّفها أهل السياسة وتقنيو الاقتصاد العالمي، تقوم على المجانسة والتنميط ومحو تاريخ طويل صرفت فيه الشعوب حياتها وأفنت مصائرها من أجل إغناء تنوّعها وتطوير اختلافها، وخلافها أيضًا. وهو ما ينبغي التصدّي له، ولكن ليس ضمن فضاء العولمة، بل ضمن فضاء الكونيّة الذي لا يحوّل الاختلاف إلى خلاف، وإنّما يجعله شرط إمكان الحوار.
وباختصار، مخلّ لا ريب، فإنّ الكونيّة أفق وجود والعالميّة استيطان مقنّع في أرض الآخر. ونقدّر أنّ اإرادة الحياةب لعمقها الأخلاقي (الأخلاق باعتبارها قيمًا إنسانية تدور مدار الحرية والمراهنة على السعادة، وليس من جهة كونها آدابَ سلوك)، تدور - دونما إرادة من الشاعر على ما يبدو - على مقولة الكونيّة، وهي التي تنهض بها ذات إدراكيّة تنخرط في ما يمكن أن نسمّيه علاقة اتذاوتب مع موضوعات إدراكها، فليس بالعسير على القارئ أن يتبيّن الخيط الواصل بين الذات ومفردات الكون الرومنطيقي، على النحو الذي أشرنا إليه، ولو في خطف كالنبض.
لعلّ هذا البُعد الكوني في القصيدة هو الذي استدعى إليها ما يسمّى الوظيفة المؤسطرة للأدب. على أن ننظر إلى الأسطرة ها هنا، لا من جهة صلتها بالجانب العقدي من الأسطورة، وإنّما من جانب االتجسيدب أو االإحيائيّةب، أي إضفاء خصائص الكائن الحيّ المريد والمالك لقصديّة على كائن أو شيء لا يتوفّر على هذه الخصائص. وبعبارة أخرى، فإنّ ما يجري داخل القصيدة حوار بين ذاتيّة الشاعر وذوات أخرى؛ قد تكون كائنات بشريّة أو حيوانات أو أشياء خرساء، أو حتّى علامات لغويّة.
سؤال الرواية
• الكومار الذهبي الذي حازته روايتك الثانية «عشيقة آدم» عام 2012، بمنزلة صكّ أدبي على أن الشاعر لم يذهب إلى الرواية متطفلًا. كيف استدرجتك معيوفة بنت الضاوي لكي تكتب روايتك الأولى عام 2011؟ ولماذا لم تستمر بعد روايتك الثالثة «ليلة الإفك» عام 2015؟
- نشرت ثلاث محاولات روائيّة هي اعشيقة آدمب، وقد فازت بالكومار الذهبي 2012، وأصدرها أستاذنا الراحل توفيق بكّار، في سلسلة اعيون المعاصرةب. وقد كتبتها بين عامي 2009 و2010، ووظّفت فيها التقنيات الفيسبوكيّة. والثانية هي اهل كان بورقيبة يخشى حقًا معيوفة بنت الضاوي؟ب، وقد حاولت فيها أن أرسم صورة الزعيم الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال، في المخيال الشعبي، وليس من منظور تاريخي أو سياسي. والثالثة هي اليلة الإفكب، وهي تعالج ما حدث في تونس منذ عام 2010 إلى عام 2014، وجلّ شخصيّاتها بأسمائهم الحقيقيّة. ولديّ محاولة رابعة بعنوان اجمهوريّة جربةب الجزيرة التونسيّة الشهيرة، وتخيّلتها وقد انفصلت عن تونس؛ وساحت في البحر؛ وأخذت تقترب من مالطة... وعسى أن أنهيها هذا العام.
الحقّ أنا لستُ روائيًا، ولا أدّعي ذلك. إنّما أنا قارئ للرواية؛ ويكاد لا يفوتني منها شيء عربيًّا وعالميًا. لأقل إنّي قارئ يكتب الرواية، أو ما يفيض عن الشعر. ولكن بلُغة الرواية. فأنا على ما أظنّ أعرف بحكم قراءتي للروائيّين العالميّين الكبار، وعلى رأسهم جيمس جويس، كيف أكفّ عن كوني شاعرًا؛ ما أن أشرع في هذا النوع من السرد الروائي.
وأدرك كيف ينهض القول السردي برواية قصّة أو مغامرة تنتظمها حبكة، يقوم بها شخوص يتحرّكون في فضاء وزمان مخصوصيْن. وهم يؤدّون القصّة في ضوء الممكنات السرديّة وما يتعلّق منها بالتغييرات الزمنيّة وإدارة فنّ الدخول إلى العالَم المحكيّ، سواء أقيّدته وجهة نظر داخليّة أم لم تقيّده. وهذا لا يتسنّى في النصّ الشعري، إلّا نادرًا؛ بالرغم من أنّ لي قصائد مركّبة ذات منحى سردي؛ ولكن شتّان بين السرد الشعري المكثّف والسرد الروائي المفصّل.
«نوبل» ونزار وحكايات أخرى
• «البنك التونسي» و«الكومار الذهبي» و«شاعر عكاظ» و«مؤسسة البابطين» و«المتوسّط للشعر» وجائزة الشيخ زايد للإبداع العربي... جوائز مرموقة حُزتها. هل أنت من الأدباء العرب الطامحين لـ«نوبل»؟ وماذا فعل نوبل بالأدب العربي؟
- لستُ واهمًا حتى يكون لديّ مثل هذا الطموح. وأنا أعرف إلى حدّ ما أنّ هذه الجائزة العالميّة المرموقة، إنّما تُسند لكتّاب وشعراء يدعمهم أدبهم لا شكّ، ولكن تروّج لهم مؤسّسات يتواصل فيها الإعلام والنقد والاقتصاد. وقد سبق أن دُعيت إلى استوكهولم وإلى مؤسّسة نوبل، بعد أن ترجمت بالاشتراك مع الشاعر التونسي محمد الغزّي ديوان الشاعر السويدي أوستون شوستراند اتحت برج الدلوب، وهو عضو لجنة نوبل (توفّي منذ بضع سنوات). وهذه شهادة من الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي وقد كنت برفقتها عام 1984 في مكتبة جائزة نوبل؛ في ملتقى الشعر العربي السويدي، حيث وقفنا على حالة شعرنا وأدبنا نحن العرب، في المشهد العالمي. وفيها ما يشفي الغليل.
عزيزي المنصف
يجيء ذكرك في كل مرة أتحدث عن لحظة اكتشافنا خلوّ مكتبة أكاديمية نوبل من إبداعنا! ألا تذكر تلك اللحظة التي فتح لنا فيها أمين المكتبة في الأكاديمية، المستر أندريس ريبرغ (ما زلت أذكُره وأذكر اسمه) درجًا صغيرًا، وأرانا بناء على طلبنا منه، ما عندهم من أعمالنا الأدبية! أربعة كُتب صغيـرة مترجمة! أي تراث هذا الذي يُختَزل بأربعة كتب صغيرة؟ لحظة ماج العالَم بي، وأدركت أن عليّ أن أودّع الحياة الشخصية الهادئة والشعر وحريّة التحرك والسفر كما أريد، وأنصرف إلى عمل مكرّس أكبر منّي ومن عمري كان سيمسك بي ليل نهار. كلّما أتحدّث عن تلك اللحظة المصيرية أتذكرك وأذكرك. كنّا مسافرين من قرية سيغريد إلى مؤتمر لُند في الجنوب، وطلبنا في مرورنا باستوكهولم أن نزور أكاديمية نوبل، وهذا ما حصل، وتغيّر به عالميب.
د. سلمى خضراء الجيوسي
• كيف أقنعت نزار 1995م بأن يكون ضيف الدورة الأولى من مهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان؟ وكيف احتفت به القيروان؟
- نزار شاعر استثنائي، وكان لحضوره في القيروان وقع كبير، فقد تدافع الآلاف للاستماع إليه من تونس كلّها؛ في حدث قلّ نظيره. وكان معنا شعراء كبار من فرنسا، فضلًا عن أدونيس وسعدي يوسف. وللتاريخ، فإنّ أدونيس بتنسيق معي هو الذي أقنع نزار بالقدوم إلى القيروان. وقد ذكر لنا نزار أنّه استشار محمود درويش، فأشاد بنا أنا ومحمد الغزّي، وقال له ااذهب ولن تندمب. هذا كلّ ما في الأمر. ولكنّ القيروان لا تزال تستحضر تلك الذكرى العطرة في كلّ ربيع فنون ينعقد فيها.
• ما هو بيت الشعر الذي تستحضره دائمًا من التراث العربي وقت المشاكسة مع زوجتك؟ ولماذا بعد كل هذه السنوات من المحبة لم تُهدها قصيدة؟
- أنا ريفيّ وبي من حياء أهل البادية والريف ما بي، بالرغم من أنّي امتحرّرب في كتاباتي. ربّما لهذا السبب لم أُهد زوجتي أيّة قصيدة لي، وإن كان طيفها يمثّل في بعض النصوص. والبيت الذي أمازحها به عادة، هو تنويع على بيت جميل:
صغيران مربعنا واحد
فكيف كبرتِ، ولم أكبُرِ؟
وأمّا بعد
• فوزك بجائزة الشيخ زايد للإبداع العربي... يعني أن الشاعر السبعيني ما تزال شعلة القصيدة متقدة متوهجة داخله، هل لديك خطة إبداعية لما بعد السبعين؟
- قد لا أجد أفضل من عبارة الشابّي، وهو الذي حاول أن يكون فاعلًا في المشهد الثقافي التونسي؛ لكنّه سرعان ما أدرك (مصيبة المشاريع التونسية) بعبارته إذ ايندفع القائمون بها في العمل اندفاعًا كلّه شغف وشوق وإخلاص، ولكنّه لا يدوم؛ فإنّه لا يلبث إلّا قليلًا حتى يخبو أوَارُه، وتركد ريحه، وينصدع شمل الجميع...ب.
تونس
• وُلدت عام 1949م قبل استقلال تونس بستّ سنوات... ما الذي أنجزه التونسيون؟ وما الذي لم ينجزوه فيما يخص الاستقلال الثقافي؟
- أظن أنّ حياتنا الثقافية لا تزال تعاني الكثير ممّا ذكره الشابي، فقد تأسست لدينا، منذ الاستقلال، دور الثقافة والنشر والنوادي والمهرجانات والجمعيّات... ولكنّها، وهذه حقيقة ينبغي أن نصدع بها، اواجهاتب أكثر منها مشاريع ثقافية متكاملة. وليس أدلّ على ذلك من أنّ الشابي استطاع بمفرده أن ينقل نصّه إلى أفق المشهد الثقافي العربي، على حين لا يزال أكثرنا، رغم كل هذه المشاريع، واقفًا على تخومه. ولكن هناك أفراد في شتّى الفنون من شعر ومسرح وسينما... استطاعوا بمجهودهم الفردي أن ينجزوا ما لم تُنجزه وزارة الثقافة عندنا ■