«الأثر... كيف يؤثر القانون في السلوك»؟
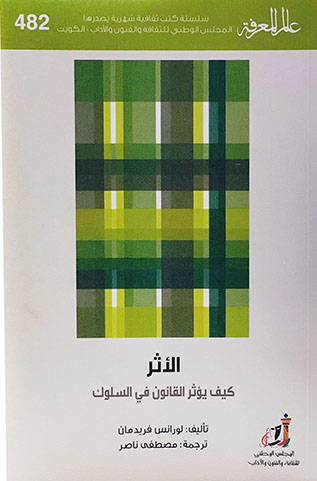
رغم الاعتراف لكل حقلٍ معرفيٍ أكاديميٍ بالتفرّد والخصوصية، فإن الفكر الأبستمولوجي ما فتئ يقرّ بالمنطلق التاريخي لهذه الحقول المعرفية والمستند إلى مبدأ وحدة المعرفة أو «تكامل العلوم»، وإن بقدرِ محدود. وعلى الرغم من ذلك، يبدو الوضع الحالي للحقول المعرفية في أغلب الجامعات وكأنها معزولةٍ عن بعضها. ويبدو هذا القصور أكثر وضوحًا في مجال علاقة القانون بعداه من الحقول، إذ لا يتلقى القانونيون في الكثير من الدول العربية أيّ دراسة ممنهجة كمقدمة في الحقول المعرفية ذات العلاقة المباشرة بالقانون، وأهمها الدراسات الإنسانية.
لمّا كنتُ طالما آمنت بوجود علاقاتٍ تاريخيةٍ وموضوعيةٍ بين جميع الحقــول المعرفيــة، لا سيّما الإنسانية منها، فإنني أعرض، فيما يلي، مراجعتي لكتابٍ قانوني يتنقل بين هذه الحقول بسلاسة، وهو الكتاب المعنون بـ االأثــر... كيــف يؤثــر القانــون فــي السلــوك؟ب، والذي يحمل في نسخته الإنجليزية الأصلية عنوان Impact: How Law affects Behavior.
ويتمثّل العرض الآتي بمراجعة الكتاب من حيث محتواه، ومنهجه، والجمهور المُخاطَب به. وعليه، أورد بيانًا تفصيليًّا برأيي حول الكتاب موضوع المراجعة، معروضًا على خلفية من الأغراض أعلاه، ومفصّلًا وفق منظوري لمحتويات فصوله.
الكاتــب والكتــاب
وضع هذا الكتاب الكاتب لورنس فريدمان، أستاذ القانون في جامعة University of Stanford الأمريكية وأستاذ كرسيّ فيها. وفريدمان هو باحثُ مبرّز في تاريخ القانون ومحاضرٌ معروفٌ في مجال الدراسات القانونية - الاجتماعية، وله إنتاجٌ علميٌ خصب فيها، كما أنه وضع العديد من الكتب في هذا المجال الذي كان ينشر فيه منذ سبعينيات القرن المنصرم، ومن أشهر كتبه A History of American Law وTotal Justice وThe American Legal Experience، إضافة إلى كتب أخرى في مجال القانون. والكتاب موضوع العرض، كما نشر بالإنجليزية، يحمل عنوان Impact: How Law affects Behavior، وصدر عن دار نشر Harvard University Press، والطبعة المقصودة هي الطبعة الأولى (2016).
وفي نسخته الإنجليزية، ورد متن الكتاب (مادته الرئيسية) في 252 صفحة من القطع المتوسّط، وحوى تمهيداً و10 فصول (منها مقدمة وخاتمة). وانتظمت تحت كلّ بابٍ عدة عناوين فرعيّة، وخُتِم الكتاب بقائمة مراجع وملاحظات ختامية جامعة وغنية، تراوح محتواها بين الإضافة، الاستطراد، الإحالة والإشارات المرجعية.
أما عن النسخة العربية من هذا الكتاب، فكعادتها في استباق دور النشر العربية باختيار العناوين الأجنبية المهمة وترجمتها إلى القارئ العربي وطرحها له في طبعةٍ جيدة وذات سعرٍ رمزي، فقد ترجمت سلسلة اعالم المعرفةب التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت هذا الكتاب إلى اللّغة العربية، وطرحته في مارس 2020 تحت عنوان االأثر... كيف يؤثر القانون في السلوك؟ب (383 صفحة). ومن الواضح أن المترجم مصطفى ناصر قد قام بعملٍ جيدٍ في ترجمة هذا الكتاب، وهو يُحسب لها بلا شكّ.
ويتبع الكتاب منهجًا تحليليًا، يعرض فيه الكاتب لموقف القانون معالجًا من منظور عبر- تخصصي خصب (interdisciplinary approach)، فيستقي مناقشاته من الدراسات المتخصّصة في مجال القانون وفي عداه من الحقول المعرفية الأخرى في مجال الإنسانيات، مثل علم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد وعلوم الإدراك. وتقسّم موضوعات الكتاب على عدة فصول، وذلك على الوجه الآتي:
تمهيد مختصر جدًا
1. الفصل الأول: مقدمة
2. الفصل الثاني: توصيل الرسالة
3. الفصل الثالث: تشريح الالتزام
4. الفصل الرابع: طبوغرافيّة الاستجابة
5. الفصل الخامس: الثواب والعقاب: جانب العقوبات
6. الفصل السادس: الثواب والعقاب: الدوافع والجانب المدني
7. الفصل السابع: ضغط الأقران
8. الفصل الثامن: الصوت الداخلي
9. الفصل التاسع: عوامل متوافقة وأخرى متصارعة
10. الفصل العاشر: كلمة ختامية
وأعرض هنا منظوري ذ كقارئة متخصصة في القانون ذ لمحتويات هذا الكتاب.
أطروحة الكتاب وموضوعاته
الاتصال هو شرط لتحقيق فعالية القانون، فالقاعدة القانونية لا تأثير لها إذا لم تصل إلى جمهورها. من هنا، فإنّ المخزون المجتمعي من المعرفة القانونية، وضوح القانون، وحضور سماسرة المعلومات القانونية تعتبر جميعها عوامل مؤثرة في تدفق المعلومات من المشرّعين إلى المواطنين. بذا، فإن القوانين واللوائح هي أدواتٌ تشريعيةٌ واسعة الانتشار، حاضرة، وتمسّ العديد من نواحي الحياة الخاصة والعامة. ولكن ما هي الاشتراطات التي تضفي عليها الفعالية؟ هذه هي الأطروحة المركزية التي يدور حولها البحث في الكتاب موضوع العرض.
وفي تمهيد مختصر جدًّا، يشير الكاتب الى أنه تم تكريس جانب كبير من الإنتاج البحثي الأكاديمي في العديد من الحقول المعرفية كالعلوم السياسية وعلم الاجتماع والاقتصاد والقانون، وعلم الإجرام، وعلم النفس لدراسة أثر التشريعات، ويعطي عقوبة الإعدام مثالًا. وقد خرج فريدمان بنظامٍ من كل هذه الفوضى. فكتابه يجمع بين كل هذه الحقول المعرفية المتناثرة في تحليلٍ واحدٍ، فيمهّد الأرضية لكلٍّ متجانس ينتمي إلى ما يُسميه فريدمان ادراسات التأثيرب.
ويبيّن الكاتب أن كثرة الدراسات في هذا المجال هي عائقٌ للباحث، لاسيما أن الأبحاث تتقاطر من كل مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية. لذلك، يسرد الباحث هنا منهجيّته فيشير إلى أنها تتمثل في خلق هيكلٍ للمسألة، ثم عرضها بطريق تبسيطي، من خلال بيان ما هو مهمّ وأساسي، وترك ما عداه من جوانب أخرى ذات علاقة ولكن غير مؤثّرة، للخروج بتطبيق يتضمن فئات أساسية تصلح للمعالجة في هذا الكتاب. ويناقش الكتاب صور الفعاليّة القانونيّة والعناصر المحقّقة لها. ومن هنا، فهو يرى أن هناك 3 عوامل تضفي على القانون فعاليّته:
1. الثواب والعقاب.
2. تأثير الجماعات القرينة أو النظيرة.
3. اعتبارات المشروعية والضمير والأخلاق.
وعندما تتحرّك جميع هذه العوامل في الاتجاه ذاته، فإنه يمكن أن يكون للقانون تأثيرٌ قوي، أما إذا تعارضت مع بعضها البعض، فإن النتائج قد تكون غير متوقّعة. في البداية، كما يقول فريدمان، كان يعتقد أن دراسات القانون والمجتمع كانت معنيّة أكثر بدراسة مصدر القانون، لكنه سرعان ما تنبّه إلى أن أثر القانون هو أمرٌ له أهميته أيضًا في مجال الدراسات القانونية - الاجتماعية. والملاحظة الدارجة من كون القانون كما يُدرّس يختلف عن القانون كما يُطبّق هي ملاحظة مُستحقّة، وهي في حقيقتها تتعلّق بأثر القانون، رغم أنها لا تُسمّى بهذا الاسم. كما أن موضوعات مثل علم الإجرام، دراسات الخضوع التنظيمي، وتأثير المحكمة الدستوريّة الأمريكية هي جميعها أمثلة على دراسات الأثر، وكذلك الأمر مع أيّة محاولة لاستكشاف وتحليل أيّ قانون سارٍ.
دوافع مهمة
في كتابه هذا، يلخص فريدمان الأبحاث في مجال القانون والمجتمع في مجال الأثر بطريقة سهلة، سلسة وشاملة. ولعلّ أحد الدوافع المهمة وراء وضع هذا الكتاب هو ملاحظة الكاتب التي يقول فيها اإن كوب البحث قد امتلأ إلى أن فاض. هناك المئات من الدراسات حول الردع، ومئات الدراسات حول تنظيم العمل التجاري، ومع ذلك فالنتائج إلى الآن غير قاطعة. هناك تغيرات كبيرة في البحث العلمي، لكن الأهم من ذلك - وهو ما يثير القلق ذ أنه لا يوجد اطّراد بحثيب.
وفي الفصل الأول، وهو المقدّمة، يبدأ فريدمان كتابه بالقول إننا يمكن أن نختصر مشروع القانون والمجتمع برمّته في سؤالين؛ أما الأول فهو معنيّ بالتساؤل عن مصدر القوانين وإلى الدرجة التي يمكن اعتباره فيها نتاجًا للقوى الفاعلة في المجتمع، وأما الثاني فهو موضوع هذا الكتاب، وهو أثر القوانين، ويسرد الكاتب هنا خطّة الكتاب، وهي تغطي الآتي: دراسة متطلبات الأثر، وأنواع الأثر المباشر وغير مباشر، وحجم الأثر، ونتائجه.
توصيل الرسالة
في الفصل الثاني الذي أسماه اتوصيل الرسالةب، يبيّن الكاتب للقارئ أنه يُواجَه ببركانٍ ثائرٍ من الأبحاث، لكنها نادراً ما يمكن أن تُعتبر ذات طبيعةٍ تراكمية.
لذا، يبدأ فريدمان بمحاولة إضفاء شيءٍ من النظام على هذا الانفجار البركاني. فيفحص متطلّبات التأثير؛ أي الطريقة التي يرسل بها القانون رسائله، وهنا يناقش فريدمان الدراسات التي تفحص طبيعة الجمهور المخاطب وما يعرفه عن القانون، وكيف عرفه، وما هو الدور الذي يؤديه الإعلام في تحليل أو تشويه رسالة القانون، وعن تأثير أو صياغة القاعدة أو الحكم نفسه، وما إذا كانت تصورات الناس عن القانون تطابق فعلًا ما هو عليه بالواقع.
وكما يشير فريدمان، فإن الاتصال - بشكلٍ من الأشكال - هو أمر ضروري ولازم، لكنه ليس كافٍ حتى يكون للقانون تأثير فعّال. ويعرض الكاتب لحالاتٍ من القانون المقارن (ألمانيا / الولايات المتحدة) تُصدِر الدولة فيها القانون ويظل الكثيرون رغم ذلك يجهلونه.
ويذهب الكاتب إلى أن كثيرًا من الناس لا يعرفون المحتوى الموضوعي للقانون، وأنهم - في أفضل الفروض - ليس لهم إلا معرفة مشتتة وغير ممنهجة به، كما أنّهم لا يعرفون عن الأحكام القضائية إلا من فاز في القضية ومَن خسر فيها، ومن دون أن يفهموا منطق هذه الأحكام، أو تركيب الحِجاج القضائي، أو قيمة السابقة القضائية أو دلالتها، وبذلك يكون القانون أرضًا مجهولة وغير مكتشفة للكثيرين. وفي حين أن الجهل بالقانون مفهوم ومبرّرٌ بسبب كثرة الأدبيات القانونية، والتشريعات، والأحكام القضائية، والدوريات الفقهية، ومذكرات المحامين، وعداها، بما ينتهي الأمر معه إلى أطنانٍ من المعلومات المتراكمة، إلّا أن هناك سوء فهمٍ واضح للقانون، وإن تكرّرت تعاملات المرء معه.
تشريح الالتزام
وفي الفصل الثالث الذي تُرجِم إلى اتشريح الالتزامب، يهدم الكاتب فكرة الأثر ذاتها. ففي حين أن الدراسات القانونية معنيّة بالأثر الداخلي للقانون ذاته، فإنّ الدراسات الاجتماعية/ القانونية تعنى بتأثير القانون على العالم الخارجي. ويميز هذا الفصل بين التأثير المباشر وغير مباشر للقانون، كما أنه يقدّم تفرقة مفيدة بين تقييم أثر القانون وتقييم ما إذا كان يحقق فعلًا النتيجة المرجوة منه (وهو تمييز دقيقٌ وغير سهل). ويظهر الكاتب شكوكًا حول ما يذهب إليه جانب من الآراء من أن لبعض الإصلاحات القانونية تأثيرات رمزيّة حتى عندما لا يتم رصد أي أثرٍ مباشر.
ومن المثير للاهتمام أنه لم تطرح، حتى الآن، أسئلة جادة بشأن السبب وراء أن بعض القوانين لها آثار فعالة مجتمعيًا من حيث السلوك الاقتصادي والاجتماعي الذي تستهدفه، في حين تخفق قوانين أخرى في ذلك. وقد تم التصدي لهذه الإشكالية عن طريق تصنيف الخيوط المختلفة من حقول معرفية متباينة نظريًا وتطبيقيًا، وذلك بقصد دراسة قدرة القانون على تغيير المجتمع.
ويتعلّق هذا الفصل بدراسة الآثار القانونية وتلك غير القانونية للتشريع. فأمّا الآثار القانونية فيُراد بها الآثار المباشرة (امتثال، دعاوى قضائية، وعداها)، وأما الآثار غير المباشرة، فهي ما يتعدى دائرة القانون إلى ما عداه من جوانب الحياة الاجتماعية. وفي فصلٍ رابعٍ يحمل عنوان اطبوغرافيّة الاستجابةب، يناقش الكاتب أنماط استجابات الناس تجاه القوانين، فيعرض لبعض صور هذه الأنماط، ومنها على سبيل المثال:
المواءمة
قوانين الضرائب التي تحمل الناس على المواءمة مع إملاءاتها، فرغم عدم التهرب من متطلباتها فإنهم يعدّلون ظروفهم بما يسمح بالاستفادة أكثر ما يمكن من الفرص التي تقدّمها هذه القوانين من خلال الامتثال بالطريقة الأكثر ملاءمة (تحويل الملكية من أسهم الشركات إلى سندات الخزينة / تحويل النقود إلى الجنات الضريبية مثل جزر كايمان / الاستفادة من فرص الإعفاءات والتخفيضات الضريبية / التبرع للجهات الخيرية للحصول على إعفاءات ضريبية، ولذلك فإن الناس يكيّفون سلوكهم وفقًا لمتطلبات القانون، فالتكاليف الموسمية واسعة الانتشار للسلوك القانوني، وجزء حيوي من أثر القانون.
التهرّب
تمثّل كل جريمة شائعة نظامًا قائمًا بذاته، ولفهم هذا النظام ينبغي ليس فقط فهم القانون الذي يخرقه المجرمون وسبب خرقهم له، وإنما فهم كيف يفعلون ذلك أيضًا، أي فهم خرقهم للقانون كعمليةٍ متكاملة، بما في ذلك أنماط هذا الخرق والاستراتيجيات التي يتبعونها لتفادي ضبطهم. أما في الفصل الخامس المسمى االثواب والعقاب... جانب العقوباتب، فيبين الكاتب أن أكثر القوانين تراوح ذ كالبندول ذ بين فكرتَي العقاب والثواب. وإن كانت الأخيرة أقل وضوحًا من الأولى، إلّا أنّ المنظومة القانونية مليئة بها (تعويضات عن المسؤولية، وترقيات، وأوسمة، وتقاعد، ونقاط المرور، وعداها من استحقاقات مقررة في القوانين المختلفة).
يناقش الكاتب صور أغراض القانون بين العقاب والثواب، مع تركيز خاص منه على الردع. فهناك العديد من الحوافز في النظام القانوني، ومع ذلك لا يركّز البحث العلمي إلّا على كل ما من شأنه أن يرتبط بالردع. وبطبيعة الحال هناك الردع الخاص المتمثل بالجزاء الذي يقع على شخص ما بعينه، ثم هناك الردع العام، وهو الأثر الذي يؤمّل أن يقع على بقية أفراد المجتمع، بعد توقيع الجزاء على شخصٍ ما، والتهديد بتوقيعه على كلّ من يرتكب فعلًا مماثلًا.
ويبيّن الكاتب أنّ فاعلية العقوبات تقاس وفق ما يعرف بـ امنحنى الردعب، وهو يعني أن للعقوبات مستوى للفعالية بالردع يمكن بعده ذ لدواعٍ مختلفة ذ أن تفقد قدرتها على هذا الردع (لأسبابٍ تتعلّق بنوع العقوبة، وفداحتها، ودرجة تطبيقها، والثقافة المحلية، والعامل الأخلاقي للشخصية، ومدى الاضطرار السلوكي أو الحاجة إليه، وعداها). فمن يواجَهون بعقوبة الإعدام لا يخيفهم شيء، ومن يعتادون الحبس لا يوقفهم التهديد به، ومن ليس لديه ما يخسره يغامر بكل ما لديه.
وعلى كل، فإنّ الثابت هو أن ما يحقق الردع هو وضوح رسالة القانون: فكلما كانت رسالة القانون واضحة ومحددة، كان الخوف منه غالبًا، والخوف هو ما يحقق الردع وليس فداحة العقوبة المترتبة على المخالفة.
الثواب والعقاب
وفي الفصل السادس، الذي حمل عنوان االثواب والعقاب: الدوافع والجانب المدنيب، يورد الكاتب أنه عادة ما تدور القوانين حول العقوبات، لكن قليلًا منها يشير إلى حوافز، فمثلًا كان القانون في كولورادو خلال القرن التاسع عشر يقضي بدفع 1.25 دولار لكل صيادٍ يُحضِر إلى السلطة فراء ثعلبٍ مع أذنيه، وكان ذلك حافزًا، فالمال إذًا حافزٌ جيد. لكن الحوافز قد تأتي على شكل أشكال أخرى (أوسمة للجنود الذين يُظهرون شجاعةً في القتال، أو تخفيض ضريبي للملتزمين بدفع ضرائبهم، أو إعفاء من الرسوم للمستثمرين، أو جوائزٌ للعلماء، أو شهادات تقديرٍ لموظفي الشهر،... إلخ).
ولعل من الأمثلة الجيدة هنا ما يظهر في قواعد اإطلاق الصافرةب، التي تعني قيام الموظفين بالإبلاغ عن الممارسات الفاسدة التي تحدث في مؤسساتهم من دون الكشف عن شخصياتهم، مع إمكان منحهم مكافآت مالية مقابل ذلك. فوفقًا لقانون Federal False Claims Act، فإنه يمكن منح الموظف المبلّغ عن حالة فساد تتعلق بمقاولٍ ينفّذ مشروعاً للحكومة الأمريكية، حيث تكون للموظف المبلّغ نسبةً من المبالغ التي تسترجعها الحكومة من المقاول. كما أن بعض المجتمعات تكافئ على شكاوى المواطنين الجادة والفعالة ضد الأعمال التجارية أو حتى ضد الحكومة. ففي الصين مثلًا، بدأت بعض السلطات المحلية بمكافأة المواطنين الذين يبلّغون عن الممارسات الملوّثة للبيئة، لا سيما أن الشركات والمصانع هناك لا تحترم قوانين حماية البيئة، قوانين الغذاء، وحماية المياه، لذلك فإن هذه السلطات تعوّل على إفادات المواطنين وتنبيههم لها حتى تستدلّ على مثل هذه الممارسات فتكافحها. كما أنّ الحكومة في سلوفاكيا دعمت خطط تقديم ضريبة القيمة المضافة، من خلال دعوة المواطنين إلى تسجيل مشترياتهم في نظام تسجيل مركزي مقابل وعدهم بالجوائز، وذلك لحمل التجار على الالتزام بقواعد هذه الضريبة والإفصاح عنها.
ضغط الأقران
أما في الفصل السابع المعنون اضغط الأقرانب، فيرى الكاتب أن سياسات الثواب والعقاب تمثّل تفسيرًا مهمًا وراء المواقف من احترام القانون. ومع ذلك، فهي لا تفسر كل شيء، فهناك أسباب أخرى تحمل المرء على الالتزام بالقانون أو خرقه، ولعل من أهمها الاعتبار الذي يوليه الشخص لرأي أقرانه والأشخاص في محيطه ونظرتهم له (الأصدقاء / الزملاء / الأسرة / القبيلة / المجتمع / الحي / النادي / الجمعية / المدرسة / العمل) والخِشية من الإحراج أو الفضيحة أو العار.
وقد بُنِيَت فرضيّات كثيرة من النظريّات الاقتصاديّة المعاصرة، على أساسٍ من اعتبار الإنسان كائنًا عاقلًا ذا اختياراتٍ عقلانية، لكنه مهما انتشر هذا الفرض، يجب أن نتذكر أنه ليس لدى الإنسان آلة حاسبة طوال اليوم يحسب بموجبها مدى عقلانية سلوكه، كما أن تصرفاتنا لا تُمليها حساباتنا العقلانية دائمًا بالضرورة، فالإنسان كائن اجتماعي يتحدد إدراكه وتنتقل له كثير من معارفه من خلال العادات والأفكار والأعراف والتقاليد والتوقعات التي يجمعها من الآباء والأمهات والأصدقاء والمدرسة والجيران والإعلام والعمل ودور العبادة.
والحقيقة هي أنّ المجتمعات الحديثة كيان عضويٌ معقّد، فجميع المجتمعات المعاصرة هي مجتمعاتٌ تعدّدية وليست كتلةٌ أخلاقيةٌ صمّاءٌ مصنوعة من عنصرٍ واحد. وهي جميعها تنحدر من مجتمعاتٍ فرعيةٍ، ولهذه معاييرها ونُظُمها الخاصة (قبيلة / طائفة / مهنة).
بطبيعة الحال، تخضع المجتمعات الفرعية لقواعد الأغلبية، التي هي في حقيقتها المصدر الرئيسي للقانون، إلا أن هذه يمكن ذ بدورها ذ أن تصطدم بالثقافة الفرعيّة، وهكذا دواليك.
الصوت الداخلي
ثم في الفصل الثامن، الذي يحمل عنوان االصوت الداخليب، يستعرض الكاتب مجموعة أخرى من العوامل التي تضفي فعالية على القوانين لما لها من أهميةٍ خاصة. وهي عبارة عن تشكيلة من المواقف الشخصية الداخلية والدوافع الأخلاقية، بما في ذلك ما نسمّيه بـ االضميرب. والضمير هو مسألةٌ صعبة التحديد، وتمثل السبب الذي يجعل الناس يلتزمون بالقانون، ويدفعون الضرائب، ويمتنعون عن رمي القاذورات في الشارع، ويصفّون سياراتهم في غير الأماكن المخصّصة للمعاقين. كما أن للشرعيّة دورًا كبيرًا في احترام الناس للقانون، وهذه مسألةُ تُعتبر حجر أساسٍ في علم الاجتماع القانوني منذ أن صدرت الدراسة المهمة والشهيرة لعالم الاجتماع Max weber. ويمكن تعريف الشرعيّة بأنها اخلق إدارة عامة لدى الناس لقبول قراراتٍ ذات محتوى لم يتحدّد بعدب.
فوفقًا لهذا التعريف، يصبح من الواضح أن للشرعيّة الحديثة صفة إجرائية قوية وقاطعة، يترتب عليها أثر من الاحترام للقواعد والمعايير والقوانين؛ لا بفضل محتواها الموضوعي، أو بسبب شخصيات المرشحين، وإنما بسبب الطريقة التي جاءت بها إلى الوجود والمتمثلة في الانتخابات الديمقراطية، أو تصويت الأغلبية، أو أية طريقةٍ قانونيةٍ صحيحةٍ أخرى. وسؤال الشرعية ينعكس على الإطار العام للوسط الاجتماعي، فالأمر لا يتعلق بالإجراءات فقط (كالانتخابات الديمقراطية)، وإنما بأن تكون لهذه الإجراءات شرعيةٌ في ذاتها أصلًا.
دور مهمّ
أما في القرون الوسطى، فقد كانت الشرعية تقوم على أسسٍ مختلفةٍ تمامًا: كالحق الإلهي لسلطة الملوك، الحق الوراثي في تولّي العرش أو الحصول على اللقب الإقطاعي، أو اختيار البابا من خلال تجمّع الكرادلة.
إن صور الشرعية تتغير وتتبدّل مع مرور الزمان، كما أن الهويّة المدنية تؤدي دورًا مهمًا أيضًا في مدى تأثير القوانين وفاعليتها. فحتى يكون للقانون الصادر من الدولة قيمة معتبرة بالنفوس وتأثير فعّال في الواقع، ينبغي أن يشعر الناس أنه يعبّر عن إراداتهم وأنهم طرف فيه، وأنّ للعبة قواعد عادلة تجعلها مستحقة للاحترام.
أما الفصل التاسع من الكتاب، وهو المعنون بـ اعوامل متوافقة وأخرى متصارعةب، فهو يحلّل التدخّلات التشريعية، فيقرّر أنها جميعاً تهدف إلى تحقيق أهدافٍ معيّنة، وهذه الأهداف عادة ما يستخدم لتحقيقها أحد أو بعض أو كلّ الأدوات التي سبق الحديث عنها والقاصدة لتحقيق أثرٍ للقانون (العقوبات والمكافآت، وضغط الأقران، والأخلاق، والشعور الوطني، وعداها).
وربما كان في التشريعات المتعلّقة بالتدخين مثالاً؛ فبعد أن كان التدخين ذ لمئات السنين ذ سلوكًا اعتياديًا سائدًا في كثير من المجتمعات، لجأت الدول من خلال تشريعاتها إلى تغيير النظرة المجتمعيّة عنه فصار ممارسةً غير مقبولة أو على الأقل غير مرحّب بها، وذلك من خلال إصدار تشريعات الحدّ من التدخين في الأماكن العامة، ومنع التدخين في الطائرات، وفرض الضرائب على السجائر، ومنع بيع السجائر لمن هم أقل من سنّ معيّنة، وإلزام مُصنّعي السجائر بوضع ملصقات التحذير على العبوّات، وما شابه ذلك من إجراءات.
تشييد الهيكل
إن نتيجة كل ما تقدّم هو أن المدخنين صاروا يشعرون أنهم مُدانون، وغير مرحّبٍ بهم ومعزولين. ومع ذلك، فهذا النجاح على جبهة التدخين لا يقابله نجاح مساوٍ بالضرورة على جبهاتٍ مُقارَنة أخرى، كالحرب ضد السمنة مثلًا باعتبارها أيضًا مسألة متعلقةٌ بالصحة العامة، لأن القانون لم يدخل بكل ثقله على هذه الجبهة بعد مثلما تدخّل على جبهة التدخين فغيّر حتى من صورته الاجتماعية. ويحدث أحيانًا أن تتزاحم أكثر من أداةٍ لتحقيق هدف القانون، مما قد يؤدي إلى إضاعة الهدف المرجو منه ابتداء. وعلى سبيل المثال، تعوّل تشريعات إطلاق الصافرة Whistle Blowing على الجانب الأخلاقي لدى الموظّف الذي يرصد المخالفات في بيئة عمله، ومع ذلك، فإن منح المكافآت لمن يقومون بالإبلاغ عن المخالفات قد يؤدي إلى سيلٍ من البلاغات الكاذبة أو المُفبرَكة. ويأتي الفصل العاشر، الذي كان عنوانه هو اكلمة ختاميةب، ليكون بمنزلة محاولة للربط بين جميع الموضوعات التي ناقشتها الفصول المتقدمة. وهو يشير، مرة أخرى، إلى المعضلات الناجمة عن كثرة الدراسات في الموضوع، والتي نجم عن خوض هذا الكتاب فيها ما أسماه بـ اتشييد الهيكلب فكريًا.
وتزايد وجهات النظر المتعارضة وإن كان مهمًا من منظور العلوم الاجتماعية، إلا أنه - بالطبع - لا يجعل من المهمة أسهل. وعلى أيةّ حال فالأمر يتعلّق، كما يرى الكاتب، بالخروج بقانون للسلوك الأخلاقي، وهي مسألة لا محال من تركها لأجيال المستقبل.
الهوامش والإشارات المرجعيّة
للكتاب موضوع الاستعراض هوامش منتظمة ومستوفاة من حيث الإشارات المرجعية، وقد حرص الكاتب في سرده على الإحالة إلى المراجع التي استند إليها في بحثه، باطّرادٍ ومن دون انقطاع. كما أن طريقة كتابة بيانات المراجع في الهوامش مُرضية، راعى فيها الكاتب الاعتبارات الببليوغرافية الفنية عند كتابة الهوامش وتدوين البيانات المرجعية، وفق الأصول الأكاديمية المعروفة في الكتابات القانونية.
وتلحق بالكتاب قائمة مراجع موسّعة ومستفيضة فعلًا، مع كثير من الإشارات والهوامش المفيدة جدًّا للباحثين وللراغبين في الاستزادة.
التقييم الشخصي للكتاب
الكتاب موضوع العرض هو بمنزلة مدخلٍ عامٍ إلى فكرة القانون، لذلك أجد أنه من حيث الجمهــور المُخاطَـب بالكتـاب، فلا شك بأن الكتاب يوجّه خطابه إلى الكافة، إذ لا تتطلب قراءته خلفيةً علميةً حقوقيّة، كما أن مساحة الخطاب فيه - وتطبيقاتها ذ لا تتركز على منطقة جغرافية بعينها ولا على نظامٍ قانونيٍ بذاته، بل يلتزم منظورًا مقارنًا واسعًا ومفيدًا.
وبعد، فإن هذا كتاب يدور حول فكرةٍ مركزيةٍ محددة، واضحة، وصلبة، وهو غنيٌ بالأمثلة وخصبٌ بالتطبيقات، كما أنه، في كثير من الأحيان، ممتع. لذلك، أجد أنه يمثّل قراءة عامة ممتعة ومفيدة للقراء على اختلاف مشاربهم وتخصصاتهم. لكل ما تقدّم، أوصي المهتمين بالقانون عامة ودارسيه خاصة بقراءة هذا الكتاب، لا سيما أنه قد كُتِبَ بطريقةٍ ممتعةٍ وعميقة في الآن ذاته، وهذه سمةٌ نادرةٌ في الكتب القانونية، التي عادةً ما تتّسم بالجفاف بسبب جديّة تناول الموضوعات التي تناقشها ■

