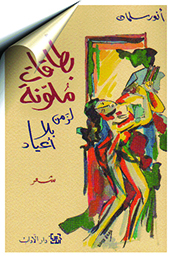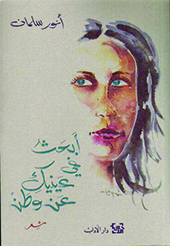أنور سلمان شاعر المرأة والوطن

منذ أربع سنواتٍ ونيِّف، رحل الشاعر اللبناني أنور سلمان، إثر حادثٍ مؤسف، عن ثمانيةٍ وسبعين عامًا، وستّ مجموعات شعرية، فترك فراغًا في المشهد الشعري العربي لا يملؤه سواه، انطلاقًا من مبدأ أنّ لكلٍّ حيِّزَهُ الذي يفرغ بعد رحيله، وليس لأحدٍ أن يشغل حيِّز الآخر. وأنور سلمان هو حلقةٌ متميِّزة في سلسلة الشعر الغزلي الحضَري، التي تعود في حلقاتها الأولى إلى عمر بن أبي ربيعة، ويشكّل نزار قباني إحدى أجمل حلقاتها الأخيرة. وبكلمة أخرى، إن أنور سلمان هو النسخة اللبنانية من نزار قباني، لكنّه ليس نسخة طبق الأصل عنه، بطبيعة الحال، فهما ينهلان من المورد نفسه، ويشتركان في الموضوعات والتقنيات الشعرية، غير أنّ لكلٍّ منهما مساره ومصيره الشعريّان.
في قرية االرمليّةب من قضاء عاليه، في جبل لبنان، وُلِدَ أنور سلمان، ذات يوم، من العام 1938، وتشبّع بمناظر الطبيعة الجبلية اللبنانية الخلاّبة، ممّا شكّل لاحقًا أحد مصادر شعريّته، ودرس في الجامعة الوطنية في عاليه، على نخبةٍ من الأساتذة، وفي طليعتهم مارون عبود، حتى إذا ما نال جائزته للشعر في العام 1956، وتُشكّل هذه الواقعة نقطة انطلاق لمسيرة شعرية راسخة، ويأتي نيله جائزة الميكروفون الذهبي لأجمل أغنية عربية في مهرجان قرطاج الدولي للعام 1994، وجائزة أفضل نص شعري في المهرجان نفسه، والجائزة الأولى لأجمل قصيدة مغنّاة في مهرجان القاهرة الدولي للأغنية العربية في العام 1997، ليُشكّل اعترافًا عربيًّا برسوخ هذه المسيرة وبمكانة صاحبها في المشهد الشعري العربي.
منذ نعومة أظفاره الشعرية، انخرط أنور سلمان في الحياة الثقافية اللبنانية، بتمظهراتها المختلفة؛ فانضمّ إلى احلقة الثريّاب الشعرية، في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وفي أعلامها الشعراء والأدباء إدمون رزق وجورج غانم وشوقي أبي شقرا وآخرون، وشغل موقعًا إداريًّا في اتحاد الكتّاب اللبنانيين لثلاث دورات متتالية بين العامين 1997 و2005، وشارك في تأسيس امجلس المؤلّفين والملحّنين اللبنانيينب، ومارس التدريس والصحافة. وهكذا، يكون قد وازى بين مسيرة إبداعية جميلة وحركة ثقافية ناشطة. وإذا كان الخطّان المتوازيان في علم الرياضيات لا يلتقيان، فإنّ الخطّين المتوازيين اللذين سلكهما الشاعر، كثيرًا ما التقيا وتقاطعا وأكمل أحدهما الآخر، ذلك أنّ في علم الثقافة والإبداع يسقط الكثير من المحرّمات الرياضيّة.
الأعمال الشعرية
خلال مسيرته الشعرية التي امتدّت على ستة عقود، أصدر أنور سلمان ستّ مجموعات شعرية، بدأها بـ اإليهاب في العام 1959، وأنهاها بـ االقصيدة امرأة مستحيلةب في العام 2008، وهي جميعها ورقية، باستثناء مجموعة احبُّك ليس طريقي إلى السّماءب الصوتية، التي تجمع بين الموسيقى والشعر، فضلًا عن مجموعة نصوص نثرية صدرت تحت عنوان امرايا لأحلام هاربةب، وخواطر ومذكّرات، ما تزال قيد الطيّ، ولعلّها تبصر نور النشر يومًا. وإذا ما وزّعنا المجموعات الست على العقود الستة، يكون الشاعر قد أصدر مجموعة شعرية واحدة كلّ عقد، ويكون شاعرًا مقلًاّ، مقارنةً بغيره من الشعراء، ولكن، من قال إن الشعر مسألة كمٍّ وعدد؟ أليس هو مسألة نوعٍ بامتياز؟ فربَّ قصيدة واحدة يكتبها شاعر تطير بها الركبان، وربّ مجموعات كثيرة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به، ولنا في الشاعر الجاهلي المنخّل اليشكري وقصيدته اليتيمة خير مثال على ذلك.
في إضاءة الأعمال الشعرية التي صدرت في العام 2018، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، في بيروت، في الذكرى الثانية لرحيل الشاعر، يقول الدكتور منيف موسى، في تقديمه الأعمال، اإنّ أنور سلمان خرج من التراث إلى عملية تحديث أصيلة، تأخذ من القديم بطرف ومن الحديث بطرف، على تجديد فنّي رصين، في الشكل والمضمون، وإذا في شعره جماع المدارس الأدبية وأنماط القصيدة الحديثة المتّكئة على أصولية القصيدة العربية الكلاسيكية، وإذا هو يؤسّس لكلاسيكية متجدّدة في الشعر المعاصر، من حيث الشكل الشعري والمضمون ولغة القصيدة وموسيقاها، وقد ركّز في البحور ذات الإيقاع الراقص المطرب والقوافي الرقيقة الناعمة، فلا تقعّر عنده ولا خشونة، ولا غموض ولا إبهام، ولا حوشية ولا سوقية، فكانت القصيدة عنده أميرة تسكن بلاطًا شعريًّا رخاميًّاب, (المقدمة ص 27). ويقول الدكتور وجيه فانوس في تقديمه الأعمال: اإن شعر أنور سلمان انماز بجمالية سلسة، وغنائية عذبة، الأمر الذي حدا بعدد من أساطين التلحين المعاصرين، في لبنان وسائر أرجاء الوطن العربي (...) إلى تلحين قصائده...ب، وحسبنا أن نذكر منهم توفيق الباشا ووليد غلمية ومحمد سلطان وشاكر الموجي ورياض البندك وسهيل عرفة وسواهم، وهو الأمر الذي حدا بعدد من كبار المطربين والمطربات إلى غناء هذه القصائد، وحسبنا أن نذكر منهم فريد الأطرش وفايزة أحمد وماجدة الرومي وسميّة بعلبكي وجوزف عازار ودلال الشمالي ونور الهدى ووائل كفوري وغيرهم، (المقدمة ص 6 و7). ويحصي الدكتور فانوس، في المقدّمة، أحد عشر ملحّنًا وخمسة عشر مطربًا ومطربة تنكّبوا هذه المهمّة الجميلة، اجتهدوا فأصابوا، وكان لهم أجرا الغناء والشعر، وكان للشاعر ثواب الانتشار، وهو به جدير. وهذه الحصيلة الغنية قلّما حظي بها شاعر عربي، على حدِّ علمي.
في مقاربة إحصائية للأعمال المذكورة أعلاه، يتبيّن لنا أنّها تشتمل على أربع مجموعات شعرية، هي، على التوالي: ابطاقات ملوّنة لزمن بلا أعيادب، اأبحث في عينيكِ عن وطنب، االقصيدة امرأة مستحيلةب واإليهاب. ويبلغ مجموع القصائد التي تشتمل عليها مئة وأربعين قصيدة، تتراوح بين أربع عشرة قصيدة للمجموعة الواحدة، في الحدّ الأدنى، وثلاثٍ وخمسين قصيدة، في الحدّ الأقصى. وفي قراءة أولى لهذه الأعمال، يتبيّن لنا أنّها تتمحور حول موضوعتين رئيستين هما: المرأة والوطن. ويبلغ عدد قصائد المرأة في المجموعة، سواءٌ أكانت لها أو عنها أو منها، سبعًا وثمانين قصيدة، أي ما نسبته 62 في المئة من هذه الأعمال، وهي النسبة الأولى بطبيعة الحال. ويبلغ عدد قصائد الوطن بتمظهراته المختلفة ثمانيًا وعشرين قصيدة، أي ما نسبته 20 في المئة من الأعمال، وهي النسبة الثانية. أما القصائد الخمس عشرة المتبقية التي تشكّل نسبة 8 في المئة من الأعمال، فتتوزّع على أغراضٍ شعرية أخرى مختلفة. وبذلك، نستنتج، وبمقاربة إحصائية علمية، أنّ أنور سلمان هو شاعر المرأة والوطن بامتياز، ما يُشكّل موضوع مقاربتنا في هذه العجالة. فأية امرأة كتب الشاعر؟ وأيَّ وطنٍ غنّى؟
على أنّه قبل الانخراط في الكلام على هاتين الموضوعتين، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الشاعر كثيرًا ما يزاوج بينهما، سواءٌ في العنوان أو المتن، فَيُعَنْون إحدى مجموعاته بـ اأبحث في عينيك عن وطنب، ويقول في قصيدة: «مهما يمرُّ عليَّ من محنِ/عيناك باقيتان لي وطني» (ص 124)، ويقول في ثانية: «بعينيك/رحت أبعثر شمس حروفي/وأبحث فيهما عن وطن» (ص 217)، ويقول في ثالثة: «لم أعرف عشقًا غيّرني/ورماني بهوى فاتنةٍ/رسمت عيناها لي وطني» (ص 175). وهنا، نلاحظ أنّ العلاقة أحاديّة الاتجاه وليست جدليًّة، هي دائمًا من الحبيبة إلى الوطن وليس العكس، وأنّ الشاعر يتدرّج في وصف العينين صُعُدًا، من كونهما ترسمان له وطنه، إلى كونهما مكان البحث عن الوطن، إلى كونهما الوطن بحدِّ ذاته.
المرأة
في قصائد المرأة، يكتب سلمان سبعين قصيدة بلسان الرجل، الذات الشاعرة، أي ما نسبته 80 في المئة منها، وسبع عشرة قصيدة بلسان المرأة الموضوع، أي ما نسبته 20 في المئة. وبذلك، يستأثر الرجل بأربعة أخماس القصائد، ويترك للمرأة الخمس الباقي، ما قد يشي بظلم ما، غير أنّنا عندما نعلم أنّها الموضوع الأوّل في شعره، وأنّ المسألة تقنية بامتياز، ندرك حينها مكانة المرأة المميّزة في حياة الشاعر وشعره. وهل الشعر شيء آخر سوى الحياة مصوغةٍ بأجمل الكلام؟
بمعزل عن المقاربات الإحصائية التي قد تبدو مقحمة على عالم الأدب والشعر، تشير الدكتورة جنان بلوط، في دراستها اتجليّات الإبداع في شعر أنور سلمانب، إلى أن تجربة الشاعر مع المرأة هي اتجربة استثنائية في أرقى تجلّياتها، تمتزج بأزمته الوجودية الكبرىب. هذه التجربة يتمّ التعبير عنها في تَرَجُّحِ المرأة بين حدّين اثنين: مثالي وواقعي. أمّا الأوّل فيتمظهر في وصف الشاعر المرأة والتغنّي بجمالها، فيضفي عليها من الصفات الأجمل، ويرتقي بها إلى درجة ما فوق إنسانية، ويتوّجها ملكةً على عرش الجمال، وهو حدٌّ يقتصر على بعض القصائد. وأمّا الثاني فيتمظهر في تقديم المرأة الإنسان التي تعتب وتلوم وتغضب وتثور وتتحدّى، وينطبق على معظم القصائد، ممّا سنأتي على تفصيله أدناه.
الحدّ المثالي
في الحدّ الأوّل المثالي، يستخدم الشاعر تشابيه غير تقليدية في وصف مكوّنات المرأة، ويكسر الصورة النمطية لجمال المرأة في الشعر العربي، ويرسم امرأة بريشته وألوانه هو، فتنتمي إليه بقدر ما ينتمي إليها، تصنعه شاعرًا ويصنعها امرأة، في علاقة جدلية بين الذات والموضوع؛ ففي قصيدة اسماوية العينينب التي تغنّيها السيّدة ماجدة الرومي، العينان هما ليالٍ صيفيّة، والفم خصلة زهرٍ برّية، والشَّعر ضفائر ليلٍ مرخيَّة، والقوام شراع شمس بحرية. وفي قصيدة االمساء الأخضرب، العينان دنيا نجوم ورؤى، والفم خاتم أحمر، والشَّعر نهر، والقوام مرمر منحوت. وهكذا، نكون إزاء مجموعة من التشابيه المبتكرة الحضرية التي تقوم على المشبّه/الإنسان والمشبّه به/الطبيعة والكون. وبين هذين الطرفين، تقوم علاقة جدلية تنتظم معظم قصائد الشاعر، سواءٌ أكانت غزلية أو وطنيّة. وبهذا المعنى، كثيرًا ما يسقط الطبيعي على الإنساني، فيتحوّل الإنسان إلى طبيعة متحرّكة. هنا أيضًا يكون الاتجاه الغالب من الطبيعة إلى الإنسان وليس العكس. ولعلّ خير تعبير عن هذا الحدّ المثالي يكمن في قوله في قصيدة االحديقة الزائرةب: «وفتحتُ بابي/ كنتِ قادمةً ملاكًا/ كنتِ حاملةً عبيرًا/ أنجمًا/ قمرًا بهيّا/ لم أدرِ حين دخلتِ/ أنت؟/ أم الحديقة كلُّها/ دخلت عليّا!» (ص 276). ولعل المثالية تكمن في استقائه المشبّه به من ثلاثة حقول معجمية كبرى، هي: الدين والكون والطبيعة.
الحدّ الواقعي
في الحدّ الثاني الواقعي، تعود العلاقة إلى طبيعتها البشرية، وما يكتنفها من مدٍّ وجزر، وصعود وهبوط، ورضا وغضب، ووئام وخصام، وغرام وانتقام، وهدوء وثورة؛ وهذا التذبذب في العلاقة لا يقتصر على أحد طرفيها، بل ينطبق على الاثنين، في صراع مضمر أو معلن، ينجلي غالبًا عن الافتراق بين الطرفين. وبطبيعة الحال، نحن لسنا إزاء امرأة واحدة في الأعمال، بل إزاء مجموعة من النساء، وهذه ميزة عرفها الغزل الحضري عبر تاريخه الطويل، ونحن لم نعد في زمن جميل بثينة وقيس بن الملّوح وأضرابهما من الشعراء العذريّين، رغم أن الشاعر كثيرًا ما يُفضّل حبيبةً على الأخريات في هذه القصيدة أو تلك.
بالانتقال من التعميم إلى التمثيل، وتعبيرًا عن الصراع بين طرفي العلاقة، يدعو الشاعر المرأة إلى الكفّ عن التبجّح والخُيَلاء في قصيدة اإلى فضوليةب، بكلامٍ لا يخلو من تمييز جنسي غير مناسب: «دعي عنك هذا التبجّح والخُيَلاء/ ولا تجنحي بالغوى للتعالي/فتاجُ جمالكِ صنعُ الرجالِ» (ص 309). ويبلغ هذا التعيير الذروة في قصيدة اامرأة من سرابب، حين يقول: اكنت من صوغ ريشتي وبناني/ من تكونين في غدٍ، أنتِ بعدي؟ب (ص 300)، غير أنّه في هذه الحالة جميل ومبرّر شعريًّا.
في المقابل، فإنّ للمرأة أيضًا غضبتها وثورتها، فنراها تعبّر عن نضجها وقوّتها في قصيدة االقصيدة الحاقدةب بقولها: «أنا الآن غيري... لم أعد من عرفتها/ تمرّ على الأخطاء والقلب غافرُ/ فمن طفلةٍ، بالأمس فيك تولَّهت/ إلى امرأةٍ في أمسها انت عابرُ» (ص 298). وتبلغ ثورتها الذروة في اثورة شهرزادب، فتعرّض بالرجال في لغةٍ جندريةٍ أيضًا، وتردُّ له الصاع صاعين بقولها: «بئس ما للرجال من كبرياءٍ/ إن تكن شيمة الرجولة غدرا/ أنت صدرٌ لا خفق فيه لقلبٍ/ وجبينٌ من الحياء تعرّى» (ص 307). وبذلك، يتعادل كلٌّ من الرجل والمرأة في هذا الصراع الجميل المندلع منذ جدّينا آدم وحوّاء، والمرشّح إلى الاستمرار للأبد.
الوطن
تشتمل الأعمال على ثمانية وعشرين قصيدة تتعلّق بالوطن بشكل أو بآخر، وتتناوله بتمظهراته المختلفة، فمفهوم الوطن في شعر أنور سلمان يتّسم بكثير من المرونة، وهو أشبه بدوائر متداخلة، على سطح الماء، أحدثها إلقاء حجرٍ كبير فيه، فتروح تنداح من الصغرى إلى الوسطى إلى الكبرى التي تلامس الضفاف، وهي دوائر لا تلغي إحداها الأخرى، فالصغرى تنتمي إلى ما يفوقها حجمًا دون أن تذوب فيه، والكبرى تشتمل على ما يقلّ عنها حجمًا دون أن تلغيه. وبمعزل عن تعدّد دوائر الانتماء وأحجامها، فإن سلمان يتناول الوطن إطارًا طبيعيًّا جميلًا، أو تاريخًا عريقًا، أو حاضرًا حزينًا، أو مستقبلًا مجهولًا. ويحوّله من واقع إلى حلم، ومن إطار إلى صورة، ومن مادّة إلى فكرة، ومن كيان إلى رمز. بمعنى آخر، هو يرتقي به إلى المقامات العلى. وتتعدّد تمظهرات الوطن في شعره، وتتدرّج صُعُدًا من الوطن - القرية، إلى الوطن - المدينة، إلى الوطن - الدولة، إلى الوطن - الأمّة، إلى الوطن - العالم. مع الإشارة إلى أنّ الحيّز الذي يشغله كلٌّ من هذه التمظهرات يختلف من تمظهرٍ إلى آخر، ففي حين يقتصر حيّز الوطن - القرية على قصيدة واحدة، يستأثر الوطن - الدولة بحصّة الأسد من شعره الوطني.
بالانتقال من التنظير إلى التطبيق، ومن التعميم إلى التخصيص، يخصّ الشاعر دائرة القرية، االرمليةب، بقصيدة جميلة، فيرى إليها جزءًا من الموطن الكبير، ويبني منزله في قلوب أهلها، كما يتبيّن من قوله في امرفأ الذكرياتب: «تلك الربوع الخضر من موطني/ تمشي على جفني لياليها/ إن لم أعمّر فوقها منزلًا/ قلوب صحبي منزلي فيها» ( ص230).
ويخصّ دائرة، بيروت، بقصيدة يتناول فيها مآثرها، على المستوى الأدبي والوطني والقومي، في ابيروت أميرة الحلمب، بقوله: «بيروت كم صاغت يداك لآلئًا/ هي فوق صدر عروبتي عقدٌ ثمينْ/ ولكم جمعتِ من البيان روائعًا/ ونشرتها طيبًا لكلِّ الزائرينْ/ ولكم رفعت من اعتزازك رايةً/ وكسرت أحلام انتصار الفاتحينْ» (ص 250).
ويخصّ دائرة الوطن، لبنان، بحصّة الأسد من شعره الوطني، فيتناول جماله الطبيعي، وتاريخه العريق، ومعاناته الحاضرة، في غير قصيدة. وحسبنا التمثيل على هذه الدائرة بقصيدة االله يا لبنانب التي يتغنّى فيها بقداسته وحلاوته وفنّه، كما نرى في قوله: «أنت أحلى ما على الأرض انسكبْ/ من عناياتٍ وما الله وهبْ/ قبّلتك الشّمس من عليائها/ فلبست الفجر عقدًا من ذهبْ/ وأذبت النور خمرًا ورؤًى/ وتغنّيت.. فرنَّحتَ القصبْ» (ص 61). وغير خفيٍّ تأثّر الشاعر، في هذه القصيدة، بكلمات أغنية اعم بحلمك يا حلم يا لبنانب التي كتبها الشاعر اللبناني سعيد عقل وغنّتها المطربة ماجدة الرومي.
ويخصّ أنور سلمان دائرة الأمّة، العربيّة، بشيءٍ من شعره، فيتوجّه إليها بسؤالٍ مركّب، ينطوي على اعتراف بواقع الحال المزري للأمّة، ويضيق ذرعًا بخطايا أبنائها، بسؤاله: «وماذا بعد عن أخبارها النكسات/ في تاريخ أمّتنا؟ ألم نتعبْ؟/ (...)/ فكيف حملت يا وطن العروبة/ نصف قرنٍ من خطايانا ولم تغضب؟»ْ (ص 234، 235).
ولا ينسى الشاعر الدائرة الأوسع، دائرة الأرض، فيخصّها، هي الأخرى، بشيء من شعره، ويتمنّى لو تكون حرّةً، مفتوحةً لجميع البشر دون استثناء، ودون شروطٍ أو قيود، فنراه يقول في ابانتظار تأشيرة سفرب: «كم جميلٌ/ لو تكون الأرض للناس جميعًا/ وطنًا حرًّا بلا أيِّ قيودْ/ (...)/ فلماذا شوّهوا هذا الوجودْ؟/ قسَّمونا... باعدوا بين البشرْ/ قيَّدونا بجوازات السَّفرْ» (ص 346). هي طوباوية الشعراء وخيالهم الجامح وأحلامهم المستحيلة، وأنور سلمان واحدٌ من هؤلاء، ومن حقّه أن يحلم وأن يتخيّل، ولكن هيهات، هيهات أن يتحوّل الحلم إلى واقع، والمستحيل إلى ممكن! ومع هذا، سنبقى نتخيّل ونحلم إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.
خاتمة
أنور سلمان شاعرٌ جميل، أنصفه الملحّنون والمغنّون بتلحين قصائده وغنائها، وظلمه النقّاد بعدم تناول نتاجه الشعري بما هو أهلٌ له من اهتمام. وحسبي في هذه العجالة أنّني حاولت أن أرفع عنه شيئًا من هذا الظلم. فهو لا يقلّ شأنًا عن نزار قبّاني وغيره من سدنة الشعر الذين وقفوا على المرأة والوطن معظم نتاجهم الشعري، غير أنّ اللحظة الشعرية التاريخية التي أصدر فيها الشاعر معظم نتاجه، عنيتُ بها الحرب الأهلية اللبنانية، ربّما تكون قد شاركت في هذا الظلم. ولعلّ خير ما أختم به هذه الإطلالة المتأخّرة على الشاعر وشعره هو قوله في اعفوًا يا سيدتي الجميلةب: «أفنى بشعري... مثلما/ بالعطر تحترق الأزاهرْ/ أبني قصوري من شتاء/ الجرح في حبر المحابرْ/ من كلمةٍ كالضوء ... من/ شفتيَّ تُولَدُ كي تسافرْ» (ص 115)، وقوله في «عندما لا يبقى غير الكلمات»: «قدري أن أعطي الشعر دمي/ أن أعي همس القلوب الشّاكيهْ/ أن أرى الدّنيا رؤًى مسحورةً/ ويراها الناس... دنيا فانيهْ»■ (