ماذا لو قرأ عبدالناصر.. شخصيَّته روائيًا؟
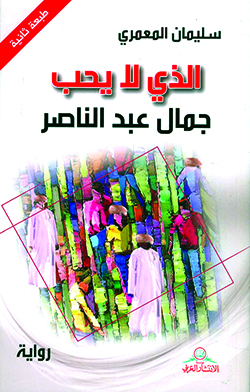
انتهيت من قراءة الفصل الأول من رواية «مسبار الخلود» للأديب المصري شريف العصفوري (مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات - القاهرة 2019)، فأسرعت إلى مكتبتي أبحث عن الرواية التي أهدانيها الأديب العُماني الصديق سليمان المعمري في أبريل 2019، في أثناء اشتراكنا بفعاليات ملتقى الرواية بالمجلس الأعلى للثقافة، وهي صادرة عن مؤسسة الانتشار العربي في بيروت (الطبعة الثانية 2014)، فالروايتان تتّخذان من الفانتازيا إطارًا لهما، وتستعيدان جمال عبدالناصر وعصره، بداية من اعتبار عبدالناصر نفسه شخصية روائية، ثم تسير كل رواية منهما، بعد هذا التشابه بينهما، في طريق مختلف.
لا تزال شخصية جمال عبدالناصر وأعماله مؤثرة في حياتنا السياسية والاجتماعية على المستويين المصري والعربي، وهو بحقّ رجل الأعمال العظيمة في أثرها، سواء كان هذا الأثر إيجابيًا أم سلبيًا، وسواء كان هذا التقييم بالسلب أو الإيجاب، متّفق عليه أم مُختلف عليه، حسب انتماء وزاوية نظر من يُقَيِّم، لذلك لا نستغرب استدعاء الروائيين لهذا العصر وأحداثه، وإعادة النظر فيه وتحليله، لأنّ به الجذور القريبة والمهمة التي تحرّك الكثير من أمور حياتنا الحاضرة، لكنّ العصفوري والمعمري لم يكتفيا بالكتابة عن العصر، بل استدعيا عبدالناصر نفسه وحوّلاه إلى شخصية روائية، فكيف تم ذلك؟ وما الذي حققاه بهذا الاستدعاء؟
افترض المعمري أن عبدالناصر يحقّ له العودة إلى الحياة وزيارة الأحياء، بشرط أن يكونوا هُم مَن يستدعونه، وبشرط أن يكون المستدعي من كارهي عبدالناصر لا من محبيه.
يقول حارس قبر عبدالناصر له: «الأعداء نادرًا ما يطلبون عودة أعدائهم إلى الحياة، ولهذا يتم التساهل في الموافقة على طلباتهم بُغية غسل القلوب من الأدران ونشر التسامح في الأرض» (ص12). كان ذلك في ذكرى مرور ستين عامًا على قيام ثورة 23 يوليو 1952، التي قادها عبدالناصر لإسقاط المَلَكية بمصر، وكان قد مرّ على وفاة عبدالناصر اثنان وأربعون عامًا.
كان عبدالناصر يريد أن يرى مصر بعد ثورة 25 يناير2011، لكنّ القانون لا يسمح له بذلك، كان حزينًا جدًا، فتعاطف معه الحارس، لأنّ هناك قانونًا آخر ينص على أن «من يُسعد طفلًا في حياته لا بدّ أن يجد مَن يُسعده في قبره» (ص 13)، وقد أسعد عبدالناصر طفلًا اسمه أحمد زويل، أرسل له رسالة «ربنا يوفقك ويوفّق مصر»، فردّ عليه عبدالناصر وشكره، داعيًا الله أن يحفظه ليكون عدّة الوطن في مستقبله الزاهر، وقد حصل هذا الطفل فيما بعد على جائزة نوبل في الكيمياء.
قلّب الحارس في الدفاتر فوجد «رجلًا ما زال على قيد الحياة يكنّ لك كراهية شديدة، لدرجة أنها لو وُضعت وحدها في كفّة ميزان ووضع بُغض جميع الناس لك في الكفّة الأخرى لرجحت كفّته... إنه مصري، ولكن يقيم في عُمان... سنسمح لك بخروج مؤقت من القبر لزيارة هذا الرجل. إن استطعت أن تسلّ من قلبه ولو 1 في المئة من حقده الشديد عليك، فستكون مكافأتك العودة إلى مصر حيًا معززًا مكرّمًا» (ص 14 و15).
أبطال الرواية يتحدثون
يذهب عبدالناصر إلى شقة الرجل الذي يكرهه، واسمه بسيوني سلطان، يعمل مصححًا لغويًا بصحيفة عُمانية كبرى، يرى بسيوني عدوّه فيُغمى عليه، ويُنقل إلى المستشفى، ليظل في غيبوبة لعدة أشهر من دون أن يعرف أحدٌ سببها، وتكون هذه الغيبوبة هي فرصة الروائي سليمان المعمري ليترك أبطال الرواية يتحدثون عن أنفسهم في مواجهة بسيوني سلطان، ابنه، صديق ابنه المختلف مع الأب سياسيًا، زملاء الجريدة، رئيس تحريرها، زوجة رئيس التحرير التي تعمل عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبسيوني سلطان نفسه يتحدث في فصل يخصّه، ويكون عبدالناصر خلال هذه الفصول مجرّد شبح، مجرد مثير روائي أدى إلى الغيبوبة التي أدّت إلى انفجار حكائي اعترافي حميم، يظهر فقط في الفصل الأخير الذي يتكون من نصف صفحة، ليكرر الفصل الأول، ولكن في ذكرى مرور ستة آلاف عام على قيام ثورة يوليو، ليعود القارئ إلى الفصل الأول لاستكمال الحوار بين عبدالناصر والحارس بانتظار زيارة جديدة لعدوّ آخر.
أما شريف العصفوري فيجعل عبدالناصر نفسه هو الراوي باسم أحمد جمال، يجعله مؤسسًا للشركة المتحدة هو وبعض رفاقه وأهمهم: عبدالواسع عميرة (عبدالحكيم عامر) وإسماعيل أنور (أنور السادات) وجابر (حسني مبارك). للوهلة الأولى يبدو ما فعله العصفوري ترميزًا ساذجًا استُخدم كثيرًا من قبل، لكنّ توغّلك في الرواية يوضّح لك أنه فعل ذلك ليقدم بناءً روائيًا بالغ التعقيد، من أجل إتاحة تشريح روائي سياسي اقتصادي اجتماعي ذي صبغة ديمقراطية يقدمه جمال عبدالناصر بنفسه. فالراوي أحمد جمال يتحدث عن الشركة/ الثورة/ مصر، وما تم فيها من صراعات، وما قامت به من أعمال مجيدة وأخرى حقيرة، بأسلوب اعترافي لرجل يعيش أحداث ثورة 25 يناير 2011، وكان يجب أن يموت سنة 1970 (وكأن رغبة عبدالناصر في رواية المعمري تحققت في رواية العصفوري!)، لولا أن وافق على تجربة علاج سرّي يمنحه الخلود.
هذه الفصول هي السيرة الذاتية لعبدالناصر، عائلته، علاقاته الشخصية، أفكاره، علاقاته مع زملاء الثورة، الانقلابات الداخلية والخيانات، تشريح حقيقة كل منهم كما هي في الواقع لا كما أُريدَ لها أن تكون في الكتب المدرسية... إلخ.
ولكون الراوي هو أحمد جمال، فإنه يتحدث بالتوازي عن مصر وعبدالناصر والسادات وحسني مبارك وثورة يناير... إلخ، محللًا المعلومات المعلنة، وموضحًا وجهة نظره فيها، ما حدث وما كان يجب أن يكون، ولا يكتفي الروائي بذلك، لكنّه يضع عدة فصول تبدو وكأنها خارج السياق، أو يمكن حذفها من الرواية من دون أن تؤثّر فيها، لكنّها في الوقت ذاته تمنح الرواية بنيتها المعقّدة وعمقها التاريخي، وتكمل الظلال المعتمة للصورة التي يرسمها أحمد جمال (اعترافات الشتاء ص 65 على لسان الأميرة شويكار، الزوجة الأولى للملك فؤاد والد الملك فاروق، الذي أطاح عبدالناصر بحكمه - اعترافات الربيع ص 129 عن الملكة نازلي أمّ الملك فاروق وفضائحها التي كانت أحد أسباب زوال حكمه - اعترافات الصيف ص 185 عن جيهان السادات الزوجة الثانية لأنور السادات - اعترافات الخريف ص 257 التي تتحدث عن الاغتيالات في المستويات السياسية العليا من أيام كاليجولا حتى سعاد حسني، الممثلة التي كانت تعمل مع المخابرات المصرية، وأشرف مروان زوج ابنة عبدالناصر الذي أصبح من كبار تجّار السلاح)، وليزيد الكاتب بناءه الروائي تعقيدًا؛ أراه ممتعًا، لا يسرد الأحداث بتسلسلها التاريخي، بل إنه يراوح في الزمن رجوعًا إلى الماضي وانطلاقًا إلى الحاضر، باختيار سنوات مهمة في حياة الراوي أو البلاد، ويجعل عناوين فصول الرواية كلها؛ عدا المعنونة بكلمة اعترافات، أرقامًا لسنوات: 2018 - 1969 - 1926 - 1982 - 2011 - 1971 وهكذا.
تقييم التجربة الناصرية
كان استدعاء عبدالناصر في رواية المعمري وسيلة لتحقيق أمرين؛ الأول إعادة تقييم التجربة الناصرية من وجهتي نظر المؤيدين والمعارضين لها، والثاني فضح طرق التفكير وآليات التعامل في الوسط الصحفي العماني، بغرض التعرُّف إلى سلبياته بما يساعد على تجاوزها، وذلك في إطار إشارات نقدية قوية إلى مشاكل الأداء السياسي العام خلال عام 2011 فيما سمّي بالربيع العماني. فقدّم المعمري رواية أصوات بامتياز، لا يتشابه فيها صوت مع الآخر، رواية ساخرة فاضحة للعيوب الشخصية والمثالب العامة، ولا بدّ أن القارئ العماني كان يفكر، وهو يقرأ الرواية، في الشخصيات الحقيقية التي استلهم منها الكاتب شخصيات روايته، ولم ينخدع هذا القارئ بما قاله الكاتب ص7 «شخصيات وأحداث هذه الرواية من نسج خيال الكاتب... فإذا ما تشابهت مع شخصيات أو أحداث حقيقية في الواقع، فذلك لا يعدو كونه مصادفة قدَريّة محضة»، وكأن الكاتب يسخر ممن سيظن بوجود هذه المصادفة القدرية، وينبّه القارئ ليفتش بنفسه عن مشاكل واقعه، ليحقق الغرض الأساس من الرواية، وهو الحضّ على التغيير.
وقد اختار المعمري أن يكتب أبطاله اعترافاتهم بأسلوب صحفي بسيط، محققًا ما أراده من سخرية، ومتوائمًا مع طبيعة عمل هذه الشخصيات في المجال الصحفي، ومشيرًا من طرف خفيٍّ إلى سطحية هذه الشخصيات التي يصعُب أن تتعمّق بعيدًا في تحليل مُجريات الحياة.
أما العصفوري فيقدّم رواية قائمة على المعلوماتية والتحليل، فصول كاملة لن تجد فيها أحداثًا تمرّ بالشخصيات الروائية بقدر ما تجد شرحًا وتحليلًا ومعلومات غير متداولة على نطاق واسع لما حدث في مصر أو بالشركة المتحدة، وهي رواية ممتعة لقارئ خاص، كان يمكن أن تُختصر قليلًا، وبالذات في الفصل الأول الذي شرح فيه الكاتب فكرة البطولة على لسان أحمد جمال بإسهاب شديد أوقف السرد في الصفحات الأولى، وكان يمكن أن يصرفَ القارئ عن متعة حقيقية على المستويين السردي والتاريخي قدّمهما له الكاتب في هذه الرواية المتميزة.
سيجد القارئ متعة فنية كبيرة في قراءة العملين، وسيجد لذّة عقلية فيما تثيره الروايتان لديه من رغبة في إعادة التفكير بتاريخه الشخصي وتاريخه العام، ولا بدّ سيسأل نفسه، كما سألت نفسي وأنا أقرأهما: لو أتيح لعبدالناصر؛ أو لأيّ حاكم آخر، أن يقرأ نفسه كشخصية روائية، هل كان ذلك سيغيّر بعض أو كل قراراته، هل كان سيمنحه وجهة نظر مختلفة تجعل تأثيره التاريخي أكثر إيجابية وأعظم أثرًا؟ خصوصًا وأن عبدالناصر ألّف رواية في شبابه ولم يكملها (في سبيل الحريّة)، فهو يعرف صعوبة وأهمية أن تكتب رواية.
ستبقى هذه الأسئلة معلّقة إلى أن أقتدي بالكاتبين المبدعين، وأستدعي جمال عبدالناصر لأتحاور معه بنفسي ■

