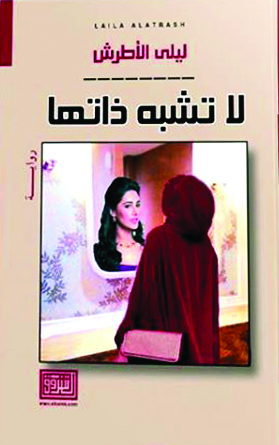الروائية التونسية حياة الرايس: نصّ لا يطرح الأسئلة فارغ وسطحيّ

الكاتبة حياة الرايس وهي تجد الكتابة أعظم تجريب، حيث تتداخل في نزيفها الشعري والنثري معًا كل فنون الكتابة، تكمل بعضها هذه الفنون على أوركسترا أصابعها وقريحتها معًا، وهي تعوّل على الحالة الشعرية التي لا تفارق إيحاءاتها.
حياة الرايس كاتبة النصّ المفتوح بامتياز! لا تهاب شيئًا أمام التجديد، مادامت الكلمات أقصى درجات الحرية... وهي تعطي الكلمات حرية المبادرة - كما أوصى العبقري مالارميه- إذ لا شكل محددٌ للإبداع، مادامت هي في «كل شكل تكتبه تبدع فيه». كاتبة، والكتابة لعبة، بكل إيقاع أنوثتها الصارخ، وهي تتحيز لجنسها... إيقاع لا تفارق بلاغته موسيقا الكلمات البركانية، المموسق بشذرات الفلسفة، منجم فكرها ورؤاها. أما عقدها الأزلي مع الحرية/ الحبيبة المقدسة، فقد جاء من إرهاصات رؤى وإبداعات الكبار الذين استعبدتهم الحرية، أمثال غادة السمّان ونوال السعداوي وسيمون دو بوفوار وغيرهم... ورهانها الأزليّ الكتابة/ الحياة منطاد النجاة في وجود غامض، وهي تجدد فيه رحلة البحث عن «عشبة الخلود» مثل «جلجامش» جدنا العظيم... وهذا البحث المضني كما القصيدة، لا يربك الحياة حين تعاش شعريًا.
حياة الرايس في حديث لا يغادره دفء الشعر، ولا طقوس السرد.
• الكتابة مسؤولية مرعبة، حسب تعبير همنغواي، فلماذا كل هذه المغامرة؛ قصة قصيرة، رواية، مسرح، إعلام وصحافة، شهادات ومحاضرات... أين المبدعة الكبيرة حياة الرايس وزورقها البنفسجي في بحار هذه المغامرة؟ ماذا أخذت منك؟ وماذا أعطتك؟ من الأقرب إليك؟ بل من يجيب أكثر عن أسئلتك الإنسانية/ الحضارية؟
-لقد بدأت قاصة بمجموعتي القصصية الأولى «ليت هندا...» سنة 1991، مجموعة قصص، آخر قصة بها كانت قصة طويلة بعنوان «إعلان زواج»، حينها قال النقاد إن حياة الرايس تتهيأ لكتابة الرواية، وهناك من اعتبرها «رواية قصيرة» وتوقعوا أن الكتاب القادم سيكون رواية، لكن الكتابة انحرفت بي عن جنس القصة، «خُنت» القصة، وكتبت بحثًا فلسفيًا عن النساء المسكونات بالجان «جسد المرأة من سلطة الأنس إلى سلطة الجن»، نشر في دار سينا (1995) بالقاهرة. كتبته ليس بطريقة البحث الأكاديمي، لكن بـ «انحرافات» السرد السابقة عندي. أحكي فيه عن كائنات عجيبة وغريبة عن نساء مسكونات بالجان... من الحضرة (الزار) ومزارات الأولياء الصالحين والحمّام التركي... إلى عيادات الطب النفسي... رغم أنه بحث فلسفي، مقاربة سيكولوجية/ أنثروبولوجية لحالات الهستيريا بالتعبير الطبي؛ النساء المسكونات بالجان، بالتعبير المحلي... لكن النقاد رأوا فيه تشكّلًا أسلوبيًا أدبيًا جامعًا بين الأدب والفلسفة، باعتبار اختصاصي الفلسفي ومراوحة بين الفلسفة والأدب، واهتموا خاصة بموضوع التابوهات الذي تناولته.
لكن في الكتاب الثالث؛ الذي جاء على شكل مسرحية بعنوان «سيدة الأسرار عشتار»، فقد بدا التداخل فيه واضحًا أو بصفة أوضح، إذ جاءت المسرحية على شكل لوحات شعرية محافظة على أسلوبها القديم، باعتبارها مستوحاة من أسطورة الآلهة عشتار، وهي قصة حب بين عشتار وتموز، فيها الأحداث والشخصيات والعقدة والدراما... وقد حار النقاد في وصفها مرة أخرى، وهنا ظهر التداخل بصفة أكبر بين مختلف الأجناس الأدبية، وكتب الناقد كمال الرياحي عنها قائلًا: «هذه مسرحية تستعصي على التصنيف، إذ هي نص تتعالق فيه الحكاية والسرد، مع الشعر مع الرواية مع المسرح»، ربما هي رواية شعرية؟
بعد المسرح عدت إلى القصة كنوع من الوفاء ربما، لأنني شعرت أنني خنتها في ثاني كتاب لي مع البحث الفلسفي. وعدت إليها مع مجموعة: «أنا وفرنسوا... وجسدي المبعثر على العتبة» (2008)، طبع في بيروت عن دار «كتابنا».
ثم وإذا بي في عام 2012 أصدر ديواني الشعري الأول «أنثى الريح»، وكأن الرياح حطت بكلماتي في القصيد، وأن الرياح التي تبعثر كل شيء قد جمعت حروفي في قصائد نثرية و«رسائل ضيعت عناوينها»، كما عنونت القسم الثاني من الديوان.
المهم في كل هذا أني لم أكن أجبر الذات الكاتبة فيّ، أو أضغط عليها أو أحبسها في جنس واحد. بتواطؤ كبير منّي أتركها تحط على الشكل الذي تراه مناسبًا لموضوعاتها. لأني أثق بالذات الإبداعية، لأنه مهما تعددت الأشكال والأجناس الأدبية، فإن الجسد الإبداعي واحد. وقد كان ذلك محل ثقة أتبادلها أنا وقلمي، لم أكن أشك في اختياراته. وفي النهاية لم يكن يزعجني أن يكتب القصة أو الشعر أو المسرح، فهو يفاجئني بهذا التنوع من جهة، ولأن التجربة الإبداعية أرحب وأرحم من أن تلوي عنق قلمها، فأنا وإياه متفقان بتواطؤ كبير على اكتشاف مساحات إبداعية جديدة!
ثم عدت إلى القصة في مجموعتي الثالثة «طقوس سريّة وجحيم»، عن هيئة قصور الثقافة - القاهرة (2015).
رغم كل هذه الحرية في اختيار الشكل الإبداعي المناسب، فإني كنت أرغب في سرّي بكتابة الرواية، أحسست أن كل هذه الأجناس إنما تهيئني إلى الناموس الأعظم، إلى النص الروائي.
وفي اليوم الذي أحسست فيه بفيض نضج إبداعي معيّن... وبعد أكثر من ثلث قرن من كتابة القصة والشعر والنص المسرحي وأدب الرحلات وأدب الرسائل والبحث الفلسفي... أقبلت بهمتي على الرواية، كأني كنت في حاجة إلى جمع شتاتي في الرواية، فكانت «بغداد وقد انتصف الليل فيها». رواية فيها السرد والحكاية وتعدد الشخصيات والأحداث والعقدة والدراما والرؤية الفلسفية والخيط الرابط والموقف من قضايا العصر في مناخات شعرية وفيّة لخصائص كتابتي الأدبية... فيها مقومات الرواية ومقومات السيرة الذاتية... أو ربما كنت أتوق إلى كتابة النص المفتوح الذي لا يحده حد.
يشجعني قول النقاد في هذا التنوع الذي اختص به ويختص به الكثيرون أيضًا: «كل شكل تكتبه تبدع فيه». (بكل تواضع).
هل كنت أهاجر مثل عديد الكتاب إلى الرواية؟ أم لأنه عصر الرواية؟ هل لأن الرواية تحتل ديوان العرب الآن وتتربع على عرشه؟
عام 2018 أصدرت روايتي الأولى، وهنا أضع الأولى بين قوسين، لأن هناك من النقاد من يعتبر مسرحية «عشتار» رواية... أو «رواية مسرحية».
أما الفلسفة والشهادات فهي مهنتي التي أعيش منها كأستاذة فلسفة، والإعلام والتلفزيون والإذاعة والجرائد والكتب والمحاضرات والسفر والتدريس والمنظمات والحياة الجمعياتية والحياة الثقافية والعائلة... مثلك والله عندما أنظر من مسافة الحياد إلى تلك البدايات القوية المتعددة أقول: «يا للعمر الذي استوعبها! كيف كنت أقوم بكل ذلك»؟ أنا المتفرغة كليًا للكتابة في شبه عزلة إرادية الآن.
نصّ فارغ وسطحي
• كتب السيميائي الكبير رولان بارت يقول: «الكتابة فن طرح الأسئلة، وليستِ الإجابة عنها»، ما هو سؤالك الأعظم المتلوّ بأجوبة ظامئة وأنت تتفجرين شعرًا ونثرًا راقيين؟
- لقد تعلمنا في أول درس فلسفي كتبه لنا الأستاذ على السبورة بخط كبير في كلية الآداب بجامعة بغداد، أن الأسئلة في الفلسفة هي أهم من الأجوبة.
لقد اهتم فلاسفة اليونان منذ القديم بقيمة السؤال، لأنه يحرّك العقل وينشط الفكر ويخرجه من جمود التقليديات والمسلّمات، لكن هنا يقول بارت «الكتابة فن طرح الأسئلة» كلمة فن تحيلنا مباشرة على النص الإبداعي. هنا نصبح أمام نص أدبي بخلفية فلسفية، والنص الذي لا يطرح أسئلة هو نص فارغ سطحي ودون عمق. النص هو حيرة الأسئلة وعدواها التي تنتقل من الكاتب إلى القارئ، وهذا هو غرض الكاتب؛ أن يستفز العقول الخاملة والخامدة، وليعطي للإنسان إنسانيته التي يتميز بها عن الحيوان. من الأسئلة التي تستفزني، أسباب تخلفنا كعرب؛ لماذا تقدمت أمم أخرى ولماذا صرنا خارج التاريخ؟ والأسئلة تتطور وتتغير بمتغيرات المرحلة، فبعد سؤال مَن نحن في علاقتنا بالآخر، يأتي سؤال: مَن يحكمنا؟ وعلى المثقف أن يضع كل المؤسسات التقليدية موضع السؤال، وأولها المؤسسة الدينية، ويعيد تقويضها ويفكّها من سلطة المؤسسة السياسية التي وظفتها لمصلحتها دائمًا منذ عهد عثمان بن عفّان ]... وأن يواجه سؤال المؤسسة الاقتصادية وأي منوال تنمية نريد، والمؤسسة الاجتماعية الزوجية، خاصة أنها اهترأت ولم تعد تنتج بشرًا أسوياء... المجتمعات البطريركية التي مازالت تستعبد المرأة في مؤسسة الزواج وتكرر نفسها في المؤسسات الإدارية وسلّم ارتقاء الكفاءات من النساء، وعدم وصولهن إلى مناصب صنع القرار.
والمؤسسة التربوية التي تنتج عقولًا خاوية وتحرم الفلسفة في بعض البلدان، وتخاف أسئلتها المحرجة التي تزعزع حكمهم وسلطانهم على رعايا البشر، تصنع شخصيات مهزوزة لا يملكون أي لغة؛ لا لغتهم العربية ولا لغة أجنبية قوية وصحيحة، ولا يدركون موقعهم بين الأمم.
كتابة صعبة
• يرى عديد من النقاد، وكبار الكتّاب، وعلى رأسهم المتمرد الأمريكي هنري ميللر، أن المستقبل للرواية الأوتوبوغرافية، رواية السيرة الذاتية... وهي شائعة هذه الأيام، ما رأيك؟ لهذا جاءت روايتك «بغداد... وقد انتصف الليل فيها»، أم أن الكاتب لا بدّ أن يكتب عن حياته الخاصة؟ أم ماذا؟
- عندما تكون تجربته الحياتية ثرية طبعًا، عليه أن يكتبها كتجربة إنسانية تستحق التدوين... وحتى من لم يكتب نصًا صريحًا لسيرته، فإن ذاته وتجاربه تتسرب داخل رواياته وقصصه... أنا اخترت عن وعي تام كتابة حياتي، بل جزء معيّن من حياتي؛ هي مرحلة دراستي الجامعية في بغداد. وقد نصصت على ذلك في مقدمة روايتي السيرية تشجيعًا على أدب البوح الشحيح في مجتمعنا العربي.
كتابة السيرة الذاتية لا تحتمل الأقنعة، ولا تجيد فن التخفي وراء الشخصيات والحقائق والأحداث... إنها أكبر من مجرد تغيير أسماء الأشخاص والأماكن والأزمنة، وهي ليست حفنة أسرار يرمي بها الكاتب في وجه قارئه دليلًا على جرأته وشجاعته.
كتابة السيرة أمر مختلف، صعب وخطير ومغامرة كبيرة في اللغة كما في الحياة ويحتاج شجاعة واثقة، وأسئلة وجودية.
هل يجب أن نقول كل شيء؟ هل كتّاب السيرة مجبورون على قول كل ما يتعلق بحياتهم الخاصة بصراحة وصدق؟
كتابة السيرة موقف من الذات ومن الآخر، كيف أريد أن أقدّم نفسي للناس, للقراء؟ كإنسان كامل؟ كبطل؟ رغم أن زمن الأبطال ولّى وتراجع... أم كفرد بشر له هناته وزلاته؟ كإنسان مظلوم مضطهد؟ كسجين سياسي؟
وهناك أمر يتعلق بكرامة الذات، هل تسمح هذه الذات بتعرية هوانها وسقوطها وإهانتها وفشلها وانكسارها وخيباتها؟
ولكن عندما يستجمع الكاتب كل شجاعته بين يديه، ويدخل فن أدب الاعتراف بكل قوة، لأنه كاتب حر في النهاية، يصطدم بالمتلقي... وهل المتلقي جاهز لتقبّل الآخر بأخطائه وزلاته في فن الاعتراف، بعدما كان يرى في كاتبه مثله الأعلى؟ وهل تقبل مؤسسات النشر كل أنواع البوح، أم أنها تروج لبضاعة الجنس الرخيص والعهر المقنن في التجارة بالنص الأدبي؟
«بغداد...» أول رواية سيرة ذاتية نسائية تونسية باللغة العربية، بشهادة الناقدة د. جليلة طريطر، مرجع الرواية السيرية والمختصة فيها.
دخلت تجربة البوح، في مجتمع يتلذذ دومًا بالتلصص على حياة الغير، فما بالك بحياة المرأة؟ التي تعتبر لغزًا في خلفية الضمير الجمعي. وفي أجواء لا يعترف فيها بقدسية الحياة الخاصة، يصير من الصعب للغاية أن يبوح المبدع بمكنون نفسه، فهو لا يعيش بمفرده، وقد يؤثر البوح على حياة آخرين، كما أن حياته نفسها قد تتعرض للخطر، كالبوح بالأسرار الخاصة وبالأخطاء، فللاعتراف قيمة تفوق قيمة الصمت أو التزوير في المدونة القانونية.
كتابة السيرة صعبة في مجتمع مزدوج الشخصية يعيش حياتين واحدة في السر، وأخرى في العلانية، وثقافته ثقافة تستر على العيوب والأخطاء والذنوب، «إذا بُليتم فاستتروا»، مجتمع يمشي بجانب الحيط، ويقول يا ربي الستر، خوفًا من أن تقع عليه مصيبة من حيث يدري أو لا يدري. مجتمع خوف من الذات ومن الآخر، غير متصالح مع ذاته ولا مع الآخر، ولا ينظر للآخر كبشر يمكن أن يخطئ، وإنما كغريم يترصد زلاته ووقعاته حتى يجهز عليه... زيادة على أننا ليست لنا ثقافة الاعتراف مثلما هي في المجتمع المسيحي، حيث يتطهر الفرد ويتخفف من ذنوبه بالاعتراف والتصريح بها بصدق في الكنيسة.
بل لنا ثقافة الكذب، الزوج يكذب على زوجته، الزوجة تكذب على زوجها، الابن يكذب على والده، الأب يكذب على ابنه، والفرد يكذب على نفسه في ضرب من الشيزوفرينية المسرحية برداءة أحيانًا. ليست هناك مواجهة بين الذات ونفسها، فما بالك بالآخر؟
لكن الكاتب هو كائن حر في النهاية يستطيع أن يتجاوز كل ذلك، بل مهمته كشف هذا الزيف وتعرية الرياء والنفاق الاجتماعي، لكنّ الصعوبة أنه في كتابة السيرة الذاتية يجب أن يبدأ بنفسه وهو الكاتب المثل، وقد دفعنا الثمن غاليًا.. ولأنه كائن حرّ، فإن هذه الحرية مأزقه لأنه من ناحية حر، ولكن حريته ستواجهه بالمتلقي الذي ينتظر منه إدهاشًا ما، لا يشير إليه بعينه إن شكلًا أو تيمة. يطالبه بصدق بليغ أكبر من الصدق الأخلاقي... صدق فني غير استعراضي، صديق حميم.
حبّ وبساطة وتواضع وثقافة
• بغداد، الإقامة والدراسة، والعلاقات، ورعب السلطة، والأيديولوجيا القسرية، والأحزاب، والمعتقلات، والتصفيات، واختفاء أشخاص.. كل ذلك كان في سطور روايتك «بغداد... وقد انتصف الليل فيها» - رواية فوبيا الخوف والرعب السلطوي... ما الجميل في بغداد بتلك الحقبة؟ هل كنت تمتلكين الشجاعة الكافية لنشر الرواية لو استمر النظام الحزبي الحديدي في بغداد؟ لو ترسمين لي بورتريهًا لحياة الرايس طالبة الفلسفة والكاتبة في ذلك الزمن المقيت الذي سبقتك إليه في عذاباته.
- الجميل في بغداد في تلك الحقبة، طيبة أهلها وكرمهم وبساطتهم وعفويتهم... عندما تسأل «حجيّة» في الشارع عن مكان معيّن، وتكتشف أنني غريبة وطالبة بعيدة عن أهلي وتائهة في شوارع بغداد، «تقول لك تلك الكلمة التي تدخل القلوب مباشرة، لأنها تخرج من القلب «خطيّة» وخطية باللهجة العراقية يعني مسكينة، لكن كلمة مليئة بالحنية كحضن أم، كذلك كانت الحجية التي سألتها عن شارع السفارة التونسية بحي المنصور الراقي حينها، وما إن عرفت أني غريبة حتى ظلت تتوسل إليّ وتعزمني على الغداء عندها، وأنا أشكرها وأعتذر لها، وهي تلحّ وتتوسل إليّ وتقسم عليّ... ووالله أذكر أني بقيت مشوارًا طويلًا وبذلت جهدًا كبيرًا حتى أقنعها أني ملتزمة بموعد ضروري في سفارتنا... وأنا محرجة أمامها لأني لمست صدق سريرتها وعفوية دعوتها. وعندما نطلع بالتاكسي ويكتشف «عمّو السائق» أننا طالبات عربيات أو طلبة عرب لا يقبل أن ندفع له، ويظل يقسم ونحن نقسم مشوارًا من الزمن، حتى نترك له الفلوس على المقعد بجانبه وننزل.
والأساتذة الودودون المتواضعون معنا بالجامعة على سعة علمهم وأدبهم وأخلاقهم العالية، وعائلات زملائنا الطلبة الذين ضيّفونا وفتحوا لنا بيوتهم وفرحوا بنا... هذه كانت بغداد أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، حب وكرم وبساطة وتواضع وثقافة، وأنت تدرك عمقهم الحضاري الذي لا يضاهى.
أما عن فوبيا حزب البعث وإن كنت سأنشر ما نشرته الآن في ذلك الزمن، فأولًا أنا في بداية حياتي لم أكن أملك النضج الأدبي والإبداعي لأكتب رواية. كنا «يا دوب» نتعلم نحرر مقالات وحوارات بالصحافة وريبورتاجات... كنت طالبة حينها أكتب بعض الخواطر والحوارات والقصص... وعمومًا لا أدري إن كنت نشرتها في ذلك الزمن أم لا، أو بعدما خرجت من العراق الذي أعرفه أنني لا أكتب رواية لأدخل السجن، ولا أنشد أن أكون بطلة وضحية. لا أعتقد أن لي جسدًا يحتمل ما احتمله «رجب»، بطل «شرق المتوسط» لعبدالرحمن منيف، ولا قوة على تحمّل كل ذلك العذاب.
بورتريه طالبة تونسية، صبية شابة مفعمة بروح المغامرة مسحورة بعوالم الشرق القديم. قادمة من مجتمع مختلف ومن تجربة حياتية مختلفة ومن تونس حرية المرأة ومجلة الأحوال الشخصية والتجربة البورقيبية وتأثيرها على نساء تونس والتزامهن بها... تصطدم بكثير من العادات والسلوكيات المختلفة، من مجتمع مدني، متحرر إلى مجتمع سلطوي ونظام عسكري والناس فيه مرعوبون، وخائفون، ومتأزمون، ومكتوم على أنفاسهم، في أغلبهم على الأقل. وأنا أصبحت في نظام لا يعجبني، بل يرعبني، وحزب لا يقنعني. البعض يحاول إغرائي بالانتماء والبعض يحذّرني منه، وأنا محسوم أمري قبل أن أصل، أنا والتحزب لا نلتقي، ولا يمكن أن نكون واحدًا أبدًا. اخترت أن أكون مستقلة، حتى في بلدي لا أنتمي لأي حزب. خلقت طليقة، لا أحب من يدجنني ويأسرني في قفص ولو كان من ذهب. ثم إن اهتماماتي ومشروع حياتي هو أدبي وليس سياسيًا، محسوم أمري من صغري. وموقفي أن الكاتب يجب أن يبقى مستقلًا دائمًا ليملك حرية التعبير والنقد والموقف، لا أن يكون في خدمة حزب معيّن.
غادة السمّان
• كتب لوكليزيو في «الباحث عن الذهب»: «الحياة لا نهاية لها، الكتب الحقيقية لا نهاية لها أيضًا»... أي الكتب شغلتك وأثرت فيك؟ بل لمن تدينين من الكتّاب لمغامرة الكتابة الشاقة/ الممتعة؟
- أنا أدين للأديبة السورية في مغامرة الكتابة غادة السمان، كانت مدرستي الأولى، أعتقد أنني تأثرت بها كثيرًا، تعلمت منها روح التمرد والثورة على كل التقاليد الزائفة وكشف النفاق الاجتماعي وقول المسكوت عنه والممنوع... تعلمت منها أناقة اللغة وشعرية ورومانسية العبارة... ثم تأثرت بثورة نوال السعداوي كثيرًا، وقبلها بزعيمة الحركات النسوية الكاتبة الفرنسية سيمون دو بوفوار، والحقوقية المناضلة الكاتبة جيزيل حليمي، المدافعة عن حقوق الشعوب المستعبدة والمستعمرة أينما كانوا، والتي ساندت قضية الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، وهي من أصل تونسي من يهود تونس، وتحمل الجنسية الفرنسية، ترجمت لها كتابها «حليب البرتقال» عبارة عن سيرة ذاتية.
تأثرت بمارغوريت دوراس ودوريس ليسينغ، تأثرت كثيرًا بأدباء أمريكا اللاتينية، خوليو كورتزار، تعلمت منه خاصة كتابة القصة القصيرة وبنيدتي وإستورياس وإيزابيل الليندي وماركيز طبعًا... شدتني مدارس أمريكا اللاتينية الأدبية بواقعيتها السحرية والغرائبية، وقد كنت أبحث عن ذلك كنوع من التميز عن القصة الكلاسيكية، التي نهلت منها منذ صغري أيضًا مثل الكلاسيكيين الروس والأدباء العرب.
أفخر بأني الحفيدة الروحية لابن خلدون ومحمود المسعدي والمتنبي والمعري وأفلاطون وفيكتور هوغو وموليير وفولتير وروسو وكورناي وراسين وغيرهم، ممن أصبحوا هم عالَمي وعائلتي وملاذي... والأدب ليس له جنسية... ولا يسعني المجال أن أعدد لك بكل من تأثرت، أنا الحقيقة تأثرت بكل من قرأت بعُمق، سواء في وعيي أو لاوعيي.
أبحث عن عشبة الخلود
• هناك ما يطلق عليه الفلاسفة «التسكع في الزمن» و«الهروب من الزمن»... وحياة الرايس بين تونس وباريس حوار مع الزمن... أم ليّ عنقه والانتصار عليه أم ماذا؟
- التسكع ليس ضياعًا، وإنما هو إطلاق العنان للرجلين حتى يصيرا أجنحة، للاستمتاع بلذة الاكتشاف زمانًا ومكانًا، والهروب من الزمن لا نعرف نهايته دائمًا؟
أنا كنت أريد الدراسة في باريس كمغامرة وجودية في اقتفاء آثار الوجوديين الذين كنا مبهورين ومتأثرين بهم منذ الثانوية العامة، أمثال سارتر (قبل أن ينقلب علينا) وسيمون دو بوفوار... ولأضع الذات أمام مسؤولياتها في التحرر واكتمال الذات كامتحان كبير في الحياة بمغامرة الوجود الذي يسبق الماهية، كنت أريد إعادة خلق نفسي وصياغتها من جديد، بعيدًا عن القدر المسبق الذي رسم لها. فإذا بعنقي يُلوى نحو الشرق إلى بغداد، لأجد نفسي أمام تجربة وجودية من نوع آخر، وجدتني أقتفي آثار «جلجامش» في البحث عن عشبة الخلود في سرديات الألواح السومرية... هناك أعادت تكويني «شهرزاد» الحكاية، لتعلّمني أن الخلود في النص، وأن الموت وحده هو الذي يعطيك حقيقتك إن كنت خالدًا أم لا... إن كنت قد عشت فعلًا، وإن كنت قد مررت من هنا، وحكايتي مع باريس قديمة تعود إلى طفولتي وصغري.
الرواية هي بغدادي أنا
• حسب إيتالو كالفينو، فإن المدن رغبات وأحلام ومخاوف... هاتي تعريفًا لمدنك الثلاث تونس، وبغداد، وباريس... ماذا تعني لك كل مدينة من هذه المدن؟
- بغداد خوف...! أخاف أن أعود إليها فلا أجدها... لا أجد بغداد التي أعرفها... لا أجد بغداد التي عشتها وكتبت عنها، ولو أن بغداد/ الرواية هي بغدادي أنا. ليست لدي القدرة على تحمّل كمية الدمار التي أصبحت عليها بعد الحرب والاحتلال!
تونس بلادي وأصلي وموطني... أخاف عليها كثيرًا من حكم الإخوان الآن وما سيفعلونه بها مستقبلًا!
باريس... الحلم الذي جاء متأخرًا جدًا، والذي سرق منّي في بداية عمري وعندما استرددته الآن لم يكن له الطعم نفسه!
الشعر مبثوث في نصوصي
• كتبت الشعر أيضًا... أهو البداية مثل كل المبدعين، أم هو اعتراف بأنه البوابة الدافئة الأزلية التي تمرّ منها جميع فنون الإبداع؟ لماذا الشعر والأبواب مغلقة أمامه ثقافيًا وإعلاميًا هذه الأيام... وعطره بات مبددًا في أروقة المؤسسات الثقافية ودور النشر؟ ماذا تقولين لهؤلاء؟
- لم أبدأ بالشعر كديوان مستقل بذاته، الشعر عندي مبثوث في كامل نصوصي في السرد وفي النثر.
أذكر أني لما كنت أقرأ قصص بداياتي في منتدى القصاصين باتحاد الكتاب التونسيين في ثمانينيات القرن الماضي، أمام كبار النقاد، كان الناقد الكبير أبو زيان السعدي، يرحمه الله، يقول: «هذه قصائد! لولا التمكن من أدوات النص لأسميتها قصائد».
كنت على يقين بأن الشعر ليس في النظم، وإنما في كامل النص أيًا كان نوعه، وإيماني الأكبر أن الشعر موجود في الكون، وعلينا أن نعيش شعريًا وإبداعيًا على الأرض، وكل الشعر سيأتي طوعًا إلى النص.
أنا أقوم في الصبح أشرع باب الحديقة، أطوف بكائنات حديقتي أصبّح على الشجرة، وأقبّل خدود الوردة والزهرة، أكلمها وأحاورها وأبارك نموها، وأربت على كتف عودها، فيميل تيهًا ونشوةً ويزهر نخوة وتتدلى أكثر الثّمر.
نتبادل الأحاسيس والشعائر الصباحية والتراتيل الكونية التي لا يسمعها سوانا، نسبّح بعظمة الخلق وعطاء الطبيعة البكر وهي تبدع ذاتها. أمتلئ بها حتى أشعر بنوع من الفيض الصوفي أسكبه في نصوصي وفي قصائدي. الشعر هو أن ترهف السمع بحسّ شفيف إلى روح الطبيعة في أدق جزئياتها وتفاصيلها في كل كائناتها وتجلياتها وإيقاعاتها... الشعر في الكون وليس في القصيد بالضرورة.
وأنا لا يهمني إن كانت دور النشر مازالت تحتفي بالشعر، أم أن دونه الأبواب قد أوصدت، وإن كان عطره قد أريق على عتبات المؤسسات، أنا الذي يهمني هو عطره الذي يسكنني وتتبدد روحي إذا فارقني، لذلك أحافظ عليه نديّا حيًا دافئًا حنونًا مختبئًا في ذاتي / في ذات النص في جسدي / في جسد النص... النص الجيد يفرض نفسه شعرًا أم نثرًا!
مسؤولية مرعبة
• حصلتِ على جوائز إبداعية عديدة... وهو استحقاق بلا شك... كيف ترين الجائزة مسؤولية مرعبة من الآتي... وخوف أكثر؟ أم أنها الحافز على المزيد من الإبداع الجاد والهادف؟ حدثيني.
- إن المسؤولية التي ترعبني فعلًا هي نجاح أي أثر أدبي... نجاح روايتي «بغداد وقد انتصف الليل فيها»، وقبلها مسرحية «سيدة الأسرار عشتار»، وقبلها «جسد المرأة من سلطة الإنس إلى سلطة الجن» يشعرني بخوف كبير من الذي بعدها... النجاح مسؤولية خطيرة يجب ألا يغوينا، فنستسهل الكتابة التي يجب أن تبقى سمونا الأبدي.
الملتقيات الثقافية
• كانت لك مشاركاتك المهمة في الملتقيات الثــقـافـية والإبـــداعـــية في بـحــوث ودراســـات وشهادات... قولي لي ماذا تضيف هذه الملتقيات - التي تبدو ديكورية أحيانًا - للإبداع والثقافة؟ هل تؤسس لتواصل جاد بين المبدعين؟ ماذا أضافت لحياة الرايس شخصيًا؟ وماذا تقترحين للقاءات فاعلة؟
- ما تضيفه هذه الملتقيات على المستوى الإنساني أكثر مما تضيفه على المستوى المعرفي، لأن المعلومات موجودة على قارعة الطريق، والبركة في «الشيخ غوغل»، لكن اللقاءات الإنسانية هي أهم شيء.
أنا أكون سعيدة جدًا عندما أخرج من كل ملتقى بصديقة أو صديق حقيقي... وأذهب إليها غالبًا لأرى أصدقائي من العائلة الأدبية التي تجمعني بهم عِشْرة عمر على مدى السنوات.
الكتابة قاسية
• «حيث يوجد قلبك، يوجد كنزك»!
متى تصغين إلى قلبك، وتعطينه الكلمة في غفلة من حراس العقل التتريين؟
- أحيانًا يسيطر قلبي على عقلي بما لا أستطيع معه أمرًا ولا صبرًا... في حالة الحب القصوى التي هي ضرب من تسلّط القلب على العقل تسلطًا مرضيًا أو سلطويًا مطلقًا، حينها تأتي الذات الكاتبة التي تتصيد مثل هذه الحالات التي ربما لن تتكرر بحلوها أو مرّها... وتستغلها لمصلحتها وتخرجها إبداعيًا؛ شعرًا أو نثرًا.. الكتابة تحتاج إلى هذه الحالات التي أتواطأ معها أحيانًا لأسكب، أو لأريق على الورق ما أعيشه من فيض صوفي أو من عذابات الروح في حالات انكسارها أو شقائها بمن تحب، لأن الفرح شحيح لا يعطينا العمق الذي يعطيه الحزن والجرح والقسوة... الكتابة بدورها قاسية، لأنها تحتاج إلى كميات هائلة من الألم.
لذلك أقول دائمًا إن الكتابة هي عصارة أرواحنا... مثل الروح المطلق الذي ينفخ في جسد النص فيعطيه روحًا أخرى... لذلك لا يستطيع أن يتخلص النص العظيم من روح صاحبه أبدًا.
الكتابة هي الحياة
• في رواية «النسيان» لأكتور فاسيولينسي عبارة تقول: «لا تتوقف عن الكتابة أبدًا... وكأنه أشار عليّ بألا أتوقف عن الحياة!
أيهما الأقرب لرؤاك من العبارتين: «الكتابة حياة» أم «الحياة كتابة»؟ ولماذا؟
- من لا يعيش بعمق لا يكتب بعمق... الكتابة حياة أو لا تكون!
الكتابة حياة ثانية... لأن حياة واحدة لا تكفي لنعيشها كما نريد، خاصة إذا لم تكن لنا أوهام بحياة ثانية... فتأتي الكتابة لتعطينا الحياة التي تريد، وبين هذا وذاك يفعل الموت ما يريد، لأنه وحده من يعطيك الخلود أو الهباء، وكأنك ما كنت يومًا هنا... ولذلك أنا أكتب كوهم جميل يساعدنا على البقاء ويزين لنا الخلود، كما يزين لنا الموت الحياة، لأنه لولا الموت ما أقبلنا بهمتنا على الحياة وعلى الكتابة أيضًا... فالكتابة هي الحياة ■

حياة الرايس والروائي واسيني الأعرج