ظاهرة تسييس كل شيء
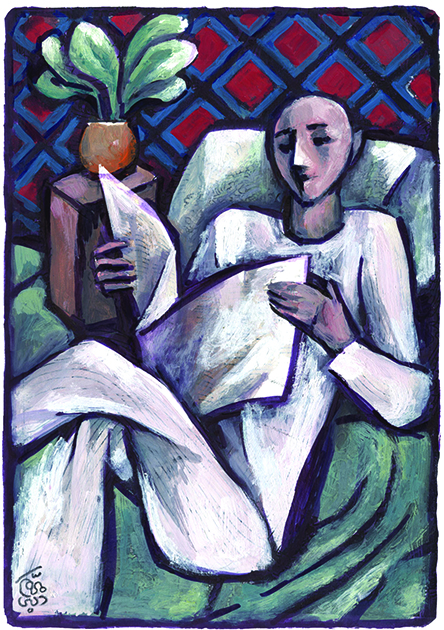
تستحق ظاهرة تسييس كل شيء، السائدة في العالم العربي، الوقوف عندها وتحليلها بصورة نقدية، لما لها من آثار سلبية على جميع الصُّعد في المجتمع، وهي لا تقتصر على طرف معيّن، بل تمتد لتشمل الحكومات ومعارضيها والمثقفين والمفكرين، وغيرهم ممن ينظرون لأي مشكلة أو قضية نظرة سياسية تتحكم في التعامل معها وتفسيرها، وحتى الحلول التي تقدم لها عادة ما تأخذ صبغة سياسية. ولا شك في أن هناك أسبابًا عدة تقف وراء ذلك؛ منها ما هو سياسي وثقافي وبنيوي وغيرها.
عادة ما يقوم أي مجتمع على أساس معيّن يلتف حوله الأفراد ويشكّل طريقة حياتهم ويكون مسؤولًا بالدرجة الأولى عن طريقة الإنتاج التي تسود في المجتمع.
وإذا نظرنا بشكل تاريخي لتطور المجتمع الإنساني، نجد أن الطبيعة، أي علاقة الإنسان بالطبيعة، كانت العامل الأساسي الذي شكّل واقع المجتمعات وقيمها معظم تاريخ البشرية، إلى أن جاء العلم منذ العصر الحديث، وأصبح العماد الذي تقوم عليه الحضارة المدنية الحديثة، وارتبط مصير الأفراد والمجتمعات وتطورها به، وغيّر من طبيعة المجتمعات وكيانها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأثّر بشكل كبير في طرق التفكير والثقافة الإنسانية.
كما غيّر العلم نظرة الإنسان لنفسه وموقفه من المجتمع والعالم، وكيف يمكن أن يمارس حياته من خلال اختيار أفضل النظم السياسية القائمة على التعددية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان والتداول الديمقراطي للسلطة، وكيف يطور واقعه بشكل لا يعرف التوقـــف عنـــد نقـــطة ما.
وما حققته أوربا في العصر الحديث، خصوصًا في النظام السياسي، أصبح النموذج الذي اتّبع منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم في معظم دول العالم. فعبر التقدم العلمي والثقافي المتزامنين في المجتمعات المتطورة، تم بناء شكل الدولة السياسي ذات الطابع المدني، وهي دولة تقسّم فيها السلطات عادة إلى ثلاث، وتقوم على المؤسسات الراسخة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها، ويسود فيها القانون والنظم التي تحدد مسيرة العمل في الدولة ومؤسساتها، ويتم تطور تلك المؤسسات من خلال القائمين عليها الذين يحظون عادة باستقلالية تامة عن أي ضغوط سياسية أو أيديولوجية، أو حتى عن المؤسسات السياسية القائمة.
رؤية وطنية
أدى ذلك إلى استمرارية العمل في هذه المؤسسات وفق رؤية وطنية ومؤسسية تنبع من الارتباط بالصالح العام للمجتمع، لا مصالح أحزاب أو تنظيمات سياسية، على الرغم من أن الدول الديمقراطية من أكثر الدول التي تتغير بها الحكومات السياسية وتوجهاتها التي تمثّل أحزابًا مختلفة الأفكار والأيديولوجيات السياسية.
إذاً كيان الدولة ومؤسساتها في المجتمعات المتقدمة كيانًا موضوعيًّا ليس حكرًا على فئة ما، ولا يمكن أن ينفرد طرف برسم سياساته وسير العمل في مؤسساته، وتدار المؤسسات وفق مبدأ الإدارة الذاتية ووفق اللوائح التي تنظمها.
وتزامن مع التطور العلمي تطورات فكــــرية تصــــاغ مـــن خـــلال الأســـس الفكــــرية والفلسفيــــة التي تقوم عليها المؤسسات والثقافة والفكر في المجتمع، إذ بناء على الصياغات العلمية التي يقوم بها الأكاديميون من مختلف العلوم، الإنسانية والاجتماعية والتجريبية، يساهم الفلاسفة والمفكرون والمثقفون في صياغة المفاهيم والقيم والأفكار العامة التي تمثّل الأرضية الفكرية لمسيرة تلك المؤسسات واستمراريتها.
ولا يفوت هنا أن نذكر دور الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية في بناء المجتمعات وتطورها، فالنجاح في التطور الاقتصادي الذي تحققه الدولة والمجتمعات ينعكس دائمًا على سياساتها، خصوصًا في المرحلة الحالية عالميًّا، حيث يؤدي الاقتصاديون الدور الأساسي في عملية التنمية، من خلال ما يعرف «اقتصاد السوق»، وأصبحوا يتحكمون بالسياسيين وقراراتهم، بل وفي نجـــاح الأحـــزاب بالانتخـــابـــات من عدمه أحياناً.
ثلاثة عناصر
خلاصة القول، هنـــالك ثلاثـــة عناصر رئيسة تلعب الدور الأساسي في بـــناء المجتمعات المتقدمة، وهي العلم والاقتصاد والفكر، فالإنتاج الاقتصادي، وخصوصًا الصناعي، يعتمـــد بالدرجة الأولى على التطورات العلمية والتكنولوجية التي تأتي بمؤثرات فكرية وثقافية على المجتمع، التي تنعكس بدورها على العملية السياسية، أي أن السياسة تأتي في مرحلة متأخرة.
ولعل النجاح الفعلي الذي تحقق في هذه المجتمعات هو عدم تسييس المؤسسات بمختلف أنماطها، فأبعدت عن الصراعات السياسية، وأصبحت تسنّ تشريعاتها وتتطور بقواها الذاتية.
ظاهرة التسييس في العالم العربي
رأينا الأسس التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، وكيف استطاعت شعوب المعمورة الأكثر تقدمًا في العالم السّير قُدمًا في تطورها، وتحقيق الاستقرار والتعايش فيها، والتقدم والرقي في مفاهيمها وقيمها. لكنّ واقعنا في العالم العربي مختلف تمامًا، فالأساس الذي تقوم عليه المجتمعات العربية ليس العلم والإنتاج الصناعي والاقتصادي، أي لسنا مجتمعات قائمة على أسس علمية وكذلك غير منتجة، فضلًا بالطبع عن غياب الفكر، خصوصًا العقلاني والتنويري ذا الطابع الفلسفي الذي تتميز به المجتمعات المعاصرة، باعتباره أساسًا لعملية التقدم والتطور في المجتمع ككل من مختلف الجوانب.
فواقع حالنا يشير إلى أن الأساس الذي تقوم عليه الدول في عالمنا العربي هو أساس سياسي، أي السياسة هي الأساس، ومع الأسف هذا الأساس لا ينبع من نظريات فكرية فلسفية تعكس رؤية متقدمة ومتطورة، بل ينبع من عوامل اجتماعية صرفة، مهما حاول البعض تلميع صورة إدارة الدول من خلال أحزاب أو أشكال معيّنة، توسم بالديمقراطية أو غيرها. وقد نتج عن ذلك أن تم تسييس المجتمع ومؤسساته ومكوناته الاجتماعية.
ولعل أول ما يشار إليه في هذا الإطار هو الإخفاق في إقامة مجتمعات قائمة على مؤسسات فعلية لها كيانها واستقلاليتها، تستند إلى قيم حقيقية للمواطنة وتسودها المساواة والعدالة التي تقود إلى قيام دولة المؤسسات الحديثة القائمة على الثقافة المدنية وتطبيق القانون.
نظرة محايدة
فالدولة المدنية غير متحققة، على الرغم من مضيّ عدة عقود على الاستقلال من الاستعمار، وبالتالي لا ينظر للدولة ككيان موضوعي مثلما هي الحال في الدول المتقدمة، نتيجة للثقافة العلمية التي تنظر للأمور بنظرة موضوعية ومحايدة، بل إن النظرة لها تأخذ الأبعاد الذاتية نتيجة لكون الثقافة السائدة في العالم العربي تقوم على أسس اجتماعية وذاتية، وهذا ما يفتح المجال للجوانب السياسية للدخول في تشكيل المجتمع والدولة.
فالأفكار السياسية والأيديولوجية ذات بُعد ذاتي أو اجتماعي، وتعكس رؤى وتصورات ذاتية لأفراد أو مجاميع تحاول من خلالها تشكيل المجتمع والدولة، وأيضًا تعمل على محاولة خلق ثقافة معيّنة تتماشى مع طبيعة الحكم السياسي الذي تريد إقامته.
وفي الوقت نفسه، تتميز طريقة إدارة الدولة والمجتمع بوجود سلطة مركزية واحدة تنفرد بالإدارة ورسم السياسات، وتخضع جميع مؤسسات الدولة لتوجهاتها السياسية.
والسلطة المركزية تكون، بالطبع، نتيجة لغياب الديمقراطية التي تعدّ النظام الأمثل لتحقيق استقلالية تامة للمؤسسات، لكن ما نراه عندنا هو تسييس تام لجميع مؤسسات المجتمع وهيئاته الرسمية، وفي بعض الدول حتى الهيئات والنقابات الشعبية، لا تخرج عن الإطار السياسي العام.
فــالمـــؤســــسات الاقـــــتصــــادية والاجــتمـــاعية والثقافية والأهم، من دون شك، المؤسسات التعليمية في جميع مراحل التعلم المدرسي والجامعي تخضع بشكل مباشر للسلطة السياسية، بمعنى أنها تسيّس تمامًا وتفرّغ من أي إطار تنظيمي داخلي فعلي يسير وفق لوائح وقرارات ذاتية.
تعيينات سياسية
تخضع المناصب المهمة والحساسة في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها لتعيينات سياسية لا تراعى فيها الكفاءة أو التخصص أو الخبرة، وغيرها من سمات تتطلبها قيادة المؤسسات الناجحة، ويرتبط ما يصدر عنه من قرارات وفعاليـــات وممـــارسات بما هو سائد سياسيًّا في المجتمع، والخــروج على ذلك يعـــنـــي الإقــــالة على أقــل تقــــدير، أو قـــد تصل الأمـــور إلى وسائل العقاب المعروفـــة، وهناك بُعد سلبي جدًّا يظهر في مسألة التعيـــينات للمــــناصــــب، ويتـــــعلق بإخضاعها لنظام المحاصصة، حيث توزع على فئات وطوائف وقبائل وغيرها، من دون الأخذ بأي اعتبار لمبدأ الكفاءة أو التخصص.
وينتج عن تسييس مؤسسات الدولة والمجتمع غياب العدالة والمساواة بين المواطنين، ويخضع تطبيق القانون على الأفراد لمعايير سياسية فئوية، وغياب فعلي لمبدأ تكافؤ الفرص، وتفشي البيروقراطية في المؤسسات والهيئات الرسمية، وخضوعها لرقابة مستمرة لما يصدر عنها من قرارات.
هنالك بالطبع بُعد ثقافي لهذه المسألة، يتمثّل في فكرة الخضوع للسلطة ذات الأساس الاجتماعي، فعادة ما تخضع التشكيلات والكيانات الاجتماعية في المجتمع لتسلسل هرمي يكون فيه القرار عند فرد أو مجموعة هي التي تحدد كل شيء، وما على الآخرين إلا اتباعها.
فلو نظرنا إلى الأسرة الصغيرة ككيان اجتماعي، نجد في الأغلب خضوع أفراد الأسرة لسلطة رب الأسرة الذي غالبًا ما يتدخل بكل كبيرة وصغيرة في شؤون أفرادها، ويحدد عنهم القرارات المصيرية، ولا تمكن مناقشته أو التمرد عليه، لأن ذلك سيوقع العقوبات في حق من يتمرّد.
تسييس كل شيء
هذه البيئة الاجتماعية تنتج ممارسات وقيمًا تسود في المجتمع نجد لها صدى في ممارسات كثير من المسؤولين في الإدارات، وكذلك في مؤسسات التعليم التي أصبحت تفتقر إلى أبسط مبادئ التفكير العقلاني والمستقل للطلاب الذين يخضعون بدورهم لسلطة المعلم.
لقد أفرزت ظاهرة تسييس كل شيء في المجتمع الأوضاع التي نعيــشـــها في واقعنا العربي، فهي تعدّ أحد أبرز العوامل المسؤولة لحالة التخلف الذي نعيشه، وإعاقـــة أي تطور حقيقي للمجتمع والـــدولة ومـــؤسســــاتها، فـتـســيــيــــــس المــؤســسة والــثـقـــافـــة والــتـعـــلـــيم والاقتصـــاد والشرائح الاجتماعية وغيرها من موضوعات سينتج عنه تحجيم لهذه المؤسسات، وإعاقتها عن لعب دورها الحقيقي في المجتمع، وسيقضي على التعددية في الآراء ومعالجة المشكلات، وسيقف حجر عثرة أمام الإبداع والأخذ بالأساليب الجديدة ومصادرة المبادرة الفردية والجماعية في طرح الأفكار التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في طبيعة عمل المؤسسات وتطور أدائها .

