هل انتهى زمن أدب الرحلات؟
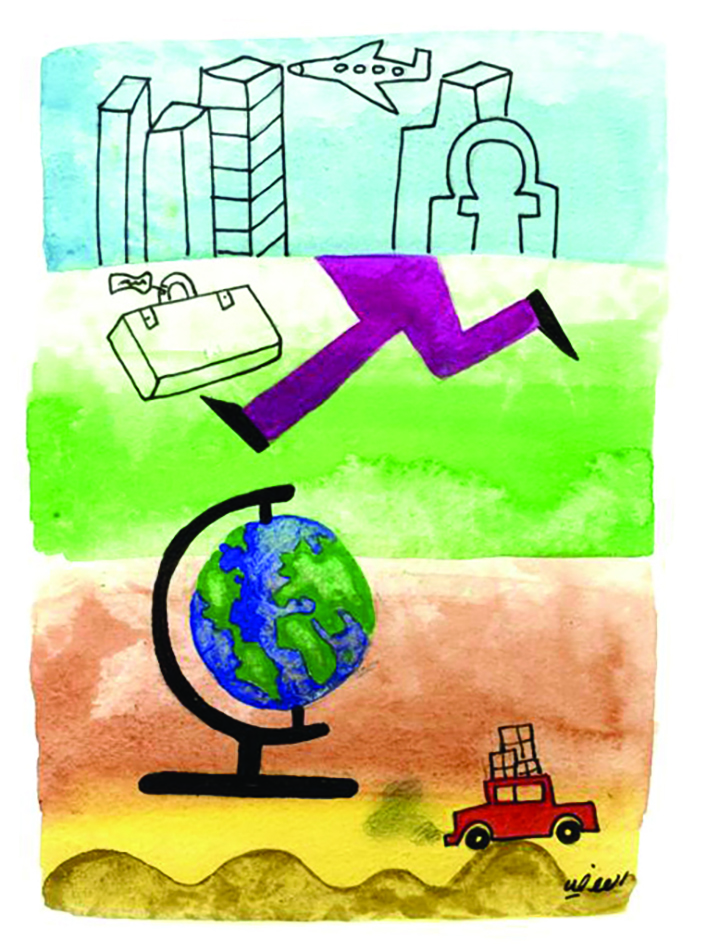
شغلتني الإجابة عن هذا السؤال فترة من الزمن، هل انتهى زمن أدب الرحلات؟ ليس للرد فقط على من يعتقدون بأن هذا الصنف من الأدب قد انتهى، ولكن لأنّ الرحلات المعاصرة بمعطياتها المتجددة بحاجة إلى مراجعة وتقييم، حالها حال ما يُقدّم للناس من علوم وآداب ومعارف، ووجدت في الفائدة خير مدخل لدراسة جدوى استمرار وجود أدب الرحلات، لأنها - أي الفائدة - سبب وجود كثير من الأشياء، ومن دونها إما تختفي أو تُحال إلى المتاحف ليراها الناس كقطعة من التاريخ.
لقد قرأت رأيًا للروائي المصري الراحل فؤاد قنديل 1944م - 2015م في كتابه «أدب الرحلة في التراث العربي» يقول فيه عن أدب الرحلات : «إنني أزعم أن أدب الرحلات أوشك أن يكون - كالفلسفة - تراثًا فقط، لا جديد يمكن أن يضاف إليه بعد أن تيسّر السفر والانتقال لكل إنسان، واستطاعت وسائل الإعلام بتقنياتها الهائلة أن تجعل من العالم قرية صغيرة، وكتابًا مفتوحًا لأغلب شعوب الأرض».
هذا الرأي الذي أحترمه وأتفهّم دوافعه سمعته كثيرًا، لكنني وجدت واقعًا في معارض الكتب العربية وأخبار الإصدارات الحديثة التي تحمل لنا الجديد في فئة أدب الرحلات من كتّاب تخصصوا في هذا الأدب وكتّاب وشعراء وروائيين وأساتذة جامعيين ساهموا بكتاب أو كتب عدة، آخرهم الروائي الليبي د. أحمد إبراهيم الفقيه، الذي رحل عن دنيانا أوائل شهر مايو الماضي، ولديه 4 كتب في أدب الرحلات.
مَن بقي ليس كمن قطع الأقطار
سأعود إلى رأي الأستاذ فؤاد قنديل، ولكن بعد أن أتناول موضوع أهمية الرحلة، ويمكن أن أضيف السؤال التالي: هل كانت الرحلة مفيدة في العصور الماضية، وبسبب التطورات التي قربت المسافات بين البشر، انتفت الحاجة إليها كمورد للمعلومات؟
يقول الرحّالة والمؤرخ والجغرافي أبوالحسن المسعودي 896م - 957م : : ليس من لزم جهة وطنه وقنع بما نمى إليه من الأخبار من إقليمه كمن قسّم عمره على قطع الأقطار.. ووزع بين أيامه تقاذف الأسفار واستخرج كل دقيق من معدنه، وأثار كل نفيس من مكمنه.
وفقًا لهذا الرأي لصاحب كتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر»، فإن المسعودي يفرّق بين من بقي في وطنه وبين من وزّع أيامه على الأسفار، والأخبار التي أتى على ذكرها، أفهمها قياسًا على زمانه في الدولة العباسية على أنها أحوال البلاد والعباد، وليست أخبار الولاة والولايات وما يستدعي نشره من أخبار عاجلة، وتلك ليست من مهام الرحّالة الذين يسيرون في الأرض وفقًا لمخططاتهم الخاصة على الأغلب، وحتى ابن فضلان الذي خرج من بغداد على رأس وفد بتكليف من الخليفة المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة، تبدل مسار رحلته ليصل إلى شمال إسكندنافيا، قبل أن يتمكن من العودة إلى بغداد مرة أخرى.
عالَم متغيّر وأحوال تتبدل
يعتبر الأديب واللغوي المصري د. شوقي ضيف 1910م - 2005م أدب الرحلات «من أهم فنون الأدب العربي»، موضحًا ذلك في كتابه الذي حمل عنوان «الرحلات» بأنه، أي أدب الرحلات «خير رد على التهمة التي طالما اتّهم بها هذا الأدب، ونقصد تهمة قصوره في فن القصة، ومن غير شك من يتهمونه هذه التهمة لم يقرأوا ما تقدمه كتب الرحلات من قصص عن زنوج إفريقية وعرائس البحر وحجاج الهند وأكلة لحوم البشر وصناع الصين وسكان نهر الفولجا وعبَدَة النار والإنسان البدائي والراقي مما يصور الحقيقة حينًا، ويرتفع بنا إلى عالم خيالي حينًا آخر».
وقد يقول قائل إن رأي د. شوقي ضيف يخص حالة محددة استدعته للرد، فضلًا عن أن المرحلة الزمنية التي صدر فيها كتابه عام 1956م، تحاكي واقعًا ليس موجودًا اليوم بفضل تطور وسائل الإعلام والتواصل، وردّي هو أن العالم بكل ما فيه من بشر ودول، عالَم متغير مليء بالتحولات واكتشاف جزء منه في وقت معيّن لا يعني أنه سيتجمد على الهيئة التي رآها فيها الرحالة، حتى إذا عاد هو أو غيره للمكان نفسه بعد مدة طويلة وجده على الحال نفسها المذكورة في كتابه، وهناك مثال أجده جديرًا بالذكر للتدليل على ما أقوله.
لقد عثرت على كتاب أعتز به وأحدّث عنه كلما وجدت الفرصة سانحة، وهو كتاب رحلات قام به مدرس أول العلوم الاجتماعية بمدرسة القبة الثانوية، محمد ثابت، وعنوانه «جولة في ربوع آسيا» وصدر عام 1936م، دوّن فيه ثلاث رحلات للصين والهند واليابان، وزوّده بصور فوتوغرافية أعتبرها قفزة كبيرة في عالم كتب أدب الرحلات.
هنا سأركز على رحلة اليابان، لأنها أعطت صورة مهمة عن تلك الدولة الناهضة في حينها من قلم عربي كتب عن اليابان قبل نشوب الحرب العالمية الثانية 1939م - 1945م بثلاث سنوات، ولأنه حمل رؤية مبكرة تطلب الالتفات إلى التجربة اليابانية في النهوض.
يقول ثابت في مقدمة الكتاب: «هأنذا أقدّم للوطن المحبوب ولأبنائه المخلصين أولى جولاتي في ربوع الشرق بعد أن تقدمتها جولتي في ربوع أوربا، راجيًا أن أكون قد أصبت بعض الشيء في تفهّم تلك الشعوب التي تربطنا بها روابط عريقة توثقها العاطفة، وإني لأصورها هنا كما رأتها عينٌ مصرية شرقية غير مغرضة، لا تبتغي من وراء ذلك إلا النفع.
وقد حاولت جهدي استقرار عناصر نهوضها وقعودها علّنا نستنير بطرائقها الموفقة فنهتدي، وعسانا نعتبر بما أصابها، فنأمن العثار الذي يتهدد الأمم في فجر نهوضها وطور انتقالها، ونحن أحوج ما نكون إلى المُثل العليا نترسم خطاها، ولنا في اليابان أسوة حسنة، فلنسلك نهجها، ولنا في الصين وما يحوط نهوضها من قذى وشباك أكبر العِبر، سدد الله خطانا، وهدى الوطن وأبناءه سبيلاً رشدًا.
وعن التعليم في اليابان كتب ثابت: «وقد نشط التعليم منذ 1869م حين أقسم الامبراطور يقصد ميجي أنه سيعمل على نشر التعليم حتى لا تبقى عائلة جاهلة»، وعن الثورة الصناعية أوضح أن الدولة هي التي أنشأت المصانع وأوفدت الطلبة للخارج كي يتعلموا الصناعة والتجارة، وهي من استقدمت الخبرات الأجنبية للاستفادة منها في هذا المجال. ولعل الغوص في تفاصيل هذه الرحلة التنويرية يتضمن كثيرًا من جوانب نهضة اليابان الأولى، خاصة فيما يخص البحث عن صيغ توفيقية بين الموروث والعادات، وبين الأساليب الجديدة المستوردة في النظم السياسية والقانونية والاجتماعية والإدارية.
الآن لنسأل لو تسنّت للأستاذ محمد ثابت رحلة ثانية لليابان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، هل كان سيجد طوكيو والمدن والمناطق التي تجول فيها قبل الحرب على حالها كما رآها أول مرة؟
أدب يستوعب الأدباء والشعراء
تزخر المكتبة العربية بكتب أدب الرحلات المعاصرة، وقد نجحت في اقتناء عدد وافر منها، أستزيد من زادها وأتجول في عوالمها، ووجدت فيها تنوعًا جميلًا يستحق التوقف عنده، فهذه الكتب أولًا ليست مقصورة على جيل أو جنس معيّن، الأمر الثاني هو المساهمات القادمة من أقلام اشتهرت بهويّاتها الغالبة، مثل شاعر أو روائي... إلخ، وهو ما يجعلني أذهب إلى القول بأن أدب الرحلات يستوعب الجميع، طالما تم الالتزام بأهم ركنين من أركانه، وهما بالترتيب الرحلة والأدب، لأن الرحلة بمشاقّها هي الانطلاقة الفعلية نحو الكتابة عن كل ما سيحصل فيها.
لا أذكر أني قرأت نقدًا قيل فيه لهذا الشاعر أو ذلك الروائي: لماذا خضت في بحر غير بحرك؟ كما يحصل هذه الأيام عندما يطرق أحد باب الرواية وهو الضليع في مجال آخر!
أما في مجال أدب الرحلات فنجد أن خليطًا من الكتّاب المتمرسين يضيف كل واحد منهم نكهة خاصة لنصه في أدب الرحلات، ما عدا المرشدين السياحيين الذين اختلط عليهم الأمر بين الكتابة مثلًا عن أسعار فندق أمبوس موندوس في العاصمة الكوبية هافانا، وبين قيمته الثقافية كمكان عاش فيه الروائي الأمريكي آرنست هيمنغواي أول أيامه قبل أن ينتقل إلى مزرعته خارج هافانا.
لقد اخترت من بين تلك الكتب ثلاثة نماذج في أدب الرحلات المعاصرة، شدتني دوافع كتّابها الذين كانوا جميعهم شعراء نحو هذا النوع من الكتابة الأدبية، الكتاب الأول للشاعر الأردني أمجد ناصر عنوانه «تحت أكثر من سماء... رحلات إلى اليمن، لبنان، عُمان، سورية، المغرب وكندا»، يقول ناصر عن رحلاته: «هاجس هذه الكتابات هو الاحتفاء بالمكان وشخوصه لا مجرد المرور بهما حتى عندما يكون للرحلة غرض آخر مرور الكرام.
إنها محاولة للتوقف في المكان وأمامه والإنصات إلى أصواته الكبيرة والصغيرة على السواء، ويحلو لي أن أزعم أن نداءات أصواته الصغيرة، التي بالكاد تبلغ السجلات والقيود والمصنفات، هي التي تشدني أكثر من الأصوات التي يمكن سماعها من مبعدة والتي لا تسوغ، دائمًا، عناء الرحلة... ولا أقول «وعثاء السفر».
الكتاب الثاني هو «شذى الأمكنة» للشاعر العماني محمد بن سيف الرحبي يبوح بما تراكم من حب للسفر والترحال «أريد أن أرى أرضًا أخرى، أشعر أنها تنتمي لغيرنا... غامر أجدادنا بالسفر، ففتحت لهم موانئ الأرض أذرعها محتضنة إياهم: بحارة وربابنة وتجارًا وباحثين عن لقمة عيش...».
ويكمل في موضع آخر «حدثتني نفسي بالارتحال... والاكتشاف، والسير نحو مجاهل جديدة، هي مجاهل في داخلي تحتاج إلى إضاءة بالسفر، الأمكنة مزروعة في بقعة ما في دواخلنا، غير واضحة وغير مرئية، لا بد من رؤية مدينة ما لنضع المتخيل (في داخلنا) بالواقع (في الأمكنة الأصلية)... بفرح الاكتشاف أن ما في (داخلنا) يطابق (ما تراه أعيننا ندرك حجم ما أنجزناه.
الكتاب الثالث عين وجناح» للشاعر العماني محمد الحارثي الذي اختير كتابه للفوز بالمركز الأول للرحلة المعاصرة في الدورة الأولى لجائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي، فالترحال أسلوب حياة خاص خبره البدو في مفازة الربع الخالي، كما خبرته قبائل «الماساي» في شرق إفريقيا... تلك القبائل التي اعتبرت الترحال وطنًا متحققًا مهما كانت الغاية منه ارتحالاً أبديًّا للوصول إلى وطن لا يتحقق ولن يتحقق أبدًا».
وأستطيع أن أختم هنا بذكر فصل كامل ورد في كتاب الشاعر البحريني قاسم حداد «ورشة الأمل» سجّل فيه رحلته إلى الجبل الأخضر بسلطنة عمان، في نص لا يخرج عن عباءة أدب الرحلات، وقد تمنيت عليه، في أثناء مرافقتي له عندما زار الكويت عام 2016م، أن يكتب عن ألمانيا التي يمضي فيها أوقاتًا طويلة خلال السنة.
تعزيز نقاط الفهم والتلاقي
نعود الآن إلى رأي الأستاذ فؤاد قنديل الذي وجد أن أدب الرحلات أوشك أن يصبح تراثًا فقط، وأرجع ذلك لسببين رئيسين؛ هما تيسّر السفر والانتقال لكل إنسان، وقدرة وسائل الإعلام بتقنياتها الهائلة على أن تجعل من العالم قرية صغيرة.
إن تيسُّر السفر والانتقال زاد من أهمية التواصل بين البشر، وزاد من قاعدة الرحّالة المعاصرين، وضاعف من خياراتهم للوصول إلى أماكن أبعد وأغرب، إن رحالة العصور الوسطى كان ينفّذون رحلة يتيمة في حياتهم، وسط مخاطر ومشاقّ لا حصر لها، أما رحّالة العصر الحديث فأمامهم فرص كثيرة للسفر، وهو ما يؤدي في النهاية إلى إثراء المكتبة العربية بالمزيد من كتب أدب الرحلات التي تعزز من نقاط الفهم والتلاقي وفتح طريق جديد مع الآخر.
إن عملاقًا اقتصاديًا مثل الصين يُتوقع له أن يحقق حضورًا عظيمًا على الساحة الدولية، فهل سنكتفي بما ينقل لنا من مصادر أجنبية عن بلد مفتوح وقريب منّا؟
إن التطور المتسارع في وسائل الإعلام والتواصل واقع لا يمكن إنكاره أو الاستغناء عنه، وهذا الواقع يطرح سؤالاً ثقيلاً، هو: مَن يصنع ذلك الإعلام؟ هل نحن العرب، أم الدول الغربية؟ الجواب معروف ويجعلنا كعرب في موضع التلقي في تلك القرية الصغيرة، وأدب الرحلات هنا ليس سوى أداة من أدوات التواصل مع الآخر، تكتب من العرب إلى العرب، فهل نتخلى عن تلك الأداة؟
هل تلغي مجلة العربي، التي ساهمت منذ عقود في صنع نموذج جديد من أدب الرحلات المعاصرة، بابها المخصص للاستطلاعات الصحافية، فقط لأن قناة أجنبية تبث أفلامًا وثائقية تحاكي مضمون ذلك الباب نفسه؟ على العكس من ذلك، لنستفد من تجارب الآخرين، ولتطوّر «العربي» رحلاتها لتشمل بعثة تلفزيونية تعمل بالتوازي معها.
يقول الشاعر محمد الحارثي في كتابه «عين وجناح» عن سلسلة السندباد الجديد: «أعادت إلى الحياة ضربًا من ضروب الكتابة في ثقافتنا كاد ينسى، وغم أن أسلافنا كانوا روّادًا وسباقين إليه في ظروف حياتية أقسى مما هو متاح لنا اليوم عبر وسائل الاتصال الحديثة التي جعلت من كوكبنا هذا قرية صغيرة، إلا أنها ستظل، أبدًا، تلك القرية التي تستحق اكتشافنا لها وارتحالنا بين شعابها».
تكرار الرحلة... لذة إعادة الاكتشاف
إن للاكتشاف لأول مرة لذة لا توصف؛ سواء للأمكنة المجهولة أو الشعوب المنعزلة، ولكن ماذا عن لذة إعادة الاكتشاف؟، مَن منّا لا يعرف مدينة البتراء الأثرية في الأردن، لقد أسست قبل الميلاد وفي مرحلة زمنية غاب ذكرها، حتى أعاد اكتشافها المستشرق السويسري يوهان بركهارت عام 1812م، وكتب عنها في كتابه ليعرفها العالم الغربي من خلاله. إن الذهاب إلى أماكن تم اكتشافها من قبل لا يقلل من قيمة الرحلة وكاتبها، بل يضيف إليها أبعادًا أخرى تبعًا لاختلاف ثقافات الكتّاب ومشاربهم.
في الختام، لأدب الرحلات قوى حقيقية موجودة على الأرض، لكنها متباعدة، وتحتاج إلى التوحد لكي تخلق زخمها الذي سيعيد رسم ملامح المشهد الثقافي، ويضع أدب الرحلات في مكانه الصحيح .

