صلة الأزجال الأندلسية باللهجات العربية
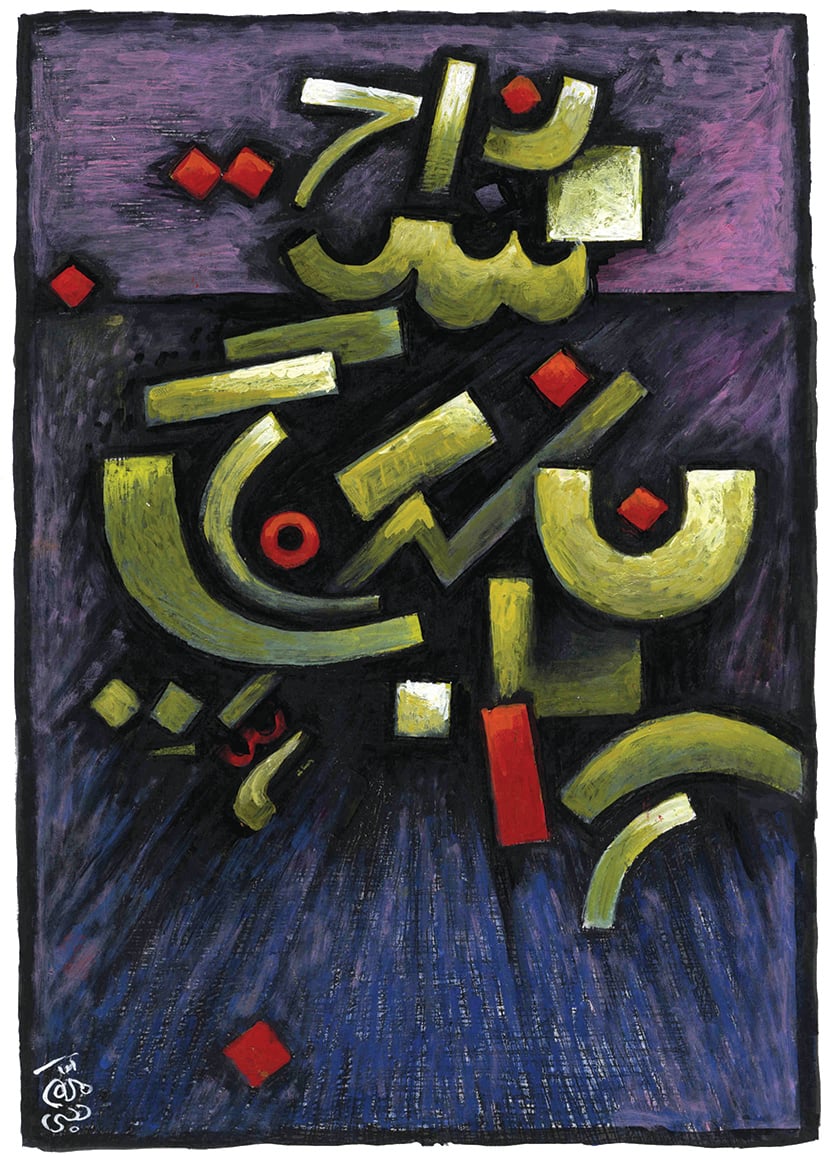
يُعد الزجل من الفنون الشعرية المستحدثة في الأندلس، ظهر تلبية لحاجة العامة التي تجنح إلى الكلام السهل، وتميل إلى التعبير الميسّر، لاسيما في عصر المرابطين الذي تذكر المصادر تعسُّر فهم الفصحى لدى كثير من المستعربين والبربر والأعاجم، ولا يعني هذا أن الزجل تجرّد من السمات التي تطبع الشّعر عادة، بل على العكس من ذلك، فقد وضع كبار الزجالين قواعد يجب على كل من أراد خوض هذه المغامرة الجديدة الالتزام بها، حتى إن بعض النقاد يذهب إلى أن الزجل موشح ملحون.
لعل السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لقي الموشح اهتمامًا من النقاد والدارسين، لاسيما المحدثين، بينما أُهمل الزجل وهو أخ غير شقيق؟
لعل إجابة أغلبهم ستكون صعوبة اللهجة التي كُتب بها الزجل، تلك اللهجة العصيّة التي لا يفهمها إلا أهل المغرب العربي، ولهذا فهم يكتفون بدراسة الزجل دراسة وصفيّة تأريخية، دون الخوض في ملامسة تلك اللغة الجديدة التي كُتب بها، والواقع أنها ليست عاميّة خالصة، بل فصحى قريبة إلى العامية، وإذا ما قورنت بلهجات العصر الحديث فسترقى إلى درجة الفصيح.
صلة اللهجات بالأزجال الأندلسية
قد تبدو اللهجات الحديثة بعيدة كل البُعد عمّا سماه المعاصرون اللهجات العربية القديمة، تلك التي لا تختلف عن اللغة الأم أو كما سماها بعضهم اللغة المشتركة، إلا في مواضع يسيرة، غير أنها حين تخضع لغربلة الكلمات الدخيلة والأجنبية، ستفضي بنا إلى صلة عجيبة باللهجات القديمة، وهو ما سنحاول الوقوف عليه من خلال عرض النماذج التالية.
تخفيف الهمزة
أغلب اللهجات العربية الحديثة يجنح إلى تخفيف الهمزة، وهو أمر ضارب في القدم، يقول برجشتراسر: «أكثر الهمزات كانت لا تنطق في لهجة الحجاز، إلا ما كان منها في أوائل الكلمات، وبعض ما وقع منها بين حركتين»، فتخفيف الهمزة خاصية عربية سامية، وليست بدعة عاميّة، ومن جملة ما قيل من أزجال في هذا الباب، قول ابن قزمان:
ونكون ضايع بحال مشط أقرع
فابن قزمان خفّف هنا كلمة ضايع التي أصلها ضائع، والهمزة إنما عادت إلى أصلها: ضاع يضيع ضياعًا.
ويقول الششتري:
خلوني هايم وفاني
قاسيت ما لم أطيق
كما عمد بعض الزجالين إلى حذف الهمزة المتطرفة كليّة بغرض التخفيف، وهي ظاهرة قديمة تعود إلى لهجة أهل الحجاز الذين «يغلب عليهم تسهيل وحذف الهمزة المتطرفة» كقول مدغليس:
ثلاث أشيا فالبساتين
لس تجد في كل موضع
ويقول ابن قزمان:
أي مرا يا قوم تسكن بجواري
وابن قزمان حذف الهمزة والتاء من كلمة (امرأة)، وهذه الظاهرة منتشرة في أغلب الدول العربية اليوم، إذ يقولون «مرا» وهم يريدون امرأة.
وإسقاط الهمزة في آخر الكلمة أمر شائع في بلاد الشام، كما نعلم.
إشباعُ الضمّة
ظاهرة إشباع الضمة موجودة في بعض اللهجات العربية القديمة، يقول عبدالواحد وافي: إشباع الضمة في عين المضارع المضموم يتولد عنها واو في بعض اللهجات، فيقال: «انظور مكان انظر... (كذلك) وصل واو بميم الجمع (كقولهم): عليهمو».
غير أن الزجالين أخذوا بهذه القاعدة فعمّموها على الحرف المضموم مطلقًا وإن لم يكن عين الفعل، كقول ابن قزمان:
قُوم أعطيني نصيبي
من قمحك الجديد
وقال أبو عبدالله اللوشي:
طلّ الصباح قم يا نديمي نشربو
ونضحكو بعد ما نطربو
وحتى وهم يفعلون هذا لم يشذوا عن القواعد العربية، فقد جاء في كتاب سر الإعراب قول الشاعر:
هجوت زبان ثم جئت معتذرًا
من هجو زبان لم تهجو ولم تدع
فكأنه أراد لم تَهجُ بحذف الواو للجزم، ثم أشبع ضمة الجيم، فنشأت بعدها واو، وظاهرة إشباع الضمة إذا اقترن الفعل بضمير المتكلم أو الجمع، موجودة في دول المغرب العربي، وفي لهجة الإسكندرية، فيقولون: نكتبو، نرسمو، نعملو.
النحت
يبدو أن العامية العربية عمومًا، والأندلسية خصوصًا، قد وجدتا في النحت فضاء رحبًا لاختصار الكلمات واختزالها، وربما لا نبالغ إذا قلنا إن أكثر الكلمات العامية اليوم منحوتة، ومن أشهر الألفاظ التي تم نحتها قولهم: آش: من أي شيء، أشنه: من أي شيء هذا، وعاليش: من على أي شيء، وأشحال: من أي شيء حال، ولش: من لأي شيء.
ونحن لا نعلم مدى صحة هذا النحت في المنظومة العربية الفصيحة، للأسباب آنفة الذكر، ومن أمثلة ذلك قول ابن نمارة:
عاليش ينكرون الجميل المصنوع
وآش يفيد الإنكار
ويقول ابن قزمان:
قل لّ أشنه يا فقي ذا الكلام
بالله ما ذقت قط شراب تفاح
ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن هذه الكلمات المنحوتة: إشحال، آش، أشنه... تستعمل في كثير من الأقطار العربية اليوم.
حذف نون (من) الجارَّة
قد يبدو هذا الفعل للوهلة الأولى أمرًا منكرًا في العربية الفصحى، ولكن إذا عدنا قليلاً إلى الوراء فسنقف على هذه الظاهرة عند خثعم وزبيدة، إذ كانت هذه القبائل تحذف نون (من) الجارة إذا وليها ساكن، فتقول: ملبيت تريد: من البيت.
ومن أمثلة ذلك في الزجل، قول مدغليس:
ثلاث أشيا فالبساتين
لس تجد في كل موضع
وقول ابن قزمان:
بيني وبين الفقي جاري فالكاس حروب
والعامة اليوم يحذفون ياء (في) على المنوال نفسه، فيقولون: فلبيت، فدّار، فدُّكان، فلخزانة.
معجم الكلمات الأندلسية المستعملة
في أيامنا
من جملة الألفاظ المتداولة في ذلك الوقت، ومازال صداها موجودًا إلى يومنا هذا قولهم: يولول، يريدون بها إظهار السعادة، على عكس دلالتها الأصلية، وهي رفع الصوت بالصياح والبكاء، والمعنى الجديد لكلمة يولول مستعملة في الجزائر، بما يقابل الزغاريد في بعض الأماكن، وفي أماكن أخرى تستعمل في معناها الأصلي، وهو رفع الصوت بالبكاء والصياح، شأنها في ذلك شأن بقية الأقطار العربية، يقول مدغليس:
قم ترى النسيم يولول
والطيور عليه تغرد
ومن الكلمات المتداولة في الأقطار العربية قولهم: «فروج» يريدون الديك أو الدجاج عمومًا، يقول ابن غرلة:
بعد ذبحك جريت يا فروجي
وإيش يفيد الجري؟
ومن الألفاظ المتداولة في كثير من لهجاتنا قولهم: مطرح وحنبل، وهي أنواع من الأفرشة التقليدية، يقول ابن قزمان:
آرّ ذاك المطرح
أبسط أنت الحنبل
ومن الكلمات التي تجاوزت سياقها الفصيح لتدل على معنى مقارب جديد في اللهجات الحديثة، كلمة مسكين التي تعني في العربية الفقير الذي لا يملك مالاً، أو الضعيف الذليل، لكن اللهجات الحديثة أضفت على هذه الكلمة معنى آخر وهو الشخص المثير للشفقة والتعاطف، وإن كان غنيًّا، وإن كان عزيزًا في قومه، يقول الششتري:
حتى جميع من يراني
يقول مسكين عشيق
وإلى جانب هذا، تستعمل العامة أحيانًا كلمات معناها الفصيح يعاكس المعنى العامي، مثل كلمة بان التي تعني في العربية ابتعد، وفي العاميات الحديثة تعني: ظهر واقترب، يقول الششتري:
والوجود قد بان
ويرى الإنسان
كما يستعملون أحيانًا كلمات محرّفة من الفصيح كقولهم: نبرا يريدون أُشفى، ولكن عندما خففت الهمزة، وعوضت ألف المتكلم بالنون كما هو جار في لهجات المغرب العربي، أضحت الكلمة ربما غريبة لدى البقية، يقول الششتري:
قطع الكمين
نقصد بيه نبرا
الضمائر وصيغ الحاضر والمستقبل
لا شك في أن اللهجات العربية الحديثة تخالف الفصحى في توظيفها الدقيق للضمائر، وصيغ الفعل والأزمنة، ففي العامية مثلاً لا يوجد المثنى، بل المفرد والجمع فقط، كما أن دول المغرب العربي وبعض المناطق في مصر يستعملون النون بدل الألف في ضمير المتكلم، فيقولون: نمشي بدل أمشي، وهو ما لاحظناه في الأزجال الأندلسية، ومنها قول الششتري:
نستبدل الحلة بدفاس
ونمزق شي لبستو
وقول ابن قزمان:
جي إلى هنا نقل لك خبر
إنني زمان لم نطبخ قدر
أما الحروف والصيغ الدالة على تغيّر الزمن، لاسيما الزمن الحاضر والمستقبل، فإنهم يستعملون، أي أهل الأندلس، حرف الكاف متصلاً بالفعل، كما يفعل أهل المغرب الأقصى، فيقولون: كنعمل - كنكتب - كناكل... وهو الأمر نفسه الذي يحدث في بقية اللهجات فقط بتغيير الكاف بحرف آخر، ففي مصر مثلاً يستعملون الهاء للمستقبل: هعمل، هنشوف، هسافر..
يقول ابن قزمان:
تدري إذا قلت لي شربت عقار
آه حقًا كنبتلعها كبار
تسكين المتحرك
من المسلّمات في الزجل أن إعرابه لحن، ولحنه صواب، وهو ما اتفق عليه الزجالون، يقول ابن قزمان:
وجردت فنّي من الإعراب
كما يجرد السيف من القراب
أي أن حركات الإعراب من رفع وضم وجرّ لا تدخل في صميم اهتمام الزجالين، وعليهم تجنبها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، وقد استعاضوا بالسكون عنها، يقول مدغليس:
والسما تنثرْ جواهرْ
فوق بساطْ من الزمردْ
وتجدر الإشارة إلى أن الزجل الأندلسي تضمن بعض الكلمات الأعجمية، ونحن لم نشر إلى ذلك من باب أنها قليلة، ثم لأن اللهجات الحديثة اليوم نصف كلماتها أجنبية .

