الرجل المغناطيسي
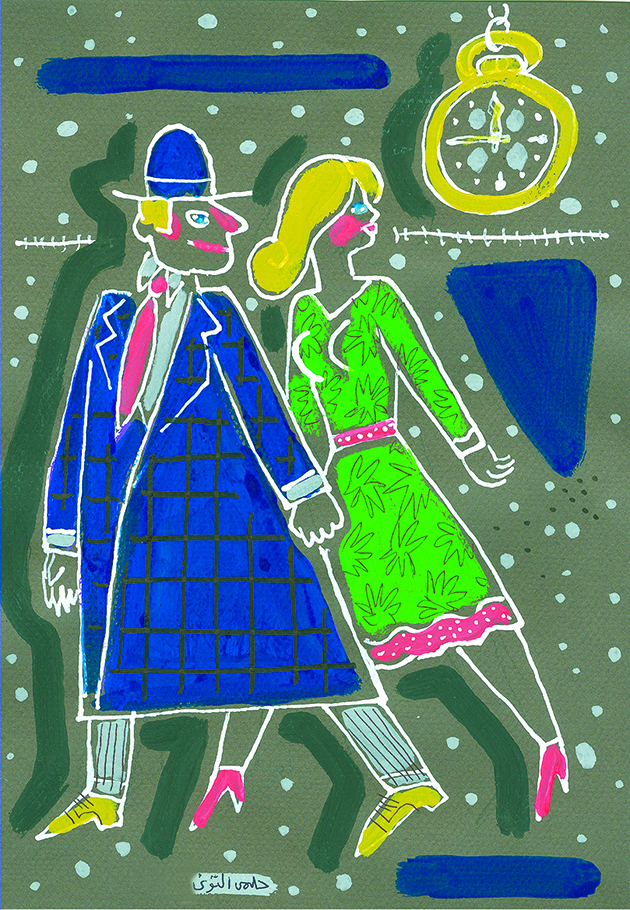
أن تتجمد في مواجهة مرآة، كأنك لقطة كاميرا فوتوغرافيا ثابتة، على رصيف محطة قطارات قديمة، هو آخر ما يتمناه مسافر، قضى وقتًا طويلاً من حياته في السفر، والتوقف أمام المرايا، في بيته وعمله، وفي محطات المترو والقطارات والمطارات، ودورات مياه الفنادق والمطاعم، يطمئن على أن جاذبيته التي اشتهر بها، لم تتركه وتغادره إلى رجل آخر.
كأنه تمثال، لكن حواسه تشتغل بكفاءة، حتى أنه انتبه لصوت امرأة غنوج، تضحك لرفيقيها الجالسين على مقعد حجري، وذلك الرجل العجوز الذي يمشي ببطء، المنعكسة صورته على المرآة.
يحرك قدمه، لا يستطيع، حتى أصابع يديه، التي توقفت عن الحركة، وهي تعدل من «الكرافت»، يا الله! حتى رموش عينيه، صار على رصيف المحطة تمثالًا أنيقًا، يمسك بشنطة سفر أنيقة، يمر به المسافرون ويتخطونه، دون الالتفات إليه، لعن اللحظة التي قرر فيها أن يتوقف أمامها، ليطمئن على أناقته قبل أن يأتي القطار الفخم.
سمع صفارة القطار القادم، وبدأ المسافرون على المحطة، يجهزون حقائبهم، لرحلة سفر طويلة، ولنا أن نتخيل الخجل الشديد الذي يشعر به رجل اشتهر بين أصدقائه بلقب «المغناطيسي»، لجاذبيته الشديدة.
هو دائم الكلام عنها، وكل ما حدث ببساطة ومن دون تعقيد، أن الرجل المغناطيسي من شدة وتطور حالته، التي وصفها بعض الغيورين - من وجهة نظره - بأنها حالة مرضية، قد مغنط نفسه، عندما وقف أمام المرآة، والشيء الثابت والمؤكد، ولا يحتاج إلى الخوض في نظريات علم النفس، أنه يقف الآن على رصيف المحطة، في مواجهة نفسه.
الأمر الآخر الذي يظهر لنا جليًّا، منذ أن نبدأ في لعبة تفكيك الموقف إلى عناصره الأوّلية، أن حل المشكلة الذي طرأ في ذهنه، ذلك الذهن الذي اشتهر بالذكاء، وقدرته الخارقة على حل المشكلات المعقدة، التي تواجهه في العمل، وفي بيته مع زوجته الكائن الهلامي، وطفليها اللذين ورثا الهلامية منها، يكمن في أن يقوم شخص بكسر المرآة فتختفي صورته، فيتوقف عن مغنطة نفسه، لكن لأنه لا يستطيع فعل ذلك، وليس بإمكانه أن يقترح هذه الفكرة على أحد من المسافرين، الذين يمرون به غير عابئين بثباته، أو غير منتبهين، لأن شفتيه لا تستطيعان الحركة والتكلّم، فكان عليه أن يبقى، حتى يأتي الشخص الذكي، الذي يفطن إلى الحل ويكسر المرآة.
توقف القطار، التقم حمولته من المسافرين، وعادت صفارته للعمل، معلنةً الانطلاق، وتاركة الرجل المجمد أمام المرآة، منتظرًا الشخص الذكي، الذي ينقذ المغناطيسي من ورطته المحرجة.
لماذا تجمد في هذه المحطة القديمة بالتحديد؟ سؤال مرق في ذهنه كأنه يسخر منه، لقد دخل كثيرًا من المحطات من قبل، وكل محطة يدخلها يشتبك مع مرآتها في حوار ينتهي بابتسامة رضا تملأ وجهه، ولماذا لم ينتبه المسافرون إليه؟ لقد مروا به كأنه غير موجود، ثم جاء السؤال الكارثة الذي سينسف كل الأسئلة السابقة، لماذا دخل محطة القطارات القديمة هذه؟ ومن أين أتى وإلى أين سيذهب، أي قطار كان سيستقله؟ لا يملك المتجمد أمام المرآة إجابات سريعة أو بطيئة، في هذه اللحظة رأى في المرآة كلبًا يشم حذاءه، ثم يلعقه.
رأى أن الموقف عبثي، بل شديد العبثية، إلى الحد الذي كان سيعجز «يونسكو» نفسه، أن يختلقه في أي مسرحية من عبثياته الشهيرة، ارتاح إلى فكرة أن ما يتعرض له، يمكن أن يسميه وهو مستقر اليقين، ما بعد العبثية، هنا فقط جاءت الفكرة، يالله... حاول أن يخبط كفه بدماغه كما يفعل كثير من المصريين، عندما تأتي إليهم الفكرة بغتة، لم يستطع، عاد إلى فكرته التي أشرقت في ذهنه، كما الخيط الأول من الشمس، الذي أنار ظلمة عقله، هذه قصة... يا الله! أنا أعيش داخل قصتي التي أكتبها، وأن كل ما يحدث مُختلق.
صفارة قطار قادم، تنبهه إلى الموقف ما بعد العبثي، الذي وجد نفسه فيه، يحاول الابتسام للكلب الذي يلعق حذاءه اللامع، لا يستطيع، يمعن النظر بصورته في المرآة، مركّزًا في لون الكرافت، الذي لا يتسق بشكل مثالي مع لون الجاكت، ثم قرر أنه، في انتظار الشخص الذكي الذي سيكسر المرأة كي يتحرر جسده، سيشغل نفسه بالتفكير بعمق، في مقالة عنوانها «ما بعد العبثية»، سيجعل من الجسد محور المقالة، بما أن أزمته الحالية تتمثل في جسده، الذي تجمّد في وضعية ثابتة تأبى الحركة، في مواجهة مرآة، في محطة قطارات قديمة، متماهيًا مع مقالات أخرى قرأها عمّا بعد الحداثة، وما بعد البنيوية، وما بعد التفكيكية .

