«الرواية والقيَم» استئناف البحث في أبعاد الرواية العربية
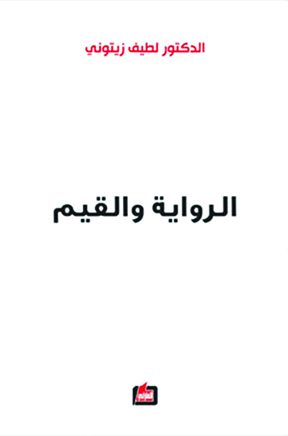
لا يزال الباحث والأكاديمي (الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت لطيف زيتوني) يواصل مسيرته البحثية في السرديات العربية، ويصدر كتبًا وأبحاثًا منذ أواسط التسعينيات من القرن الماضي.
صدرت لزيتوني الأعمال الآتية: الرواية العربية؛ البنية وتحولات السرد (2012)، معجم مصطلحات نقد الرواية (2002)، وسيمياء الرحلة (بالفرنسية، 1997)، وحركة الترجمة في عصر النهضة (1994)، بالإضافة الى عشرات الأبحاث في مجال السرديات كان قد توالى صدورها على صفحات المجلات العربية ذات الطابع الأكاديمي. أما الكتاب الأخير، وهو بعنوان «الرواية والقيَم» (2018) والصادر عن دار الفارابي، والذي سوف نعرض له في ما يأتي، فيمثّل وقفة تأملية لازمة في أحد أبعاد الرواية العربية الحديثة والمعاصرة، عنيتُ القيَم، بعيدًا عن الإشكاليات النامية إلى النوع أو الجنس الأدبي (الرواية) الجديد – نسبيًا – في عالمنا العربي، من مثل التبئير، ودرس الشخصيات، والحبكة القصصية، وأنواع الخطاب، وغيرها مما حفلت به الروايات العربية، منذ نشأتها أواخر القرن التاسع عشر ،على قولة البعض («وي إني لستُ بأجنبي» ،خليل الخوري)، وحتى أوائل القرن الواحد ولعشرين و صدور آخر رواية عربية في لبنان («في أثر غيمة «حسن داوود، 2017)، على سبيل المثال لا الحصر.
ولكن الكاتب لطيف زيتوني يعرف أن الدخول إلى هذا المعترك يلزمه مدخل ،وأنّ خير المداخل هو النظر في دور«الروائي المثقّف في الدفاع عن القيَم الإنسانية وفي الثورة على القيم المضادة معًا.. .
وبعد أن يؤكد زيتوني على دور الرواية المتعاظم في «التوعية على الواقع... وعلى المسائل الاجتماعية» وفي صلاحيتها لحمل «التوعية الثقافية» الشاملة إلى أكبر شرائح المجتمع، في مقابل محدودية العلوم العلمية وحصرية فائدتها التي تطاول الخاصة والعامة والمتعلمين على حدّ سواء، وفقًا لآخر الدراسات ينتقل إلى التوسع في الحديث عن المثقف، فيفرد الفصل الأول من كتابه (ص:13-79) للكلام على «تحولات المثقّف»، فيذكر زيتوني كيف تحوّل مفهوم المثقف، على يد «زولا» من أهل القلم الذين دافعوا عن الحقيقة في قضية ألفرد درايفوس، إلى جورج كليمنصو الذي كان له السبق في إطلاق صفة «المثقفين» على كل من كان يدافع عن قضية معينة ويؤثر في الرأي العام، فيعزز بذلك الأمل بالمستقبل. ومن ثمّ ينتقل إلى التعريف الذي أداه جان بول سارتر في ربطه ما بين المثقف ووظيفته الاجتماعية بل السياسية بالمقام الأول.
ومن ثمّ تناول الكاتب رأي جوليان بندا (1927) في المثقفين على أنهم هم «كلّ الذين لا يسعون إلى تحقيق سعادتهم في ممارسة الفن أو العلم أو التأمّل». وما عتم أن عدّل تعريفه المثقفين بتعيين وظيفتهم في «الدفاع عن القيَم الموضوعية والثابتة» (1946). وفي ما بعد، أفرد الكاتب زيتوني مكانا للحديث عن «المثقف العضوي» لدى المفكّر الإيطالي اليساري الماركسي أنطونيو غرامشي، فاعتبر الأخير، بحسب زيتوني، أنّ «كلّ فئة اجتماعية ناشئة من... بنية اقتصادية سابقة، تجد نفسها محتاجة إلى مثقفين يضمنون تماسكها ويرسخون وعيها لوظيفتها» (ص:25) بيد أن الكاتب لا يلبث أن ينمي التعريفات التي سبق له أن ساقهاعلى لسان المفكرين المذكورين، فيتوقف لدى تعريف الكاتب الوجودي سارترللمثقفين والذي يعتبر فيه أن هؤلاء هم المتعلمون الذين، وإن أوتوا المعرفة العلمية بفضل الطبقة البورجوازية وصاروا اختصاصيي معرفة فإنهم يعملون في خدمة المعرفة العامة التي تناقض خصوصية هذه الطبقة (ص:31).
وبعد أن يعرّج على تصوّر المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد للمثقف العام الذي يحرص على معياري الحرية والعدالة ويواجه كلّ من يتعمد خرقهما بكل شجاعة، ينتقل إلى تعريف الفيلسوف ميشال فوكو للمثقف الخاص، الذي يؤهله علمه أن يتولّى مهام في المؤسسات العامة، «ويتمرّد على المؤسسة كلما اصطدمت بالحقيقة» (ص:41).
ولا يكتفي الكاتب زيتوني، من دراسته المعمقة والشاملة لمفهوم المثقف كما وردت لدى المفكرين والفلاسفة الغربيين، إنما تراه يعرض، على نحو بانورامي، لتصورات المفكرين العرب المعاصرين، علمانيين وإسلاميين، لمفهوم المثقّف (الجابري، أركون، نصر حامد أبوزيد، العلاّم) ليخلص إلى أنّ على المثقف المتعلّم أن «يلتزم بالمثُل الإنسانية العليا» (ص: 73)، ويؤدي أدوارًا عملية من مثل الكشف عن «زيف البورجوازية المتسترة بالمبادئ العقلانية» (ص:78)، ومحاربة الفساد والسهر على «إعلاء صوت الحقيقة واحترام قيم الحق والعدالة والحرية والتقدم...» (ص:79).
ولكنّ قارئ هذه الدراسة المعمقة عن المثقف، شأني، لا يسعه إلا أن يطرح أسئلة تطاول المسلّمة التي انطلق منها الكاتب زيتوني، وهو اعتباره كاتب الرواية مثقفًا، وملتزمًا – بالضرورة – قضايا مجتمعه ومدافعًا عن قيَم الحق والعدالة والحرية، التي سبق لنا الحديث عنها، من مثل: هل يدرك كلّ كاتب رواية أنه مثقّف، كامل الأوصاف ؟ ثمّ هل يعتبر كلّ روائي نفسه ملتزمًا الدفاع عن القيَم والمثُل الإنسانية الكبرى، في رواياته؟ ولئن صحّ هذا التوصيف على بعض من الروائيين – وههنا نخصّ بالذكر العربَ – فماذا نقول عمّن قصد إلى التملّص من الالتزام، بل التمرّد عليه باسم الفردانية يتصدّى بها للرؤية السياسية الجماعية (الاشتراكية، العروبية،الإسلامية...إلخ) التي سادت الكتابات الروائية في ظهرانيهم؟ ولنا مثال على ذلك نوع من الأعمال الروائية صادر عن لبنانيين، جلّ قضاياهم محصور في هوية الفرد وانفصاله الحاد عن محيطه وإطاره العائلي («ليرننغ إنغلش» لرشيد الضعيف، مثلا). وفي التصدّي لمسائل فلسفية ذاتية، كاستحالة الفرد استعادة لحظات الحب أو استحضار الحبيب عبر الزمن («نقّل فؤادك»، 2015، و«في أثر غيمة»، 2017، لحسن داوود)، وفي الرفض الصارخ لكلّ زمن الالتزام (اليساري والإسلامي، والجماعي العام) من وجهة نظر فردانية ومزاجية حادّة (نساء بلا أثر، لمحمد أبي سمرا، 2017). أم نعتبر أنّ هذه النزعات الفردية تمثيلٌ لقيمة الحرّية التي باتت عملة نادرة في مجتمعاتنا العربية الميّالة إلى التوتاليتارية أو التيوقراطية؟ أم ندع خانة للمثقف غير الملتزم والذي لا يرى لزاما استثمار روايته في غير رؤيته الفنية وعالمه، كما هي الحال في «الاتجاه الثالث الذي تنأى فيه الرواية عن أي دور – سياسي أو اجتماعي – غير دور الفن..» (ص:167)؟
ولكن مهما يكن من أمر الروائيين العرب المتمرّدين على وظيفة صنيعهم الأدبي (الرواية) الاجتماعية، والذين يحتاجون إلى دراسة متأنية، فإنّ الكاتب لطيف زيتوني يواصل بسط نظريته في القيم المحمولة عبر الرواية، فيخصّ الفصل الثاني (ص:81-135) «بالدفاع عن القيَم الإيجابية»، والفصل الثالث بالكلام على «الثورة على القيَم المضادة» (ص:137-226). في الفصل الثاني، يجري الباحث زيتوني فصلا بين القيَم والأخلاق؛ فيعتبر أنّ الأولى «أفكار عامة ضرورية لوجودنا وتطورنا، ومنها ما يرتبط بالصواب والخطأ ومنها ما يشعرنا بالخجل والفخر...» (ص:89). أما الثانية، أي الأخلاق فهي مجموعة من المعايير والسلوك والطقوس متعارف عليها في مجتمع معيّن دون آخر . وبعد أن يبيّن أن غالبية الروايات تحمل في ثناياها قيمًا إنسانية، من مثل المال والصداقة والحب، والحذر والعدالة، والقوة، والاعتدال وغيرها، يذكر أنّ الأخلاق، في المجتمعات غير المتقدمة كمجتمعاتنا العربية، لا تزال تشكّل، منذ أوائل الخمسينيات حائلا دون المس ببعض المعتقدات غير السليمة؛ ولنا أمثلة على ذلك في روايات «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ، و«الشميسيى» لتركي الحمد، و«مدن الملح» لعبدالرحمن منيف، و«سفينة حنان إلى القمر» لليلى بعلبكي.
ولكنّ الدرس المستفاد من هذا الفصل (الثاني) ليس اتضاح الفروق بين القيم والأخلاق فحسب، وليس تقرير الباحث زيتوني بقدرة الرواية المتقنة على حمل القيَم الإيجابية فقط، بل إثباته المبنيّ على محاجّة مفحمة بأنّ الرواية عمل تربوي بامتياز أيضا، وبأنها تخدم تنمية موسوعية القارئ، بحسب أومبرتو إيكو، أيا يكن وفي أي مجال يعمل، وبأنها تنمّي معرفته العالم الذي ينتمي إليه، وبأقلّ الطرائق قسرًا.
أما الدرس المستفاد من الفصل الثالث، وعنوانه «الثورة على القيم المضادة» فهو أنّ التزام الأدب، والرواية بالأخص، بقضايا الإنسان والمجتمع أمر لا جدال فيه، وإن تعددت أنواع الروايات (الرواية الطريحة، والرواية الملتزمة)، وتبدّلت فيها الأقنعة (الحيوان، المجنون، الزمن، المكان، والاسم المستعار. وأنّ الالتزام بالقيم الإنسانية – عبر الرواية هذه الوسيطة المثالية – كفيل، بحسب زيتوني، بأن «يحمي البشرية من شريعة القوة» (ص:222) إلا أن ملاحظة جديرة بأن تذكر وهي أنّ الثقل والعمق النظريين اللذين اتّسمت بهما الدراسة بشكل عام، والفصلين الثاني والثالث بخاصة، لم ترفدهما أمثلة كافية، مستمدة من روايات عربية قديمة وحديثة، تيسيرًا للفهم وترسيخًا للإثبات.
يبقى أن يُخضع قرّاء هذا البحث المستفيض، للكاتب والأكاديمي لطيف زيتوني، للمزيد من التفحص والتدقيق، وبين أيديهم و في أذهانهم الروايات العربية المعاصرة التي يتوالى صدورها هذه الأيام، بكثرة لافتة .


