مذكّرات رجل مجهول
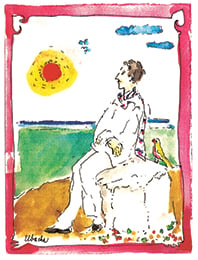
هذا عنوان لافت للانتباه. ولا شك في أنه يؤدي نوعًا من المُفارقة في سياقه، أعنى تركيبًا لغويًّا ظاهره يُخالف باطنه، فالحديث عن رجلٍ مجهولٍ - بعد إرجاع المجاز إلى حقيقته - يقود إلى دلالة غير المراد من ظاهره؛ فهو ليس حديثًا عن رجل مجهول بقدر ما هو حديث عن رجل معلوم، لكنّ اللجوء إلى المفارقة التي تُظهر غير ما تُبطن، هو نوع من الحيلة التي يُريد بها الشاعر صلاح عبدالصبور أن يُنطق المسكوت عنه من الكلام العادي، وأن يتكلم من خلال قناع المفرد إلى صيغة الجمع. أعني يرد المُفرد الشاعر إلى الجمع الذي يمكن أن يكون أي إنسان، وهذا هو مصدر المفارقة وسببها في آن.
لكنّ الحديث عن ارجل مجهولب يمكن أن يكون مفيدًا، فالتجهيل يُمكن أن يكون نوعًا من الحيلة البلاغية التي تعني أي إنسان، والتي تعني قانون الاحتمال والضرورة، كما يقول أرسطو في كتابه افن الشعرب. ولذلك يبدأ الشاعر مذكرات ذلك الرجل المجهول على النحو التالي:
أصحو أحيانًا لا أدري لي اسمًا
أو وطنًا، أو أهلًا
أتمهّلُ في باب الحجرة حتى يدركني وجداني
فيثيب إليّ بداهة عرفاني
متمهلة في رأسي، تهوي في أطرافي ثِقلًا
تُلقِي مرساها في قلبي...
هذا يوم مكرور من أيامي
يوم مكرور من أيام العالم
تلقيني فيه أبواب في أبواب
ويغللني عرقي ثوبًا نسجته الشمس الملتهبة
وأعود إلى بيتي مقهورًا
لا أدري لِي اسمًا
أو وطنًا
أو أهلًا
والمقطع دال على مدلولاته، رغم مُراوغاتها، فالكائن الذي يتحدث والذي لا نعرفه يقدّم لنا نفسه تقديمًا دراميًّا، أشبه بمنولوج يقدّم به البطل نفسه في مسرحية من المسرحيات التي تدور حول كائن لا يَعِي الغاية أو العِلّة، أو الهدف الأسمى والأسنى من وجوده على هذه الأرض، ولذلك فهو يصحو أحيانًا غائبًا عن كل شيء، مُغيبًا عن كل شيء، كما لو كان يستيقظ من إغماءة طويلة أو قصيرة، لكن تعقبها إفاقة فلا يدري بعد صحوته المُفاجِئة اسمه أو وطنه أو أهله، فيظل في حالة بينية تتوسط ما بين اليقظة والنوم، أو الوعي واللاوعي، أو الحضور والغياب إذا أردنا الدقة، فهو لا يُدرك لنفسه اسمًا أو وطنًا أو أهلًا في هذه المرحلة التي يُسقِط الغياب فيها ظِلَّه على أول الحضور.
يوم مكرور
وما إن يتمهل قليلًا ويسير بعض الخطوات حتى يسترجع وعيه كاملًا، ويُفيق من ضياعه أو يسترجع حضوره من غيابه، حتى تتداعى على وعيه معاني الأشياء ومعارفها مُتمهلة، متأنية كي يستوعبها تدريجيًّا بما يتناسب مع حاله المعرفية التي لم يفارقها حال الغياب تمامًا.
وعندما يعود إليه الوعي يكتشف أن اليوم الذي هو فيه، هو يوم لا يفترق عن سابقه، ولن يختلف عن لاحقه، فهو يوم مكرور من أيام العالم، تخرج الذات التي تتحدث فيه من باب إلى باب كأنها - وكأننا معها - نسير في ممر طويل بلا نهاية، ندخل كي نخرج من باب يُسلمنا إلى باب غيره، والباب الذي يلقانا يسلمنا إلى غيره. وهكذا إلى ما لا نهاية، وذلك في وضعٍ أشبه بوضع سيزيف في الأسطورة الوجودية، الذي حكمت عليه الآلهة الوثنية لليونان القديمة بأن يحمل حجرًا ضخمًا من أدنى السفح إلى أعلى القمة، كي يعاود الحجر الضخم سقوطه، ثم يعود سيزيف ليحمله إلى الأعلى، مُكرِّرًا الفعل العبثي نفسه إلى ما لا نهاية، كأنه هذا الرجل المجهول الذي تُلقيه الأقدار من باب إلى باب، إلى أن يتفصد منه العرق الناتج عن الجهد ووقدة الشمس الملتهبة، فلا يدرك الغاية ولا ينتهي ما يفعله، فيدخل تدريجيًّا مرة أخرى في حال من الغياب، تاركًا وراءه حال الحضور أو الوعي، ومن ثم يعود إلى بيته بالخيبة والضياع، وفي حال كاملة من غياب الوعي أو الذاكرة، فلا يعرف له اسمًا، أو وطنًا، أو أهلًا.
مسرحية بلا معنى
هكذا ينتهي المقطع الأول الذي يشبه الفصل الأول في مسرحية لا نعرف معانيها من أول فصولها، بل ننوس فيما نراه ما بين حالي الصحو والغيب، حتى ينتهي المقطع، لكن قبل أن ينتهي نشعر بنوع من التعاطف الذي يدني بنا إلى حال من الاتحاد مع الذات التي تتحدث على خشبة المسرح، أو في مفتتح القصيدة، فنغدو إياها كما تغدو هي إيّانا. هكذا ندخل في المقطع الثاني من القصيدة، حيث نقرأ:
هذا يوم تافه
مزقناه إربًا إربا
ورميناه للساعات
هذا يوم كاذب
قابلنا فيه بضعة أخبارٍ أشتاتٍ لُقطاءْ
فأعنّاها بالمأوى والأقوات
وولدنا فيه كذبًا شخصيًّا،
نمَّيناه حتى أضحى
أخبارًا تعدو في الطرقات
هذا يوم خوّان
سألونا قبل الصبح عن الحق الضائع
فنكرناه وجحدناه
وتمسَّينا في الحانات
ودفعنا أجرة رشوتنا، ثمن فطانتنا الصفراء
بين ضجيج الكاسات
هذا يوم بِعناه للموت اليومي
بحياة زائفة صلدة
وفرحنا أنّا ساومناه
وخدعناه، ومكسناه
ما أحسن أنّا علَّقنا هذا اليوم الغارب...
في منحدر الشمس
فهوت ببقاياه
وفي هذا المقطع الثاني نكون قد بعدنا عن الاستهلال أو التعريف بالذات الشعرية التي تقدّم نفسها، وندخل في أول أيامها فلا نجد شيئًا ما ذا قيمة في هذا اليوم الذي يمرّ بلا إنجاز أو فعل إيجابي أو حتى حياة، فهو يوم حياة كالموت، أو يوم ميت يشبه أيام الحياة السلبية، وهذا هو المعنى الذي يسلب من هذا اليوم كل ما فيه من إيجاب يرتبط بالحياة ليكدّس فيه كل السلبيات التي تردُّ الحضور إلى الغياب وتجعل الحياة أشبه بالموت، فتُرينا الموتى الأحياء، أو الأحياء الموتى الذين تحدَّث عنهم الشاعر في قصيدة أخرى من قصائده.
ولذلك فهو يوم خالٍ من القيمة، بلا إنجاز، لا يستحق أن يُذكر أو نتحدث في صفحته عن أي فعل خلّاق، ومن ثم فهو يوم تافه لا يستحق سوى أن نرميه من أيام حياتنا وننساه.
لكن هذا اليوم - فوق تفاهته - هو يوم كاذب نتلقى فيه من الأخبار الكاذبة ما يجعلنا نتفاعل معها، متوهّمين أنها حقائق، فنُسهم في أكاذيبها، ونضيف إليها من الكذب ما نصدقه وما نسعى إلى أن نقنع الآخرين به، فيتحول ما أسهمنا في صُنعه من أكاذيب وأوهام وأباطيل إلى ما يُشبه الحقائق التي تعدو في الطرقات، مخايلة، متخايلة، توهم الآخرين أنها حقائق، رغم ما نعرفه نحن الذين أسهمنا في صنعها، من أنها أكاذيب ينبغي ألا يصدقها العقل.
حيوات زائفة
ويزداد الأمر مأساوية حين نَقبل ما يبيعه لنا الآخرون من أكاذيب وأباطيل هي نفسها التي أسهمنا في صنعها، فنكاد نَتقبَّلها بين ضجيج الكلمات، أو بريق التخييلات، فلا يبقى لنا سوى إدراك الحقيقة التي تقول إننا اشترينا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتنا، وبِعنا الحياة للموت، فلم نربح سوى حيوات زائفة صلدة، عندما لم يبقَ أمامنا سوى النهاية، أو الموت الذي حاولنا التحايل عليه وتصوّرنا أننا خدعناه، لكن - والحق يقال - لم نخدع سوى أنفسنا، ولم نفعل سوى أننا راقبنا انتهاء اليوم الغارب من حياتنا في منحدر شمس الغروب، أو نهاية الحياة التي نعيشها، فهوت بقية هذه الحياة بما تبقَّى منها في هوة العدم أو الموت. وكانت النتيجة أننا هبطنا في الأرض كجثامين الموتى حين يدفنون بكل أكاذيبهم في باطن الأرض، فلا تكون النتيجة غير أن الأرض نفسها تتلوث بكل ما جلبه إليها البشر من الموتى الأحياء أو الأحياء الموتى. هكذا ينتهي المقطع الثاني لندخل إلى الثالث، حيث نقرأ:
الأرض بغيّ طامث
لا يُطهرها حمل أو غُسل
مَن ضاجعها ملعون
الأبنية المرصوصة في وجه المارين سجون
سجّانوها الحيطان وقرب الإنسان من الإنسان
سجنًا أبديًّا... يا مسجون
والأيام الأشراك
من تحت مُلاءتها أخفتها عنا مائدة الإفطار
في الشارع غطَّتها أوراق الأشجار
علبُ التبغ المُلقاة، وأوراق الصُّحف الممزوقة
والبسمةُ في عين الجار
فاسقط يا مطعون
في هذا المقطع ترتفع القصيدة إلى ذروة من ذُراها. وهي ذروة تكشف عن علاقة الحاضر بالماضي أو علاقة الشاعر بتراثه، خصوصًا أننا نرى في هذا المقطع كيف يستفيد عبدالصبور من جده الحكيم الشاعر أبي العلاء المعري، ويأخذ عنه بعض صفات السلب التي يناقلها أبو العلاء بين المرأة والأرض، لكن عبدالصبور يُسرف في هجاء الأرض، كما لو كان يسرف في هجاء الوجود الذي يراه وجودًا محكومًا بالعدم.
شراك متربصة
لذلك تبدأ القصيدة بهذه الصورة التشبيهية التي تجعل من الأرض بغيًّا أو عاهرة، لكنها ليست عاهرة عادية، وإنما عاهرة ملعونة تُبيح نفسها للآخرين وهي طامث مُدماة لا يردعها دم حيضها عن غواية من يقع في شِراكها، فهي أرض ملعونة لا يطهّرها ماء أو غُسل، فضلًا عن أن الحمل الذي إن حدث - على سبيل المصادفة - فهو حمل ملعون لا حياة له ولا أمل فيه.
وعندما يهبط الشاعر من هذا المعنى الكلّي للكرة الأرضية إلى العناصر الصغيرة الموجودة على كل أسطح من أبنية أو بشر أو أيام أو فصول، انسربت اللعنة من الأرض الأم الأسطورية إلى الأبنية التي تتراص أمام البشر كأنها سجون، سُجّانها الحيطان والجدران والأعمدة الخرسانية التي تسند الجدران أو الأسقف، ولذلك لا توجد علاقة حقيقية حية بين إنسان وإنسان، فالبشر يعيش كل واحد منهم في عزلة يفصله عن غيره جدار كأنه جدار سجن.
أما الأيام فينسرب إليها هذا المعنى السلبي، ولكن يُحيلها لي شراك يقع في خيوطها الكائن التائه بلا معنى. هذه الأيام االأشراكب (جمع شَرَك) تتربص بنا في الشارع، تُخادعنا عنها أوراق الأشجار، أو علب التبغ الملقاة، أو أوراق الصحف الممزُوقَة، أو البسمة في عين الجار، كلها شِراك تتربص بنا كما لو كانت متأهّبة لتوقعنا في حبائلها، فلا نملك إلا السقوط في حبائلها ملعونين منطوين على الخطأ الجذري الذي ارتكبناه عندما أحببنا هذه الأرض وأصبحنا من صُلبها.
وبهذه النظرة التشاؤمية التي تجعل من الحضور في الوجود - مجرد الحضور- مأساة قاتلة تُسقِط أي معنى من معاني القيمة أو الحرية أو الأمل في النجاة ينتهي المقطع الثالث، ليبدأ الرابع؛ حيث نقرأ:
الحمد لنعمته من أعطانا هذا الليل
صمتُ الأشياء وسادتنا
والظلمة فوق مناكبنا
ستر وغطاء
الحمد لنعمته من أعطانا الوحدة
لنعود إليها حين يموت اليوم الغارب
ونلمّ الأشلاء
الحمد لنعمته من أعطانا ألا نختار
رسم الأقدار
فلو اخترنا لاخترنا أخطاء أكبر
وحياة أقسى وأمرّ
وقتلنا أنفسنا ندمًا
ثمن الحرية... ما دُمنا أحرار
إشارة إيجابية
هذا المقطع نتيجة مُترتبة على المقطع السابق، ولذلك يبدأ كله بعبارة تتكرر، والتكرار سمة بلاغية أساسية في شعر عبدالصبور، والبداية هي االحمد لنعمته من أعطانا هذا الليلب، والإشارة الإيجابية إلى الليل في هذا السياق هي إشارة إلى كل ما يستر ويخفي، فلا يُتيح للعين أن ترى ما اختبأ فيه أو استتر عنها، فرارًا من الانفضاح والانكشاف، ولذلك فالليل هو نعمة لمن أراد الاختفاء أو آثر المُضيّ في الغياب، فهو مريح كالصمت الذي يمكن أن يكون وسادةَ الهاربين من ضوء النهار، تمامًا كما أن الظلام ستر وغطاء لكل الهاربين من عار الوجود وسلبياته، وعندما يتكرر االحمدب يأتي معنى الوحدة التي تجمعنا في أول الضوء، والتي تفرِّقنا مع وقدة الوعي بالحضور اليومي الذي يحيل الحياة إلى غابة، والأحياء إلى حيوانات.
وعندما يغرب الضوء وتأتي الظلمة لا تتبقى من وحدة الإنسان أو الإنسانية إلا الأشلاء، ثم يأتي الحمد الأخير على أن الله خَلقنا مُجبرين لا مُسيّرين، لا نملك قدرة الاختيار على رسم الأقدار، فلو كان الله قد منحنا هذه القدرة لاخترنا أخطاء أكبر من أخطائنا وحياة أقسى عنفًا وأمرّ طعمًا من حياتنا، وقتلنا أنفسنا ندمًا على ما فعلنا.
فللحرية ثمن أبهظ من أن ندفعه ما دمنا أحرارًا، ولذلك رحمنا الله من أن نملك الخيار في حياتنا أو وجودنا؛ لأنه أعرف بنا وأقدر على ترويض جرثومة الفساد التي ينطوي عليها خَلقُنا.
والحق أن هذه الحرية التي يتحدث عنها عبدالصبور، هي جنة الإنسان المُشتهاة وجحيمه المغوِي في نهاية الأمر، فهي تدفعنا إلى الهلاك عندما نستجيب إلى الجانب الغرائزي في ضعفنا البشري، وتدفعنا إلى النعيم إذا استجبنا إلى النسيج الملائكي الذي يتخلل عقولنا لنسيطر به على غرائزنا ونزواتنا الحيوانية. وعندما نختار العقل فإننا نُغلِّب الحرية على الضرورة، فنؤثِر تمام الحضور في الوجود على نقصان الغياب في العدم، وهكذا ننتقل إلى المقطع الخامس؛ حيث نقرأ:
يا هذا المفتون البسّام الداعي للبسمات
نبّئني، ماذا أفعل؟
فأنا أتوسل بك
هل أغمس عيني في قمر الليل؟
أم أقتاتُ الأعشاب المُرّة والورقا؟
أم أفتح بابي للأشباح
وأدعوها، وأُطاعِمها
وأقدّمها للألواح الممدودة حول خواني
وأقوم خطيبًا فيهم...
أحبابي... إخواني؟
أم أبكي حين يجن الليل،
وأغفو دمعي في فودي
أم أضحك في مرآتي وحدي
إن كنتَ حكيمًا نبئني كيف أُجّن
لأحسّ بنبض الكون المجنون؟
لا أطلب عندئذ فيه العقل
وردة الصقيع
يبدأ المقطع الخامس بالحديث إلى شخص من الأشخاص، أو كائن من كائنات الحياة، أو إنسان عادي من البشر، لكنّ هذا الإنسان يعيش الحياة كما يتلقاها، ولا يشغل عقله بمراميها وأهدافها أو غاياتها العُليا، فحسبه من الحياة أن ينعم بما فيها، وأن يهنأ بخيرها وينأى عن كل ما يرى من شرورها. شعاره الأمن والأمان، والاستجابة إلى كل ما يطلب منه، أيًّا كان الطالب والمطلوب، فالحياة سهلة هيّنة لهذا النوع من الكائنات، ولذلك فهو دائم الابتسام، ساخر من كل هؤلاء الذين يُعقِّدون الحياة ويشغلون أنفسهم فيما وراءها، أو مغزاها أو معناها، كما يفعل كل باحث عن الحقيقة المطلقة، أو كل ساعٍ وراء اوردة الصقيعب، ولذلك فهو ينظر إلى المهموم بكل ما في الوجود من أسرار نظرة باسمة هازئة، داعيًا إياه إلى أن يهوِّن على نفسه، ويأخذ الحياة ببساطة ويُسر بلا تعقيد، فالحياة أبسط من أن نُعقّدها بكل هذه الأسئلة المهولة، وأجدر بأن نحياها دون تفكير أو إجهاد للعقل والقلب معًا.
وهذا نوع من البشر يمثّل النقيض المكروه للذات الشعرية في هذه القصيدة. أعني الذات التي ينطوي عليها صاحب المذكرات الذي لا يطيق مثل هذا النوع من البشر، فيراه مفتونًا بجهله، بسّامًا ساذجًا، داعيًا للبسمات الساذجة، نائيًا عن كل إشكالٍ من الإشكالات التي تواجهنا بها الحياة، ولذلك يطرح علينا االرجل المجهولب أسئلته الاستنكارية، طالبًا الإجابة عن هواجسه التي تؤرّقه فعلًا، والتي لا يدري عنها هذا االمفتون البسّام الداعي للبسماتب شيئًا، طالبًا منه أن يضع نفسه موضعه، وأن يُجيب عن الأسئلة الحائرة التي تؤرّقه؛ لأنه في حقيقة الأمر حائر لا يعرف هل يعيش حياته في بساطة ساذجة لا تسمح لعقله أن يجتهد في الفهم، أو أن يعرف علّة الوجود، أو ماذا نفعل في هذه الحياة؟ وكيف نتوصل إلى معنى لهذه الحياة؟، وسبب وجودنا فيها؟ وماذا ينبغي أن نفعل مع كل ظلم يقع علينا أو على غيرنا؟ هل نتباعد عن ذلك كله ونتجاهله كما لو كنا لا علاقة لنا بما يحدث حولنا، فنكتفى بالتأمل في جمال قمر الليل، أو بمديح النسيم المتموج على صفحات النهر؟ أم نفعل العكس فنواجه ما يؤرّقنا حقيقة في هذه الحياة، ونفتح الأبواب لأسلافنا الذين عانوا مثلنا وكتبوا معاناتهم على الأوراق قبلنا، هل يكفي هذا؟ أم نهرب من كل هذه الأسئلة الحائرة، ونكتفي بعجزنا أو سلبنا عن الإسهام في شيء إيجابي، أم أن نضحك وحدنا ساخرين من عجزنا وقصورنا ويأسنا من إنجاز أي شيء إيجابي؟ ويصل المقطع إلى ذروته في الأبيات الأخيرة:
إن كنتَ حكيمَا نبئني كيف أُجّن
لأحسّ بنبض الكون المجنون
لا أطلب عندئذ فيه العقل
حياة جادة
الأبيات حادة الإيقاع يدعمها في ذلك النبض السريع في أسباب وأوتاد بحر المُتدارك التي تتدافع لتصل بالمعنى إلى ذروته التي تفرض إجابة. ولكن من قال إن المسؤول أعلم من السائل؟! إنه لا يملك إجابة؛ لأنه لم يطرح على نفسه هذا السؤال أصلًا، ولماذا يطرح على نفسه مثل هذا السؤال، وهو بسّام داعٍ للبسمات؟، إنه إنسان بسيط يتلقى الحياة كما تأتي إليه، ويعيشها كما يرى الناس تعيشها من حوله، ولو أجاب بصدق لقال للسائل: ولماذا لا تعيش الحياة كما يعيشها كل من حولك؟! لكن مأساة الرجل المجهول االتي هي مأساتناب، أنه لا يمكن أن يعيش الحياة بمنطق البسام الداعي للبسمات، فالحياة أكثر جدية من أن نأخذها بهذا المنطق الساذج، ولا حتى أن نتقبَّلها على عِلّاتها، فنحن لم نُخلق عبثًا، وعقلنا يصرخ فينا باحثًا عن أجوبة مقنعة لنا أولًا. ولأننا لا نجد إجابة عن كل ما نطرحه من أسئلة جادة، ولأننا لا نجد إجابات مقنعة عن هذه الأسئلة، فإن النتيجة هي التي يتوصل إليها الرجل المجهول في آخر القصيدة، حيث نقرأ:
ها قد سلّمت لكم... قد سلمت
ضاعت بسماتي
لم تنفعني فلسفتي
سلمت
كُسِرت راياتي
عَجَزَتْ عن عوني معرفتي
سلمت
وشجاعًا كنتُ لكي أنضو
عن نفسي ثوب الزهر المزعوم
وشجاعًا كنتُ لكي أتهاوى عُريانًا
أثني ساقي، أستصرِخُكم...
هل تدعوني وحدي؟
وكفاكم أني سلّمت
أم تضعوني في لَحدي؟
...........
كونكم مشؤوم
كونكم مشؤوم
رؤية مأساوية
إجابة الشاعر تعود إلى الرؤية المأساوية، حيث يتجلى إحساس الإنسان بالعجز عن أي فعل إيجابي في وجوده، سواء بالمعنى المحدود، أو بالمعنى الأوسع والعام. وذلك في كل مجال من مجالات الكون، خصوصًا حين ينغلق الكون أمام الإنسان على نحوٍ يؤدي إلى شعور مُمِض بالعجز أو الفشل كل الفشل في إيجاد ثغرة، فلا أمل ولا ثغرة ضوء ينفذ منها إلى مستقبل واعد، ولا يملك االرجل المجهولب سوى ختام فعل المسرحة الذي قام به في القصيدة كلها عبر فقراتها، فيُعلن عجزه وتكسر راياته، كما يُعلن أن كل ما يعرف لم يُساعده في الوصول إلى يقين أو حقيقة مقبولة، أو حضور إيجابي في الوجود.
فحضوره كالغياب، وغيابه كالحضور، ولذلك فإنه يُسلِّم بعجزه ويأسه الكامل، ولا يبقى له سوى أن يسأل من يستمعون إليه أن يتركوه في حاله، أو أن يضعوه في لَحدِه. ثم يأتي السطر اللاحق بمجموعة من النقاط المتجاورة التي تُشير إلى كلام مُضمر لم يُقَل، أو حتى إلى صمت له دلالة الكلام الذي يُقال بعد يأس. وبعد النقاط التي تمثّل السطر الصامت بلا كلام، يأتي التقرير الجازم كالضربة الإيقاعية الأخيرة في سيمفونية فكرية تختتم حركاتها الأخيرة بنغمة طويلة حزينة مكتومة الإيقاع تقول:
كونكم مشؤوم
كونكم مشؤوم
وللتكرار دلالته التي تُرجعنا إلى ترجيع دلالة االحمدب في المقطع الرابع. هكذا تنتهي القصيدة نهاية فُجائية حادة، قد لا تتباعد كثيرًا عن توقّعات القارئ، لكنها على الأقل تدفعه إلى نوع من الصدمة التي توقظ فيه رغبة طرح الأسئلة التي تتصل بعلاقتنا بالعالم المنظور وغير المنظور في مدى البحث عن حقيقة كليّة، موجودة أو غير موجودة، وعن أوضاع اجتماعية وسياسية قد تسمح للإنسان أو لا تسمح بطرح مثل هذه الأسئلة الوجودية المُحيِّرة التي لا إجابة يقينية عنها، فكل إجابة عنها تؤكد مأساة الإنسان في الوجود، أو مأساة الإنسان في كل وجود .

