التناص الأدبي في شِعر محمد الشهاوي قراءة في «تنويعات على وترِ الفجيعة»
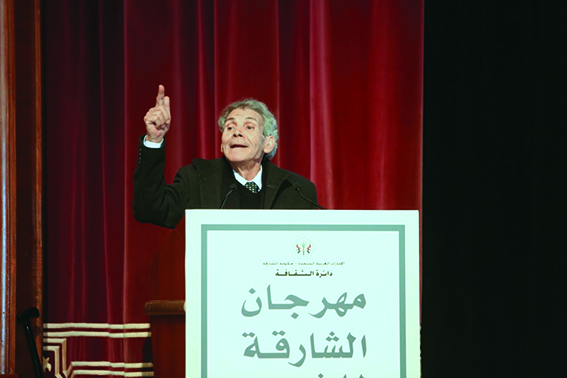
التناص الأدبي من الظواهر الأسلوبية التي طاب للشاعر العربي المعاصر أَنْ يتمثّلها في نصه؛ لأسباب فنية، ودلالية ولقد تمثّلت هذه الظاهرة في الشعر القديم على نطاق ضيق، وربما على أساس آخر، حين كان بعض الشعراء أحيانًا يضمِّن قصيدته بيتًا أو أكثر من قصيدة شاعر آخر.
كان هذا قليلاً ما يحدث، وكان الملحوظ فيه أنه دليل على «ظرف الإشارة» و«حسن الالتفات»، وما هو من هذا القبيل. وفي الوقت نفسه كان مجال التضمين مقصورًا على الشعر العربي وحده، فكان الشاعر عندئذٍ يستمد من التراث العربي وحده ما يضمنه قصيدته، ولم ينشغل الشاعر وقتها بأكثر من أن تستتب للقصيدة معياريتها، كان هذا يحدث، وظل يحدث بين الشعراء التقليديين حتى العصر الحديث.
وجد الشاعر المعاصر - الذي استقر في وعيه أنه ثمرة الماضي كله، بكل حضاراته، وأنه صوت وسط آلاف الأصوات التي لابد أن يحدث بين بعضها والبعض الآخر تآلف وتجاوب - في أصوات الآخرين تأكيدًا لصوته من جهة، وتأكيدًا لوحدة التجربة الإنسانية من جهة أخرى.
وهو حين يضمّن شعره كلامًا لآخرين بنصه فإنه يدل على التفاعل الأكيد بين أجزاء التاريخ الروحي والفكري للإنسانب، وتجلَّت مظاهر التناص الأدبي في شعر محمد الشهاوي في التناص مع الشعري والنثري، فتَنَاصَّ الشعري مع نظيره الشعري القديم والجديد، كما تَنَاصَّ مع النثري في الأمثال العربية، والأقوال والحكم المأثورة.
التناص مع الشعر
يعد النص عند الشهاوي عالمًا مفتوحًا على عوالم كثيرة من الشعري والنثري والديني، والتاريخي والأسطوري، ولا يمكن بحال أن نفصل بين جميعها أو بعضها في أثناء قراءتنا له، غير أن طبيعة الدراسة اقتضت التخصيص فيما يخص التناص الأدبي.
ومن قصائده التي احتملت كثيرًا من المرجعيات الأدبية التراثية والمعاصرة، قصيدته اتنويعاتٌ على وترِ الفجيعةب، حيث استدعى الشهاوي من أقوال الشعراء امرئ القيس، والنابغة الذبياني، والأخنس الجهني، وعنترة العبسي، والمتنبي، وأبي تمام، وعمران بن حطان، ثم هو يمزج هذا التراث بالمعاصر من أقوال شوقي، وعلي محمود طه، وإيليا أبي ماضي، بما يخدم النص ويجعل منه قطعة من الفسيفساء.
وفيما يلي سنعرض لهذا الاستدعاء وحجمه، وكيف تعامل معه الشاعر.
وقصيدته اتنويعات على وتر الفجيعةب هي حالة شعرية خاصة جدًّا، ربما لم يوجد هناك نص في الشعر العربي المعاصر بكل هذا الثراء، وهذا التقاطع، وتلك الحميمية، وهذا التلاحم، فقد أُوتي من كل ما تقدم بنصيب يشهد له بفرادته وتفرّده، وهو نص الحرب والفجيعة، والسطو والهزيمة، والفقد والضياع، هو نصٌّ يفسر الجديد بالقديم، والقديم بالجديد، ويربط بين الأحداث، ويجمع الشتات، محاولة منه للإحياء وبعث الآمال، ورغم ما يحمله النص من بكاء، وتهكّم، وسخرية، وأمشاج أقوال تشبه الهذيان؛ فهو من باب قول أبي نواس: اوداوني بالتي كانت هي الداءب يقول الشهاوي:
هي الحربُ جرحي الجديدُ القديمْ
وقومٌ يهونُ بأعينِهم كلُّ شيءٍ
سوى أَلَقِ الصولجانْ!
هي الحربُ عاري الذي لا يريمْ
وقرطبةٌ لم تزلْ تتزيَّا الهوانْ!
هي الحربُ والإخوةُ الفرقاءْ
ويستدعي من امرئ القيس مفتتح معلقته الشهيرة التي مطلعها:
قفا نبك، من ذكرى حبيبٍ، ومنزلِ
بسقط اللِّوى بين الدَّخول، فحوملِ
فيقول:
«قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ»
ولا تسقياني اليومَ كأسَ التعلُّلِ
هي الأرضُ أُنثى لم يصنْها رجالُها
ولم يدفعوا عنهـــا يدَ المتطــفَّلِ
ثمَّ يستدعي من المعلّقة ذاتها الشطر الأول من البيت السادس والأربعين:
ألا أيُّها الليلُ الطويلُ ألا انجلِ
بصبحٍ، وما الإصباح منكَ بأمثل
يقول الشهاوي:
«ألا أيُّها الليلُ الطويلُ ألا انجلِ»
ومزِّقْ بسيفِ الحقِّ كلَّ مضلِّلِ
وأظهرْ لعينِ الكونِ كلَّ خفيّةٍ
لعلّ - غدًا - ليلَ الأباطيلِ ينجلي!
استدعاء متعدد
ويستدعي مطلع معلّقة النابغة الذبياني، التي امتدح فيها عمرو بن الحارث الأصغر، بن الحارث الأعرج، بن الحارث الأكبر، بن أبي شمر، حين هرب إلى الشام ونزل به:
كليني لهمٍّ، يا أُميمةُ، ناصبِ
وليلٍ أُقاسيهِ، بطيءِ الكواكبِ
فيقول
«كليني لهمٍّ يا أميمةُ ناصبِ»
وعصرٌ أقاسيه كثير العجائبِ
كليني فإنّي قد بُلِيتُ بنكبةٍ
تذكَّرْتُ فيها اليوم كلَّ نوائبي!
وفي المقطع الثالث، عندما أراد أن يتحدث عن شهداء 1967م الذين خرجوا ولم يدلّ على حياتهم أو موتهم أحد، استدعى من التراث قصة المرأة التي خرجت تسأل عن زوجها، وكان قد قتله صاحبه من جهينة:
على كل دربٍ غرابٌ وبومةْ
ووشمٌ لدارٍ قديمةْ
وسائلةٌ:
أين زوجي؟
وسائلةٌ:
أين أهلي؟
وسائلةٌ:
هل لأولادنا من رجوعْ؟
ثمَّ يذهب إلى الوافر والقافية النونية المضمومة؛ ليختتم المقطع الثالث من القصيدة، ناسجًا على نول الجهني، يقول الشهاوي:
أراها تقطّع الأيام بحثًا
وما غيرُ الرمال لها سفينُ
تراودها المُنى طوْرًا، وطـوْرًا
تساورها الوساوسُ والظنونُ
ويتكئ الشهاوي على قول الأخنس الجهني:
تسائلُ عن حُصَيْنٍ كلَّ ركْبٍ
وعند جُهيْنَةَ الخبرُ اليقينُ!
فيقول:
كَصَخْرة إِذْ تُسائلُ فِي مَرَاحٍ
وأنْمَارٍ وعلمهُما ظُنُونُ
«تُسَائِلَ عن حُصَيْنٍ كُلَّ رَكْبٍ
وعنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبَرُ اليَقِينُ»
فيستدعي الشهاوي النص من سياقه الشعري، وزمانه، إلى سياق جديد وزمان جديد؛ ليصبح هناك أكثر من (صخرة)، تسائل عن فقيدها، وأكثر من (حصين) ضلَّ سبيله، أو قتل ولم يتم التعرف عليه، أو الوصول إلى جسده، كما أنَّ هناك أكثر من خيانة، بل وأعظم وأفدح!
استشراف القادم
ثمَّ يعود الشهاوي إلى بحره الأساسي (المتقارب) الذي نسج عليه نصه، ويفتتح المقطع الرابع باستشرافه للقادم، ولا يمر الموقف دون استدعاء جديد، فيتناص مع بيت المتنبي الشهير- في المعنى - عن العيد:
يا كوابيسُ أقضَّتْ مضجعي
منذُ عام الحزن، كيف النوم مَرَّةْ؟
أقبل العيدُ كئيبًا شائهًا
مثل أيامي الكوابي المكفهرَّةْ
من قول المتنبي:
عيدٌ بأيَّة حالٍ عدت يا عيدُ
بما مضى أم لأمرٍ فيك تجديد
ثمَّ يتعانق مع المعاصر، مشيرًا إلى أبي ماضي:
لا تقلْ لي يا أبا ماضي: ابتسمْ
وابكِ - إنْ شئتَ - معي همًّا وحسرةْ
أو فدعني وجراحي والأسى
فأنا شعبٌ أناخَ القهرُ ظهرَهْ!
ويتناص مع قصيدة علي محمود طه (فلسطين) ملتحمًا معها في الوزن والقافية، مُخَلِّصًا النص القديم من سياقه، وداعمًا لسياق جديد فيه ملامح التهكم. ليس التهكم لذات التهكم، وإنما للغصة والاحتقان والمرارة التي يعيشها الشعب والوطن العربي جرَّاء الهزائم، والتخاذل العربي:
أخي أيُّها العربيُّ الخليُّ
لتبكِ الكنيسةَ والمسجدَا
وأبلغْ (يسوعًا) بما قد دهانا
وأخبرْ بخيبتِنا (أحمدَا)
ويمتد التناص مع النص المعاصر (علي محمود طه)، إلى المقطع السادس، وقبل ذلك يربط بين حدثين: أحدهما سقوط الأندلس، والثاني سقوط سيناء، عروس الرمال:
ولكنَّني ــ يا أميرةَ حُبِّي،
ويا شهرَزادِ الليالي الطوالْ ــ
أقلِّبُ سِفْرَ انتكاساتِنا (منذُ أندلسِ الدمعِ
حتَّى
سقوطِ عروسِ الرمالْ)
ثمَّ يُشير إلى صوت عبدالوهاب وهو يغني قصيدة علي محمود طه:
وأخمشُ وجهي إذا مطربٌ أنشدا:
طلعنا عليهم طلوعَ المنونِ
فطاروا هباءً وصاروا سُدى
عودة إلى العباسي
ثم يعود إلى التراث الشعري العباسي، فيستدعي من قصيدة المتنبي التي كتبها في هجاء ابن كيغلغ لما طلب إليه أن يمدحه، فاعتذر، فضيّق الطريق عليه، وهي تتضمن مدحًا لأبي العشائر:
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعمُ
ومن البليّة عذْلُ من لا يرْعَوي
عن جهله وخطاب من لا يفهم
يقول الشهاوي:
«ذو العقل يشقي في النعيم بعقله
وأخو الجهالةِ في الشقاوةِ ينعمُ»
ومن الحماقة عذل من لا يرعوي
عن غيِّه، وخطاب من لا يفهمُ!
ثمَّ يمزج بين الشعري والحدث القرآني، فيستدعي من النص القرآني حكاية امرأة العزيز، وكيف أنَّ النسوة قطعن أيديهنَّ. والشهاوي يأخذ الحكاية، ويطوّعها لزمان النص الشعري، فيجعل هذا الزمان ممتدًّا ومستمرًا، بكل ما فيه من ظلم، وقبح وخيانة:
فأبصرُ وجهَكَ - يا زمنَ الأغنيات -
على صفحة الماءِ... أعجبُ
كيف تملّككَ الزَّهوُ يومًا؟
وكيف دعوتَ نساءَ المدينةِ
كيما تَراهُنَّ يَقْطَعْنَ أيْديَهُنَّ
وهُنَّ يشاهِدْنَ سحنتَكَ
الخادعةْ؟
ثمَّ هو يتناص مع قول شوقي، هازئًا من جراء الهزيمة:
وما نيل المطالب بالتمنِّي
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
فيقول
«وما نيل المطالب بالتمنِّي
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا»
وما نال الهزيمةَ غيرُ شعب
يرى في كل ناعقة صوابَا!
ويستدعي من معلّقة عنترة قوله، وهو من االكاملب:
يا دار عبلةَ بالجِواءِ تكلَّمِي
وعِمِي صَبَاحًا دَارَ عبلةَ واسْلَمِي
وقوله:
ولقد ذكرتُكِ والرماح نواهلٌ
مني، وبيض الهند تقطر من دمي
يقول الشهاوي، وهو يطوّع النص للحالة ذاتها، عازفًا على وتر الفجيعة، فيأتي شعره بين الحسرة، والألم، والاحتقان، والتهكم والسخرية، هي حالة الحزن التي تتخبط فيها أحوال النفس البشرية بين اليأس والأمل. تلك الحالة التي تستدعي كل مفردات الخيبة، وتدعو مواقف المدح، ثمَّ تحيلها إلى هجاء، وضجر وتهكّم:
يا دارَ عبلة (حيث كنتِ) تكلمي
وصِفِي لنا يومَ اللقاءِ الأسحمِ
لا تكتمي سرًّا، فما أضحى لنا
- يا دار- سرٌّ لم يُذع كي تكتمي
قلبي عليك وأنتِ في كفِّ اللظى
مسبيةٌ! وحِماكِ مطلولُ الدمِ
«ولقد ذكرتك والرماح نواهلٌ
منّي! وبيضُ الهند» تطحنُ أعظمي
ويستدعي الشهاوي قول عمران بن حطان، في هجاء الحجاج:
أَسَدٌ عَلَيَّ وَفِي الْحُرُوبِ نَعَامَـــةٌ
فَتْخَــــاءُ تَنْفُرُ مِنْ صَفِيـــرِ الصَّافرِ
فيقول:
«أسدٌ عليّ وفي الحـروب نعامةٌ»
يا ويحَ ويحِكَ كيف ذاك يكــونُ
يا أيُّها المُقْعِي عــلى أبوابنا
متحفِّزًا وبِكَفِّه السِّكينُ
أظَنَنْتَ أن حـدودنا انتقلت هنا
فأتيتَ تكفيها العِدَى وتَصُونُ؟
ويريد الشهاوي أن يرسل رسالة للقيادة فحواها: قدرت علينا ولم تقدر على أعدائنا، تركت الحدود الخارجية، وظننت أنَّ الحدود في الداخل، تركتهم يتربصون بنا وجئت تتلصص علينا.
ثُمَّ يستدعي من العصر العباسي من قصيدة أبي تمام، وهو يرثي محمد بن حُميد الطائي:
كذا فلْيجِلَّ الخطبُ ولْيفْدَحِ الأمرُ
فليسَ لعيْن لمْ يَفِضْ ماؤُها عُذْرُ
ثمَّ يبني الشهاوي على الوزن نفسه، لكنه يرثي وطنًا، ويبكي مجدًا:
«كذا فليجلّ الخطبُ وليفدح الأمْرُ»
ويجثمْ على أنفاسنا القاتُ والسُّكْرُ
كذا فلْتَصِرْ تلك البلادُ طريدةً
تُداهمُها الأمراضُ والجهلُ والفقْرُ
التناصّ مع النثر
ومثلما امتدت ثقافة الشهاوي إلى كل العصور الأدبية، واستوعبت قصيدته كثيرًا من النصوص الشعرية، ظهر هذا من خلال استدعاءاته لأقوال الشعراء من العصر الجاهلي حتى مطلع العصر الحديث مرورًا بالشعراء الأمويين والعباسيين والأندلسيين وغيرهم؛ فقد استدعى نصه الأقوال المأثورة، من الأمثال والحكم المشهورة، وسوف نتوقف عند المثل العربي القديم في قصيدة الشهاوي، بوصفه بنية ضمن بنى النص.
عُرف المثل عند العرب، ورُبَّما كانت جذوره الأُولى هناك، وجاء انظمًا ونثرًا، وأفضله أوجزه، وأحكمه أصدقهب، وقد اجتمع للمثل ما لم يجتمع لغيره من فنون القول، فهو منبثق عن واقعة أصلية حدثت في بداية الأمر، ثمَّ يتمثّله الشعراء والخطباء والحكماء في مواقف مشابهة لقصته الأولى.
وتعد بنية المثل بنية قائمة بذاتها مكتملة الأركان، فهي صياغة مختصرة لقصة قصيرة غالبًا، امتازت بشعرية عالية مستمدة في الأساس من الحدث. والمثل قبل وضعه في سياقه الشعري، لديه قرابة شعرية؛ لما يتمتع به من إيجازٍ، وأُسلوبية.
وكان للأمثال في شعر الشهاوي النصيب الأوفر، حيث صارت تمثّل بنية أسلوبية فيه، ومن الأمثال التي استدعاها هذا النص قولهم اأَجْبَنُ مِنْ نَعَامةٍب.
االنعامة: واحدة النَّعام... والنَّعامُ يوصف بالجُبْن كثيرًا. ويقال إنَّ النَّعامَةَ إذا خافت من موضع لا ترجع إليه أبدًا. وقال الشاعر في الحَجَّاج:
أَسَدٌ عَلَيَّ وَفِى الْحُرُوبِ نَعَامَـــةٌ
فَتْخَــــاءُ تَنْفُرُ مِنْ صَفِيـــرِ الصَّافرِ
وقد استدعى الشهاوي هذا المثل، مضمنًا الشطر الأول من البيت السابق لعمران بن حطان:
يعذبني أنَّ في كل بيت جدارًا من الرصدِ
يعرف كل اللغاتْ
ويحفظ أسماء أصحابنا والسماتْ
ولا يستحي أن يقاسمنا المرقدا
«أسدٌ عليّ وفي الحـروب نعامةٌ»
عِنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبَرُ الْيَقِينُ
ويستدعي الشهاوي المثل العربي اعِنْدَ جُهَيْنَةَ الْخَبَرُ الْيَقِينُب؛ ليرمز للمرأة المصرية، وهي تبحث عن أخيها أو زوجها أو ابنها الذي ذهب ولم يعد في حرب 1967م، أو هو من البحث عن الحقيقة:
أراها تقطع الأيام بحثًا
وما غيرُ الرمال لها سفينُ
...
«تسائلُ عن حُصَيْنٍ كلَّ ركْبٍ
وعند جُهيْنَةَ الخبرُ اليقينُ»!
وقصة المثل في تراثنا العربي تحكي مقتل حصين على يد شريكه من جهينة، وقد سبق ذكره في أثناء الحديث عن تضمينات الشهاوي الشعرية، والأبيات للأخنس الجهني.
من الأقوال المأثورة
ومثلما اتكأ الشهاوي على المثل في تشكيل لغة النص الشعري ورؤاه، اتخذ من الأقوال المأثورة تفسيرًا لكثيرٍ من الأحداث المعاصرة، أو تأنيبًا، أو عصيانًا، أو استبعادًا واستنكارًا:
هيهات هيهات؛ إن الخرق متّسع
وكل ما ندّعي ضربٌ من الهربِ
ويا ربوع الهوى إني لذو وَلَهٍ
بكل ظبي أغنّ طاهر وأبي
وفيه إشارة إلى قول أنس بن العباس بن مرداس، وقيل لأبي عامر جد العباس بن مرداس:
لا نسبَ اليوم ولا خلّة
اتسع الخرق على الراقعِ
ونستطيع أن نقول إِنَّ لغة الشهاوي هي خلاصة قراءاته العريضة ومحفوظاته الكثيرة وفهمه الدقيق لكلِّ ما تفتحت عليه عيناه، فبقدر ما وقع في شعره من تعالقات نصيّة مع الكتب السماوية، والحديث النبوي والسيرة النبوية، والأقوال الصوفية، والتاريخ، والأساطير، والحكايات الشعبية عامة، والشعر، والمأثور من الأمثال والحكم خاصة؛ بقدر ما أبقت كلُّ هذه التعالقات من تأثيرٍ في لغة النص عنده .

