دوزي و«طوق الحمامة» لابن حزم
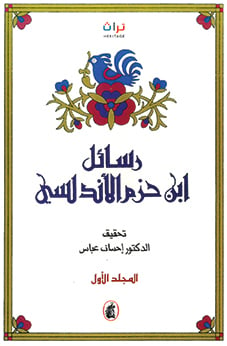
يختلف الباحثون العرب عن زملائهم الباحثين الأجانب في تفسير الحكايات العاطفيّة التي يرويها الفقيه الأندلسي ابن حزم عن نفسه في كتابه «طوق الحمامة»، الذي يصفه الباحث الإسباني أورتيغا أي غاسيت بأنّه أروع ما خُطّ عن الحب في الحضارة العربيّة الإسلاميّة.
وقبل أن نعرض للتفسير العربي والأجنبي لهذه الحكايات النابضة بالوَلَه والصدق يحسُن إيرادها كما سجّلها صاحبها في كتابه.
يقول ابن حزم في كتابه الموجّه أصلًا إلى صديق له: «وإنّي لأخبرك عنّي: أنّي ألفتُ في صباي، أُلفة محبّة، جارية نشأت في دارنا، وكانت في ذلك الوقت بنت ستة عشر عامًا، وكانت غاية في حُسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها وخفرها ودماثتها، عديمة الهزل، منيعة البذل، بديعة البشر، مسبلة الشعر، فقيدة الذام، قليلة الكلام، مغضوضة البصر، شديدة الحذَر، نقيّة من العيوب، دائمة القطوب، حلوة الإعراض، مطبوعة الانقباض، مليحة الصدود، رزينة القعود، كثيرة الوقار، مستلذة النفار، لا تُوَجه الأراجي نحوها ولا تقف المطامع عليها، ولا معرس للأمل لديها، فوجهها جاذب كل القلوب، وحالها طارد مَن أَمَّها، تزدان في المنع ما لا يزدان غيرها بالسماحة والبذل، موقوفة على الجدّ في أمرها، غير راغبة في اللهو.
على أنّها كانت تُحسن العود إحسانًا جيدًا، فجنحتُ إليها، وأحببتها حبًّا مفرطًا شديدًا، فسعيت عامين أو نحوهما أن تجيبني بكلمة، وأسمع من فيها لفظة – غير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل سامع – بأبلغ السعي، فما وصلتُ من ذلك إلى شيء البتّة.
فلعهدي بمصطنع كان في دارنا لبعض ما يصطنع له في دور الرؤساء تجمّعت فيه دخلتنا ودخلة أخي، رحمه الله، من النساء ونساء فتياننا، ومن لاث بنا من خدمنا، ممن يخف موضعه، ويلطف محله، فلبثن صدرًا من النهار، ثم انتقلن إلى قصبة كانت في دارنا، مشرفة على بستان الدار، ويطلع منها على جميع قرطبة وفحوصها، منفتحة الأبواب، فصرن ينظرن من خلال الشراجيب وأنا بينهن.
تضاعف الحُسن
فإنّي لأذكر أنّي كنت أقصد نحو الباب الذي هي فيه، أنسًا بقربها، متعرضًا للدنّو منها، فما هي إلّا أن تراني في جوارها، فتترك ذلك الباب الذي صارت إليه، فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الزوال إلى غيره. وكانت قد علمت كلَفي بها، ولم يشعر سائر النسوان بما نحن فيه، لأنهنّ كنّ عددًا كثيرًا، وإذا كلّهن ينتقلن من باب إلى باب لسبب الاطلاع من بعض الأبواب على جهات لا يطلع من غيرها عليها. واعلم أن قيافة النساء فيمن يميل إليهن أنفذ من قيافة مدلج في الآثار.
ثم نزلن إلى البستان فرغب عجائزنا (الفتيات المتزوجات) وكرائمنا إلى سيدتها في سماع غنائها، فأمرتها، فأخذت العود وسوّته في خفر وخجل لا عهد لي بمثله، وإن الشيء يتضاعف حسنه في عين مُستحسنه، ثم اندفعت تغنّي بأبيات العباس بن الأحنف، حيث يقول:
إنّي طربتُ إلى شمس إذا غربت
كانت مغاربها جوف المقاصيرِ
شمسٌ ممثّلة في حلق جارية
كأن أعطافها طيُّ الطواميرِ
ليست من الإنس إلّا في مناسبةٍ
ولا من الجنّ إلّا في التصاويرِ
فالوجهُ جوهرةٌ والجسمُ مبهرةٌ
والريحُ عنبرةٌ والكلُّ من نورِ
كأنّها حين تخطو في مجاسدها
تخطو على البيضِ أو حدّ القواريرِ
فلعمري لكأنّ المضراب إنّما يقع على قلبي، وما نسيت ذلك اليوم، ولن أنساه إلى يوم مفارقتي الدنيا، وهذا أكثر ما وصلت إليه من التمكّن من رؤيتها وسماع كلامها».
قصّة أخرى
وفي صفحة أخرى من «طوق الحمامة» يروي ابن حزم قصّة عاطفيّة أخرى مع جارية له فيقول: «كنت أشدّ الناس كلفًا، وأعظمهم حبًّا، بجارية لي، كان فيما خلا اسمها نُعم، وكانت أمنية المتمنّي، وغاية الحسن خُلُقًا وخَلْقا وموافقة لي. وكنت أبا عذرها، وكنّا قد تكافأنا المودّة ففجعتني بها الأقدار، واخترمتها الليالي ومرّ النهار، وصارت ثالثة التراب والأحجار، وسنّي حين وفاتها دون عشرين سنة، وكانت هي دوني في السنّ. فقد أقمتُ بعدها سبعة أشهر لا أتجرّد عن ثيابي ولا تفتر لي دمعة على جمود عيني وقلّة إسعادها.
وعلى ذلك فوالله ما سلوتُ حتّى الآن، ولو قُبل فداء لفديتها بكلّ ما أملك من تالد وطارف، وبعض أعضاء جسمي العزيزة عليّ مسارعًا طائعًا. وما طاب لي عيش بعدها، ولا نسيت ذكرها، ولا أنستُ بسواها، ولقد عفى حبّي لها كلّ ما قبله، وحرم ما كان بعده».
وتشهد أيّام الصبا حُبًّا ثالثًا لابن حزم قد لا يكون بضراوة الحبّين السابقين، لكنّه ينطوي على مشاعر رقيقة دافئة: «وقد ضمّني المبيت ليلة في بعض الأزمان عند امرأة من بعض معارفي مشهورة بالصلاح والخير والحزم، ومعها جارية من بعض قرابتها، من اللّاتي قد ضمّها معي النشأة في الصبا.
ثم غبت عنها أعوامًا كثيرة. وكنت تركتها حين أعصرت، ووجدتها قد جرى على وجهها ماء الشباب، ففاض وانساب، وتفجّرت عليها ينابيع الملاحة فتردّدت وتحيّرت، وطلعت في سماء وجهها نجوم الحسن فأشرقت وتوقدت، وانبعثت في خدّيها أزاهير الجمال فتمّت وأعتمت».
أهداف عدة
تلك حكايات ثلاث نابضة بالحياة تدلّ على شغف ابن حزم بالجمال، كما تدلّ على نزوع روحي أو عذري له جذوره في تاريخ العشق عند العرب.
وابن حزم يعترف في «طوق الحمامة» بعزوفه عن كلّ ما هو جنسي، فيقول: «إنّي أُقسم بالله أجلّ الأقسام أنّي ما حللتُ مئزري على فرج حرام قطّ، ولا يحاسبني ربّي بكبيرة الزنا منذ عقلت إلى يومي هذا».
لكن الأمور لم تسلك هذا المسلك عند بعض المستشرقين، إذ وجدوا في حكايات ابن حزم هذه فرصة لتحقيق أهداف عدة أوّلها النيل من العرب وأساليب العشق عندهم، وثانيها فصل ابن حزم عن جذوره الثقافيّة العربيّة وإلحاقه بالحضارة الإسبانيّة المسيحيّة.
من هؤلاء المستشرقين المستشرق الهولندي رينهارت دوزي، المتخصّص بالدراسات الأندلسيّة ومكتشف مخطوطة «طوق الحمامة» بين العديد من المخطوطات العربيّة في مكتبة جامعة ليون بهولندا. فهو يقول معلّقًا على القصّة الأولى التي رواها ابن حزم:
يُلاحظ دونما شكّ في هذه القصّة ملامح عاطفة رقيقة غير شائعة بين العرب الذين يفضّلون بصفة عامة الجمال المثير، والعيون الفاتنة، والابتسامة الآسرة. والحبّ الذي كان يحلم به ابن حزم يختلط - دون ريب - بما هو حسّي جذّاب، وعندما يكون الحبيب المنشود اليوم غيره بالأمس، يصبح الإحساس أقلّ قسوة، لكنّ فيه أيضًا ميلًا إلى ما هو أخلاقي، من رقّة بالغة واحترام وحماسة، وما يأسره جمال رائق وديع، فيّاض بالكرامة الحلوة.
ليس عربيًّا خالصًا
لكن يجب ألا ننسى أنّ هذا الشاعر الأكثر عفّة، وأكاد أقول الأكثر مسيحيّة، بين الشعراء المسلمين، ليس عربيًّا خالص النّسب، إنّما هو حفيد إسباني مسيحي لم يفقد كليّةً طريقة التفكير والشعور الذاتيّة لجنسه. هؤلاء الإسبان المتعرّبون يستطيعون أن يهجروا دينهم، وأن يبتهلوا بمحمّد بدل المسيح، وأن يلاحقوا بالسخرية إخوانهم القدامى في الدين والوطن، لكن يبقى دائمًا في أعماق أرواحهم شيء صاف رهيف وروحي غير عربي.
لكن - مع الأسف - فإنّ فرحة دوزي لم تصل إلى القلب، كما تقول العبارة الشعبيّة. فقد تبيّن للباحثين في سيرة ابن حزم أنّه لم يتحدر في الأصل من أسرة إسبانيّة نصرانيّة، بل من أسرة إسبانيّة وثنيّة.
بدايةً يُلاحظ هؤلاء الباحثون أنّ مسيحيّة الإسبان كانت عند الفتح رقيقة، وكانت معرفة الجمهور بها مشوّشة. وكان قسم كبير من الإسبان وثنيًّا. وإذا صحّ أنّ ابن حزم من أصول إسبانيّة، فمن المرجّح أنّ أجداده لم يكونوا قد اعتنقوا المسيحيّة عند دخول المسلمين إلى إسبانيا، لأنّه من المنطقة الفقيرة في جنوب غربي إسبانيا التي كانت غالبيّة أهلها عند الفتح وثنيّة.
وفي أيّة حال، فإنّ ما كان يجري بين العرب الفاتحين من مظاهر الحبّ الحسّي، كان يجري مثله أو أكثر في الجانب الإسباني المسيحي الذي لم يعرف أبناؤه في عروقهم دماء عربيّة ولا أجدادهم الإسلام دينًا.
وقد فات دوزي أنّ ابن حزم الذي روى هذه الحكايات العاطفيّة التي وقعت له في شبابه لم يكن واحدًا من شهداء الحب في تاريخ الأندلس، ولا في تاريخ العرب، فهو لم يعتزل الناس وينصرف إلى إحدى الصوامع ليبكي ما تبقّى من عمره على حبّه الضائع، بل أمضى عمره في غمار السياسة المتقلّبة الصاخبة في بلده، وكذلك في الاهتمام بقضايا الفقه والشريعة وفي مقارعة خصومه العقائديين، ومنهم ابن النغريلة اليهودي الذي لم يكن يهوديًّا بالديانة فقط، بل وبالعداء للعرب والمسلمين أيضًا.
الشاعر الأكثر عفّة
كما فات هذا المستشرق الكبير أنّ ابن حزم الذي يصفه بـ «الشاعر الأكثر عفّة» ويكاد يقول عنه «الأكثر مسيحيّة بين الشعراء المسلمين»، كان الشعر أضعف مواهبه، ولا يمكن وصف شعره (وأكثره في «طوق الحمامة») بأنّه في خطوطه العامة شعر عفّة. ذلك أنّ ابن حزم بثّ من شعره في هذا الكتاب ما يوفق مضمون كلّ باب من أبوابه. وفي الكتاب أبواب شتّى تتعلّق بأحوال العشق والعشّاق بعيدة كل البُعد عن العفّة التي حسب دوزي أنّ ابن حزم رمز متألّق من رموزها في الأندلس، وهو لم يكن في الواقع كذلك. فهو رجل دولة وفقيه من الفقهاء قبل أن يكون أي شيء آخر.
ويبدو أنّ دوزي لم يتنبّه إلى أنّه لو صحّ أنّ هذا الفقيه الأندلسي كان ينطوي على نزعة عذريّة في ذاته، فلا يجوز تفسيرها حصرًا بالعوامل الثقافيّة والدينيّة الموروثة عن الأصل الإسباني المسيحي، وإهمال عوامل ثقافيّة ودينيّة أخرى موروثة وشائعة أي شيوع في الذات المسلمة وفي الحضارة الإسلاميّة التي كان ابن حزم أحد رموزها في الأندلس.
يمكن في هذا المجال الإشارة حول هذه المثاليّة في الحبّ التي ينسبها إلى أصول إسبانيّة مسيحيّة مفترضة في ابن حزم إلى كتب عربيّة كثيرة بحثت، قبل ابن حزم، في الحبّ، ومنها كتاب «الزهرة» لابن داود الأصفهاني الذي اطّلع عليه ابن حزم وتأثّر به، ويمكن التأكّد من ذلك عند المقارنة بين هذا الكتاب وكتاب ابن حزم.
على أنّ المرء يكاد يقول إنّ الحبّ العذري «صناعة عربيّة» إذا جاز التعبير. ويتأكّد الباحث من ذلك إذا اطّلع على التراث الشعري الضخم للعذريين العرب، ومنهم مجنون ليلى وجميل بثينة وعلى أخبارهم.
الحبّ العذري عند هؤلاء العذريين قاتل لأنّه عفيف، والمحبّون يموتون فيه عشقًا عندما يدفعون بالودّ إلى أقصاه حفاظًا على رقّة العواطف وعلى الوفاء لعفّة غير مقدّسة، ولكي «لا يمدّوا أيديهم» إلى المحبوب.
ليس شاعرًا عذريًا
هذه الثقافة العربيّة حول الحبّ العذري لم تكن غائبة عن ابن حزم، لكن ابن حزم لم يكن واحدًا من العشّاق العذريين رغم رومانسيّة القصص العاطفيّة التي ذكر في كتابه أنّها وقعت له في شبابه، ثم تجاوز مناخاتها لاحقًا إلى حياة سياسيّة صاخبة يعرفها كلّ من اطّلع على سيرة حياته.
فهو إذن ليس عذريًّا وليس شاعرًا عذريًا كما توهّم دوزي. والأهمّ من كلّ ذلك أنّ العذريّة غير مرتبطة بدين من الأديان، بل هي ظاهرة ثقافيّة قابلة للالتماس في بيئات موزّعة على أديان مختلفة، وليس وجوبًا على بيئة دينيّة دون سواها.
أفكار المستشرق دوزي حول عذريّة ابن حزم لم تجد صدى إيجابيًّا لدى أحد من الباحثين العرب. فقد فنّدها د. الطاهر مكّي في كتابه «دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة»، ولم يلتفت إليها د. إحسان عبّاس في المقدّمة التي وضعها لكتاب ابن حزم هذا، وهي مقدّمة علميّة رصينة تحيط بطوق الحمامة إحاطة كاملة، وتتضمّن تفسيرًا وافيًا لمشاعر الحبّ في حكايات الفقيه الظاهري الكبير الإمام أبي محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، التي رواها في كتابه «طوق الحمامة في الألفة والألّاف».
لا يستخدم إحسان عبّاس كلمة «عذريّة» و«حبّ عذري»، بل كلمة «رومانسيّة» في تشخيص حالة ابن حزم إزاء جواريه الّلواتي افتتن بهنّ.
ويشرح بدايةً صورة ابن حزم في «الطوق»، فيقول إنّه كان لصلة ابن حزم بالنساء منذ الطفولة حتى الصبا، عن طريق المعاشرة والثقافة، أثر كبير في ذوقه وشخصيّته. ويبدو أنّه لم ينعم بمعرفة الأمّ وتربيتها وحنانها، فاستعاض عن ذلك بالدلال الذي لقيه من الجواري، وأصبح يلاحقهنّ وينصت لأحاديثهنّ ويشره إلى معرفة أخبارهنّ وأسرارهنّ وحيلهنّ، وكنّ لا يتحرجنّ لصغره من البوح بأشياء كثيرة جعلته يسيء الظنّ بتصرّفات النساء، كما أكسبته تلك العشرة محبّة الانفراد بالعطف، فنشأ شديد الغيرة، واكتسب من البيئة التي ساعد عليها ذوق والده (في محبّة الشقراوات) ميلًا إلى الشقرة.
خلقة مجبولة
ورسّخ تلك الحقيقة أنّ حبّه الأوّل اتّجه إلى فتاة شقراء، وقد أرهفت تلك البيئة البيتيّة إحساسه بجمال الأنثى، وعلّمته التجارب الأولى في تنقّل الميل مع كل حسن لائح، أنّ المحبّة لا بُد أن تكون «خلقة» مجبولة في فطرة الإنسان. لقد مارس كل ذلك على نحو عملي قبل أن يتعلّم أحكام النظر ومخالطة المرأة الأجنبيّة في مجالس الفقه.
ولذلك لم يستطع – بعد أن تعلّم ذلك – التخلّص ممّا نشأ عليه، إذ ما دامت العفّة عن الحرام قد حالت بينه وبين الوقوع في الكبيرة، فما ثمّة ضير كبير في محقّرات الذنوب عند ربّ غفور. ولهذا قال فيه ابن القيم إنّه «انماع في باب العشق والنظر»، أي لم يستطع أن يواجههما بتشدّده الذي أظهره فيما بعد في الشؤون الأخرى.
ويضيف العلّامة الكبير: ولعلّه – صونًا لذلك التعفّف – تزوّج «نُعمًا» في سنّ مبكرة «فكانت أمنية المتمنّي وغاية الحسن خَلقًا وخُلُقًا، وكان هو أبا عذرها (تلك أيضًا حقيقة مهمة)، فكان فقدها فاجعًا، لأنّه أبرز إلى العيان ما انطوت عليه نفسه من «حدّة رومانطيقيّة كامنة» كان يداريها من قبل بالاستحسان والأُلفة والتودّد، فلم تعد هذه كافية لصدّ تيّار الحزن الجارف، المتدفّق من نفسه.
فقد أقام بعدها سبعة أشهر دون أن يغتسل، وهو آخذ في بكاء متواصل، رغم أنّه معروف بجمود الدمع بسبب إدمانه أكل الكندر – على ما يقول – لمداواة خفقان القلب، ولم يطب له عيش بعدها ولا أنس بسواها ولا نسي ذكرها.
شيء واحد لم يستطع ذلك الفقد أن يزلزله، وهو إيمانه بالتعفّف. وممّا زاده رسوخًا في ذلك اتخاذه أستاذه أبا علي الحسين بن علي الفاسي نموذجه الأعلى، وكان رجلًا صالحًا ناسكًا، ولعلّه كان حصورًا لم يتزوّج.
قال ابن حزم «فنفعني الله به كثيرًا، وعلمت موقع الإساءة وقبح المعاصي». نعم ظلّ قلبه يخفق كلّما شاهد جمالًا، وكان يقترب حتّى يكاد يصبو «ويثوب إليه مرفوض الهوى ويعاوده منسي الغزل»، لكنّه كان يغلّب الإرادة فيفرّ مبتعدًا.
أمر مستحيل
بقيت تلك «الحدّة الرومنطيقيّة» في معايشة الماضي محور شخصيّة ابن حزم حتّى بعد سنوات من كتابة «الطوق»، وأحسبها لم تتغيّر إلى النهاية، وإنّما كانت تتلبّس أشكالًا مختلفة، وقد غرست في نفسها شعورًا بالظمأ الدائم، لأنّ ريّه إنّما يتمّ بالعودة إلى الماضي، وذلك أمر مستحيل. ولهذا كان واقع الحياة يزيد في حرارة ذلك الظمأ.
وفي مجال الحبّ عبّر عن ذلك الشعور بقوله: «دعني أخبرك أنّي ما رويت قط من ماء الوصل، ولا زادني إلاّ ظمأ. وإذا كان الصوفيّة يرون غايتهم في الفناء، فإنّ ظمأ ابن حزم لم يكن يشفيه إلاّ أحد شيئين: إمّا الاتّحاد النهائي بالمحبوب أو العودة إلى رحم الماضي، وقد خلّصته السنّ من الظمأ الأوّل وأبقت له الثاني».
هذا تفسير معقول ومقبول لمشاعر الحبّ عند ابن حزم في مقتبل شبابه، يبتعد فيه عن الشطط والغلو اللذين أظهرهما المستشرق الهولندي دوزي في دراسته عن ابن حزم وكتابه «طوق الحمامة»، ويقترب فيه من العالم الحقيقي لابن حزم وبيئته العائليّة والأندلسيّة.
تبقى كلمات قليلة عن دوزي الذي اكتشف هذا الكتاب الثمين، ولولاه لربّما ضاع إلى الأبد. كان ذلك في عام 1841 وكان دوزي (1820 – 1883) في الحادية والعشرين من عمره، فكتب ما كتب عن الكتاب وهو في تلك السنّ المبكرة، دون أن تكون قد اكتملت عنده صورة كاملة عن الموضوع الذي يكتب فيه ولا الطرائق والمناهج التي توافرت للباحثين من بعده.
ولكن يُحمد لدوزي ما فعله وما كتبه أيضًا، ذلك أنّ تاريخ العلم لا يقتصر فقط على النظريّات العلميّة الراسخة، بل على النظريّات المهجورة أيضًا، فهي جزء من هذا التاريخ، ولولاها لما وصل العلماء إلى النظريّات الصحيحة التي اعتُمدت لاحقًا ■

