العرب لم يستعمروا إسبانيا فتح الأندلس ... حقيقة أم أسطورة؟
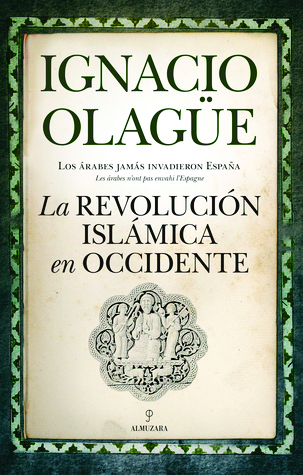
يعكس عنوان هذا الكتاب «العرب لم يستعمروا إسبانيا»، أو لم يغزوا إسبانيا، وهي الترجمة الأدقّ التي تعبّر عن أطروحة الكتاب، وجهة نظر الباحث الإسباني إغناسيو أولاغوي، حول الوجود العربي الذي استمرّ ثمانمئة سنة في إسبانيا.
فعنده أنّ هذا الوجود لم يكن نتيجة غزو عسكري، وإنّما نتيجة غزو ثقافي كما نقول بلغتنا المعاصرة. ينفي الباحث حصول الحادثة التاريخيّة المشهورة عن دخول طارق بن زياد وجيشه بحرًا إلى الشاطئ الإسباني المقابل للمغرب، واحتلال المسلمين بالتالي لشبه الجزيرة الإيبيريّة، ويعتبرها واحدة من الأساطير الشائعة.
أمّا كيف بدأ الوجود العربي في إسبانيا واستمّر طوال هذه المدّة الطويلة، فبسبب تقبّل الإسبان للإسلام كدين منسجم مع تصوّرهم الاعتقادي.
فقد كان قسم كبير منهم على المذهب الأريوسي الذي يتّفق في تصوّره لشخصيّة المسيح مع تصوّر القرآن الكريم الذي يقول بوحدانيّة الله ويرفض التثليث.
هذا التصوّر المشترك بين وجهتي النظر الإسلاميّة والمسيحيّة ساعد في فتح الباب أمام المسلمين للدّخول إلى إسبانيا، ولكن هذا الدّخول، وهذا المهمّ في الكتاب، تمّ سلمًا لا حربًا، فلا فتح ولا جيوش ولا حروب.
يناقض هذا التصوّر رواية المؤرّخين العرب عن فتح الأندلس، بل رواية كل المؤرّخين الإسبان والأوربيين عن بكرة أبيهم، ولا يشذّ عن هؤلاء جميعًا سوى الباحث الإسباني أولاغوي، الذي يصف نفسه في كتابه بأنّه ارجل آدابب.
ومن هؤلاء المؤرّخين الإسبان المعاصرين إميريكو كاسترو، الذي يتحدّث في كتبه عن الفتح العربي لبلاده كحدث من أحداث التاريخ، ويشيد بنتائج هذا الحدث على صعيد تشكّل شخصيّة إسبانيا الوطنيّة. وهو ما فعله المؤرّخون الإسبان والأوربيون الآخرون، إلى أن ظهر كتاب أولاغوي في الربع الأخير من القرن العشرين، فقابله المؤرّخون بالسخرية المرّة، ومنهم المؤرّخ الفرنسي بيار غيشار، الذي ردّ على أولاغوي، بمقال جاء عنوانه تهكّمًا: االعرب فتحوا بالفعل إسبانياب، ردًاّ مفصّلًا دقيقًا.
ويحسُن قبل الإشارة إلى ما ورد في المقدّمتين العربيتين للكتاب، وفيهما ما يجدر التوقّف عنده، نقل ما يمكن اعتباره الأسباب الموجبة الأساسيّة التي بنى عليها أولاغوي أطروحته، فهو يسأل: كيف يراد منّا أن نقتنع بأن موسى بن نصير تمكّن من السيطرة على إقليم شمال إفريقيا في غضون سنوات قليلة، وهو إقليم يتّسم بتضاريس جبليّة شديدة التعقيد، كما أنّه مأهول بسلالة محاربين أثبتت على مدار التاريخ قدرتها وفاعليتها؟ وهل كان العرب في وضع جيد لغزو إسبانيا عام 711 ميلاديّة، في الوقت الذي كانوا في حاجة إلى أكثر من قرن لتأمين قواعدهم في الشّمال الإفريقي؟
معجزة رائعة
يجيب أولاغوي: لم يهتمّ المؤرخون بالتأكد من ذلك، فقد وجدوا أنّ من الطبيعي للغاية أنّهم عبّروا مضيق جبل طارق واحتلّوا شبه جزيرة إيبيريا بصلاتهم على طريقة اأبانا الذي في السّماواتب، أي أنّهم سيطروا على 192584 كيلومترًا مربعًا، أي على الإقليم الجبلي الأكثر وعورة في أوربا، في غضون ثلاث سنوات. اكانت المعجزة رائعة، ذلك أن كتاب الحوليّات المسلمين يقدّمون لنا بالتفصيل عدد الغزاة، فقد اكتفى طارق بن زياد بسبعة آلاف رجل للقضاء على لذريق في معركة وادي لكّة. وبعد ذلك أتى موسى بن نصير بثمانية عشر ألف رجل، وكان يشعر بالغيرة من النجاح الذي حقّقه أحد قادة جيشه. وإذا لم يخدعنا علم الرياضيّات فإنّ كلّ واحد من هذا العدد الإجمالي المكوّن من خمسة وعشرين ألف عربي كان عليه أن يسيطر على ما يزيد قليلًا على ثلاثة وعشرين كيلومترًا مربّعًا. ولمّا لم يكن ذلك كافيًا لهؤلاء الأبطال العمالقة سارعوا بعبور جبال البرانس للسيطرة على فرنسا.
ويتابع أولاغوي روايته السّاخرة للأحداث على النحو التّالي:
أدّى انتصار طارق (المزعوم برأيه) إلى فتح باب شبه جزيرة إيبيريا على مصراعيه أمام الآسيويين الذين احتلّوها دونما كثير عناء.
وعندئذٍ حدثت عمليّة تحوّل هائلة وكأنّنا في مسرح نقوم بتغيير ديكوراته. كانت إسبانيا لاتينيّة فتحوّلت إلى العربيّة، وكانت مسيحيّة فاعتنقت الإسلام، وكانت تسير على أنّ لكلّ رجل زوجة واحدة فتحوّلت إلى تعدّد الزوجات، وكأنّنا أمام الروح القدس وهو يكرّر عيد العنصرة، وبالتالي استيقظ الإسبان فوجدوا أنفسهم يتحدّثون لغة الحجاز، كما وجدوا أنفسهم يرتدون ملابس مختلفة، ويمارسون عادات أخرى، وكذلك أسلحة من صنف آخر.
مهمة ضخمة
ولكي يتمّ توزيع الغنائم الناجمة عن الغزو، كان على الغربيين أن يتصارعوا فيما بينهم على مدار سبعين عامًا. كانت شبه الجزيرة الإيبيريّة مأهولة جيّدًا بالسكّان في تلك الآونة، وكان سكّانها موزّعين توزيعًا جيّدًا في الهضبة الوسطى خلال عصور مضت. وبصفة عامة يمكن تقدير تعداد سكّانها في رقم يتراوح بين خمسة عشر وعشرين مليون نسمة. وعندما نعرف العدد القليل للغزاة، يصبح من العجيب ألّا ينتهي الأمر بهؤلاء المحاربين القادمين من خضمّ صراعاتهم الداخليّة وتقاتلهم إلى هذا. وهنا نتساءل: ما الذي كان يفعله كلّ هؤلاء الملايين من المشاهدين في تلك الآونة؟
ويضيف الأديب الساخر: وفقًا للروايات التاريخيّة التي نجدها في الكتب المدرسيّة، أو وفقًا للتحليلات التي قام بها الباحثون المحدثون، فإنّ الإسبان قد اختفوا، وليس هنالك إلّا العرب. ويتساءل: هل يمكن أن يختفي بين عشيّة وضحاها كلّ هذا العدد المكوّن من ملايين البشر وكأنّهم اورق كوتشينةب أو قطعة عملة في يد حاذقة؟
لذلك، فإنّ مهمّة الغزاة برأيه ستكون ضخمة إذا ما كان عليهم أن يذبحوا سكّان البلاد واحدًا واحدًا مثلما يؤكّد لنا ذلك مؤلّفو الحوليّات اللاتينيّة. ففي ذلك العصر لم تكن هنالك إجراءات سريعة للقيام بمذابح جماعيّة. وكانت الوديان الضيّقة في إقليم أستورياس غير قادرة على تلقّي أعداد هائلة من اللاجئين. اوحقيقة الأمر نجد أنفسنا أمام مشكلة مختلفة للغاية، إذ كان من الضّروري الصّمت عنها، لأنّها غير مريحة، ذلك أنّها معضلة لا تجد حلًاّ حتى يومنا هذا. فإذا كان غزو إسبانيا أمرًا لا يحتمل التصديق، فكيف يمكن تحوّل الإسبان إلى الإسلام واضعين في الحسبان وجود الإسبان على الأرض وتمثّلهم للحضارة العربيّة؟ب.
معركة وادي لكّة
حول معركة وادي لكّة، وهي التي فتحت الباب واسعًا أمام الفتح والفاتحين، يثير أولاغوي الكثير من الغبار: اعدد الغزاة كان ضئيلًا، وما من وسائل نقل فعّالة، ومن ثمّ لم يجد الجنرالات العرب أنّ تكتيكاتهم ستعيقها عمليّات الإمداد، ولم تكن هناك مؤن مع المحاربين، لذلك كانوا معرّضين للموت جوعًا. وفي مثل هذه الظروف جرت معركة وادي لكّة بعددٍ قليلٍ من الرجال، اللّهمّ إلّا إذا كانت قصّة من قبيل الأساطير (وهي عنده كذلك)... كما يجب أن نفهم كيف تحوّلت المقاطعات الثابتة التي تشكّل جماع الأقاليم الطبيعيّة في شبه الجزيرة الإيبيريّة على يدّ هذا العدد القليل من السحرة، وفي غضون زمن قصير للغايةب.
ولكن ومع الأسف، انتصر هذا العدد القليل من السحرة كما يجمع المؤرّخون في العالم، ولكن أولاغوي لم يفرغ بعد من سرد حججه، فهو يقول: اهناك الصعوبة الأكبر، لِم لَم يقولوا لنا: إنّ هؤلاء كانوا من جنسيّات مختلفة؟ فوفقًا للحوليّات العربيّة كان تعداد العرب ضئيلًا، أمّا الباقون فهم مغامرون من سلالات وأوطان مختلفة: من السوريين والبيزنطيين والأقباط، وكذلك من البربر على وجه الخصوص.
وهنا نرى خلاصة عمل لا معقول تقول إن إسبانيا جرى غزوها وتعريبها على يد أناس لا يتحدّثون العربيّة. فأهل إقليم المغرب لم يُتح لهم وقت لتعلّم العربيّة، وإسبانيا تمّت أسلمتها على يدّ وعّاظ كانوا لا يعرفون القرآن الكريم للسبب نفسهب.
حرب عصابات
وإذا كان هذا هو الموقف، فالأمر الذي لا شكّ فيه، كما يقول، هو أن هذا الجيش سيذوب وفقًا لعلم الرياضيّات وكأنّه السكّر في كوب ماء، إذا ما انتشر في ربوع البلاد، ولو حدث غير ذلك فكيف يمكن السيطرة على الأرض؟ ما الذي كان يمكن أن يحدث إذا ما بدأ الإسبان عمليّات حرب العصابات في أقلّ معدّلاتها؟ اسوف يُفهم الآن أنّه كان من الملائم ألّا يضع المرء إصبعه على الجرح، أي أنّ التجاهل وعدم الحديث عن هذه التفاصيل، في إطار اتّفاق عام غير معلن كان هو الخطّ الذي فضّله المؤرّخون، وهو أن يتركوا الإسبان نائمين طوال عدّة قرون.
ويتحدّث عن موسى بن نصير، فيصفه بأنّه مجرّد امغامرب وهي الصفة نفسها التي يلحقها بعقبة بن نافع، وهما من هما في تاريخ الفتوح الإسلاميّة. ويصوّر عقبة بن نافع على النحو التالي:
افي حوالي 670 ميلاديّة ظهر سيّدي عقبة، الذي يتمّ تقديمه بصفة عامة على أنّه من غزا الشمال الإفريقي. وهذا ليس بصحيح، إذ لم يكن إلّا مغامرًا بدأ واحدة من الرزايا في الشمال الإفريقي، ولم يحالفه الحظّ، إذ مات في المعركةب.
أمّا اصقر قريشب، أو عبدالرحمن الداخل، وهو من أكرم الوجوه التاريخيّة التي عرفها تاريخ الأندلس والعرب معًا، فهذه صورته كما يرسمها أولاغوي:
في نهاية المطاف يصل إلى شواطئ الأندلس أحد الأمويين، وهو سليل العائلة الأكثر شهرة في مكّة، حكم آباؤه الإمبراطوريّة الإسلاميّة. هو ساميّ قحّ، لكنّهم يصفونه لنا على النحو التالي: طويل القامة ذو عينين زرقاوين، وشعره كستنائي، وبشرته بيضاء، أي أنّه على النمط الجرماني. ونظرًا إلى نسبه الملكي والعربي لم يستجب أحد لنواياه، ومن ثمّ كان عليه أن يُسهم بروحه وجسده، ويضع نفسه في أتون الحرب الأهليّة التي كانت سائدة منذ حوالي أربعين عامًا.
وهنا تعرّض للأذى الجسدي والمعنوي. ولما كان ذا ألمعيّة عسكريّة لا جدال فيها، فقد تمكّن من تحقيق بعض النجاحات التي هيّأت له توّليه منصب الأمير في جامع قرطبة (756م)، ورغم هذه الجرأة نجد أنّه كان مجبرًا على الدخول في أتون الحرب على مدار حياته، ولم يرتح من الموقف إلّا بالموت (788م)ب.
مخاض عسير
الكتاب المنقول حديثًا إلى العربيّة عن امكتبة الإسكندريّةب وامركز نهوض للدراسات والنشرب، والذي مرّ أصله بمخاض عسير قبل أن يصدر بالفرنسيّة أوّلًا، والإسبانيّة لغة أولاغوي ثانيًا، مرفق في ترجمته العربيّة بمقدّمتين: الأولى لمدير مكتبة الإسكندريّة د. مصطفى الفقي، والثانية لرئيس مجلس أعضاء وقف انهوض لدراسات التنميةب
د. علي الزميع.
يرى د. الفقي اأنّ قصّة المسلمين في الأندلس يحوطها الغموض بدايةً ونهاية، وأنّه لم يُحتكم إلى العقل في رواية تاريخها، ولم تكن الحقيقة هي غاية من قلّبوا صفحاتها، وتأمّلوا ممالكها ومسالكها، وتحيّزوا ما شاء لهم يمنةً ويسرة في قراءة أحداث لم يكونوا من صنعها ولم يعاصروا أهمّ فصولها. وعندما جاء مؤرّخ استفاء بنور الحقيقة معتمدًا على أدقّ الوثائق، مسلّحًا برؤية تاريخيّة صادقة، وقوائم لا حصر لها من الوثائق والمؤلّفات، في تحقيق تاريخي يقلُّ نظيره، وتوثيق القوائم من الكتب والمراسلات والتوثيقات، وبمنهجيّة معرفيّة صارمة... عندما يفعل المؤرّخ الإسباني الكبير إغناسيو أولاغوي كل ذلك ولا يجد أُذنًا صاغيةً، ولا دار نشر كبيرة أو صغيرة ترغب في طبع كتابه، أو الترويج لمضمونه، أو حتى إصدار صغير محايد يترك للقرّاء مهمّة التقويم وردود الأفعال، فإنّه لأمر يعجب له أي عاقل محايدب.
عنوان مثير
أمّا د. الزميع فيرى أن عنوان الكتاب االعرب لم يستعمروا إسبانياب كان عنوانًا مثيرًا لأطروحة مستفزّة للوجدان اليميني المحافظ في إسبانيا، وأنّ أولاغوي أراد أن تكون أطروحته انقلابًا جذريًّا على كثير من المسلّمات التي ركزها التوجّه الكلاسيكي في التأريخ لإسبانيا العصر الوسيط، حيث ينتقده بشدّة، معتبرًا إيّاه قائمًا على تصوّر مؤدلج وقاصر عن تأسيس رؤية واعية قادرة على إعادة قراءة التاريخ الإسباني وتشكيل هويّة إسبانيّة متسامحة مع ماضيها، لا تشوبها الضغائن العرقيّة والدينيّة.
إذ يوضّح أولاغوي أنّ استماتة كاثوليكيي ويمينيي إسبانيا بتوهيم الناس بأنّ ما حصل في القرن الثامن الميلادي هو استعمار إسلامي للأراضي الإسبانيّة الكاثوليكيّة الرومانيّة، تعود إلى قصد ضمني هو تبرير طرد مسلمي الأندلس في بداية القرن السادس عشر الميلادي من طرف الملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيزابيلّا. فيصير تأكيد وقوع غزو إسلامي لإسبانيا في القرن الثامن، واقعة تضفي الشّرعية التاريخيّة على فعل الطرد ذاك. وبذلك يكون ما حصل في القرن السادس عشر مجرّد استرداد مشروع لأراضي استعمرت من قبل. وهكذا يتجنّب الوعي الكلاسيكي العديد من الأسئلة المحرجة حول مدى شرعيّة طرد الموريسكيين من الأندلس.
ملاحظات
وحول ما ورد في هاتين المقدّمتين، يمكن إبداء الملاحظات التالية:
- إذا كان ثمّة غموض يحيط بقصّة المسلمين في الأندلس في بدايتها، فهذا الغموض لا يحيط بعمليّة فتح الأندلس بحدّ ذاتها، بل بتفاصيل هذه العمليّة لا غير، وهي تفاصيل يغيب مثلها في أكثر الأحيان عن مؤرّخ يتصدّى للتأريخ لأحداث معاصرة له، ولا يرى ما يمنعه من تناول هذه الأحداث، رغم هذا الغياب مادام يلمّ إلمامًا جيدًا بجوانبها الأساسيّة، وبإمكانه إصدار أحكام بصددها.
أمّا اتّهام كلّ من كتب عن الأندلس بأنّه لم يحتكم إلى العقل في رواية تاريخها، ولم تكن الحقيقة هي غاية من قلّبوا صفحاتها، وأنّهم تحيّزوا في رواياتهم، ودون أي تحديد، عبارة عن أحكام عامة تظلم الكثيرين من المؤرخين ممن استوفت كتاباتهم شروط الكتابة التاريخيّة من عرب وأجانب.
- ولا غموض بصورة خاصة في نهاية الأندلس، فقد حصلت هذه النهاية في وضح التاريخ إن جاز التعبير، أي في الأمس القريب نسبيًاّ، في سنة 1492 ميلاديّة بسقوط آخر مملكة عربيّة في الأندلس، وهي غرناطة، ولدى العرب ما لا يُحصى من الوثائق حولها وحول سقوط الأندلس بوجه عام.
مكتبة متخصصة
لدى الإسبان وثائق أكثر، ثمّة مكتبة إسبانيّة ضخمة متخصصّة بالأندلس، وبخاصة بنهايتها، هي مكتبة الإسكوريال. فلا غموض إذن ولا غياب حتى للتفاصيل، وعندما لا يُحتكم إلى العقل في رواية التاريخ، فهناك باحثون آخرون يقفون إلى جانب العقل ويردّون له اعتباره. ومن غير الإنصاف اتّهام جميع الباحثين والمؤرّخين بأنّهم تحيّزوا في قراءة تاريخ الأندلس، وأنّ هذا التاريخ ظلّ ينتظر حتى جاء الباحث الإسباني أولاغوي مستفيئًا بنور الحقيقة الذي لم يستفئ به سواه ليقول الكلمة الفاصلة في تحقيق تاريخي قلّ نظيره، في حين أنّ أحدًا حتى من المؤرّخين الإسبان لم يتعامل معه تعاملًا جدّيًا.
أمّا لماذا أهمل الإسبان كتاب أولاغوي سنوات طويلة، ولم يهتمّوا بنشره حتى صدر في فرنسا وبالفرنسيّة أوّلًا، قبل صدوره في مدريد لاحقًا، على الرغم من الإثارة التي يتضمّنها، فمن الممكن الإدلاء بعدة افتراضات، منها أنّ دور النشر الإسبانيّة لم تقتنع بالأطروحة التي يدافع عنها الكتاب، والتي لم يُشر إليها مؤرّخ قبله، واعتبرتها أقرب إلى االصرعةب منها إلى النظريّة الجادة الرصينة. لذلك خافت من أن تكون طباعة الكتاب مغامرة، حيث لا تجوز المغامرات، فرفضت جميعها طباعة الكتاب. وقد يكون الخوف من طباعته متأتيًا من كون مؤلّفه غير مصنّف في عداد المؤرّخين، ولم يسبق له أن زاول مهنة تدريس التاريخ، وهما صفتان لا بدّ منهما، وبخاصة الأولى، لمن يتصدّى لكتابة التاريخ. فالتاريخ لا يكتبه عادةً إلّا المؤرّخون.
تفسير غير مقبول
لكنّ للدكتور الزميع تفسيره لإهمال دور النشر الإسبانيّة للكتاب. فهو يقول إنّ اليمين الإسباني لم يرحّب بالأطروحة المبني عليها الكتاب، لأنّها تنفي صفة المستعمرين عن العرب وتدين، ضمنًا، عمليّة طرد الموريسكيين في القرن السادس عشر. وهو تفسير قد لا يصحّ لأنّ دور النشر الإسبانيّة ليست كلّها يمينيّة، وهناك دور النشر التجاريّة غير المؤدلجة، فضلًا عن أنّ اليمين الإسباني ما كان لينزعج من أطروحة تقول إنّ إسبانيا لم تخضع عنوةً لاستعمار االجراد الإفريقيب، كما يصف أولاغوي العرب، وبالتالي لم تكن أبدًا مستعمرة عربيّة بالفعل، وهو وصف لواقع حصل، ولواقع آخر منفصل عنه هو طرد الموريسكيين بعد ثمانية قرون من وقوع الأوّل. ردّ بعض المؤرخين العرب على أولاغوي، منهم المؤرّخ المغربي د. طارق مراني، ومما ذكره في بحثٍ له: اعلى عكس ما يدّعيه أولاغوي، فإنّ الحوادث العامة للفتوحات الإسلاميّة، ومنها فتح الأندلس، لا تترك مجالًا للشك.
لكن الاختلاف يبقى فقط في جزئيّات هذا الحادث وفي كرونولوجيّته ومراحله، فهذا الأمر ثابت تاريخيًّا حتى بالنصوص اللاتينيّة القديمة وببقايا النقود العربيّة التي أصدرها موسى بن نصير.
إنّ التحوّلات السياسيّة والدينيّة التي طرأت في شبه الجزيرة الإيبيريّة، وكانت على درجة كبيرة من الأهميّة، حقيقة ثابتة، لكنّ المصادر العربيّة الراصدة لهذا الحدث متأخرة وذات صدقيّات مختلفة، وفي بعض الأحيان متضاربة، وتعتمد على العجائبي.
كان عالم دار الإسلام في مرحلة تشكّل واكتمال، وكان الاهتمام منصبًّا أساسًا على الكتابة في المجال الفقهي والديني المحدّد للإطار التشريعي، ولم ينشأ التدوين بطريقة تحليليّة إلّا في القرن الرابع الهجري أو الحادي عشر الميلادي، إذ بدأ تدوين الروايات الشفهيّة وغير المنتظمة كرونولوجيًّا والمرتبطة بالحوادث الأولى للدولة الإسلاميّة.
مصادر ضعيفة
من المعلوم أنّ تسمية الأندلس استعملت مع الفاتحين المسلمين منذ الأعوام الأولى للفتح 92هـ/711م. وعوّض مصطلح هسبانيا على نقود االمرحلة الانتقاليّةب التي سكتّها منذ فترة 712/720 السلطات العربيّة وإمارة الخلافة الجديدة.
هذه النقود كانت في البداية، عام 92هـ/711م، باللغة اللاتينيّة، ابتداءً من عام 102هـ/720م. ومنذ تلك الفترة أصبح مصطلح الأندلس يعني مناطق شبه الجزيرة الإيبيريّة الخاضعة للسيطرة الإسلاميّة.
ألا يدلّ ذلك على افتحب للأندلس؟ وهل يسكّ العملة باللغة العربيّة سوى فاتح للبلاد له سلطانه؟ وهل كان اللقاء الفكري بين المسلمين وجماعة المسيحيّة الآريوسيّة في إسبانيا هو الذي سمح لموسى بن نصير بممارسة سلطانه هذا؟
لا شكّ في أنّ ضعف المصادر التاريخيّة المعاصرة للفتح العربي لإسبانيا معطى منهجي معروف، لكن أولاغوي أردف هذه القضيّة إلى مسألة التغيّرات المناخيّة الكبرى (تجفيف الأرض) غير المؤكّدة علميًا.
وأضاف دوام الاعتقادات الأريوسيّة حتى بعد دخول القوط في المذهب الكاثوليكي في القرن السابع الميلادي، ليجعل منها مجموعة من الحجج الواهية في مواجهة حقيقة تاريخيّة كبرى.
نظريّة هشّة
نفي فتح الأندلس أو نفي غزو إسبانيا نظريّة هشّة غير صحيحة تاريخيًاّ وغير مقنعة، تعسّف صاحبها أي تعسّف في محاولة لإثباتها وهو يرتدي لباس الميدان. وهو لباس إذا كان يليق بمن يتوجّه إلى ساحات الحروب، فلا يليق البتّة بمن يتوجّه إلى وقائع التاريخ قاصدًا استنطاق أحداثه ومساءلتها وتفسيرها وإعطاءها وصفها الصحيح.
تستلزم كتابة التاريخ تدريب الذهنيّات قبل كلّ شيء، بحيث يكون المؤّرخ مجرّدًا من الأهواء والعصبيّات نزيهًا أقصى حدود النزاهة، بعيدًا عن التعصّب والعصبيّات، لا يبتغي سوء الحقيقة ولا يلتزم من أساليب الكتابة سوى بالأسلوب العلمي. وقد رأينا في النماذج التي نقلناها لأولاغوي عن العرب حديثًا، ساخرًا حينًا، وهاجيًا حينًا آخر، ومتأبطًا مشروعًا لا يحيد عنه، هو نفي ما أجمع الآخرون على حصوله. وعلى الرغم من ظاهر الجديد الذي يتبدّى به مشروعه، فإنّه لا يختلف في جوهره، وبخاصة في نظرته إلى العرب والمسلمين، عمّا كتبه المستشرقون ذوو الميول العنصريّة.
لقد سلب الغرب من العرب الحاضر، لكن أحد باحثيه يريد أن يسلب منهم التاريخ أيضًا، فينتزع منه حقيقة كبرى من حقائقه هي فتح العرب للأندلس .

