سراديب الذهب
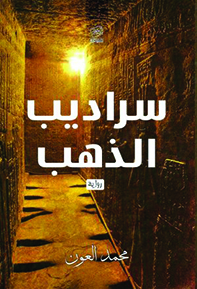
«سراديب الذهب» رواية جديدة للكاتب المصري المبدع محمد العون، أخرجها عام 2017 م، وهي الرواية السابعة في ترتيب مؤلفاته الروائية، وتدور أحداثها في مصر القديمة وبالتحديد في عصر الأهرامات، وتحكي وقائع سرقة لمقبرة الملكة «حتب حرس» أم الملك الإله «خوفوي» باني الهرم الأكبر، تنفذها عصابة يتزعمها نحات مصري فقير اسمه «حرنخت» من رعايا الملك نفسه، وأحد المشاركين في تشييد هذه المقبرة عندما كان شاباً.
لا يكتفي الكاتب بتتبع وقائع السرقة، بدءاً من رسم الخطة لها حتى النجاح في الهروب بجسد الملكة وتقطيع أوصالها وصهر الذهب الذي تحمله معها وبيعه، بل يرسم صورة حية لحياة الملكة حتب حرس وابنها الملك خوفوي، ويصور الحياة المصرية القديمة عامة في ظلال هذه الأسرة الملكية وحالة الشعب المصري في ذلك الحين، وعلاقة الحكام بالمحكومين حينئذٍ، وعلاقة الحكام بعضهم مع البعض الآخر.
لذلك فإن الرواية تحمل صورتين متقابلتين، كل منهما عكس الأخرى: الأولى عبارة عن صورة لحياة الملكة الأم نفسها في أثناء حياتها الباهرة، وفي أثناء التخطيط المحكم الذي تقوم به لبناء مقبرة «بيت أبدي فخم» لها، وحفظ الذهب والمومياء الملكية المقدسة فيها، بواسطة الملك خوفوي نفسه، وبمباركة الكهنة، والمبالغة في إحكام السرية والحراسة المشددة للجسد المقدس لأم الإله.
والصورة الثانية ترسم حكاية نجاح حرنخت وعصابته في سرقة هذا الذهب، رغم كل هذه الحراسة المشددة والتخفي المحكم والقداسة المرهبة التي تفرضها السلطة الحاكمة، ويأتي التقابل في الحكايتين من أن الأولى تقص عملية بناء المقبرة وحفظ الذهب فيها، وإغلاقها عليه والثانية تقص عملية فتح المقبرة وإخراج الذهب منها وتبديده، الأولى تحفظ الذهب من أجل الموت وما بعد الموت، والثانية تنفق الذهب من أجل السعادة في الحياة الدنيا.
والترتيب الزماني المتخيل في الرواية يقضي منطقياً وواقعياً بأن تكون وقائع الحكاية الأولى قبل وقائع الحكاية الثانية، فمن المنطقي أن تكون قصة حياة الملكة «حتب حرس» وزواجها وإنجابها للملك «خوفوي» وتخطيطها لبناء بيت أبدي لها، وبناء هرم لابنها، من الطبيعي أن تكون هذه الأحداث قد وقعت قبل الأحداث التي وقعت بعد موتها وما جرى فيها من سرقة لموميائها، لكن الكاتب لا يلتزم بهذا الترتيب التاريخي في السرد، بل يقص أحداثهما معاً، ففي الوقت الذي يسير فيه الزمان المتخيل في أحداث حكاية السرقة مطرداً إلى الأمام مع اتجاه السرد، يسير الزمان في أحداث الحكاية الثانية متعرجاً إلى الخلف، فكلما تقدم القارئ خطوة إلى الأمام تكشفت له الخطوة التالية لحكاية السرقة، وفي الوقت نفسه تتكشف له قطعة من الماضي بالنسبة لحياة الملكة والأسرة الحاكمة، عن طريق الذكريات التي تتوارد على ذاكرة اللص حرنخت أو المعلومات التي يوردها الراوي العليم والمنظورة من زاوية حرنخت نفسه.
إمكانات دلالية
هذا هو الوجه التاريخي السطحي للرواية، مجرد قصة تاريخية من القصص التي تحكي وقائع سرقة لمقبرة فرعونية عميقة محفورة في سراديب تحت الأرض في صحراء دهشور، ومكدسة بالذهب، وفي هذه الحالة يشير عنوان الرواية «سراديب الذهب» بطريقة مباشرة إلى مادة السرقة، وهو الذهب الموجود في سراديب مقبرة الملكة، لكن الوجه الدلالي العميق للرواية يحمل إمكانات دلالية متنوعة، تتجاوز حدود الأطر التاريخية المحدودة بزمان ومكان معينين، لتعبر عن كل حالة مشابهة لها في أي زمان وفي أي مكان، فالفن مثل العلم ومثل الفلسفة بحث عن الحقيقة، ولكن بطريقة خاصة، لأن الكاتب في هذا المستوى يوظف التاريخ توظيفاً فنياً ويصنع من أحداثه لوحة رامزة مشعة بالمعاني العميقة.
وفي سبيل ذلك قسم الكاتب العالَم الروائي في الرواية إلى قسمين: القسم الأول مكون من طبقة الحكام ورجال الدين، أي الملوك والملكات والأميرات والأمراء والكهنة، والقسم الثاني مكون من العمال الحرفيين والمهندسين والفلاحين، الطبقة الأولى مترفة منعمة لا تعمل ولا تنتج، ومع ذلك تستمتع بكل ما تنتجه الطبقة الأخرى، فهذه الطبقة المترفة تأكل في أوانٍ من الذهب وتلبس أفخر الثياب وتتحلى بأغلى الحلي وتعيش في قصور جميلة على النيل، ولا يمشي أبناؤها على الأرض، بل يتنقلون بالسفن الفارهة في النيل أو على محفات ذهبية يحملها رجال من الطبقة الكادحة على أكتافهم، هذه الطبقة المترفة لا تكتفي باستئثارها بمتع الدنيا، بل تضن بمتع الحياة الأخرى بعد الموت، فتسخر الطبقة الكادحة في تشييد مقابر فخمة خالدة تضمن السعادة والمتعة في الحياة الأخرى الأبدية، ولذلك تجمع في هذه المقابر كل ما تملكه من ذهب وجواهر وأثاث ليكون مصدر سعادة بعد الموت، والأداة التي تستخدمها هذه الطبقة للحفاظ على مكتسباتها هي الدين، والتخويف من عذاب الآخرة، وذلك بأن تجعل الناس يؤمنون بأن الملك إله من سلالة الآلهة، ومن ثم لا يُسأل عما يفعل، وأن من يعصي الملك يعذب في الآخرة عذاباً أليماً.
لكن مثل هذه الحياة لا يمكن أن تستمر، لأنها حياة مختلة وغير متوازنة، وإرادة الحياة دائماً تعمل على إعادة التوازن الطبيعي، وهي تملك من القوة ما يمكنها من فعل ذلك، لأنها تملك سلاح العدل، فإذا تخلى أي حاكم هو وأفراد طبقته عن وظيفتهم في خدمة شعوبهم وإقامة العدل، وأصبحوا أنانيين لا يعملون من أجل سعادة الناس، ولا من أجل جودة الحياة، بل يسخرون كل خيرات بلادهم من أجل سعادتهم هم فقط، فإن الحياة تنتقم منهم على أيدي الضعفاء والمقهورين، وتحقق العدل سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة، هذه هي الحقيقة الخالدة، التي هي الذهب الحقيقي المخفي في سراديب الغفلة، إنها سنة الحياة في كل عصر وفي كل مكان، وقد تتجلى هذه السنة بطرق مختلفة وأشكال متنوعة، لكنها تظل حقيقة واحدة تتمثل في أن التوازن المختل لا يستمر، وأن الحاكم الذي يبدد ثروة بلاده في أعمال وهمية لا تفيد حياة أبناء بلده لا يكتب له البقاء.
طاقات مهدرة
وهكذا كانت الطاقات المصرية في هذا المجتمع الذي تصوره الرواية مهدرة في إقامة مشروعات لا تخدم الأحياء، بل هدفها خدمة الموتى، فكل هم الملك أن يسخر الشعب كله في بناء هرم عظيم يكون داراً أبدية له، وكل القرارات التي يتخذها الملك لا تراعي مصالح الفقراء، بل هدفها حماية الأغنياء والسادة، وإكساب أجسادهم الخلود بعد الموت، أما «الفقراء فلا يحصلون إلا على تحنيط رديء ويدفنون في حفر بلا نقش ولا رسم واحد على جدرانها، وبلا تابوت أيضاً، الأغنياء يحصلون على كل شيء في هذه الحياة وفي الأبدية أيضاً، الملك وأسرته ورجاله «(ص 25) أبناء الطبقة الغنية المترفة يبحثون عن الخلود/ الذهب، أما أبناء الطبقة الفقيرة العاملة فيبحثون عن البقاء على قيد الحياة والحصول على الطعام/ الذهب أيضاً، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكاتب يشير إلى أن اهتمام الطبقة الفرعونية الحاكمة بالذهب لم يكن بسبب قيمته المادية فقط، كما هو الشأن مع الطبقة الفقيرة، بل لأنهم كانوا يعتقدون أن الذهب هو ذاته تجسيد حي للخلود، فهو المعدن الذي لا يصدأ ولا يؤثر فيه الزمن، ومن ثم فإن صفة الخلود تنتقل منه إلى الأجساد التي تلتصق به فتبقيه ولا تتأثر بعوامل الزمن، من ثم كانوا يضعونه على وجوه موتاهم، أما عند الطبقات الفقيرة فالذهب أداة للنعيم الدنيوي، ولتوفير لقمة الخبز.
حقيقة غالية
هذا الاختلال في التوازن الاجتماعي أدى تلقائياً إلى الاختلال في التوازن النفسي لدى الشخصيات المظلومة، فتمردت على الواقع بل على الآلهة، وغرست في عقولها وصدورها بذور الحقد الطبقي، بل الشك في المسلّمات والعقائد الموروثة التي تمثل الرابط القوي بين الحكام والمحكومين، وهي الثروة الحقيقية للطبقة الحاكمة، عندئذِ تبحث الحياة بصورة تلقائية عن الوسائل التي تعيد لها التوازن من جديد، ولو أدى ذلك إلى انتهاك المحرمات والشك في العقائد الراسخة، بل اتباع (ست) إله الشر، فحرنخت يقول في نفسه: «لا أدري لِمَ نحتفي بالموت ونهتم به إلى هذه الدرجة وأمامنا الحياة مليئة بالمتع؟»، «هذا الذهب المكدس حول الموتى وكل أغراضهم؟ ماذا يتبقى للأحياء إذن؟» (ص 24)، ثم يقول: «هذه الشمس التي يقدسها الناس لماذا تعذبنا وتحرق جلودنا بهذه القسوة؟» (ص25)، ثم ينتهي به الأمر إلى أن يقنع نفسه بأن الحل هو سرقة الذهب من المقبرة الملكية، لأن ذلك لا يعد حسب رأيه سرقة، وينجح في ذلك، وتنتقم الحياة لنفسها، ويساعدها على ذلك غفلة الملك عن إدراك هذه الحقيقة الغالية التي هي الذهب الحقيقي، ويكون البقاء والخلود المتمثل في الذهب في النهاية في أيدي أحباب الحياة، حيث يستخدمونه في زراعة الأرض، وحيث «القمح هو الذهب الحقيقي» (ص 21) ويزول الذهب من أيدي أحباب الموت الذين يستخدمونه في بناء المقابر، هكذا نرى أن الخلود الذي يسعى إليه الملك لا يتحقق مع الظلم، فالملك في نهاية الرواية يعيش في الوهم بأنه إله مقدس، رغم أنه الوحيد الذي لا يعلم أن أمه قد انتهكت حرمتها وأن «ما حدث لأمه أمر مروع ومهين لأي رجل، لم يسبق لأحد من الأحياء أن تعرض له، ولا حتى لرجل من عامة الناس، إخفاء الحقيقة أرحم له من معرفتها» (ص 178).
وهم الخلود
وهنا تتسع دائرة الإشارات والدلالات الرمزية لكلمة «الذهب الواردة في عنوان الرواية، فهي إلى جانب إشارتها إلى الذهب الحقيقي الذي سرق من المقبرة تشير إلى معنى الخلود، فسرقة الذهب ترمز إلى ضياع وهم الخلود الذي كان الشغل الشاغل للملك وسائر طبقته، ويمكن أن تشير الكلمة إلى القداسة أو الهيبة الملكية التي تبددت أو الثقة التي فقدت، ويمكن أن يكون الذهب إشارة إلى الحقيقة التي تكشف عنها الرواية، فالرواية نفسها تحتوي على الحكمة الخالدة التي تكمن خلف سراديب من الرمز.
ويجسد الكاتب ملامح هذا الوجه الرمزي للحقيقة في الرواية بطرق فنية ماهرة، فهو يستخدم الكناية للتعبير عن الجو المحيط بالأحداث ولرسم الملامح الدقيقة للشخصيات، فحرنخت وأنصاره لا تجري أعمالهم وتحركاتهم إلا في الليل الحالك الذي لا يظهر في سمائه قمر، كناية عن الظلم والفساد الخفي، وهم يعملون وظهورهم منحنية، كناية عن القهر، ويمشون بحذر، كناية عن الخوف، ويمشون بعيداً عن الطريق المعبَّد، كناية عن الانحراف والتمرد، بينما يصور الملك وهو يسعى في ضوء النهار، كما أن الكاتب يهتم بتفاصيل الصورة الجسدية للملك والأمراء والحاشية، بينما لا يهتم بالوصف الجسدي للطبقة الفقيرة العاملة، بل بالجوانب النفسية، مما يجعل شخصيات الفقراء من أمثال اللص حرنخت وصديقه أونن نفر أكثر عمقاً وحيوية من شخصية الملك ورجال الحاشية.
إلى جانب هذين المستويين السطحي والدلالي في الرواية هناك مستوى ثالث هو الوجه الجمالي، ويتمثل هذا الوجه في عدة مظاهر، أبرزها المفارقة، فالملك كان يعمل جاهداً في بناء ما يظن أنه يحقق له ولأسرته البقاء والخلود، بينما هو في الحقيقة كان يعمل جاهداً في السعي إلى الفناء، أي بناء ضريح أو حفرة تكون مقبرة له ولأسرته، فهو يبني في الظاهر، لكنه في الحقيقة يهدم، وهنا يكون الهرم في ذاته مفارقة تجمع بين معنيين متناقضين، هما: الموت والحياة، وفي الوقت الذي ظن فيه الملك أنه بلغ ما يريده من الجمع بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة على حساب الشعب الكادح، كان الشعب الكادح نفسه هو الذي حقق ما يريده من الحصول على الثروة وانتهاك حرمة أم الملك وتحويل خرافة القداسة بل السلطة نفسها إلى سراب.
اللص الحقيقي
كما تبدو المفارقة في أن اللص الحقيقي في الرواية ليس هو اللص الذي سرق الذهب من المقبرة، بل اللص الحقيقي هو من سرق مقدرات الناس وجهدهم وباع لهم الوهم، عن طريق استنفاد طاقاتهم وثرواتهم وشغلهم بمشروعات لا تعود عليهم بالنفع ولا تحقق لهم الحياة الكريمة، وهنا يكون الشخص الواحد لصاً وليس لصاً في وقت واحد.
كما يتمثل الوجه الجمالي في الرواية في الإيقاع القائم على التوازي والتقابل والتشكيل الفني، ويظهر التوازي والتقابل بين طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، كما يبدو التشكيل الفني في التناغم الدقيق والمنتظم بين الوعي بما يحدث في الواقع وبين كينونة ما يحدث في الواقع نفسه، فالكاتب يقيم علاقة جدلية بين وعي كل من الملك وحاشيته وعامة الشعب بالأشياء والأحداث التي تجري في الواقع وبين كينونة هذه الأشياء والأحداث في وجودها الموضوعي، فالوعي الحقيقي هو إدراك لكينونة الواقع كما هي، أي عندما تكون الصورة التي في عقول الناس مطابقة لما يجري في الحقيقة، أما الوهم فهو إدراك غير حقيقي وتزييف للواقع وعدم التطابق بين الصورة التي في عقولهم وما في الواقع، فالملك وحاشيته يعرفون الحقيقة، وهي أن الملك ليس إلهاً، لكنهم يزيفون هذه الحقيقة في عقول البسطاء من الناس، ويصدرون لهم الوهم، بهدف السيطرة عليهم واستغلالهم، والفقراء يعرفون حقيقة ما آل إليه الملك، بينما الملك يعيش في حالة من الوهم بامتلاك السلطة، وكلما زادت مساحة الزيف في العقول ازداد الظلم والقهر، ومن ثم زاد الفقراء فقراً وتعاسة وازداد الأغنياء غنى ورفاهية، وكلما زادت درجة الوعي تحقق العدل، وازداد الفقراء سعادة.
لوحة فنية
وهكذا نرى أن الكاتب يرسم من هذه العناصر لوحة فنية ذات ثلاثة أبعاد، البعد الأول عرضي طرفاه الوعي وغياب الوعي، والبعد الثاني طولي طرفاه العدل والظلم، أما البعد الثالث فهو في العمق وطرفاه السعادة والشقاء، ومن هذا التقابل ينشأ صراع خفي من نوع خاص، مصدره أن الساسة الذين يعملون مع الملك أذكياء ويعرفون الحقيقة لكنهم يتغافلون عنها للحفاظ على مكتسباتهم الشخصية، لكن المحرومين من عامة الشعب كانوا أكثر ذكاءً.
ومن الجوانب الجمالية في الرواية الالتفات السردي الذي تميز به أسلوب محمد العون ليس في هذه الرواية فقط، بل في رواياته السابقة، ويعتمد هذا الأسلوب على الإيقاع الثنائي الذي يعتمد على تعشيق زاوية رؤية الراوي العليم بزاوية رؤية الشخصيات، فهو في الوقت الذي يستثمر فيه المعرفة الواسعة للراوي العليم لا يتخلى عن الرؤية المنظورية للشخصية التي يتعلق بها الحدث، عن طريق الاحتفاظ بأسلوبها وبمستواها اللغوي المعروف، فنسمع صوتين في وقت واحد، صوت الراوي وصوت الشخصية، مثال ذلك قوله: «الغنيمة كبيرة تستحق المخاطرة، يمكن للرجل أن يبقى ثرياً إلى آخر حياته، لو تمكن من الحصول عليها، لكن الأمر ليس سهلاً، بل في منتهى الصعوبة، والخطورة أيضاً، الإنسان لا يحصل على شيء بلا مقابل في هذا العالم، لا بد من العمل الشاق لأيام متواصلة» (ص 5)، هذه الفقرة تجمع بين أسلوب حرنخت اللص في احتوائها على تطلعاته للثراء وملامح من مناجاته لنفسه وهو يفكر في السرقة، لكنها في الوقت نفسه ليست بضمير المتكلم، بل تندرج في إطار السرد بضمير الغائب الذي ينتمي إلى الراوي العليم.
وهكذا نرى أن الكاتب نجح بمهارة في رسم لوحة فنية جميلة ثلاثية الأبعاد، كشف فيها النقاب عن وجه من أوجه الحقيقة ■

