تجربة الألم
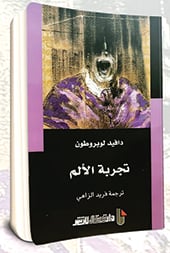
تكتسب أبحاث العالم الأنثروبولوجي الفرنسي دافيد لوبروطون أهمية خاصة، ضمن حقل العلوم الاجتماعية المعاصرة، وذلك بالنظر إلى جدة وعمق القضايا التي يشتغل عليها، وتفرد مقاربته لها، حيث عرف باهتمامه بمجالات هامشية، لا ينتبه لها علماء الأنثروبولوجيا، وعلماء الاجتماع إلا فيما ندر، ونخص بالذكر منها لا الحصر بحثه الموسوم بـ «تجربة الألم»، الصادرة ترجمته العربية حديثًا، عن دار توبقال للنشر والتوزيع (المغرب - 2018)، بقلم الباحث والمترجم المغربي فريد الزاهي.
يبسط الزاهي في الكلمة التي خصها لهذه الترجمة مجموعة الدوافع التي جعلته ينكب على نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية، مركّزًا أهمها في سعيه الحثيث إلى الإسهام في تبديد الشح والهزالة اللذين يحيطان باستقبال النصوص الكبرى التي تهم الجسد واليومي على مستوى حقل العلوم الاجتماعية، إذ لا تولي هذه الأخيرة في العالم العربي اأهمية كبرى للجسد واليومي، مديرةً الظهر للظواهر الفردية التي يعيشها الإنسان، فالعلوم الاجتماعية لا تختص فقط بالجمعي، بل بالفردي، ولا أدل على ذلك من أن رائد علم الاجتماع إيميل دوركايم، خصص دراسة مرجعية مهمة عن ظاهرة الانتحار في بدايات القرن الماضي، التي صارت تستشري بين الشباب منذ مدة في بلدان العالم العربي، من غير أن يتم الاهتمام بها وبعللها وطبيعة ممارستها والألم الشخصي والاجتماعي الثاوي وراءهاب.
يبرز لوبروطون أن هذا المصنف هو امتداد لمصنفات سابقة، حين يؤكد قائلاً: «الكتاب امتداد لكتاب أنتروبولوجيا الألم (1995)، الذي أعيد طبعه سنة 2004، والذي ألحَّ بالأخص على البعدين الاجتماعي والثقافي للألم.
ومنذ الطبعة الأولى لذلك الكتاب، لم أكتفِ فقط بمتابعة تلك الأبحاث في سياق المرض أو الحوادث، بل تابعت أيضًا الأبحاث الخاصة بالسلوك ذي المخاطر لدى الشباب (2002، 2003، 2007) والرياضة القصوى (2002)، وفن الجسد والطقوس المعاصرة لتعليق الجسد (2003).
إن هذه الأوجه المتعددة للألم توسع من فهمه بتبيان التنويعات الهائلة للإحساس به». ومن ثم فعلى القارئ إن أراد الإمساك بخيوط المعاني والدلالات المتشعبة داخل هذا المصنف أن يستحضر نتائج هذه الأبحاث.
رحلة ممتعة
على امتداد مئتي صفحة، يطوف بنا لوبروطون، في رحلة ممتعة داخل عوالم الألم، انطلاقًا من أبعاده المادية، المتمثلة في المرض أو التعرض لحادثة، وصولاً إلى أبعاده الرمزية المتمثلة في العذاب النفسي الذي يهدد هوية الفرد، مستنطقًا بذلك أنواع الألم القسرية والطوعية، وطرق ووسائل تملّك الألم وضبطه وترويضه، إذ يعالج تجربة الألم والطريقة التي يعيش بها الأفراد ويحسون بها، ويحاول الاقتراب ما أمكن من الشخص، ليحقق فهمًا دقيقًا حول الحياة الفردية المَعيشة، وذلك بالاستناد إلى أدوات البحث الأنثروبولوجي.
يسعى لوبروطون إلى الكشف عن مجموع التمفصلات التي تسكن العلاقة القائمة بين الألم والعذاب، إذ باستثناء الفصل الأول المعنون بـ «لا وجود لألم من غير عذاب»، والذي صور فيه الألم كتجربة تقود إلى العذاب، كالذي يعيشه الشخص في أثناء المرض أو مخلفات الحوادث أو التعذيب، يصر لوبروطون على تصوير الألم، كضرورة وجودية تتعالى على العذاب لتحصيل اللذة وتحقيق الذات، والمتعة، والتفتح الذاتي، خصوصًا في فصول الكتاب الموالية، التي جاءت عناوينها كما يلي: الألم والمعنى/ ألم ضروري للوجود /الألم والتعذيب، تهميش الذات/ اشتغال الألم، الألم الملتبس: الوضع/ الألم ضد العذاب.
مادة أولية
يرجع ذلك إلى اعتقاد لوبروطون في أطروحة أساسية مفادها أن «الألم المطلوب أو المَعيش من خلال السلوك ذي المخاطر أو حزّ الجسم هو من طبيعة مغايرة للألم الملم بالمريض مثلًا. فالرياضي الممارس للرياضات القصوى، أو الرياضي في المسابقات أو خلال التدريبات هو امرأة أو رجل يقبل بالألم باعتباره مادة أولية لمنجزاته، فيسعى إلى ترويضه وكبحه، ويعلم أنه إن لم )يهاجمه بكل قواه) ، فسيكون ذلك من باب التهور.
أما الشخص الذي يعلّق نفسه بمعلاق من الحديد في الصدر، فإنه يسعى إلى النشوة أو إلى عيش تجربة روحانية.
وفي سجل آخر، تبين تجربة وضع الحامل لحملها عن لَبس قوي، حيث إن بعض النساء يعشنها باعتبارها عذابًا لا يُحتمل، والأخريات بوصفها إحساسًا لا يُنسى، لكن لا علاقة لها بالألم. ثمة أيضًا من يبحث عن النشوة الجنسية من خلال تمارين متنوعة للقسوة في الممارسات السادومازوشية. الألم متراكب كالدمى الروسية. ما إن نفتح واحدة حتى تظهر أخرى، وهكذا دواليك.
بالجملة فإن أوجه الألم لا حصر لها، اغير أنه لا تفوتنا الإشارة إلى أن نؤكد مع لوبروطون أن هذا البحث بعيد كل البعد عن كل أنواع التصوف، إذ بالإمكان القول إن المرء، رجلًا كان أو امرأة، بإمكانه أن يعرِّض نفسه لمختلف أنواع الحرمان الفظيع، وأن يعيش مختلف أنواع الجروح، ليس بما هي عذاب، بل بما هي ضرب من ضروب التلذذ، تبعًا لاعتقاد مفاده أن هذه المحن قد تقربه من الله.
قول كهذا لا يدخل ضمن دائرة اهتمام هذا الكتاب، بيد أن لوبروطون أفرد لهذا المستوى من النقاش كتابًا خاصًا يحمل عنوان «أنثروبولوجيا الألم»، صدر سنة 2001.
خاصية جوهرية
تنطوي تجربة الألم على خاصية جوهرية، تجعله لا يمنح الشهية في أي شيء، إذ سرعان ما يستأصل الإنسان من فضاء عاداته القديمة، ويدفعه مكرهًا إلى التملص والانفلات من ذاته، ليعيش مغتربًا عنها، فيما يشبه الحداد على الذات، دون أن يتيح له أدنى إمكانات الالتحاق بها مرة أخرى.
وفي الوقت نفسه، يستأنف العذاب توسيع وتمطيط هذا الانزياح، ليشمل الوجود بكامله، مما يجعل العذاب جزءًا من الألم، أو وظيفة للمعنى الذي يكتسيه الألم، إنه بعبارة أدق، العنف الذي يخضع له الإنسان.
ومن أجل ذلك فإن «الألم يكون دوما متضمَّنًا في عذاب معيّن، إنه منذ البدء ألم وعدوان لا يطاق إلى هذا الحد أو ذاك. العذاب هو الصدى الحميم للألم، ومقياسه الذاتي. إنه هو ما يفعله الفرد بألمه، وهو يشمل مجمل سلوكه ومواقفه، أي استسلامه أو مقاومته للانصياع لتيار الألم ومصادره الجسمانية والمعنوية ليصمد أمام المحنة. العذاب ليس امتدادًا لتشوه عضوي، لكنه هو نشاط للمعنى لدى الإنسان الذي يتعذب.
وإذا كان الألم زلزالًا حسيًّا، فإنه لا يصيب إلا بمقدار العذاب الذي يؤدي إليه، أي المعنى الذي يتسم به.
لنذكّر بهذا الصدد بتعريف بول ريكور، الذي يعتبر أن الألم ينطبق على )الأحاسيس التي تعاش باعتبارها متموقعة في أعضاء خصوصية من الجسد أو في الجسد بكامله، وأن العذاب لفظ يحيل على أحاسيس منفتحة على الانعكاسية واللغة والعلاقة بالذات والعلاقة بالغير والعلاقة بالمعنى وبالتساؤل).
الألم إذن، تجربة تُعاش، وقوة لا يتلمّس مفعولها إلا من يحس بها، بيد أن الألم شأنه شأن المرض أو الموت، فدية للبعد الجسماني للوجود، إنه حظوة الشرط الإنساني والحيواني ومأساته، ورغم أنه ضرورة يشترك فيها جميع الناس، فإنه يظهر دومًا للشخص الذي يعيش تجربته وكأنه معطى دخيل على ذاته، «هذا الألم لم نكن نتصوره قبل أن يصيبنا. ونحن، بعد أن ألمّ بنا، بالكاد نستطيع تصوره باعتباره ألمًا» ■

