سويلم ومذكرات الفتى الشاعر
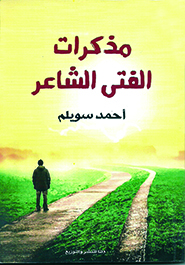
لم يتحدث الشاعر أحمد سويلم كثيراً عن نفسه في هذا الكتاب الذي أسماه «مذكرات الفتى الشاعر»، والذي تساءل عنه قائلاً: «هل هذه المذكرات هي سيرة ذاتية؟ أم لقطات من الذاكرة البعيدة والقريبة، أم إضاءات حول بعض المواقف والشخصيات التي لاقيتها في حياتي أحكيها ببساطة وعفوية»؟
في واقع الأمر، أنا أميل إلى استبعاد الكتاب عن دائرة السيرة الذاتية، لأنني لم أجد أحمد سويلم كثيراً به، فهو يتحدث عن الشخصيات التي أثرت في حياته وفي مشواره الإبداعي والإنساني والوظيفي، وربما يلقي عليها الضوء أكثر من إلقائه على نفسه، كما نرى في كتب السيرة الذاتية الأخرى، مثل «الأيام» لطه حسين، أو «الخبز الحافي» لمحمد شكري،
أو«أنا» للعقاد، وغيرها.
قسّم أحمد سويلم كتابه إلى قسمين: مذكرات الطفولة، وشخصيات القامات العالية. ولعلنا نجد في القسم الأول الذي استغرق حوالي 45 صفحة ملامح من السيرة الذاتية، التي تحدث فيها الشاعر بصيغة الغائب وعبّر عن نفسه
بـ «الفتى»، ويرى أن في ذلك حرية أكبر وبعداً عن النرجسية والمبالغة، وهو ينهج في ذلك نهج طه حسين في «الأيام»، الذي كان يطلق على نفسه «الصبي» أحياناً و«الفتى» أحياناً أخرى.
وقد روى الشاعر أنه كان أكبر إخوته الصغار، لذا أحس بالمسؤولية تجاه والدته وإخوته طوال حياته، سواء في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أو عندما انتقلت الأسرة للعيش بالقاهرة، بعد أن انتقل الشاعر للعمل فيها بدار نشر.
كما يشرح لنا كيف اكتشف موهبته الشعرية في فصل «أحلام كبيرة في عقل صغير»، حيث «فجأة هاجم الفتى شيطان الشعر، جذبه كثيراً من مذاكرته، لكنه سرعان ما كان يتذكر مسؤوليته القادمة، فيخفي أوراقه وقصائده».
وفي لمحة ذكية يحكي لنا سويلم كيف تبدت العلاقة بينه وبين والدته عندما أحست الأم بأن هناك شيئاً ما يصرف ابنها عن المذاكرة، فيكتب قائلاً عن الفتى: «يتذكر كيف كانت أمه تدخل عليه، وهو يجلس متربعاً على السرير وأمامه حقيبته الخشبية، متخذاً منها متكئاً لكتابه الذي يذاكر فيه ذ وتدخل الأم ذ وهي مثل كل أمهات ذاك الجيل أميّة لا تعرف القراءة ولا الكتابة - لكي تطمئن عليه.
لكن الفتى كان يندهش حينما تدخل عليه وهو يكتب الشعر. فتدرك أمه ذلك وتصيح في وجهه: مش وقته يا ابني. ذاكر الأول وبعدين اكتب الشعر اللي بيعطلك ده. يندهش الفتى: كيف أدركت الأم الأمية أنه يكتب الشعر ولا يذاكر؟ لابد أن إحساس الأم بولدها أعمق وأصدق كثيراً من أي شيء آخر».
وقد كان سويلم واقعياً في استخدامه العامية المصرية على لسان الأم غير المتعلمة أو الأمية، ثم يعود إلى الفصحى عندما يتكلم هو أو يعلّق على كلام الأم.
ثم يتحدث الكاتب عن «الفتى والبيت البسيط» و«براءة الدهشة», حيث أدهشنا من خلال شرحه لكيفية استقبال جهاز الراديو الذي يغني فيه محمد عبدالوهاب وأم كلثوم، فيتساءل: من أين يأتي هذا الصوت؟ ويظن أنه سيرى عبدالوهاب من خلال فتحة الراديو، بينما المرأة فمن المؤكد أنها تغني من وراء حجاب، لذا لن يستطيع أن يراها.
ويشب فوق أطراف أصابع قدميه ويثبت عينه اليمنى فوق الفتحة، لكنه لم ير شيئاً. فيغلق الجهاز بعصبية غاضبة، ويتكور فوق الكنبة في كآبة شديدة.
ويتذكر الفتى الشاعر ندوة الشيخ عبدالهادي التي تعلّم من خلالها أدب الحوار والنقاش، وكان صاحب الندوة يفخر بنفسه بأنه لا يحمل أي شهادات سوى شهادتين: أنه مسلم وشهادة الفقر.
كما يتحدث عن أول إحساس عاطفي تحت عنوان «نبضة قلب في غير وقتها» حينما عاش وهم أن هناك فتاة سمراء تبتسم له من نافذتها، ولم يعرف عنها أي شيء، فبدأت تتحرك داخله أشياء مختلفة عن إحساسه بأمه وأخته، وحتى لأخت الطبيب اليوناني جورجي، الذي كان يذهب إلى منزلها فتلعب معه وتحكي له بلسانها الملتوي بالعربية، وتغني له أغنية ليلى مراد «الدنيا حلوة»، وكان صوتها جميلاً.
من تلك اللقطة الأخيرة وعلاقة الفتى سويلم البريئة بالفتاة اليونانية نستطيع أن نستخرج هذا الإحساس بالآخر غير العربي والانفتاح على العالم الذي تتصف به أعمال الشاعر عامة.
ولعل الدارس لشعر أحمد سويلم يستطيع التوقف عند هذه الجزئية الصغيرة التي ذكرها بعفوية تامة، ليستنتج منها كثيراً فيما وراء شعر الشاعر.
وقد بخل سويلم علينا بالمزيد من علاقته بالفتاة اليونانية، فهل هنالك شيء مسكوت عنه لم يرد لنا الاطلاع عليه، فهرب سريعاً إلى فتاته السمراء التي تبتسم له من وراء النافذة، ففجّر شيئاً كامناً في لاوعيه، يقول: «لابد أن اللاوعي الغامض كان يحس بشيء تفجر فيما بعد شعراً وحباً!».
إذن علينا أن نبحث في شعر سويلم عن تلك الفتاة السمراء التي أيقظت شيئاً حقيقياً داخله.
وتمضي الأيام بالفتى سويلم، فيحدثنا عن «شجرة التوت» التي تلقَّى بسببها ضرباً وصفعاً من صاحب الحقل، عندما تسلّق الشجرة، فوجد الرجل يقف أسفلها، بعد أن هرب أصدقاؤه الأطفال؛ ومن يومها قرر الفتى ألا يأكل توتاً طوال عمره. هل سنجد ذكراً للتوت في أعمال سويلم؛ سواء للكبار أم للصغار؟
كما يحدثنا عن «الصديق جرجس»، حيث كان الفتى يؤمن بالصداقة، وكان أصدقاؤه يعتزون به لأنه شاعر حساس، وخاصة جرجس الذي رحل في صباه، فحزن عليه الفتى حزناً شديداً، وكتب عنه قصيدة نشرها في إحدى مجلات الحائط المدرسية، فقامت أسرته بدعوته ليلقي قصيدته في كنيسة بيلا في ذكرى الأربعين، لكنه انخرط في البكاء حزناً على رحيل صديقه، ولم يستطع إكمال قراءة القصيدة.
هكذا كانت صداقة الفتى مع أصدقائه من مسلمين ومسيحيين وغير مصريين. وتظل هذه سمة من السمات الكبرى في شخصية أحمد سويلم التي أعرفها عن قرب.
ويذكر سويلم كيف أن إحدى قصائده عن الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم أشعلت تظاهرة في مدينته، حيث ألقى قصيدة عام 1958 في إذاعة المدرسة مطلعها:
يا قاسم التوحيد يا بئس الأعادي والجناةْ
قسَّمت أحرارَ العراقِ وسرتَ في أزكى دماه
فوقعت القصيدة في قلوب التلاميذ، وفجَّرت فيهم الوطنية، وتعالت الهتافات وتحرك الجميع إلى أبواب المدرسة وخرجوا في تظاهرة قوية، فخرجت كل مدارس بيلا على إثرها للمشاركة في الهتاف ضد قاسم العراق.
وهنا دلالة أكيدة على أن الشاعر سويلم - منذ صغره - شاعر عروبي يهتم بقضايا الوطن الأكبر ويعيش محنه وآلامه، وأن له رؤى سياسية تصب في مصلحة الوطن دائماً، وهو ما نراه يتجلى بعد ذلك في معظم قصائده ودواوينه المتتابعة.
واللافت هنا أن إدارة المدرسة كانت واعية للأمر، ولم تعاقب الفتى الذي أشعل التظاهرات سوى بحرمانه من الإذاعة أسبوعاً، فقط لأنه لم يعرض القصيدة على مشرف الإذاعة.
هكذا تمضي حياة الفتى الشاعر وصولاً إلى القاهرة، حيث تحقيق الحلم، سواء حلم العمل في دار نشر خاله محمد المعلم، واستكمال دراسته الجامعية، أو تحقيق الحلم الشعري بالكتابة والنشر على مستوى كبير، متصدراً المشهد الشعري المصري منذ عام 1964، فكانت أول قصيدة ينشرها في إحدى المجلات البيروتية من دون واسطة، ثم تقدم بها إلى وسائل النشر بالقاهرة واثقاً بخطوه وإبداعه.
في الباب الثاني من الكتاب «شخصيات القامات العالية» (ويقع في حوالي 100 صفحة) يمضي الفتى في حكاياته عن شخصيات التقاها وقابلها، وأصبحت مؤثرة في حياته الشخصية والأدبية بطريقة أو أخرى، وبلغ عددها في الكتاب إحدى عشرة شخصية: أنيس منصور (القلم الرشيق)، توفيق الحكيم (اليقظة الفكرية)، يحيى حقي (سيمفونية العشق)، صلاح عبدالصبور (الشاعر الإنسان)، د. عبدالقادر القط (شيخ النقاد)، عباس محمود العقاد (شموخ الشخصية)، سعدالدين وهبة (الفارس الذي مات واقفاً)، عبدالرحمن الشرقاوي (القامة الشعرية العالية)، طاهر أبوفاشا (آخر ظرفاء العصر)، د. أحمد مستجير (زراعة الفقراء)، محمد المعلم (الفارس المعاند).
ويؤكد سويلم أن هذه الشخصيات لم تكن هي التي حفرت في ذاكرته فحسب، فهناك شخصيات أخرى ليست أقل من هؤلاء قيمة وتأثيراً، ولكن مواقفه معها قليلة، وربما مرت به أو مرَّ بها سريعاً، ومنها ثروت أباظة، ونجيب محفوظ، وفاروق خورشيد، وأمل دنقل، الذي كانت بينه وبين الفتى علاقة محترمة، حتى أنه جاء ليستشيره في زواجه بعبلة الرويني، كما جاءت هي الأخرى لتسأل سويلم في الموضوع نفسه.
بالإضافة إلى شخصيات أخرى عربية وعالمية مر عليهم سريعاً.
ولا شك في أن القسم الثاني من الكتاب لا يؤرخ لحياة أحمد سويلم بقدر ما يؤرخ للحركة الأدبية والثقافية في مصر، ومن هنا تأتي «مذكرات الفتى الشاعر»، لتكون شهادة شاعر على جيله وعلى عصره وعلى مصره. إنها بالفعل إضاءات حول بعض المواقف والشخصيات التي لقيها الشاعر في حياته، تحدث عنها بكل بساطة وعفوية بلغة سردية سهلة شائقة ومشوِّقة.
ولعله في الجزء الثاني من تلك المذكرات يقدم لنا الكثير الذي لم يقله من قبل، ولم نعرفه بعد عن الشاعر وعصره والمزيد من مفاتيح شعره ونثره.
وفي النهاية أتساءل: ترى لو ركز الفتى حكاياته على جانب النشر والطباعة فحسب، وصنع منه عالماً روائياً واقعياً ومتخيلاً يتعاطى من خلاله الكلمة وكيف تخرج إلى عالم النور من خلال المطبوعات المختلفة من مجلات وجرائد وكتب، وكشف لنا عن الخبايا والمسكوت عنه والمهمَّش في تلك المهنة، والصعوبات التي يلقاها من يعمل فيها وعلاقته بزملائه والكتَّاب والأدباء والمثقفين من أصحاب الكلمة، وكذا أصحاب دور النشر المختلفة، سواء الخاصة أو الحكومية، وأصحاب مصانع الورق والأحبار والخامات اللازمة للطباعة، وكذلك تشابكات المجتمع من حوله، من واقع تجاربه الشخصية، وتوظيف لقاءاته بنجوم الفكر والثقافة والكشف عن شخصياتهم من خلال الوصف والحوار والسرد، ترى هل كان سينجح في تقديم عمل روائي جديد تتضافر فيه السيرة الشخصية مع سيرة متخيلة؟
أعتقد أن الفتى كان سينجح في ذلك، فهو صاحب قلم وموقف وصاحب رؤية وكلمة■

