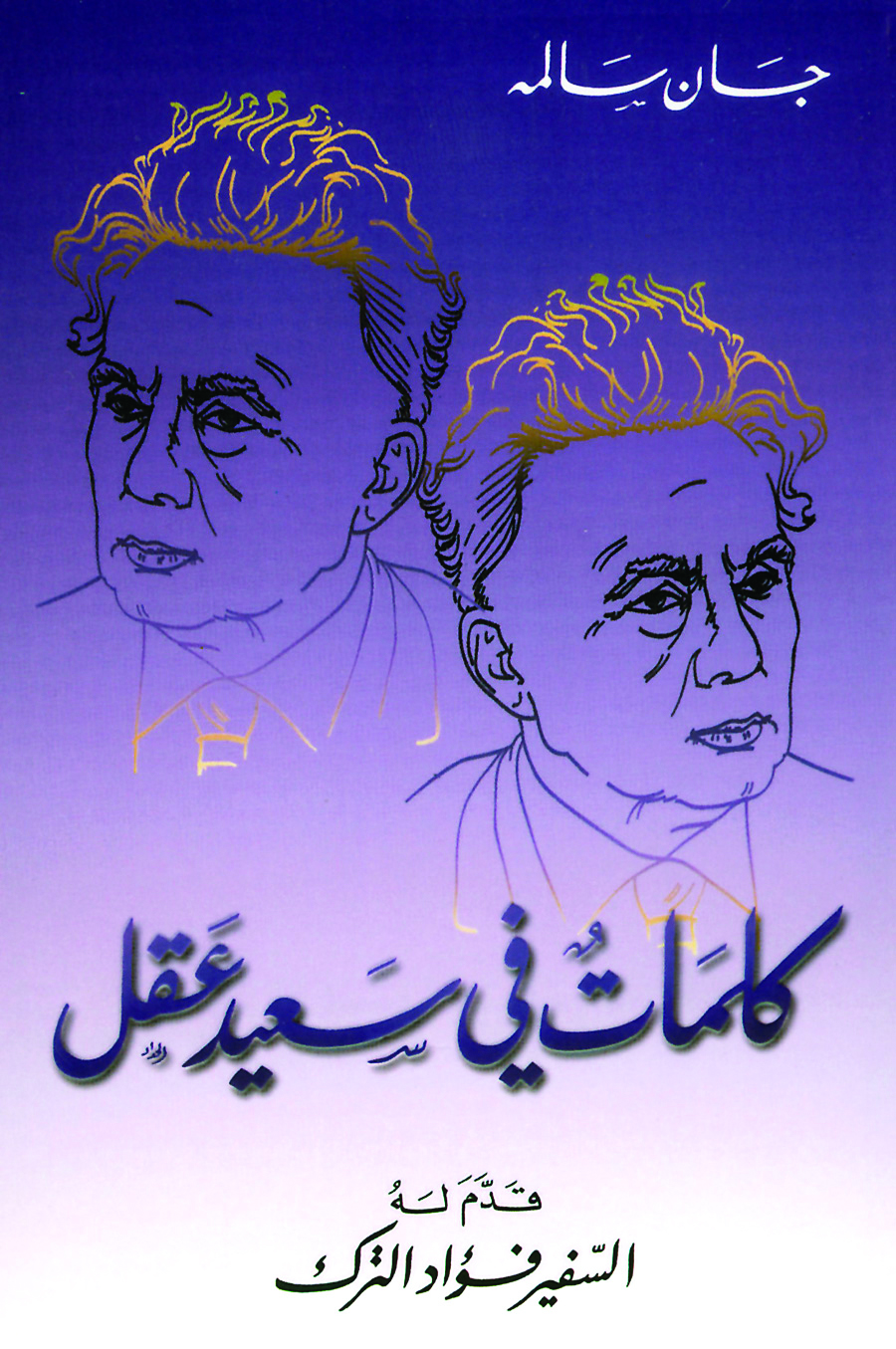سعيد عقل شمس الشِّعر لا تغيب
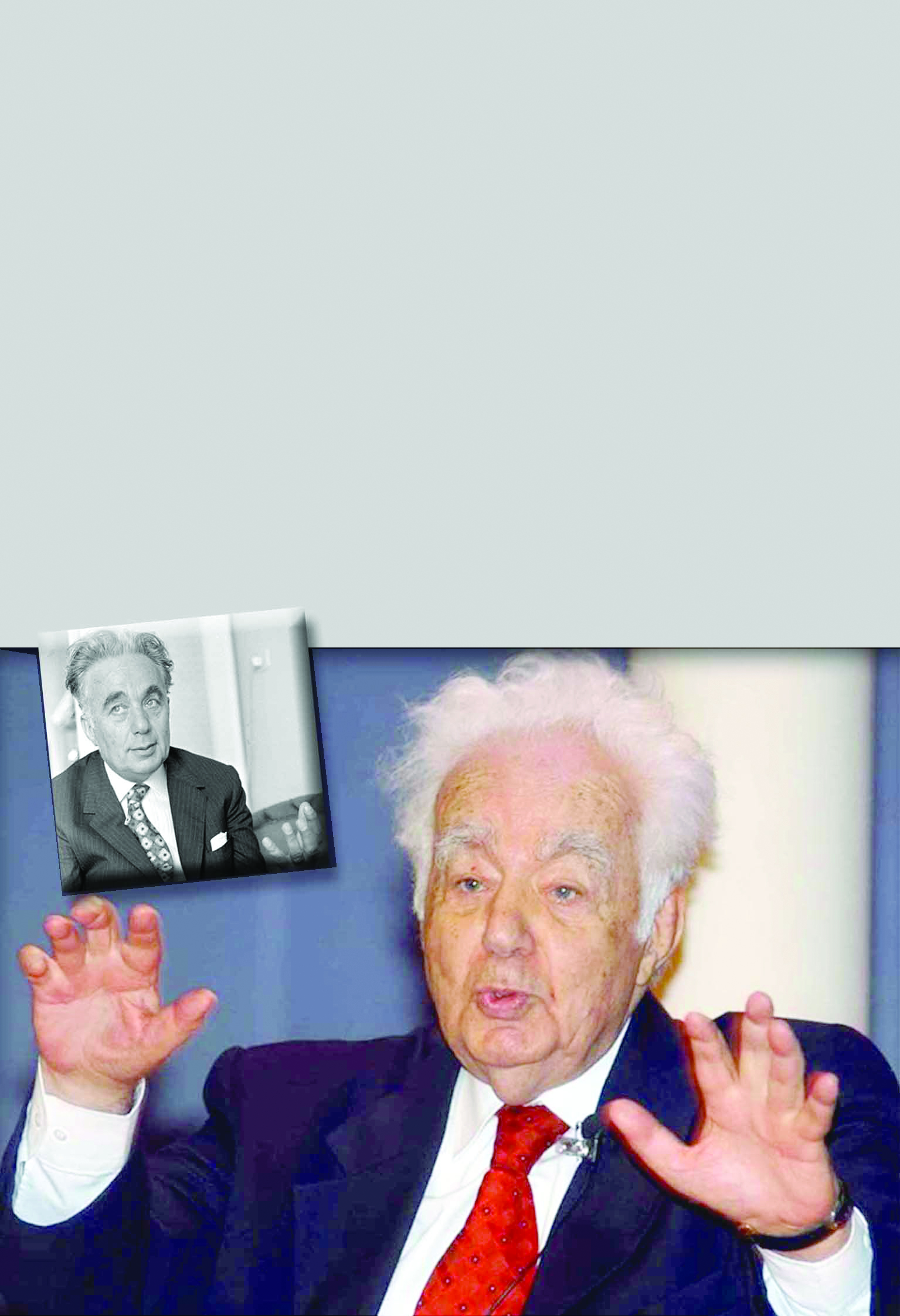
لكأنما كان يعنيه أبو تمام بقوله:
راحت وفود الأرض عن قبره
فارغة الأيـــدي مِلَاءَ القــــلوبْ
قد علمــــتْ ما رزئـــــت إنما
يُعرف فقد الشمس بعد الغروب
ذلك أن مفردة «الشمس» في المتن الشعري لشاعر العربية الراحل سعيد عقل إحدى اللبنات الأثيرة في معماره الشعري، الشمس وهي تغمر التلال، والشمس وهي ترتمي على أهداب أنثى، والشمس وهي - حتى - تغرب في عُقَد الأصابع.
وعلى مدار رحلة عمْرية أربت على قرن من الزمن، ومسيرة فنية أبدعت مزيجاً فريداً من أمشاج أدبية تراوحت بين القصيدة والحواريات الشعرية والمدبجات النثرية، من «بنت يفتاح» و«المجدلية» و«قدموس»، إلى «رندلي» و«أجمل منك؟ لا» و«أجراس الياسمين» و«قصائد من دفترها»، ومن «غد النخبة» إلى «لبنان إن حكى» و«كأس لخمر» و«كتاب الورد».
باقات من النظيم والنثير طوقت جيد «العربية» بقلائد من نور تجعل صاحبها - بحق - شمساً لا تغيب.
سعيد عقل والنظرية الرمزية
في مفهوم الشعر
يتفرد سعيد عقل، بين شعراء العربية المحدثين، بأنه لم يقتصر على محاولة تطبيق وسائل الأداء الرمزي، تأسيًا بأفذاذ هذه النظرية من الشعراء الأوربيين - الفرنسيين بخاصة - من أمثال بودلير وفيرلين ومالارميه، بل حاول تقرير هذه الوسائل وفلسفتها في مقالاته وكتبه ومقدمات دواوينه، أي أنه جاهد أن يصنع ما يصنعه رواد المذاهب والاتجاهات الأدبية من التمهيد لها بنقد نظري يشرح معالمها وخصائصها الفنية، فالقصيدة - فيما يرى - «مأثورة كلامية توصلت بتجارب موصولة إلى فِلَذ، إلى أبيات، إلى مجموع إيحائي يعطل بتعددية الأصوات وعي المتلقي، ويتكوّن في لا وعيه بأكثر مما يمكن من مساواة لحالة الشاعر جوهراً وشكل جوهر».
وواضح أنه في حديثه هذا عن القصيدة بوصفها «مجموعًا إيحائيًا يعطل وعي المتلقي» يمتاح من المصادر الرمزية التي آمنت بأن وظيفة القصيدة لم تعد مقصورة على التعبير عن حقائق النفس أو الوجود، وإنما أصبحت توليد المشاركة الوجدانية بين الشاعر والمتلقي عن طريق الإيحاء، وكذلك عن طريق الاعتماد على الموسيقى اللفظية في خلق مناخ شبيه بالمناخ النفسي للشاعر.
واللاوعي عند سعيد عقل هو منبع الحالة الشعرية من ناحية، ثم هو - من ناحية أخرى - أصلح الظروف النفسية التي يمكن فيها للمتلقي أن يستقبل كل عطاء القصيدة وإشعاعاتها الغنية، لأن وضع القصيدة في منطقة «الضوء المنطقي» - يعني الوعي - يحد من قدرتها على نقل واقع النفس بكل ما فيه من اضطراب وتناقض، ومن ثم نراه يقول: «أرى أن اللاوعي رأس حالات الشعر، ورأس حالات النثر الوعي. قبل إبداعي الشعر، بل في ذروة إبداعي، لا أكون واعياً في ذاتي ولا واحدًا من الأشياء الواضحة، والثابت أن لا أثر فكريًا ذا قيمة، رياضيًا كان أم سياسيًا، موسيقيًا أم شعريًا، تحقق في الضوء».
ونحسب - من جانبنا - أن الفكر، وهو وليد الوعي، لا يضاد الفن الشعري على إطلاقه، شريطة أن يستطيع الشاعر تحويل الفكرة الواعية إلى صورة موحية تشف عن الفكرة ولا تقررها تقريرًا برهانيًا جامدًا.
ثم إن تعطيل الوعي - كما يفهمه سعيد عقل - هو في حد ذاته عمل إرادي يحتاج إلى كثير من الدربة والمكابدة، كما أن كل عمل فني بحاجة إلى قدر من الوعي والتنظيم والإدراك الكلي، على الأقل في مرحلته الأولى، حين يكون ما يزال كائناً جنينياً يحاول التكون والانبثاق.
ولأن عناصر الوعي - وفق سعيد عقل - لا تلعب في الشعر دورًا ذا خطر، فإن الفكرة والصورة والعاطفة إنما هي نثر الحالة الشعرية وليست الحالة الشعرية ذاتها، لأن النثر في طبيعته وعي بوعي، أما الشعر فلا. «الشاعر في ذروة إبداعه - يقول عقل - لا تخامره أفكار أو صور أو عواطف، وهو إن خامره شيء منها أفسد عليه العمل. عناصر الوعي - ولم أستثنِ العاطفة صنم النّظامين الأفذاذ - لا تلعب في الشعر أي دور».
وكلامه هذا - من حيث مفهوم الشعر - لا يكاد يخرج في جوهره عما كان يراه مالارميه - رائد الرمزية - من أن العمل الشعري استنفاد للموضوع والصورة واللفظ داخل عملية الإبداع الفني، كما أنه يشبه ما علق به جوستاف كوهين على شعر بول فاليري، حين قرر أن الأفكار المستوحاة من العمل الشعري ليست هي العنصر الجوهري، ولكنها تتعاون مع الأصوات والإيقاعات في إثارة ضرب من النشوة النفسية.
فلنرَ إلى أين بلغ بنا الشاعر في مسيرته تلك نحو مفهوم جديد للشعر...
اللاوعي رأس الحالة الشعرية، والعناصر النثرية من فكرة وصورة وعاطفة لا تلعب في الشعر دورًا ذا بال، لأن مادة الشعر جوهر أشبه بجوهر الموسيقى. كيف إذن يتسنى للشاعر أن يوحي بهذا الجوهر ما دمنا قد رفضنا فاعلية ما أسماه بالعناصر النثرية؟!
إن ذلك - فيما يرى الشاعر - يتم بوسيلتين تتواكبان معًا في العمل الشعري، أولاهما: تعطيل قوى الوعي عن طريق إلهائه بالأصوات المتعددة يحاول اللحاق بها جميعًا، حتى يصيبه الكلال، فيترك المجال لقوى اللاوعي منفردة، وثانيتهما: خلق تركيب صوتي يتساوى فيه جوهر الحالة الشعرية مع الشكل اللفظي، ذلك أن الألفاظ فقدت إيحاءها الطبيعي بالمواضعة والاصطلاح، وعلى المبدع أن يعيد إليها ما فقدته، فمهمة الفن أن ينتقي ويرتب بحيث يوجد تركيبًا كلاميًا يعيد بين لغة الشعر وما توحي به رابطة عضوية سبق للتدخل العقلي أن فصمها، وبقدر ما يوفق الفن إلى ذلك تكون درجة الخلوص في الشعر.
تجربة سعيد عقل الشعرية
التجربة الجوهرية في شعر سعيد عقل - إذا جاز التعميم - هي محاولته الدائبة أن يتخطى الجزئي إلى الكلي، والخاص إلى العام، وأن ينفذ من الواقع المحسوس إلى ما وراء الواقع المحسوس، ففي مطولته الشعرية المعنونة «المجدلية» (الطبعة الأولى سنة 1937) نراه يحاول الإيحاء بهذه الدلالة الفريدة، وهي أن التوبة جنين ينبثق من ظلام الخطيئة، وكأنه في هذا يستلهم روح التراث المسيحي، أو كأنه يفسر ما قاله يوما من أن «الكون الرهيب الصمت نادراً ما انفتح بابه للطائعين»، وهو للإيحاء بهذه الدلالة يتخذ من المجدلية - الغانية التي أرادت إغواء المسيح فصدها في رفق كان بدء توبتها - رمزًا للهداية عن طريق التجربة الحسية التي تمثّلها هذه الأبيات:
عرف الـــناس شهوة الحب في نديان جسم مخضوضر اللذات
مرّغوا في أريجه الجــــبهة البيضاء، واستوقفوا الهنيهة بِكْرا
واستلذوا نبض الأسرّة، وانهدّوا هَيَامى على جنى الطــــــيبات
وتغنوا مع الجمال، وهزوا لذة الوصل في ســـــــرير الحـــياة
من صبا المجدلية اقتصفوا العود، ومن رنّ كأسها النغـــــمات
وكما حاول الشاعر في المجدلية أن يرصد انبثاق الطهر من رماد الخطيئة، حاول أن يوحي بأزلية الحب بوصفه جوهر الوجود الإنساني، فالحب - كما يقول - «تجربة كوْنية» تتولد من خلال التواصل الحسي بين المحبين، ولكنها رغم ذلك ترقى على قلم الشاعر إلى مستوى الواقعة الروحية أو الفناء المطلق، وكأن الحواس هنا معراج يسمو به إلى آفاق نشوة جمالية فوق الزمان والمكان. تقول الحبيبة في قصيدة بعنوان «على رخامة»:
لأجْلِيَ كان الوجـود وجودًا، وكانت ليالْ
حبيبي ستسأل عني الورودُ كأني ســــُؤال
وما بَعْد عيْنَيّ بَعْدُ، ولا كان قبلي احتمال
ولعل في هذه النظرة المثالية التي تسمو بالجمال الحسي إلى ما يشبه الذوبان الصوفي ما يذكرنا ببودلير، الذي كان عطر الحبيبة يحمله إلى آفاق ساحرة أو عوالم ليست لها أبعاد الواقع وتخوم المادة، وإن كان قصارى شاعرنا أن ينتقل من المحسوس إلى المجرد انتقالًا مفاجئًا ومباشرًا، فيبهتنا بهذه الوثبات المرتجلة، كتلك التي نلمسها في قصيدته «ترحيب»، حيث يقول:
لكِ جسم، يا بَيْلسانُ اسْتَندْ، لافح سُرَى
خِلعة الشمـــــس عرّيت للأزاميل مرمرا
حُلُمْ إن يَلحْ فغُصَّ، وعرّج على الكَرَى
عَبَث ضمّه، ومدّ ذراعـــــــيك مفترى
فالشاعر - كما هو واضح - معْنيّ بأن يحدد أبعاد الواقعة الجمالية تحديدًا حسيًّا، وحظ هذه الأبعاد من نسب الشكل والضوء واللون، فإذا أراد أن يزيد هذا الجمال تعريفًا لم يجد غير المرمر والإزميل نموذجًا يشبهه به، مع فارق أن الإزميل هنا لا يعمل في مرمر حقيقي، وإنما ينحت في ضوء الشمس - مرة أخرى مفردة الشمس واسطة عقده الشعري - ليصوغ منه كيان الحبيبة المنشودة.
وقد وصلت وفرة من إبداعات الشاعر في هذه السبيل إلى درجة من التصفية والخلوص تتجلى عندها الرؤيا وتختفي كثافة الحس، وتغدو المغامرة الشعرية مرقاة يصعد بها المبدع من الواقع إلى المجرد، وفي تلك الآونة تتحول الحبيبة المبتغاة إلى رمز فيه شفافية المثال وانبهامه، أوْ قُلْ تتحول إلى فكرة تقف على الحافة بين الحقيقة والوهم، خارج نطاق الماضي والحاضر، ليستشرف - فحسب - هامة الغد:
ليالي المغنّين أنت، فقولي، وُجدت أمَ انّك في المحتملْ؟!
هممت بأن تخْــطُري في الوجود ولم تفْعلي، فاعْتَرتْه العِلل
وأفرغْتِ مما هما الأمس والآنَ، فارضَيْ عن الغد أو يُبتذلْ
وهذا المقتطف من قصيدة للشاعر بعنوان «سلاف العصور»، ولنا - بعد - أن نتساءل: أي كيان أنثوي ذلك الذي يستقطر من خمرة السنين إذا لم يكن قمة عروج جمالي من عالم الحس إلى عالم المثال؟!
سعيد عقل والهندسة الشكلية للجمال الفني
ينظر سعيد عقل إلى الجمال في مستوييه الطبيعي والفني نظرة شكلية تلحظ هندسة الخطوط والألوان، وتولي أهمية كبرى لتناسب المقاييس والأحجام، ولعلنا لم ننس بعد أنه حين التمس نموذجًا للجمال في الطبيعة لم يجد خيرًا من «المرمر» و«الإزميل»، وهو مقياس نلمحه في كثير من قصائده صراحة أو إيماء، وأما على مستوى الجمال الفني فإن النظرة الفاحصة لا تخطئ أثر هذه النزعة الشكلية في مفهوم الجمال الشعري لدى سعيد عقل، حتى وضع الكلمات في القصيدة، ومسافات الفراغ البيضاء، وعلامات الترقيم، كل هاتيك الملامح تخضع في إبداعات هذا الشاعر لهندسة دقيقة تكاد توحي إلى البصر بقدر ما توحي الأصوات إلى حاسة السمع.
ورغم أن سعيد عقل يرى العمل الفني كائنًا كليًا لا ينبغي فيه الفصل بين شكل ومضمون، فإنه - في مقام آخر - لا يتحرج من التصريح بما قد يبدو مناقضًا لهذه الفكرة، حين يرى أن العمل الشعري «قطعة معمارية دونها البناية المعتقة الأبراج»، والحق أنه لا تناقض بين الموقفين، لأن الشاعر إن كان يرى العمل الفني كُلاً غير موزع العناصر،
فإنه - وبنفس القدر - كان يعتقد ما اعتقده الرمزيون من أن الشعر جهد ومعاودة وتنقيح، وليس فيضًا تلقائيًا من الأفكار والعواطف، كما كان يتصور المهجريون وبعض ذوي النزعة الرومانتيكية في شعرنا الحديث.
وطبيعي أن الجهد والتنقيح يظهران - أوضح ما يظهران - في الشكل، وإن كان أثرهما ينعكس تلقائيًا على المشاعر والأفكار التي يوحيها هذا الشكل، «ومن يقل إنه وقع على فكرة وهي بعد بلا تعبير يكن جاهلًا لألف باء الفن، ونحن لا نستطيع القول بأننا حصلنا على الفكرة نهائيًا إلا بعد ما تجيء بعبارتها».
وإذا كان الشعر جهداً ومعاودة، فليس ثمة مجال - فيما يرى الشاعر - لذلك الشيء المبهم الذي يسمونه الإلهام، إذ لا وجود لأية شرارة جمال إلا ووراءها عُمر من التحضير، ومن هنا كان سعيد عقل من أكثر شعرائنا المعاصرين حرصًا على تنقية أسلوبه، ومراوغة الحرف واللفظة، وتصفية الجملة فلذة فلذة، حتى يعثر على الصوت الدال، واللفظة المشعّة، والجملة المصقولة، وقليلًا ما نعثر عنده على الروابط المنطقية بين جزئيات التشكيل اللغوي، كأدوات التشبيه والتعليل والتعقيب والشرط، حتى جاء شعره وفق ما كان يبتغي: تمثالًا من المرمر فيه جهد النحت والإزميل.
أداء مكثّف
لنتأمل هذه الأبيات من قصيدته «نيانار»، ولنَرَ كيف يلجأ فيها إلى تكثيف إجراءات الأداء بحذف بعض المفردات التي يمكن استنباطها من السياق، ثم تنقية هذا السياق بنفي الحشو والفضول والزوائد الكلامية، والاقتصار على المقومات الضرورية في الجملة الشعرية.
أطيب ما في الطيب، أغوى من الإغواء، أنقى من مُطلّ الصباحْ
كانت فكان الحســـــن، وازّيّنتْ مُلْد، وغنّى حــــــول قدّ وِشاح
قطف اسمها من ياسمين، فيا فراشتي مــــــــــهلا بـرفّ الجِناحْ
خاطرة البال «نيا»، قالــــــــــــها يخجِّل الشمس شعاع وَقاح
وقد نشرت هذه القصيدة للمرة الأولى بجريدة المكشوف البيروتية سنة 1941 م، ثم أعاد الشاعر طبعها في ديوانه «رنْدلي». وندهش كثيرًا إذا علمنا أن معظم أبياتها قد مسّه قلم الشاعر بالتغيير، ولعاً منه بالتنقيح والمعاودة، حتى انتهت إلى هذا النحو الفريد من التصفية والخلوص الشعري، فالجمل قصيرة مركزة، تميل إلى إنشاء المعاني أكثر مما تميل إلى تفسيرها أو تأكيدها، وتنأى عن الربط المنطقي الواضح، حتى لا نكاد نعثر فيها على أداة واحدة من أدوات التشبيه، رغم أن لغتها - في مجملها - لغة صورية غير مباشرة، بل لو لاحظنا جمل البيت الأول لوجدناها جميعًا جملًا خبرية حذف فيها المُخبر عنه؛ إيثارًا للتركيز الأسلوبي فيما لا يضير حذفه وقد يفيد.
الصورة والرمز في شعر سعيد عقل
الصورة الشعرية لدى سعيد عقل ليست محاذاة للواقع، ولكنها تشكيل جديد لهذا الواقع، وصياغة ذاتية لعناصره الحسية والمعنوية، بحيث تغدو مفردات الطبيعة رموزًا نفسية لا وجود لها إلا في المخيلة، وبحيث تلتئم جميعًا لتخلق الإحساس الذي يعيشه الشاعر.
ومن أهم التقنيات الفنية التي يعتمد عليها الشاعر في تشكيل هذا النمط من الصور الشعرية إيحاءات الألوان؛ فالألوان عنده ليست مدركات بصرية متميزة، بل هي شتيت من الإيحاءات والمعاني المبهمة، ولعل اللون الأبيض هو أسخى الألوان في نظر الشاعر، وهو لذلك يكثر منه، متفننًا في إبرازه بطرق وأوضاع مختلفة، كقوله من قصيدة بعنوان «تضحك لي»:
للأبيض الآن سنىً آخــر
في الحجرة الضِّليلة الموعد
كأنما الأشياء في قهقرى
إلى ثــــوانٍ من صِــبًا أوْدَدِ
زنابق في ضحكة فالْتَقِطيا
جفن من ضــحكتها وازْدَد
تلقّني يا يد كيــف الهوى
وكيف سجْن النغم المفرد
فالشاعر في البيت الأول يذكر الأبيض صراحة، ثم يعود إليه في البيت الثالث، ليشير إليه بذكر ما يستلزمه، نعني الزنابق التي هي بطبيعتها بيضاء.
وقد اختلف مفهوم الأبيض في الحالتين، إذ لم يعد لونًا يبصر، بل أضحى زنابق تقتطف باليد، ثم تحول إلى نغم سجين، فكأن هذا اللون قد غدا على قلم الشاعر - في لحظة واحدة - موضوعًا للبصر واللمس والسمع جميعًا.
وإذا كان في اقتران موضوعات الحس على هذا النحو الفريد ما يذكّرنا بنظرية العلاقات الرمزية في إبداعات الرمزيين الذين كانوا مصدر إلهام لشاعرنا، فإن بناءه للرمز الشعري يمثّل وشيجة أخرى تصله بآباء الرمزية الفرنسية بخاصة، والرمز عنده يتجلى في وضعين رئيسيين؛ فهو تارة صورة شعرية مركّبة، وهو تارة أخرى إطار كلي للقصيدة تتآزر في تكوينه وسائل الأداء المختلفة من ألفاظ وإيقاعات وصور، ومن ثم يمكن أن نطلق على الرمز في الحالة الأولى «الرمز الجزئي»، كما يمكن أن ندعوه في الحالة الثانية
بـ «الرمز الكلي».
و«الحُلْم» من أبرز الرموز الجزئية التي تترد في كثير من قصائد الشاعر، ولكنه حين يستخدمه يحرص على أن يحيطه بهالة من الظلال، وأن يزرعه في بيئة من الصور المكثفة التي ترقى به إلى مستوى التجريد، وهو ما نرى نموذجًا له في قوله:
يا هـــناء اللون، يا زيــغَه
في فم بالصحو يأتزر
مؤنِق الحُسن، حيــيُّ الندى
هـــــــــــــشـــّه للــــــحـــــلـــــم مــــبتـــــــــكَر
فالحلم هنا - ولنتذكر أنه رمز أثير لدى آباء الرمزية بعامة - لا يقف عند حدود المعنى الدلالي لتلك الكلمة، وما أراد به الشاعر إلا أن يضفي على فم الحبيبة ظلًا مبهمًا يخرج به عما تعوده الناس في الأفواه من ألوان وأبعاد، وكأن الحبيبة تقف على الحافة بين الواقع والوهم، تمامًا مثلما يقف الحلم على الحافة بين النوم العميق واليقظة الكاملة.
أما الرموز الكلية عند سعيد عقل فكثير منها يدور حول المعاناة في تجربة الخلق الفني، وكيف يراود الشاعر خواطره وأحلامه المثالية البعيدة المنال، وكيف تراوغه هي حتى تسكن إلى ثوبها الشعري؛ اللفظة والصورة والبيت، ومدى ما يقترن بهذه المحاولة من مكابدات، هي مكابدات المبدع الفنان الذي يبرأ الجمال الشعري على غير نمط سابق، أو هي مكابدات «الكدح الأبجدي»، كما يدعوه شاعرنا.
ولقد سبق أن أشرنا إلى أن جمال الرخام وملاسة المرمر هما - فيما يرى الشاعر - نموذج الحسن الذي يبدعه صانعه بجهد النحت والإزميل، وكثيرًا ما كان يرمز بذلك إلى تجربة الإبداع الشعري وما يصحبها من معاناة، فها هي «مركيان»، أو الرخامة الفريدة بين التلال، تتجسد رمزًا كليًّا لحبيبة مثالية لم يبح باسمها لسان، ولم تتجسم في مادة؛ لأنها كومض الآل أو كالعبير المحال - لا يرقى إليه الحس ولا يدركه المقال - ذلك ما تحدث به مركيان نفسها:
أنا مركبــــان الخــــيال
أنا مات بعدي الجـمالْ
وللــــــــــصحـــــــــو شـــــــهقة طــــــــفــــــــل
عــــــــــــــــــــلــيّ، ودم ســـــــجــــــــــــــــــــــــــــال
عبير، عبير، فلمْ بــتّ
وحدي العبير المـــحال
أما لمروري ذكرى هنا
أو حـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــال حــــــــــيــــــــــــال
لأجلي كان الوجـــــــود
وجودًا، وكانت ليـــالْ
ترى هل يتحدث الشاعر حقًّا عن أنثى تنتمي إلى عالم البشر؟ إن حديثه عنها - أو حديثها عن نفسها - ينفي كل السمات الواقعية التي يمكن أن تتميز بها امرأة من لحم ودم، فهي بعيدة المنال، بل هي مستحيلة، وهي وهمية إلى حد أن مرورها لا يترك أثرًا حتى مجرد الذكرى، ثم هي علة الوجود وحقيقته، ولولاها ما كان الوجود وجودًا.
ترى هل يرمز الشاعر إلى حقيقة الوجود وجوهره المطلق؟ أم تراه يرمز إلى الخاطرة الشعرية التي يحلم بها ويسعى إليها ولا يكاد يدركها؟ وهنا نلمح - بوضوح - أثر الفلسفة الأفلاطونية في فكر شاعرنا وامتزاجها بالنزعة المثالية الرمزية، وهما تفسير ما يبدو في إبداعه من جنوح إلى تظليل المادة بالمعنى، وردّ الواقع المتكثر إلى الجوهر الواحد، وتلك نظرة فطن إليها الكاتب الفرنسي المرموق جاك بيرك، حين وجد أن «رٍنْدلي» - التي أطلقها الشاعر عنوانًا لأحد أشهر دواوينه - آتية في آن واحد من سماء أفلاطون وغوطات دمشق، وهو يعني بهذا ما في إبداعه من نزوع إلى توحيد الواقع بالمثال أو المادة بالحقيقة المجردة، وربما كان في هذا التلميح ما يغني عن أي تصريح... ترى هل تجاوزنا الحقيقة حين رأينا في سعيد عقل شمسًا لا تغيب؟! ■