حكاية أم تتعلم كيف تعيش من غير أطفالها
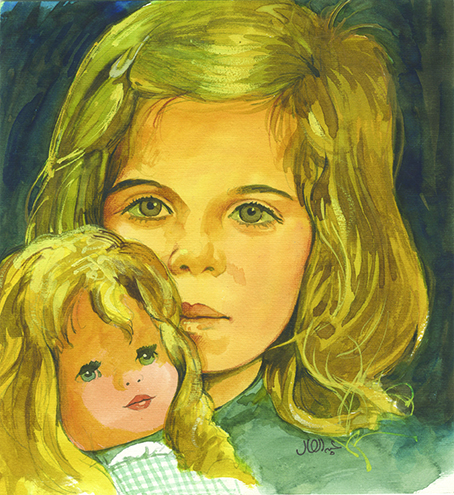
تحصل النساء عادة على حق حضانة الأطفال، لكن ليس دائماً... أم تحكي كيف ضاع منها طفلاها، وكيف بدأت تلملم شتات حياتها وعلاقاتها.
عندما ينفصل الوالدان، تحصل الأم في معظم الأحيان على حق حضانة الأطفال، لكن هذا لا يحدث دائماً، إذ يؤْثر الأطفال أنفسُهم في بعض الأحيان العيش في كنف أبيهم.
لكن كيف يؤثر هذا على الأم؟ وما الذي يدور بخلدها عندما تضيع منها فلذات أكبادها؟ وأي شيء تفعل لتعيد بناء حياتها؟ ما نورده في السطور التالية هو رواية إنسان واحد، التجربة الشخصية لأم وجدت نفسها مضطرة لمواجهة هذه الأسئلة.
جميعنا تربطنا علاقة خاصة بأمهاتنا. وكل امرأة جرّبت أن تكون أمّاً تعرف بأمر الصلة الفريدة التي تشعر بها حيال الإنسان الذي حملته في بطنها تسعة أشهر. فالأم وطفلها يظلان مرتبطين بآصرة غير مرئية حتى لو تفرقت بهما السبل، وحتى لو انقطعت بينهما العلاقات اليومية.
وفي هذا الإطار، روت أم ألمانية قصتها في صحيفة «زود دويتشي تسايتونج» الألمانية، فقالت: مضت عليّ الآن سنتان وأنا أعيش في إحدى قرى الغابة السوداء، ولأول مرة في حياتي أشعر أني في بيتي وأن الحياة تسري في عروقي. دائماً ما أتساءل: كيف واتتني بالضبط هذه القوة الداخلية التي تزداد باستمرار. وكيف تمكنت من العثور على نفسي من جديد، بعد أن قاسيت هذا القدر الهائل من الألم وخيبة الأمل والذل والهوان؟
مضت عليّ الآن خمس سنوات وأنا أعيش من غير طفليّ. وكنت قبل ذلك أدير أنا وزوجي السابق شركة صغيرة منذ أربع عشرة سنة أنجبت خلالها طفلين. سار كل شيء على ما يرام زمناً طويلاً. كنا نقسم وقتنا بين العمل والبيت. لابد من أننا كنا نبدو كأسرة مثالية، لكن فجأة تغيّر كل شيء.
اقتحمت مشكلات العمل علينا داخل بيتنا، فقررت ترك العمل مع زوجي في الشركة. لكن المشكلات ظلت على حالها، فكان الطلاق بعد ذلك بسنة، والعواقب كانت حتمية.
بعد طلاقنا عشت في بيتنا مع طفلينا لمدة سنة ونصف السنة بعد ذلك، أما زوجي فانتقل ليعيش في شقة أخرى في البلدة ذاتها. كان طفلانا يقضيان العطلات الأسبوعية معه، واعتدنا جميعاً هذا النظام الجديد، كما هي الحال مع كثير من الأسر الأخرى.
وبما أنني كنت عاطلة ولم أستطع الحصول على عمل، فقد قررت الرحيل مع طفلينا، اللذين كانا يبلغان من العمر 9 سنوات و12 سنة في ذلك الوقت. كنت أريد العودة إلى المنطقة التي نشأت فيها. وتوخياً للعدالة مع زوجي السابق الذي صار آنذاك نائياً بنفسه عنا ولا يبدي اهتماماً بالطفلين، أخبرته بنيّتي الرحيل قبل الموعد المقرر بستة أشهر.
بدا كل شيء يسير على نحو طبيعي، إلى أن لاحظت ذات مرة أن طفليّ بدآ يتصرفان بمزيد من العدوانية تجاهي يوماً بعد يوم؛ إذ حاول زوجي السابق التأثير عليهما واستمالتهما لمنعهما من الرحيل معي. كنت أشعر بعدم الأمان، لكني لم أقو على الحديث معهما في هذا الشأن.
كانت أفعاله تبدو ملتوية ومليئة بالرغبة في الانتقام. لكنها كانت ناجعة أيضاً؛ إذ شيئاً فشيئاً دبت الجفوة بيني وبين طفليّ. بدا الوضع كما لو كنا نمارس لعبة «شدّ الحبل» بلا نهاية. وفي النهاية كان لتلك الجفوة تأثيرها الشديد على نفسي؛ لأنني لم أكن أستطيع ببساطة أن أتخلى عن طفليّ، مهما حاولت جاهدة.
استغل والد طفلي حالي تلك ليصورني كمريضة عقلياً. ومن ذا الذي يريد العيش مع أم مريضة عقلياً؟ بلغت الأحداث ذروتها في المحكمة، وفي النهاية حصل زوجي على حق حضانة الطفلين، باعتبار أن «الخير للطفلين» أن يبقيا في البيئة التي ألفاها وألا يرحلا عنها مع أمهما.
كان حكم المحكمة فاجعاً لي بكل معنى الكلمة. لقد حصل على حق حضانة الطفلين وحق تقرير مصيرهما. انهرت، لكن أحداً لم يبال. شعرت بأن حكم المحكمة طعن في مصداقيتي كأم. كنت أخشى أن حكم المحكمة بحرماني من حضانة الطفلين كان يعني ضمنياً ارتكابي فعلاً بشعاً بحق طفليّ. صار الحكم وصمة عار في جبيني، فأحسست بالخواء والإنهاك والوحدة، شعرت بأنني وصلت إلى الحضيض، وهذا بالضبط ما كان يرجوه زوجي. كان كل شيء قد ضاع مني، وإلى الأبد. وكان لزاماً عليّ أن أتكيف مع ذلك الوضع.
قبل أن تعقد المحكمة جلستها، كانت مصلحة رعاية الأطفال قد سألت طفليّ عمن يفضلان العيش معه، فاختارا أباهما بدلاً مني. كانت تلك اللحظة موجعة بشدة، ومع ذلك فقد آثرت ألا أباشر حقي في استئناف الحكم؛ لأنني أردت أن أجنّب طفليَّ ونفسي عناء السير في مزيد من الإجراءات القضائية.
بحثت عن شقة في البلدة التي كنا نعيش فيها كأسرة. لكن بعد فترة من الزمن أدركت أنني لن أتمكن أبداً من إعادة بناء حياتي هناك؛ فرحلت عن تلك البلدة، من دون طفليّ، وعثرت على وظيفة في هذه البلدة التي صارت موطني الجديد.
كان الوقت الذي أقضيه في الشقة الجديدة الكبيرة التي تحتوي على غرفتي أطفال مفروشتين وجاهزتين وقتاً مريعاً. انزلقت إلى حالة من الأزمة العميقة، ولم أجد لنفسي مخرجاً منها. شعرت بأنني هُجرت وحيدة. كان لدي فعلاً بعض الأصدقاء والمعارف، لكن حياتي كانت تبدو بلا معنى من غير طفليّ. بل وكنت أوشك أن أُحرم من حقي في رؤيتهما. قيل لي إنهما لا يحبان زيارتي، وإن الرحلة طويلة جداً عليهما، وإنهما يشعران بالملل في بيتي.
تراجعت وتيرة الاتصال بيني وبين طفليَّ شيئاً فشيئاً. بل ومضت عليّ فترة كدت لا أراهما خلالها بالمرة؛ إذ حدد زوجي رؤيتي الطفلين بحوالي سبعة أيام في السنة. وعندما كان يحدث ونلتقي، كنت أتبين أن الطفلين ليسا سعيدين برؤيتي.
لن تندمل الجروح التي تركتها هذه التجربة تماماً أبداً، لذا قررت تغيير حياتي مرة أخرى، فرحلت إلى الغابة السوداء مع شريكي الجديد. ومنذ ذلك الحين وطّنت نفسي على القرار الذي اتخذه طفلاي وقبلت واقع أنهما لا يزورانني إلا إذا أرادا ذلك ومتى أرادا. قررت الانسحاب من حياة طفليّ، لأنني أدركت أنهما قادران على أن يجدا طريقهما بنفسهما، وجعلت كل همي في الحياة أن أكون حضنهما الدافئ كلما احتاجا إليّ.
لقد مررت بتحول خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن أيقنت أن أمامي خيارين: إما أن أستسلم لليأس وأواصل الشعور بالقهر على كل ما فقدته، وإما أن أنتشل نفسي من تلك الهوة السحيقة وأمضي في حياتي. ويتطلب المسار الأخير قدراً هائلاً من القوة، لكن الميزة في استخدام تلك القوة هي إمكان إضفائها على حياتك الجديدة، وهذه القوة هي التي مكّنت طفليّ ومكنتني من تجاوز تلك المرحلة.
ساعدني بيتي الجديد ووظيفتي وشريكي على أن أصبح امرأة مختلفة، وأداوم الآن على الاتصال بطفليّ، بعد أن تصالحت مع الوضع وتقبّلته. يبلغ ابني من العمر الآن 18 سنة، ويقول لي إنه يحبني، وأنا أصدقه، وأشعر بأنني أحظى بالحب والتفهّم. لكننا لا نستطيع تغيير حقيقة أن السنوات التي أضعناها ضاعت إلى الأبد. أما ابنتي فلها من العمر الآن 14 سنة، وقد أقامت حفلة أخيراً، وأرادت مني حضورها، والمفاجأة أنها كانت عيداً عائلياً جميلاً.
أنا فخورة بنفسي لصمودي في وجه الأحداث، وإنْ كنت أرجو أيضاً أن يأتي
عليّ في نهاية حياتي يوم ينظر فيه طفلاي إلى الوراء ويقولان: «لم تكن شيئاً بالنسبة
للعالم كله، لكنها كانت كل العالم بالنسبة
إلينا» .

