الترجمة الآلية... هل تُنشئ لسانيات جديدة؟
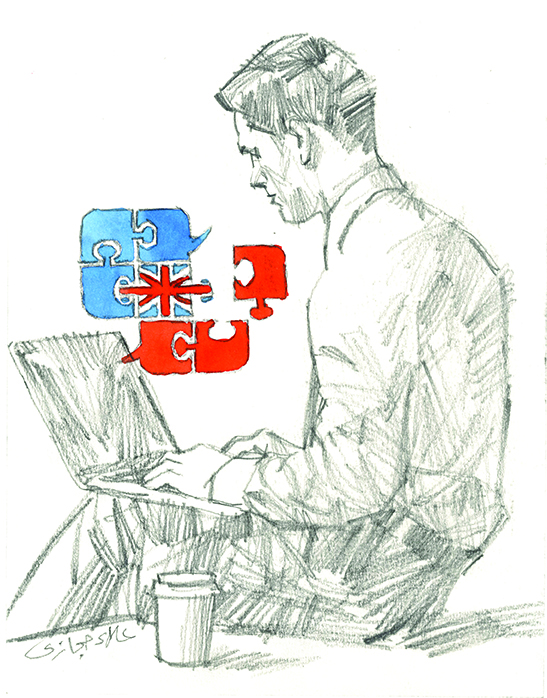
في خضم التفاعل والتواصل بين المناطق المختلفة وشعوبها، لعبت الترجمة بصفة عامة، والترجمة الآلية على وجه الخصوص، الدور الأكثر فاعلية في هذا التقارب، فخدمات الترجمة الآلية وفرت كثيراً من العناء، وساعدت في ترجمة الكلمات والفقرات الكاملة، بل أيضاً الملفات وصفحات الإنترنت، من أي لغة وإلى أي لغة. لكن الترجمة الآلية، رغم مزاياها المتعددة، تتضمن جوانب أكثر خطورة، خاصة في ما يتعلق باللسانيات المختلفة، وذلك حينما تضع ترجمات لمصطلحات وكلمات لا تعبر عن مضمونها الصحيح في السياق المستخدم.
من هذا المنطلق، يحاول هذا المقال أن يستعرض تأثيرات الترجمة الآلية على اللغات المختلفة، وهل يمكن أن ينشئ هذا النوع من الترجمة لغة جديدة مؤسسة على تحوير في اللغات الأخرى، عبر ما يطلق عليه البعض الوساطة اللغوية، حينما تكون هناك لغات وسيطة بين اللغات المترجمة؟ وإلى أي مدى يؤثر ذلك على المنطق الخاص بكل منظومة لغوية؟
تكمن الإجابة عن هذه التساؤلات بشأن مدى هذا التأثير وانعكاساته من خلال محورين:
الأول: الترجمة الآلية... المزايا والمخاطر
من دون الدخول في تفاصيل كثيرة حول تعريف الترجمة الآلية وأشكالها، وكذلك من دون دخول في استعراض طويل للمزايا التي يتمتع بها هذا النوع من الترجمة، التي كثر الحديث عنها، يمكن التأكيد على أن أبرز هذه المزايا أنها عملية تتسم بالسرعة وبانخفاض التكلفة مقارنة بالترجمة العادية التي يقوم بها المترجمون، بل يمكن القول إنها أضحت عاملاً مساعداً للمترجم البشري، حيث تعطيه الترجمة الآلية ذ رغم عدم دقتها غالباً - فكرة كلية عن محتوى النص، بما يساعده على إنجاز عمله في ضوء حجم الإنتاج المعرفي الذي يشهده عالم اليوم من دراسات وتحليلات وكتب وتقارير ونشرات وصحف تحتاج إلى الاطلاع عليها في ظل تنوع اللغات وتعددها. فضلا عن ذلك، تتسم الترجمة الآلية بأهمية أخرى، تتمثل في سهولة القيام بها، فلا تحتاج إلى أي تدخل، حيث لا يوجد أي حاجز لغوي.
ولكن، على الجانب الآخر، يؤخذ على الترجمة الآلية كثير من السلبيات، من أبرزها التأثير سلباً على مهنة الترجمة والأعمال المساعدة المتعلقة بها مثل صناعة المعاجم، والنشر...إلخ، حيث يتراجع دورهما أمام التوسع في مجال الترجمة الآلية. كما أن توفير الوقت الذي يعتبره البعض من مزايا الترجمة الآلية أمر غير صحيح في مجمله، فالأخطاء النحوية والصرفية، إضافة إلى الركاكة في المحتوى، واحتوائه في كثير من الأحيان على تعابير مبهمة ومغالطات، تحتاج إلى وقت طويل للتعديل والتصحيح، وهو ما لا يقارن بالوقت الذي يمكن أن تستغرقه الترجمة البشرية التى تتقن مثل هذه المفاهيم والمصطلحات.
وغني عن القول إن هذه السلبيات الناتجة عن الترجمة الآلية، والتي تحدث عنها كثيرون، لا تقاس بحجم الأخطاء والمخاطر التي قد تترتب على هذا النوع من الترجمة التي غفل كثيرون في حديثهم عنها، ومن أبرزها:
- سيطرة لغة واحدة على عملية الترجمة، حيث تكون هي اللغة المركزية بالنسبة إلى اللغات الأخرى. فعلى سبيل المثال، تلعب اللغة الإنجليزية دور المركز بالنسبة إلى اللغات الأوربية، وهو ما من شأنه أن تكون هناك على المستوى العالمي شبكة من سلاسل الترجمة مُؤسسة في مرجعيتها على اصطلاحات وسيطة عدة، حيث تعتمد الترجمة الآلية على الوساطة الحسابية أو ما يطلق عليه البعض الخوارزمية، التي تتعلم من الأنماط والتكرارات التي تتم فيها ترجمة العبارات إلى لغات أخرى على الإنترنت. ولا شك في أن هذه اللغة تلعب دور المركز أو ما يطلق عليه في ترجمة «جوجل» منهج «التجسير»، أي استخدام اللغة الإنجليزية كجسر بين اللغة العربية على سبيل المثال واللغات الأخرى، كالترجمة من الألمانية أو الفرنسية إلى العربية أو العكس، حيث تقوم ترجمة «جوجل» بترجمة النص أولاً إلى اللغة الإنجليزية ومنها إلى العربية، وهو ما قد يسبب أخطاء إضافية، فلكل لغة منظومتها النحوية التي قد تختلف عن اللغة الأخرى، بل ربما عن اللغة الوسيطة ذاتها، فعلى سبيل المثال تستخدم اللغة العربية التذكير والتأنيث للجمع، في حين أن اللغة الإنجليزية ليس فيها ذلك. بل وقد تتفاقم هذه المشكلة إذا ما نظرنا إلى الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى، حيث تؤدي الترجمة على مرحلتين ضياع هذه المعانى كليةً.
- عدم الدقة في المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في الترجمة، حتى بين اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى التي تتم ترجمتها مباشرة إلى الإنجليزية أو العكس من دون وجود لغات وسيطة، فعلى سبيل المثال، قد تواجه الترجمة من اللغة العربية إلى الإنجليزية صعوبات عدة، إذا لم تراع بنية الجمل العربية طبيعة بنية الجملة في اللغة الإنجليزية، فحينما تبدأ الجملة العربية بالفعل ثم الاسم، تختلف في ذلك عما هو متبع في بنية الجملة الإنجليزية، التي تبدأ بالاسم ثم الفعل، ففي العربية تكون الجملة «جاء الرجل» أما في الإنجليزية فتكون الجملة «الرجل جاء»، وهو ما يؤدي إلى ضعف في صياغة الجملة المُترجمة. أضف إلى ذلك، مثلاً حينما تكون الجمل العربية طويلة، قد يتبع الفعل أكثر من عشر كلمات قبل ورود الفاعل، ما يجعل من الصعب على الترجمة الآلية أن تنقل الفعل إلى مكانه الصحيح في الجملة الإنجليزية، بل إن كثيراً من أنظمة الترجمة الآلية تحذف الفعل بالكامل، وهو ما قد يخل بالمعنى كلية.
- ليس صحيحاً ما يدعيه البعض من أن الطريقة التي تعتمد عليها الترجمة الآلية في استفادتها من الذخيرة اللغوية المنتشرة من مفردات كل لغة تمثل المنبع الرئيس الذي تنهل منه الترجمة الآلية، وأنه منبع كافٍ لتقديم ترجمة متميزة عبر الإنترنت، فهذا الافتراض لايصدقه الواقع العملي لأن مفردات أي لغة متوافرة على شبكة الإنترنت مهما بلغ حجم ذخيرتها من الحروف (مئات الميجابايت)، لا تمثل سوى الحدود الدنيا لحجم الذخيرة التي يمكن الاعتماد عليها للحصول على ترجمة معقولة ومقبولة، فالذخيرة اللغوية الممكن توافرها على سبيل المثال باللغة العربية لاتزال محدودة.
الثاني: الترجمة الآلية... رؤية نحو التطوير
في ضوء هذه المخاطر والأخطاء التي تترتب على الترجمة الآلية، يصبح من المهم، بل من الضروري، أن تكون هناك دراسات متكاملة حول كيفية معالجة مثل هذه المخاطر، حفاظاً على المنظومة الخاصة بكل لغة دون تحويرها.وهو غاية هذه المقالة.
ومن الأهمية بمكان، قبل أن نطرح رؤيتنا في هذا المضمار، أن نشير إلى أهم الأسباب وراء هذا التردي الذي تتسبب فيه الترجمة الآلية، خاصة في ما يتعلق باللغة العربية، ومنها:
- أن القائمين على تصميم وإنتاج برمجيات الترجمة هم من المتخصصين في مجال الحاسب الآلي على اختلاف تخصصاتهم، ولا نكاد نرى بينهم عالماً متخصصاً في اللغويات أو في اللغات المترجمة الأخرى ومن بينها اللغة العربية. في حين أن معالجة اللغة الطبيعية تختلف بشكل كبير عن غيرها من تطبيقات الحاسب المختلفة، فهي تحتاج بشكل أساسي إلى مختصين باللغة يعملون جنباً إلى جنب مع مصممي تطبيقات الحاسب، وهو ما يكاد يكون منعدماً عند تصميم أو تطوير برامج الترجمة بصفة عامة، وترجمة اللغة العربية بصفة خاصة.
- عدم اهتمام المؤسسات الكبرى في العالم العربي بقضية الترجمة المباشرة من اللغات المختلفة، فلاتزال تعتمد بصفة رئيسة على وجود اللغة المرجعية (الوسيطة) في عملية الترجمة.
- طبيعة بعض اللغات وصعوبتها، ومنها اللغة العربية، التي تتسم بالتنوع الواسع لمفرداتها وعباراتها، فضلاً عن تميزها بوجود عدد كبير من الطرق والوسائل البلاغية والاشتقاقات، إضافة إلى تعدد الترجمات العربية للمصطلح الواحد، بسبب عدم توافر القواميس العلمية العربية، وهو ما يُربك القارئ الذي تعود على مصطلح معين، ما يجعله يعتبر أن الترجمة غير صحيحة. كل هذا يزيد من مستوى الصعوبة في معالجتها عبر البرامج المصممة لذلك، خاصة أن غالبية المبرمجين ومصممي النظم يفضلون المجالات الأكثر سهولة التي لا تحتاج إلى أوقات طويلة، وتحقق لهم عائداً مادياً أكبر، حيث تغلب على عمليات الترجمة الآلية عادة الدوافع التجارية والسعي إلى تحقيق الأرباح السريعة دون الاعتناء بجودة الترجمة أو السعي إلى تطويرها.
ولعل في هذا كله ما قد يدعونا للظن أو الشك أن ثمة حرب لغات أو لسانيات تجرى في عالم الإنترنت، تستهدف التأثير على مستويات التقدم والإبداع لدى البلدان النامية، ومن بينها البلدان العربية، وبالتالي يصبح من الأهمية بمكان وضع رؤية متكاملة لتطوير الترجمة الآلية بصفة عامة والترجمة الآلية في اللغة العربية بصفة خاصة، بما يعظّم من فوائدها ومزاياها ويقلل من مخاطرها وأخطائها، ومن أبرز أبعاد هذه الرؤية ما يلي:
1 - الحاجة إلى معجم عربي محوسب، يتضمن كل مفردات اللغة العربية بشكل يسهل التعامل مع المفردات في جميع التطبيقات ذات العلاقة، وذلك على غرار ما هو موجود في اللغات الأخرى، سواء كان معجماً أحادي اللغة أو ثنائياً أو متعدد اللغات.
2 - تشجيع الجامعات ومراكز البحث العلمي للبدء في تطوير الترجمة الآلية في مجال اللغة العربية، وهو ما يتطلب:
- تخصيص ميزانيات للبحث العلمي في هذا المجال.
- زيادة حجم الأبحاث اللغوية المتعلقة بالترجمة الآلية من اللغة العربية وإليها، خاصة في مجال التحليل الإحصائي بهدف التعرف على المشكلات التي تواجه عملية الترجمة الآلية، ومنها على سبيل المثال: مشكلة الكلمات متعددة المعاني، مشكلة التحليل الصرفي المشترك لفظياً، مشكلة فهم المعنى من السياق، مشكلة الإعراب والنحو، مشكلة التشكيل.
- توحيد الجهود العاملة في هذا المجال وتنظيمها تحت مظلة واحدة، ولتكن المنظمة العربية للترجمة، بكونها المظلة الأكثر قبولاً في هذا المجال.
وخلاصة القول، إن الترجمة الآلية التي تتم عبر مواقع الإنترنت المختلفة، بغض النظر عن مسمياتها، تشترك في خاصية واحدة، هي اعتمادها على ما يُعرف بالترجمة الآلية الإحصائية، وإن المختلف بينها هو في طريقة التنفيذ أو في طبيعة البيانات التي تعتمد عليها عملية الترجمة، بما يؤكد أهمية البحث عن أطر جديدة تعالج تلك المخاطر وتحمي اللسانيات الموجودة من التحوير إلى لغات أخرى مؤسسة على منطق لغوي واحد يؤثر بدوره على أنماط التفكير، لأن اللغة هي الأداة الأولى والرئيسة لعملية التفكير والإبداع .

