بين الغيطاني وألبير كامو ... الخير والشر والجمال
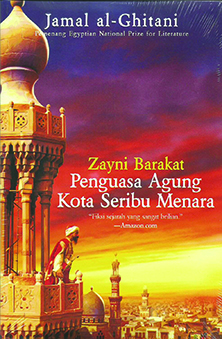
كاتبان روائيان، يمثلان الاستثناء في السرد، أما الأول فهو من تونس والثاني من مصر، كلما قرأت رواياتهما ذكراني بما يحملانه من أسئلة الوجود والجمال، بالكتابات الروائية والفلسفية لألبير كامو (Albert Camus 1960- 1913).
أما الروائي التونسي فهو محمود المسعدي (1911 - 2004) صاحب الأعمال الشهيرة: «حدث أبوهريرة قال» و«السد» و«مولد النسيان»، وأما الروائي المصري فهو جمال الغيطاني الذي فقدته الساحة الأدبية العربية والعالمية هذه الأيام (1945 - 18 أكتوبر 2015)، وصاحب «الزيني بركات» و«أوراق شاب عاش منذ ألف عام» و«التجليات»، و«رسالة في الصبابة والوجد»، و«متون الأهرام»، و«شطح المدينة» وسواها.
يتقاطع عالم محمود المسعدي الروائي المليء بالإشارات الصوفية والوجودية في حياكة لغوية غير مسبوقة، وفي بناء روائي فريد أيضاً، مع عالم ألبير كامو في غموضه وفي مصائر الشخوص الروائية الغامضة، تماماً كما هو غموض الوجود، على نحو ما نرى في روايتي «الغريب» و«الطاعون».
وإذا كان المسعدي قد دخل في نقاش فلسفي مع كامو في بداية الخمسينيات، نقاش يؤكد التقارب المختلف، ويؤكد أيضاً المتون المشتركة في القروئية وفي الهواجس الفلسفية، فإن العوالم الروائية لجمال الغيطاني في «الزيني بركات» أو في «التجليات» تتقاطع مع عوالم ألبير كامو في البحث الفلسفي والتاريخي عن مصدر الشر ومصدر الخير ومصدر الجمال، وكذا في مقاربة الكتابة؛ لغة وبناء.
يلتقي جمال الغيطاني بألبير كامو أيضاً، في أن كلاً منهما عمل طويلاً في الإعلام، حتى تقاطعت أعمالهما الأدبية بكتاباتهما الإعلامية، فكانت أسئلتهما الروائية بقدر ما هي مرتبطة بسؤال الوجود، إلا أنها ظلت على صلة باليومي وبالتاريخي؛ في عنفه المسلط على الفرد وعلى الجماعة وعلى الشعوب وعلى الهوية، وفي مقدمة هذا الوجود اليومي الواقعي ظاهرة «الحرب» وظاهرة «الفقر» وظاهرة «التراث» أو الموروث المادي واللامادي الذي شغل الروائيين.
اشتغل الروائي جمال الغيطاني مراسلاً للحرب، من على الجبهة التي دارت عليها وقائع الحرب خلال معركة 1973، وقد كتب عنها عشرات التحقيقات، وظل يراقب هذا الشر الإنساني في النصوص الأدبية أيضاً كما في عمله الذائع «حكايات الغريب»، شاهداً ومتابعاً لما تزرعه الحروب من كراهيات وخراب، مراقباً من الداخل حرب أكتوبر من منطلق «فكرة التحرير» و«الكرامة» و«الشرف»، ولكن أيضاً من منطلق «الخوف» و«الدم» و«الخراب» و«الأحقاد»، وفي كل ذلك كان الروائي يطل على «أشكال الموت»، ومثله وقبله دخل ألبير كامو في نقاش إعلامي وفلسفي وأدبي عن موضوع «الحرب الجزائرية» التي دامت سبعة أعوام ونصف العام، والتي اتخذ منها الروائي موقفاً سياسياً معيناً، لكنه استطاع أن يرفع الحوار إلى مستوى «سؤال الحرب» الفلسفي، الخراب وإعادة التشكيل، وقد خلقت علاقته بالحرب الجزائرية وضعية تعارض وقطيعة فكرية وسياسية مع كتاب اليسار الفرنسي، وعلى رأسهم جان بول سارتر وغيره.
كانت تلك الحرب خزاناً حقيقياً لكثير من أعمال ألبير كامو الأدبية، بالإضافة إلى عدد من الطروحات الفلسفية، والشأن ذاته كانته حرب أكتوبر بالنسبة إلى جمال الغيطاني. فلم تكن الحرب عند الغيطاني مسألة عابرة، بل كانت رؤية فلسفية للوجود وقراءة للإنسان في لحظة مواجهته للموت والنسيان والمصير.
مثل ألبير كامو، الذي كان ابن عاملة نظافة عاشت حياتها في حي بلكور الشعبي بالجزائر العاصمة، نشأ في حي المغلوبين الذي يلتقي فيه الأوربي والجزائري التقاء طبقياً، فإن الغيطاني ابن قلب القاهرة الشعبي أيضاً، كان مسكوناً بفكرة «المواطنة»، ما جعل منه مثقف الأحياء الشعبية وصوت القاهرة العميق والصادق، الذي يفقهها بكل تفاصيلها ومواسمها ولغتها ونكتها وأسرارها وألغازها ومقابرها ومقاهيها ونرجيلتها (ملامح القاهرة في ألف سنة)، وهو ما جعل كتاباته وشخوصه الروائية والقصصية قريبة إلى القلب لواقعيتها العفوية التاريخية، تلك الواقعية غير المبتذلة، ومن هذه المعرفة العميقة خرج كثير من نصوصه الروائية والقصصية مؤسساً على فلسفة «المشاهدة» أو «سلطة العين» (وقائع حارة الزعفراني)، وهو الأمر الذي جعل كثيراً من أعماله السردية قابلة للتحويل وبيسر فني إلى لغة الشاشتين الصغيرة والكبيرة معاً.
كان ألبير كامو مسكوناً أيضاً بحال الفقر والتهميش الذي عانى منه سكان منطقة القبائل، وكتب عن ذلك أعمق التحقيقات الصحفية التي نشرها وقتها في «جريدة الجزائر الجمهورية» اليسارية، وفي تلك التحقيقات كشف، بحس الروائي، فداحة ما كان يقوم به الاستعمار الفرنسي من أعمال إجرامية ضد الإنسانية في منطقة حُرم أهلها من الفلاحين البسطاء من لقمة الخبز، ومن أراضيهم التي صودرت من تحت أقدامهم.
مثل جمال الغيطاني الذي أعتبره روائي «العين» بامتياز لا شبيه له في الكتابة الروائية العربية، لا تفوته تفاصيل «نافذة» أو «مشربية» أو «رصيف» أو «جدار» إلا وحاوره، خوفاً من أن يُضيِّع ذاكرتَه، قلّبه تقليباً ليخرج منه سراً أو سؤالاً، وذلك هو مركز فلسفة الكتابة الروائية لدى جمال الغيطاني، وعلى هذا المنوال أيضاً أسست كتابات ألبير كامو الذي كان مهووساً بالآثار، أمام الآثار الرومانية بمدينة تيبازا (مدينة ساحلية تبعد عن مدينة الجزائر العاصمة بحوالي 80 كلم) وقف مندهشاً، متسائلاً، في حالة صوفية عميقة، فكتب أجمل نصوصه التي عنونها بـ«الأعراس»، والتي فيها أبان عن عبقريته الشعرية والسردية.
ولعل هذا التقارب الذهني والفني من ألبير كامو هو الذي جعل روايات جمال الغيطاني المترجمة إلى «الفرنسية» تحظى بكثير من حسن الاستقبال والتلقي؛ سواء من قبل القارئ العادي أو الجامعي أو الإعلامي، وهو أمر نادر إلى حد كبير في الثقافة الفرنسية، إذ نادراً ما تحقق رواية عربية جادة مترجمة إلى «الفرنسية» استقبالاً وحضوراً في المقروئية الفرنسية مثلما حققته وتحققه روايات الغيطاني، وهو أكثر الروائيين العرب حظاً في الترجمة إلى الفرنسية، بل أكثرهم حظاً في الدرس الجامعي، حيث يحظى كثير من أعماله بالدراسة الأكاديمية في الجامعات الفرنسية.
لهذا كله فإنني أقول إنه كما فقد الأدب المغاربي والتونسي في محمود المسعدي روائياً ظاهرة لم تتكرر، وفقد الأدب الفرنسي والفرنكفوني في ألبير كامو روائياً من حبر خاص ومن حساسية خاصة... فقد الأدب المصري والعربي برحيل جمال الغيطاني صوتاً روائياً فريداً في لغته وجنونه وسرده وعمق فلسفته وإنسانية طروحاته .

