الغزل في شعر المتنبي
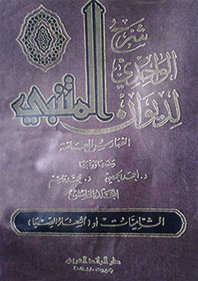
لن أعرِّف به، ولا بسيرته، ولا بزمانه، وأحداث عصره، بل أكتفي بما قيل فيه في أيامه: «مالئ الدنيا وشاغل الناس»، وإنّ ما نطق به ودوَّنته الأقلام من حوله، لم يكن نتاج خاطره ووجدانه وحده... بل كان نتاج أجيال وحقبٍ تخضَّبتْ بدموع آمالها، وتسربلت بألق المصير المضطرب... وصوت أمّة تصدّعت شرايينها من فرط الجوى المتهدج على مذبح الذات ودوّامة الوجود.
فلا نستكثرنّ الرقم الذي بلغتْه الدراسات والمقالات والبحوث التي تناولته وهي: ألْفان، أحصاهما الأستاذان كوركيس عواد وميخائيل عواد في كتابهما المعجمي الإحصائي النفيس: «رائد الدراسة عن المتنبي» الصادر في بغداد عام 1979... فكم سيكون الرقم اليوم لو أعيد طبع الكتاب؟
تناول أبوالطيب معظم الأغراض الشعرية السائدة في عصره، وفي العصور السابقة، بين مديح وفخار وهجاء ورثاء وأوصاف شتى وحكمة وغزل... احتلَّ المدح فيها ما يزيد على ثلثي ديوانه.
أما الغزل فلم يُفرَد له باب خاص، لم يُقَل: قال يتغزل، أو: في امرأة بعينها، على غرار معظم أشعار الغزل في العصور السابقة.كانت أشعار الغزل ترِد في معظم مقدمات قصائد المدح التي نظمها في عدد لا بأس به من أعيان عصره ممن التقاهم أو قصدهم في مسيرته الطويلة، بحيث لم تكن تتجاوز ربع القصيدة المدحية، اتّباعاً لتقليد قديم سنّه كعب بن زهير في مدحه الأول للنبي محمد في «بانت سعاد».
فما الذي قاله المتنبي في أغزاله، وما نصيب الصدق أو التكلف في هذه الأشعار، وصولاً إلى القيمة الفنية والتاريخية التي أفرزَتْها؟
تعريف بالغزل وبمضامينه في الشعر العربي
الغزل هو شريان الحياة الأدبية في جسد الشعر العربي، لم ينقطع مداده ولا خفَّ نبْضه على مرّ الأيام والعصور؛ فهو دائم الخفق، وئيد الخطو، حاضر في ضمير الشعراء، شاخصٌ إلى الجمال يسْتجليه: حُسْناً حسّياً، ونضرةً متألقة، أو خُلُقاً سمْحاً ووصالاً داخلياً يهدر في الأعماق، وخفقاناً مدوِّياً تُترجمه الألسنة أشعاراً جمْرية تحترق منها الشفاه وتضطربُ بها الأفئدة.
هذا هو شعر الغزل في مختلف العصور، لا تكاد تتغيّر مسيرته ولا أغراضه ومعانيه... جلُّ ما هنالك شبوبٌ وتوهّج لدى هذا الشاعر، وهذه البيئة، وخفوتٌ وسجوٌّ لدى ذاك الشاعر، وتلك الحقبة.
أما المعاني التي تضمّنها هذا الشعر، فيدور معظمها، في فلك الشوق والصبابة، والحنين واللوعة والاحتراق، والأمل الشاحب أو الثابت، والاستذكار والاستعبار، والخوف من المصير المجهول يترقبه الحبيب، والأطلال الباقية أو الدراسة، وما يستلزم ذلك من أوصاف السفر وأدواته ومراحله، وقبْل ذلك، وأثناءه، ملامح الحبيب وقسماته الجسدية، والرموز والآثار التي خلَّفها الحب بدرجاته المختلفة والمتفاوتة.
إنّ الغزل، بمفهومه العام, هو كل ما يتعلّق بالتعبير عن الجمال والانفعال ما بين الرجل والمرأة. مع توضيح مهم هو أن الغزل في الشعر العربي كان معظمه – إن لم يكن كله – لغة الخطاب من الرجل إلى المرأة، والوصول إلى قلبها، ولا يكون ذلك إلا بالتمهيد والمكابدة، فقد نصل إلى هذا القلب ونجده مغلقاً، فيصدُّك، وما أشقى الإنسان المصدود؟
أما لماذا الغزل، فلأن الشوق إلى الشيء، وإلى تحقيق الرغبة أو الأمنية، ألذُّ وأجمل من الوصول إلى الشيء نفسه واحتوائه.
وقد أثبتَت التجارب أن أبناء العشق حينما يتلاقون ينتهي كل شيء تقريباً، من صنوف العذاب والتفكير، وربما التلذذ الغيبي.
أين نحن من غزل المتنبي؟
لقد قلَّبتُ ديوان المتنبي الذي عُنيتُ به ضبطاً وشرحاً وتعليقاً، وتخريجَ شواهد، مع مقدمة ضافية، لِما قام به أبوالحسن الواحدي (ت 468 هـ) في خمسة مجلدات... وقمتُ بجردة دقيقة، فتحصَّل لدي قرابة 450 بيتاً غزلياً، من أصل مجموع أبيات ديوانه البالغة خمسة آلاف وأربعمائة وتسعين بيتاً, أي أقل من عشرة في المائة, ما يعني للوهلة الأولى أنّ المرأة لم تملك عليه شغاف أمره، ولا محرور أشواقه إليها، كما كانت الحال لدى كثير من شعراء زمانه والأزمنة السابقة، وأن غاية ما كان يصبو إليه، ويَحْشُد له كل طاقات فكره ولسانه، مجْدٌ لا يُؤتاه أحد من بني جلدته، أو كما قال:
يقولون لي ما أنتَ في كل بلدةٍ
وما تبتغي؟ ما أبتغي جلَّ أن يُسْمى
ومثله، وهو غاية الغايات:
أُريد من زمني ذا أن يُبلِّغني
ما ليس يبلغُه من نفسه الزمنُ
مثل هذا الكلام، إنْ لم يبعث فينا تساؤلاً عن سبب ضآلة شعر الغزل الأنثوي لديه، فقد نتساءل بكثير من العجب: كيف استطاع أن يجد لقلبه وقريحته الشعرية، سبيلاً إلى المرأة وجمالها وفتونها وشجون العلاقة الأزلية في ما بينها وبين الرجل؟!
ومع ذلك، فإن أشعاره الغزلية قد أكدت حضور المرأة في فكره ووجدانه، فسلك إليها غير مسْلكٍ، وحاك حولها من أفانين الإحساس المرهف، وبديع السبك والتصوير، والنفاذ إلى ما وراء عالم العشق، ما لا جدال في صدق معاناته واحتراق قوافيه بحثاً عن سكنى ذاتية تَقيه حرَّ نزواته، ومُرَّ حرمانه المزمن مما يلهث إليه القلب والفكر، ودأبه الدهري لبلوغ آرابه ومشاهيه.
وجوه المعاناة الصادقة
قال في صباه الأول، ولعلها من تجاربه العاطفية الأولى ذاكراً مرارة الهجر والفراق:
أبْلى الهوى أسفاً يوم النوى بدَني
وفرَّقَ الهجْرُ بين الجَفْنِ والوَسَنِ
روحٌ ترَدَّدُ في مثْل الخيالِ إذا
أطارت الريحُ عنه الثوبَ، لم يَبنِ
كفى بجسمي نحُولاً أنني رجلٌ
لولا مخاطبتي إياكَ، لم ترَني
يكفي المتنبي من المباهاة والتمايز، سبْقهُ إلى هذا المعنى الذي توكّأ عليه كثير من الشعراء، مع أنه قد تأثر بغيره ممن سبقوه إليه، عنيتُ النُّحول الكلي لدرجة الرقّة الشبيهة بالهواء، لولا الكلام والنطق لما وقَع عليه البصر.
لعله أرقّ بيت في وصف رقّة الأرق العشقي الذي يصيب العاشق المحزون الذي تغمره العبرات ونشيج البكاء.
جُهْدُ الصبابةِ أن تكون كما أُرى
عيْنٌ مسهَّدةٌ وقلبٌ يخْفِقُ
لم يكتف بوصف حاله بل رسم أبعاد العشق وهيئة العاشق الولهان، وذلك لا يكون إلا من معاناة صادقة وتجربة عميقة الأثر.
وعذَلْتُ أهلَ العشق حتى ذقْتُه
فعجِبْتُ كيف يموتُ من لا يعشقُ؟
كأنما الموت وقْفٌ على أهل العشق والهوى... أو أن كل موتٍ آخر، هو موت الجسد ونهاية العمر قضاءً وقدراً، بينما الحب العظيم يُحرِقُ معه كل الجوارح ويَسحقُ كل لَبِنات الحياة التي يصبو إليها المرءُ في محبوبه.
يقول: لما ذقتُ العشق وعرفتُ شدّته، عجبتُ كيف يكون موتٌ من غير عشق, أي من لم يعشق، يجب ألا يموت. وقال، في صباه، يمدح علي بن أحمد الخراساني:
حُشاشةُ نفسٍ ودَّعَت يومَ ودّعوا
فلم أدْر أيّ الظاعنينِ أُودِّعُ؟
يقول: لي بقيةُ نفسٍ ودّعتني يوم ودّعني الأحباب، فذهبتُ في آثارهم، فلم أدْر أيّ المرتحِلَيْن أُشيِّع منهما؟
ولو حُمِّلتْ صمُّ الجبالِ الذي بنا
غداةَ افترقنا أوشكتْ تتصدَّعُ
وقد تأثر في ذلك بقول البحتري، الذي لم يسُغْه الشرَّاح والمفسِّرون:
فلو أنّ الجبالَ فقَدْنَ إلفاً
لأوشك جامدٌ منها يذوبُ
والكلُّ متأثر بقوله تعالى: {لو أنزَلْنا هذا القرآنَ على جبلٍ لرأيْتَه خاشِعاً مُتصدِّعاً من خَشْيةِ الله} (سورة الحشر: 21).
وجوه المعاناة في الصنعة الشعرية
على الرغم من القدر العالي من الطلاوة والرقة وعذوبة الأداء التي اكتنفت فضاء الشواهد الغزلية السابقة – وهي متوافرة، ذكية الرائحة في شعره– فإننا لا نستطيع عدّ المتنبي بين شعراء الغزل والهوى، ولا أن نقارنه بأيّ من شعراء الغزل في مختلف العصور، لأنه لم يؤْثَر عنه علاقة حب كبير مع أي امرأة معيّنة, وما قيل من أصداء متناثرة عن هيامه بأخت سيف الدولة التي بلغه خبر وفاتها وهو بعيد، لا يُشكل دليلاً كافياً لتجربة حب صهرتْ فيه شاعريته وذوّبت عبقريته الشعرية، كما هي حاله مع مدائحه الشهيرة لغير أمير وقائد ممن قصدهم ومدحهم، فحُفظت مطالع شتّى وأبيات كثيرة ردّدتها الألسن وحفظتها الذاكرة العربية، وما أكثرها وأجودها وألصقها في ذاكرة الأجيال، بينما غابت عن التداول والتناقل أشعاره الغزلية.
وما سنراه في الشواهد الآتية قد يُنصف رأينا وربما رأي كثير من الدارسين غيرنا، لأننا سنقع على مجاهدات بيّنة في صياغة أوصاف الجمال والشوق والحنين، ومعاناة الهجر والفراق، من غير أن يعني ذلك تكلفاً مكشوفاً أو صنعة لفظية احترافية.
قال أبوالطيب، في مستهل قصيدة يمدح فيها عبيدالله بن خراسان الطرابلسي:
أظَبْيةَ الوحشِ لولا ظبيةُ الأَنَسِ
كما غدوتُ بجَدًّ في الهوى تعِسِ
ولا سقيتُ الثرى والمُزْنُ مُخْلِفُهُ
دمعاً يُنشّفهُ من لوعة نفَسي
ولا وقفتُ بجسمٍ مُسْيَ ثالثةٍ
ذي أرْسُمٍ دُرُسٍ في الأرسُم الدُّرُسِ
أفرد الواحدي ما يقرب من صفحتين لشرح الأبيات الثلاثة، أتممتُها بمثل ذلك، في ثماني حواشٍ مكثّفة الكلام:
يخاطب الظبية الوحشية لأنها ألِفَتْه لكثرة ملازمته الفيافي.
لولا الحبيبة التي هي ظبية الأنَس، أي الإنس، في الحُسْن، لما صرت في الحب ذا جدٍّ منحوس.
وفي شرح البيت الثاني، قال الواحدي: الإخلاف يكون بمعنى الاستقاء، والمُخلف: المُسْتقي. يقول: ولا سقيتُ الثرى دمعي، والذي يستقي الماء هو المُزْن.
يريد دمعاً يُذهب رطوبته حرارةُ نفسه.
وقال في البيت الثالث: المُسْي: المساء، مثلُ الصبح والصباح. والدُّرُس: جمع دارس، يعني بجسم بالٍ قد أبلاه الحزن في رسوم بالية دارسة.
وقوله «مُسْي ثالثة» يعني وقوفه ثلاثة أيام بلياليها، أو في اليوم الثالث من زمن الرحيل.
وهكذا بقية أبيات الغزل الاستهلالي لقصيدة المدح، التي ناهزت السبعة، دبّجها بكثير من معاناة الصنعَة، والتصوير البياني الموفي إلى شروح وتفاسير مختلفة لهذا الجانب أو ذاك من عناصر الكلام والتعبير.
وقال، في مستهل قصيدة يمدح فيها محمد بن زُريق الطرسوسي:
هذي برزْتِ لنا فهجْتِ رسيساً
ثم انصرفتِ وما شفَيْتِ نسيسا
وجعلتِ حظّي منكِ حظّي في الكرى
وتركتِني للفَرقدَيْن حليسا
قال ابن جني: أي يا هذه! وقال أبوالعلاء المعري: «هذه» موضوعة موضع المصدر، إشارةً إلى البَرْزة الواحدة. والرسيس، والرسُّ = مسُّ الحمّى وأوّلها، وهو ما يتولد منها من الضعف، يقول: برزْتِ لنا فحرَّكْتِ ما كان في قلبنا من هواكِ، ثم انصرفتِ عنا ولم تشْفي بقايا نفوسنا التي أبقَيْتِ لنا بالوصال...
ولنلاحظ هذا التعقيد الذي أصاب لغة الشرح، فإذا كان الشرح بمثل هذا التشابك، فكيف هي حال الشعر إذاً؟
وجاء في شرح البيت الثاني: حُلْتِ بيني وبينكِ، كما حُلْتِ بيني وبين الكرى، فحظِّي منك ومن وصالكِ كحظي من الكرى.
وقال، في مطلع قصيدة يمدح عليّاً بن منصور الحاجب:
بأبي الشموسُ الجانِحاتُ غواربا
اللابساتُ من الحرير جَلابيا
المُنْهِباتُ قلوبَنا وعقولَنا
وَجَناتِهنَّ الناهباتِ الناهِبا
كنى بالشموس عن النساء، والجانحات: المائلات، وكنى بالغروب عن بُعدهنّ. والجلباب: الخمار.
وأنهَبتُهُ الشيء إذا جعَلْته نَهْباً له، يقول: أنْهَبْن وجوهَهنَّ قلوبنا وعقولَنا حتى نهبَتْها بحُسنهنَّ، ثم وصف تلك الوجنات بأنها تَنْهَبُ الناهبَ أي الرجل الشجاعَ المغوار.
كذلك هي حال الأبيات التسعة التاليات، ترشح بالضباب البلاغي وإشكالية الأداء الشعري المختلف النظرة والإشارة واستخراج مقاصد الشاعر.
وأسوق شاهدين غزليَّين، درجةُ المعاناة والصنعة الشعرية فيهما متزايدةٌ...
الشاهد الأول مطلع مديح لأبي علي هارون الأوراجي:
أَمِنَ ازديارَكِ في الدجى الرقباءُ
إذْ حيثُ أنتِ من الظلام ضياءُ
قلَقُ المليحة وهي مِسْكٌ هَتْكُها
ومَسيرها في الليل وهي ذكاءُ
أسَفي على أسَفي الذي دلَّهْتِني
عن عِلْمه فبِهِ عليَّ خفاءُ
لن أشرح الشعر، بل أوضح أن الواحدي، وهو يُعْرب البيت الأول ويشرحه، قد باهى بما توصَّل إليه، لأنه اهتدى إلى مفاتيح اللغة والمقاصد في شعر المتنبي.
الشاهد الثاني: مطلع قصيدة يمدح فيها بدْر بن عمّار:
أبْعَدُ نَأْيِ المليحةِ البخَلُ
في البُعْد ما لا تُكلَّف الإبلُ
مَلُولَةٌ ما يدومُ ليس لها
من مَلَلٍ دائمٍ بها مَلَلُ
(..) ومَهْمهٍ جُبْتُهُ على قدَمي
تعْجزُ عنه العرامِسُ الذُّلُلُ
علّة هذا الشعر وكثير غيره أنه غالباً ما يتألف من مفردات لا تقعُّر فيها ولا وحشيّة، إنما هي التراكيب والتداخل بين الألفاظ والصيغ التي تُخرج النص من وضوح الألفاظ، إلى غرابة التعبير والتصور الشعريين.
وعلّة هذه العلّة أن شاعرنا العظيم، في معظم أغزاله، لم يكن يصدر عن تجربة عاطفية ينعصر لها القلب وتلظى الكبد، فيخرجُ الشعر مكوَّر القافية مضمَّخ الأردان والأغصان. بل كان يعوِّض عن ذلك، بمكابدة الخيال ولَيِّ هام البلاغة لتدُلَّ على طول باع الشاعر في صناعة الغزل واستحضار لواعج الشوق والالتياع، من خزائن اللغة وأساليبها البيانية والبديعية المغرقة في تجرُّدها وتصلّب دلالاتها ورموزها!
وجملة القول في غزل المتنبي أنه لم يكن في المرتبة الأعلى من عنايته الإبداعية كما هي حال الفخر والمديح والرثاء والهجاء... لأن معظم ما ألمحتُ إليه، كان مدخلاً أو مطيَّة لغرض المدح الرئيس، ونادراً ما قرأنا له شعراً غزلياً خالصاً لذاته... لكأن المرأة التي شغلت شعراء العربية وكتّابها وفنّاني العالم، لم تأخذ موقعها الطبيعي في وجدانه الذي اكتنفه همٌّ وجوديٌّ بحجم الكون والتاريخ، عبَّر عنه بكثير من صفاء اللغة ونصاعة التركيب وعذوبة العسل المصفى، كقوله من قصيدة يمدح فيها عليّ بن أحمد الأنطاكي:
ولا تحسَبَنَّ المجْدَ زِقّاً وقَيْنةً
فما المجد إلا السّيفُ والفتْكةُ البكرُ
وتضريبُ أعناقِ الرجال وأن تُرى
لك الهبواتُ السُّودُ والعَسْكر المجْرُ
وترْكُكَ في الدنيا دويّاً كأنّما
تداول سمْعَ المرءِ أنْمُلُه العَشْرُ
ولنتأمل بوضوح هذا الدويّ الذي تُسَدُّ من هوله وشدّته مسامع المرء بكل أصابعه العشرة... ولنتأمل هذه الصياغة التي سالت فيها القريحة وتأجّجت معها جمار النفس الكبيرة التي ملأت عليه مداركه وآماله، الأمر الذي كان عسيراً في معظم ما قرأنا له من أشعار الغزل .

