الشاعر والإنسان واللغة الجميلة
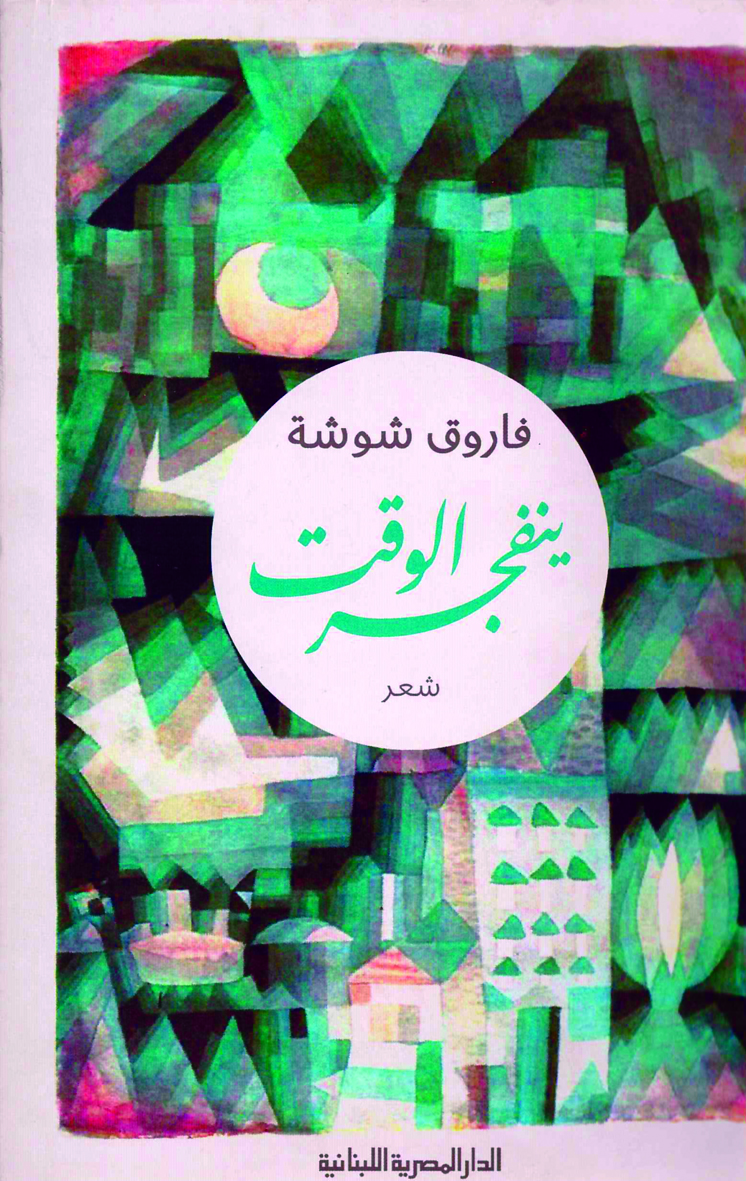
لم يكن فاروق شوشة مجرد شاعر كبير فحسب، ولم يكن مجرد إعلامي كبير فقط، ولكنه نجح في الجمع بين الاثنين (الشعر والإعلام)، ليحقق بذلك ذيوعاً وانتشاراً لم يحققهما شاعر إعلامي آخر من قبل، فدخل كل البيوت العربية من باب البرنامج العام بإذاعة القاهرة عن طريق برنامجه اليومي الشهير «لغتنا الجميلة»، الذي قدمه على مدى خمسين عاماً متواصلة، منذ عام 1967 وحتى رحيله في 14 أكتوبر 2016، وعن طريق برنامجه التلفزيوني الثقافي الناجح «أمسية ثقافية» بالقناة المصرية الثانية على مدى سنوات متعاقبة، إلى أن نقل ميعاد إذاعة البرنامج، ليكون بعد الثانية صباحاً، فشعر بأن برنامجه أصبح من البرامج غير المرحب بها من المسؤولين عن الإعلام أو عن الخريطة الإعلامية في مصر، فقرر عدم الاستمرار في تقديمه حفاظاً على اسمه واسم البرنامج الذي أصبح الآن مرجعاً ثقافياً مهماً، خاصة بعد أن بُثّت حلقات منه على شبكة الإنترنت من خلال موقع «يوتيوب».
كما أسهم الباب الشهري في مجلة العربي (جمال العربية) في ترسيخ اسم فاروق شوشة لدى القارئ العربي على مدى سنوات طوال، وكان هذا الباب من أعمدة الأبواب الثابتة بالمجلة.
كان فاروق شوشة يتصل بي تليفونياً عندما عملت محرراً بمجلة العربي مدة ثلاث سنوات، ليتأكد من وصول مقاله عن طريق الفاكس، وأن كل حروفه وصلت سليمة أو غير متآكلة، وكنت أطمئنه على وصول المقال بصورة جيدة أو أطلب منه إيضاح كلمة أو أكثر في حالة عدم وضوح بعض الكلمات.
التقيت فاروق شوشة كثيراً في مصر وخارجها، وبدأت رحلة صداقتي به في بدايات ثمانينيات القرن الماضي (1981) عندما كان يأتي إلى الإسكندرية ليشارك في أمسياتها وندواتها ومهرجاناتها الشعرية، وكان يسجل لنا قصائدنا التي نلقيها في حضوره، ليذيعها في برنامجه التلفزيوني «أمسية ثقافية» بعد ذلك.
وأتذكر أن حواري معه لصفحة أدب وثقافة بجريدة «الجزيرة» السعودية كان من أوائل الحوارات التي أجريتها في حياتي الصحفية. ففي عام 1985 عملت مراسلاً لتلك الصفحة، وكان أول حوار أجريه للجريدة مع الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبوسنة في بهو فندق سيسل بالإسكندرية، وجلسنا طويلاً نتحدث.
أما فاروق شوشة – الذي كان حاضراً معنا - فكان وقته ضيقاً، وطلب مني كتابة الأسئلة في ورقة، ليجيب عنها عندما يعود إلى القاهرة، ظننت في بداية الأمر أنه نوع من التهرُّب من اللقاء الصحفي، لكنني كتبتُ الأسئلة كما طلب مني. وفي الزيارة التالية للإسكندرية، كانت معه الإجابات بخط يده. ونُشر الحوار في مساحة واسعة بالجريدة السعودية في عددها رقم 4515 الخميس 7 فبراير 1985 (17 جمادى الأولى 1405 هـ).
وكان من المانشيتات الرئيسية للحوار: «أرحب بقصيدة النثر، باعتبارها نسقاً للكتابة وليس باعتبارها امتداداً للشعر الحر، ومن حق المبدع أن يغامر ويجوّد ويُدهش، ولكن دون شرخ لمقاييس الصحة والصواب، وأعترف لك بأنني لم أفهم كثيراً من كتابات البنيويين». وتتالت اللقاءات والحوارات، خاصة بعد أن انتخب رئيساً لاتحاد كتاب مصر عام 1999 (لمدة عامين)، وفي آخر حواراتي معه سألته عن سر تراجع أو غياب المسرحية الشعرية عن مسرح إبداعنا، فقال: أصبحت القصيدة المفردة تقوم بدور المسرحية الشعرية في الحشد والتجسيد، وتعدد الأصوات ومساحة الوعي والأفكار الأساسية، هذه القصيدة في كثير من الأحيان هي مشروع مسرحية.
الأمر الثاني الذي يوضحه شوشة في هذا المجال أن المسرح الجاد، نثرياً وشعرياً، لم يعد له وجود لدينا على الأقل، وأصبحت خشبة المسرح للعري والابتذال والسوقية في اللغة والحركة والفكرة، فكان على الشعر أن يغادر، ومن قبله غادر النثر الحقيقي والجاد، إلا فيما ندر. وكان لفاروق رأي في قضية الجوائز والمسابقات الشعرية التي انتشرت في السنوات الأخيرة من جهات عدة، على الرغم من أنها حركت مياهاً راكدة في الحياة الثقافية، إلا أنه كان يرى أنها أصبحت قصة مُلبسة، وتحتوي على أمور لم يحب الخوض فيها.
ويضيف أن نقادنا، وكثير منهم أعضاء في لجان الجوائز، لم يعودوا يضعون سياسات ويقررون اتجاهات بقدر حرصهم على خدمة ما هو مقرر. وعن دور هذه المسابقات في تنشيط الحركة الشعرية واكتشاف شعراء حقيقيين، كان يؤكد أن الشعر موجود وجمهوره الحقيقي موجود، ولا أظنه محتاجاً إلى جوائز - مهما كانت - للاعتراف بقيمته. ويتساءل: هل كان المتنبي أو المعري أو حتى شوقي ينتظرون جائزة؟.
لم يكن فاروق طاووساً في يوم من الأيام، وبخاصة في أمسياته وندواته الشعرية التي تشارك فيها معنا، فكان يحتضن الجميع ويبتسم في وجه الجميع، ويحنو على الجميع صغاراً وكباراً، وحينما تنتهي الأمسية أو الندوة ونعود إلى الفندق أو مكان الإقامة، نتحلق حوله مرة أخرى ونُسمعه شعرنا مجدداً، وحينما يجيء دوره، ونطلب منه أن يقرأ من أشعاره، يطلب منا أن نختار أي قصيدة في التراث العربي ليسمعنا إياها عن ظهر قلب، حيث لم يكن يحفظ شعره.
ومن المؤتمرات التي حضرتها مع فاروق شوشة المؤتمر الذي عقدته مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بمقر اليونسكو في باريس عن الشاعرين أحمد شوقي ولامارتين عام 2006، وهناك ألقى فاروق بطريقته الساحرة قصائد لأحمد شوقي، بعدها قلتُ له إن شوقي لو سمعك لجعلك تُلقي كل قصائده بتلك الروعة. صفق الفرنسيون لروعة إلقائه، برغم أن معظمهم لم يفهم معنى الكلمات.
لم يأخذه ثنائي عليه بعيداً، وسألني: ألن نسمع صوت الإسكندرية الشعري هنا في اليونسكو؟ فقلتُ له: إنني حاضر كإعلامي، ولم أُدعَ كشاعر.
كانت رسائل فاروق شوشة التي تصل إلي عندما عملت سنوات بالرياض (1987 – 1998) رداً على رسائلي التي كنت أرسلها له على عنوانه (35 شارع محمد مظهر – الزمالك – القاهرة) تمثل لي ثروة أدبية ومعنوية.
وفجأة يتسلل شخص فاروق شوشة، وعنوان ديوانه «الدائرة المحكمة» الذي كتبتُ مقالاً طويلاً عنه، إلى قصيدتي «رائحة البحر» التي كتبتها أثناء سنوات الغربة (1993)، فقلت:
كانَ الشاعرُ
يبسمُ بهدوءٍ
رغم الدائرةِ المحكمةِ عليه
وبصوتِ الموسيقى في أحرفِهِ
يمنحُكَ أمانَ الشعر
ِ ثقافتَك الأدبية
وأثناء عملي هناك، صدر له كتاب بعنوان «مواجهات ثقافية»، وأبلغته في أحد خطاباتي بأنني قرأت الكتاب وكتبت عرضاً له في جريدة «الجزيرة»، وأُفاجأ بأنه لم يعلم بصدور هذا الكتاب. فوعدته بإحضار عدد من النسخ في إجازتي القريبة إلى مصر.
حملتُ نسخاً عدة لا أتذكر عددها، وذهبتُ إليه في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، مررتُ على مكتب صديقي الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبوسنة أولاً في إذاعة البرنامج الثاني (البرنامج الثقافي فيما بعد) – كما هي عادتي عندما أذهب إلى هذا المبنى العملاق – ثم اصطحبني أبوسنة إلى مكتب فاروق، وسعدنا برؤيته للكتاب الجديد، والفرح يتلألأ في عينيه ويشعُّ في قلبه، فيصبح وجهه بستاناً من المحبة والإشراق، وعندما أراد أن يدفع لي ثمن النُّسَخ، رفضتُ بشدة، بل احمرَّ وجهي خجلاً من هذا الموقف، وعندها تدخل أبوسنة قائلاً: خلاص يا فاروق، لا تفسد فرحة أحمد بإحضار الكتاب لك. أصرَّ فاروق على طلب فنجان شاي لي في مكتبه، وعندما تأخر الساعي في إحضار الشاي، وكان ميعاد اجتماع لجنة النصوص بالإذاعة قد حلّ، أصرّ على اصطحابي معه إلى غرفة الاجتماع، وعرفني على أعضاء لجنة النصوص، وكان من بينهم الشاعر مصطفى عبدالرحمن، والإذاعي الكبير وجدي الحكيم، وجلست بينهم ضيفاً سعيداً بما يتم طرحه من آراء حول النصوص الغنائية المقدمة للإذاعة المصرية.
كان فاروق هو الذي يقرأ النصوص بصوته الجميل العذب، وكان أعضاء اللجنة الآخرون يصدرون أحكامهم بعيداً عن تأثير إلقائه عليهم.
جاء الساعي بالشاي في غرفة الاجتماع، فأردتُ أن أتعجلَ في شربه واحتسائه لأغادر الاجتماع الذي لم أكن عضواً فيه، فطلب مني فاروق التمهل، لأنني لن أغادر إلا معه بعد انتهاء الاجتماع والاستماع معهم إلى النصوص الغنائية المقدمة للفحص أو الاعتماد.
التقينا كثيراً في الإسكندرية التي كان يحبها ويكتب بعض قصائده عنها، ونشر إحداها في ديوان «سيدة الماء»، قائلاً:
إسكندرية!
جاء سِمَّانُكِ الخريفيُّ
فاهتزت لأسرابه الشطوطُ القَصيّة
وتنادت حتى الشعابُ العصيّة
تلك ريحُ الشمالِ
تنهلُّ في صدركِ
مُبتلةَ الثياب ِنديّة
قبّليها.. وعانقي في ثناياها هوىً كامناً
وزحاماً من الأمانيّ
فنوناً من التصاويرِ
أيقونةً من النجوم الحفيّة
أنتِ لن تُغلقي نوافذكِ البيضَ
ولن ترتضي حياةَ الدنيّة.
لذا لم يأتِ كتابي عنه «في صحبة فاروق شوشة» من فراغ، وقد استقيتُ عنوانه من أحد عناوين كتب فاروق، وهو كتاب «في صحبة هؤلاء» - ولكنه كان ثمرة صداقة ومحبة عميقة امتدت لأكثر من 35 عاماً، كتبتُ عنه وكتب عني، وحاورته وحاورني، وأحياناً كنت أتشبه به عندما عملتُ في إحدى القنوات الفضائية بالكويت، وظهرتُ على شاشة تلك القناة أكثر من مرة، وخاصة في أحد البرامج الحوارية التي كنت أعدُّها أيضاً .

