فن المدح في الشعر العربي القديم
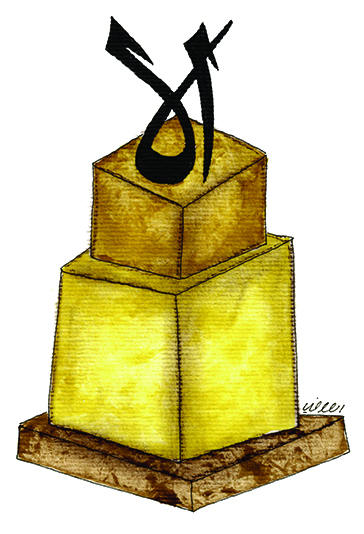
نشأ المدح في الأدب العربي مع البدايات الأولى للقصيدة، شعراً ورجزاً، وارتبط هذا الغرض بمظاهر إعجاب الشاعر بالمواقف الإنسانية النبيلة التي تمثل النموذج المثالي في السلوك الفردي والجماعي في القبيلة، في مظاهر الكرم والجود، أو في الشجاعة والإقدام وإغاثة الملهوف وحماية المستضعفين، أو في الحكم الدالة على نضج العقل وسلامة التفكير، أو في الحلم والتسامح والعفو الذي يحقق للقبيلة السلم والأمان.
إذا كان الشاعر العربي قد استحسن هذه الفضائل وودَ لو تكون شائعة في مجتمعه، فإنه ذم ضدها من بخل وجبن وطيش ورذائل، لأنها لا تمثل قيم الخير العام والفضيلة المثالية والسلم الذي ينعم به الجميع، فلذلك تراه يهجو من يتصف بتلك الصفات ويعمل على نشر الشر وإشاعة الفتن.
إن نزعة الخير التي جعلها الله سمة بارزة في الإنسان تمثل الفطرة السليمة في هذا المخلوق، كما أنها تُبرز صفة الاستخلاف في الأرض وسمة أداء الأمانة في أبهى كمالها، لكونها جعلت الإنسان مكرماً ومفضلاً على سائر المخلوقات في هذا الكون.
والإنسان العربي الذي عاش في بيئة بخلت عليه بكل مقومات الحياة الضرورية من نبات وشجر وماء إلا في جهات قليلة، كما حرم من الاستقرار والأمن على حياته وأسرته وماله، كان يدرك أن مواقف النبل والخير والتسامح هي التي ينبغي أن تسود في المجتمع، لأنها تخفف عنه ظروف هذه البيئة القاسية، فكان مدحه للرجل الذي تتمثل فيه هذه الصفات يمثل الرغبة القوية في شيوعها بين أكثر الناس، لأنها الأمل في استمرار الحياة الكريمة والسلام الدائم، فالجواد يعين الجياع في بيئة قاسية لا تجود بالكافي من الطعام، والشجاع المقدام يحمي الضعفاء من النساء والولدان والشيوخ الذين لا قدرة لهم على مواجهة الأشرار في بيئة ينعدم فيها الأمن، والحكيم الحليم الذي يدعو إلى التسامح والرفق يعمق في المجتمع المثل النبيلة والأخلاق العالية التي ينبغي أن تسود بين جميع الأفراد.
والغاية التي كان يسعى الشاعر إلى تحقيقها من ذكر تلك الفضائل في شخص مَا أو يحلم بوجودها في مجتمعه هي عيش الناس بسلام دائم وتضامن وتكافل اجتماعي.
أخلاق نبيلة
في ذاكرة الشعر العربي القديم رجال كانوا شعلة مضيئة في المجتمع الجاهلي، ما زال ذكرهم يتردد في عصرنا الحاضر، ففي الجود والكرم والرغبة في تحقيق السلم برز في هذا المجتمع رجال مثل هرم بن سنان والحارث بن عوف، اللذين سعيا إلى تحقيق السلم والأمن بأموالهما في مجتمع طالت فيه الحروب والصراعات, وذهب ضحية ذلك عدد كبير من الأبرياء. يقول زهير بن أبي سُلمى في مدحهما وفي سعيهما إلى وقف الاقتتال بين قبيلتي عبس وذبيان:
فأقسمتُ بالبيتِ الذي طافَ حولَهُ
رجالٌ بنوهُ من قريشٍ وجُرهُم
يميناً لنعْمَ السيدانِ وُجدِتَما
على كل حال من سَحيلٍ ومبرمِ
تَدارَكْتُما عبساً وذُبيانَ بعدما
تفانَوا ودقُّوا بينهمْ عطرَ مَنشمِ
إن كل إنسان نبيل الخلق يحب هذا الموقف ويجل من يقوم به، لأن الإصلاح بين الناس ليعيشوا في سلام دائم يعد من الصفات الإنسانية النبيلة التي حثت عليها الأديان السماوية، ودعت إليها الأخلاق العامة، والمذاهب الفلسفية والأخلاقية، والتزمت الدول في عصرنا الحاضر تطبيقها والحرص عليها لضمان استمرار الأمن بين الجميع. والإنسان العربي الذي عاش في العصر الجاهلي واكتوى بنيران الحروب واعتداء الجماعات الخارجة على الأخلاق والعرف السائد في القبيلة، كان يدرك دلالات هذه المعاني ومقاصدها النبيلة من أجل تامين حياته.
وهذا عمر بن الخطاب ] كان سيداً من سادات قومه في الجاهلية، ثم ازداد علواً وشرفاً وقدراً في الإسلام، يقول قولة بالغة الدلالة لابنة زهير بن أبي سلمى في المدح الصادق الذي يظهر أثر الفعل الجميل في المجتمع الجاهلي وفي كل المجتمعات الإنسانية «ما فعلت حلّة هرم بن سنان التي كساها أباك؟ قالت: أبلاها الدهر. قال: لكن ما كساه أبوك هرما لم يبله الدهر». وقال لبعض ولد هرم بن سنان «أنشدني ما قال فيكم زهير، فأنشده. قال: لقد كان يقول فيكم فيحسن، قال: يا أمير المؤمنين إنا كنا نعطيه فنجزل. قال عمر: ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم».
سمات فاضلة
هكذا كان العربي يقدر أثر الكلمة الطيبة والفعل الحسن في النفوس، فما قام به كل من هرم بن سنان والحارث بن عوف هو عمل جليل وفاضل ينبغي أن يسود في جميع المجتمعات، ومدح زهير بن أبي سلمى لهذين الرجلين عمل أحق بالتقدير والثناء، لأنه أبرز بصدق المسعى الجميل الذي يُرسي دعائم السلم والأمن في المجتمعات التي مزَّقتها الحروب واكتوت بنار الفتن التي لم يسلم منها أحد.
وبفضل قصائد المدح التي لا زيف ولا غلوّ ولا إفراط فيها، وصلت إلينا أخبار سادة العرب وأشرافهم، الذين أصبحوا نتيجة مواقفهم الإنسانية نموذجاً مثالياً لكل من يسعى إلى بلوغ مراتب المجد والكمال الإنساني في الجود والشجاعة والحلم والتسامح والصبر والعفو عند المقدرة، إنها سمات فاضلة كان الفرد العربي يتغنى بها في شعره لتستمر في مجتمعه. وهذا الشاعر البحتري حينما أراد أن يتمثل بخصلتي الحلم والمعاني الشعرية الرصينة، وجد ضالته في الأحنف بن قيس، الذي اشتهر بالحلم، وفي الحطيئة، الذي كان شاعراً مطبوعاً وموهوباً، فقال:
فكأنما إذ قمتَ قام حطيئةٌ
للشعرِ، أو للحلمِ قام الأحنفُ
وهذا أعرابي وقف أمام علي بن أبي طالب ] يطلب حاجة، فلما أعطاه حلة لم يجد شيئاً يكافئه به غير مدحه، فقال:
كسوتني حُلَّة تُبلى محاسنُها
فسوفَ أكسوكَ من حسنِ الثنا حللا
إن الثناءَ ليُحيي ذكَر صاحِبِه
كالغيثِ يُحيي نَداهُ السهلَ والجَبَلا
هكذا كانت أغراض الشعر عامة، والمدح خاصة، عند العرب مرآة للفضائل والأخلاق العالية في المجتمع، يبرز الشاعر فيه تصوره المثالي لمكارم الأخلاق والمثل العليا وما يسعى المجتمع إلى تحقيقه.
ومن هنا نفهم لماذا كان النبلاء والأشراف وأصحاب الفضل والخير في هذا المجتمع يطمحون إلى أن يقال فيهم مدح صادق من شاعر موهوب يُخلّد أعمالهم ويحيي ذكرهم الجميل مثلما يحيي الماء التربة الطيبة فتعطي أزهاراً وعشباً وثماراً.
وكذلك كان كل فرد في هذا المجتمع يخشى أن يكون ضد الصفات الحميدة التي يذمها المجتمع، فويل لمن قصدته سهام الشعراء بالذم والهجاء، لأن الشعر كان ينتقل بين القبائل بأسرع من انتقال الرياح في يوم عاصف، فتظل تلك المثلبة عالقة بصاحبها مدى الدهر ولو كانت زوراً، ومَن منا لا يذكر هجاء حسان بن ثابت والحطيئة وابن الرومي والمتنبي وغيرهم من الشعراء؟ فقد ظل هجاؤهم صامداً لا تبليه الأيام.
الخشية من الشعر
لهذا السبب كانت خشية العرب من الشعر أشد من ضربة سيف قاطع ورمية سهم نافذ، وقد ذكر ابن رشيق القيرواني مقارنة بين هيبة الشعر عند العرب وإعجاز القرآن الكريم لهم، ليثبت أن الإعجاز كان أقوى دليل على هيبة الشعر وفخامته، لكونهم نعتوا رسول الله [ بأنه شاعر، إقراراً منهم بهيبة الشعر الذي كان يؤلمهم، فقال «وكما أن القرآن أعجز الشعراء وليس بشعر، فكذلك أعجز الخطباء وليس بخطبة، والمترسلين وليس بترسل، وإعجازه الشعراء أشد برهاناً، فقالوا هو شاعر، لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته، وإنه يقع منه ما لا يلحق».
وهذا هجاء جرير للشاعر النميري لم تبله الأيام برغم مرور هذه القرون الطويلة، فقد ظل عالقاً بالمهجو، ومثالاً لكل هجاء مقذع:
فغضَّ الطرفَ إنَّكَ من نُمَيْرٍ
فلا كعباً بلغتَ ولا كِلابا
وهذا الحطيئة يهجو الزبرقان هجاء مؤلماً حتى إنه شكاه لعمر بن الخطاب ] فحبسه لأجل ذلك في قوله:
دعِ المكارمَ لا تَرحل لبُغْيتِها
واقعُد، فإنكَ أنتَ الطاعِمُ الكاسي
هكذا كان المدح يرفعَ أقواماً، والهجاء يحطُّ آخرين، فلذلك كان العرب يهابون الشعر أكثر مما يهابون ضربة السيف.
وقد ظل المدح غرضاً أصيلاً في الشعر العربي حتى بعد مجيء الإسلام وانتقال العرب إلى الأمصار الجديدة، لأنه كان يعبر عن رؤيتهم للفضائل والأخلاق ومعالي الأمور التي آمنوا بها وأقرها الإسلام.
ولعل خير ما نختم به هذه الرؤية المثالية لقصيدة المدح في ثباتها على هذا النهج قصيدة أبي زيد الفازازي، الأديب والفقيه والشاعر المغربي (ت 627)، التي مدح بها العالم الجليل أبا المعالي محمود بن أبي القاسم الفارسي الخراساني، بصفات العلم والجلال والوقار والخلق النبيل والتواضع، وهي التي ينبغي أن يتصف بها كل عالم.
قال عنها ابن عبدالملك المراكشي: «وامتدحه بقصيدة فريدة رأينا إثباتها تكميلاً للإفادة، وتنبيها على ما لأهل المغرب في الفضل من الحسنى والزيادة»، منها هذه الأبيات:
العالمُ العلمَ الذي تزهى به
أرضُ العراقِ إلى أقاصي الصينِ
والأوحدُ السَبَّاقِ غيرُ مدافعٍ
في حلبةِ المفروضِ والمسنونِ
إنسانُ عينِ الفضلِ قلبُ ضلوعهِ
بشواهد جلَّت عن التبيينِ
باللهِ أو في اللهِ أو للهِ ما
يأتيه حينَ تحرُّكٍ وسكونِ
لم يأتِ في الإبداع فنَّاً واحداً
إلاَ أتى من بعدِهِ بفنونِ
حفظ ابن إسماعيل، فقه ربيعة
زهد الجنيد ذكاء أفلاطون ■

