الاتجاه السياسي في أدب الأخطل الصغير
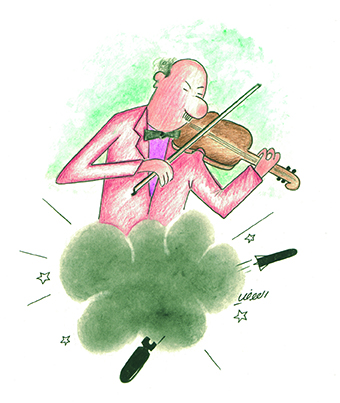
قدّم الأخطل الصغير (بشارة عبدالله بن الخوري ميخائيل 1885-1968) إلى جمهوره العربي في مدى ستين سنة من عطائه الأدبي مائتين وأربعاً وتسعين قصيدة، نال منها الشعر السياسي وحده ثلاثين قصيدة، وكان توزّعها من حيث العهود السياسية في عهدين: ما جاء في العهد العثماني، وما كان في عهد الانتداب الفرنسي لكلّ من سورية ولبنان. وقد تداخلت أحداث كثيرة في ذينك العهدين، وكان لهما أثرهما في أدب شاعرنا، وعنيتُ بأمرين عنده، هما: مواقفه من الولاة الترك في مرحلة المتصرفية، ومواقفه من الثورة العربية وتداعياتها، أمّا فلسطين فكانت لها حظوة خاصة، ومكانة سامية في فكر شاعرنا وقلبه.
عوامل مؤثرة في اتجاهه السياسي
ثمة أربعة عوامل كثيراً ما فعلت فعلها في شخصية الأخطل الصغير، ووجّهت رأيه، وأكّدت موقفه مما يعمل في ذاته، وما يجري حوله من أحداث، هي: ذرائعيته الخاصة به، وانحيازه المطلق إلى لبنان، والفقراء، والدولة الديمقراطية، وعداؤه الشديد للطائفية، وعروبته الأصيلة.
أمّا ذرائعيته الخاصة به فهي واقع تجربته الحياتية، كما عاشها مع الناس، بأفراحهم وأحزانهم، وما تعلّمه ومارسه في مهنة الصحافة، عبر جريدته «البرق»، ثم ما خبُره من حقائق الحكّام وجشع الأغنياء، ومكائد الولاة، مما جعله كثير الحذر، وكثير الإيمان بأن حقيقة الأشياء، ولاسيما الحدث السياسي، لا تتجلى إلا في جملة التجربة الإنسانية، وبقدر ما تكون نافعة للمجتمع اللبناني والعربي، وتخدم مطالب الحياة. هو ذرائعيّ، في توجهه التحليلي للحدث، إلى نتائجه النفعية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، لذا تعامل مع إعلان الدستور العثماني، وإعلان دولة لبنان الكبير، وإعلان الثورة العربية، وسواها، بمنطق واقعي جرّاء ما أملته مسارات التطورات السياسية، وما صاحبها من مناخات سياسية، ثم كان يراقب مسار هذه الأحداث، ليعلن مناوأته لها حين تنحرف عن اتجاهها، وما أعلنته من أفكار ومبادئ.
مواقفه السياسية من السلطة العثمانية
وثّق الأخطل الصغير في جريدته «البرق» (أسسها سنة 1908) يوميات مرحلة شهدت قبول الإصلاحيين العرب ورضاهم على ما عزمت عليه الدولة العلية من إصلاحات، فهم كانوا مستمسكين بـ«الشرعية» العثمانية ما بقيت وفية لهدف «التنظيمات» وإعلان «خط شريف كلخانة» (1839)، ولاسيما حرمة الحياة والمال، وتطبيق العدالة والمساواة بين أهل الأديان في تطبيق القوانين.
وفي رأي جورج أنطونيوس فإن «عودة الدستور قوبلت بحماسة، وكان ابتهاج العرب به أكثر من غيرهم، وتوهّموا أنه حقق الحرية الحقيقية، فأخذت حُمَيّا التآخي، فتآخى العرب والترك والمسلمون والمسيحيون، وهم يعتقدون اعتقاداً مخلصاً أن الدستور سيسدّ حاجات كلّ منهم» (يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القومية،
(ص 176-177).
ويسجّل شاعرنا هذه الفرحة بمناسبة صدور الدستور العثماني الجديد (1908) في قصيدة «عيد الأمة»، يستهلها بقوله:
عيدٌ تصافح فيه السيف والقلمُ
فليبشر الشرفان العِلْمُ والعَلَمُ
وليهنأ الشرق، إن المجد مرتجعٌ
ولتطمئنّ العلا، فالعرش مندعم
(الديوان الكامل، ص44).
لكن سمة «الحذر الشديد» التي عُرف بها شاعرنا وروز الأمور بنتائجها، توافقت ومرحلة تأسيس الإصلاحيين العرب في سورية ولبنان منتديات وجمعيات تحذّر من عواقب انقلاب السلطان عبدالحميد على الدستوريين ودعاة الإصلاح الأتراك، ثم راحت النبرة تعلو لتغدو دعوة صريحة إلى الوقوف في وجه الطاغية السلطان عبدالحميد، فانبرى شاعرنا ملتزماً بالتعبير عن أوجاع أمته وأحزانها، فقال مصوّراً مشهد الجوع والتشرد في لبنان وسورية:
عصفَ الفقرُ بهم فانتشروا
كانتشار الوابِئ المُسْتَفْحِلِ
يَلْهَمُون العُشْبَ من جوعِهمِ
وَيْحَهُم، ما تركوا لِلْهَمَلِ؟
(الديوان الكامل:ص 164)
ونظم يوم سقط عرش عبدالحميد الجائر (1909) قصيدة «عَبْرة وعِبرةَ»، مبدياً قدراً من الشماتة:
قُلَلُ الشرقِ حاذري أن تميدي
سقط العرشُ عرشُ عبدالحميد
(...)
إيهِ عبدالحميد، حدِّثْ عن الدهـ
رِ، وحدِّث عن يومك المشهودِ
كنتَ تبكِي، فصرتَ تُبْكى، وعهدي
بِكَ، عبدالحميد، غير بعيد
يا لياليه في سلانيك، قولي
لليالي في «يَلْدِزَ»: لن تعودي
يا لياليه، لا تُريه ضحاياهُ،
فتعروه رِعْشَةُ الرِّعديد
(...)
كان بالأمس، والرعايا عبيد
فغدا اليومَ صاغراً للعبيد
(الديوان الكامل: ص 34، 37).
وفي تصاعد الاحتجاج على سياسة الاتحاديين، دعاة التتريك، وخاصة عقب انعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس (يونيو 1913) تجلّت الصرخة العربية الأولى بمناداتها بـالحكم اللامركزي.
لكن نشوب الحرب العالمية الأولى (1914) طاح بكل جهود الإصلاحيين العرب، فقد أحكم الاتحاديون قبضتهم على سورية ولبنان، وأخذوا يثبتون بسط سيادتهم بضروب من الوحشية بلغت من سوء التدبير مبلغاً متفرداً.
وبخطوة احترازية توارى شاعرنا عن الأنظار بعد أن فُرضت رقابة مشددة على الصحافة، فأغلق «البرق» في أواخر سنة 1914، وراح يعمل سرّاً مع رفاقه في «جمعية أرز لبنان»، وظل متخفّياً عن عيون وشاة جمال باشا حتى منتصف 1916، وكان الديوان العرفي قد جَدّ في القبض عليه حيّاً أو ميتاً. وأقسى ما آلم شاعرنا، وحزّ في نفسه كثيراً إقدام السفاح جمال باشا على شنق 14 مناضلاً من رجالِ القضية العربية في 6 مايو 1916، وممّا جاء في قصيدته «الحبل أنَّ على الخشب»:
الحبلُ أنَّ على الخشبْ
أَوَ ما تراه قد اضطربْ
سَئِمَ الرقابَ وقد شكا
زوراتها عُصَـباً عُصَبْ
سالتْ نفوسهم عليها
كاللُّجَيْنِ على اللَّهَبْ
(...)
أنا لو قدرت لَصُنْتُها
صونَ العزيز المستحبْ
(...)
وجعلتها في هيكل الـ
أوطانِ تَذْكَارَ النُّوَبْ
تذكارَ غَمْدِ مهنَّدِ الـ
أتراكِ في صدرِ العَرَبْ
(الديوان الكامل: ص 176-177).
بعد حادثة شنق عدد من رموز قادة العرب ومناضليهم، ازداد الشعور في سورية ولبنان حماسة وتحفزاً، وأصبح الاستقلال والسيادة أمراً حيوياً، وقد ترافق ذلك دولياً بتشجيع «الحلفاء» للعرب على القيام بثورة ضد الأتراك، مع الوعد بمساندتهم في حقهم بالحرية والاستقلال؛ وقد تجلّى هذا المناخ السياسي بالصرخة التي «تُعيذ العرب أن يكونوا عَبَدة مسخّرين، يقبلون الضيم شأن الأذلاّء المستضعفين»، ثم راحت هذه النداءات تناشد كلّ عربي «نصرة جنسيته» وتأييد الشريف حسين الذي «تحرّكت أمشاجه لمصائب قومه» (عبدالعزيز الدوري... التكوين التاريخي للأمة العربية، ص 259).
وقد رافق ذلك ما شاع من أن «الحلفاء» سيبعثون الامبراطورية العربية، برئاسة الحسين بن علي، وهو ما أثلج صدر الأخطل الصغير، فراح يدعو للدولة العربية بالنجاح، موقّعاً قصائده، أول مرة، (1916) بتوقيع «الأخطل الصغير»، وقال مستبشراً:
لقد رجعتْ خلافتنا إلينا
وكان رجوعها نصراً مبينا
(...)
أَتُركيٌّ وفينا هاشِميٌّ
دمي دمه، ويبقى الدينُ دينا
(الأعمال النثرية: ص 83-84).
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى (1918) بدأ العرب بتأسيس «دولة عصرية جديدة» في الشام، وأصدر الأمير فيصل بياناً إلى «أهالي سورية المحترمين» يعلن «أن حكومتنا قد تأسست على قاعدة العدالة والمساواة، فهي تنظر إلى جميع الناطقين بالضاد، على اختلاف مذاهبهم وأديانهم نظراً واحداً» (أحمد قدري: مذكراتي عن الثورة العربية، ص 76-77).
وعلى الرغم من تحقيق حكومة فيصل في الشام بعض الأهداف المهمة، فإن الشعور باسترداد «الهوية العربية» لم يكن شاملاً، ذلك أن القطاع الأوسع من السكان كان أقرب إلى التمسّك بـ«الحس الديني...»، إضافة إلى ما تعرّض له فيصل من نقد، جرّاء سياسته: «خُذْ وطالب»، وهو ما أثار العديد من التناقضات والخلافات التي نشبت في الشام بين مختلف الجماعات والقياديين، وأفرز مناخاً ممالئاً للفرنسيين، تجلّى لدى بعض الأوساط الأرستقراطية في الشام، ولدى عناصر سياسية.
مواقفه السياسية من الانتداب الفرنسي
في موازاة هذا المناخ السياسي كان الأخطل الصغير قد كتب افتتاحية «البرق» (1918 العدد 31-424 ص1) بعنوان: «لماذا نريد حكومة لا دينية»: (...) إن الطائفية في لبنان وسورية، هي التي فرّقت أهله شتاتاً، وهي التي حكمت عليهم بالضعف، فمن أجل ذلك حاربناها، وكذلك كان شأن الفرق المذهبية الأخرى، وانقسامها بعضها على بعض، بحيث تلاشت قواها، وطمع بها الطامعون. من أجل ذلك، ومن أجل أن لا نعيد على مسرح الحياة تمثيل الأدوار السالفة (...) أتمنى وأطالب بحكومة وطنية لغتها العربية - بحكومة مستقلة - بضمانة ومساعدة أمّة، لها من شرفها وسابق مجدها ما نأمل معه إخلاصها وصدق نيّتها - وذلك إلى أن ننشأ وطنيين، لا نُدخل الدين في شؤوننا الوطنية الزمنية والسياسية، كما هو شأننا بين الأمس واليوم»
(الأعمال النثرية: ص170).
وأشار بوضوح في افتتاحية «البرق» (1919، العدد 38-431، ص1) إلى «أن الدول العظمى، باختيارها فرنسا الشريفة لتكون معلماً وقائداً لنا في حياتنا الاجتماعية هذه، قدمت برهاناً جديداً على أنها حاربت في سبيل سلام العالم، في سبيل العلم والرقي والمدنية».
(الأعمال النثرية: ص173).
ويرحّب الأخطل الصغير، أيّما ترحيب بالجنرال غورو، الذي أعلن إحياء دولة «لبنان الكبير» (سنة 1920) بحدوده الحالية، مقروناً باعتراف فرنسا باستقلاله عن سورية. وفي قصيدة بعنوان: «في سبيل المجد واستقلاله» يقول شاعرنا:
إيْهِ غورو، والأماني جَمَّةٌ
وثمارُ الفور للمستبسلِ
إن لبنانَ الذي أَوْجَدْتهُ
ليس بالجاحِدِ كفَّ المُفْضِلِ
(...)
أَمَلٌ عاش به في ما مضى
ولقد يحيا به في ما يلي
ثم يسوّغ الشاعر هذا الانفصال عن سورية، بقوله:
إيْه سوريا التي غزلانها
تُلبس الشيخَ ثياب الغزل
مَهْدُنا العهدُ الذي جَرَّبْتِهِ
والهوى ذاك الذي لم يحل
إنْ نفرق فلنا مصلحة
ونفوسٌ إن تفرّق تقتل
قسمةٌ أملى بها ما كابدوا
من جراحات الزمان الأول
مشكلٌ ضِقنا يداً في حَلِّه
فتركناه إلى المستقبل
عاد لبنان كبيراً، وغدا
الأرزُ شيئاً في حقول الدول
(الديوان الكامل: ص 230-231)
وتوالت نصوص الأخطل الصغير، على صفحات جريدته «البرق» بتمجيد هذا الحدث السياسي، ففي هذا «اليوم يضحك ثغر لبنان، وترقص عرائس المروج فيه. (...) اليوم يقف فخامة الجنرال غورو في زحلة ليعلن ضمّ البقاع إلى لبنان (...)
(البرق 3 أغسطس 1920، العدد 1058)،
(الأعمال النثرية، ص185).
وفي نصّ آخر يعبّر عن إعجابه بوفاء فرنسا، ممتدحاً غورو: «سيقول للبنان، هذه ثمرة الوفاء فاستطبها، لك ما طلبته من فرنسا أمّك، هذه البقاع وبعلبك، وتلك حاصبيا وراشيا، ثم هذه بيروت (...) ألا فلتحيا فرنسا، وليحيا غورو، ولتحيا بيروت عاصمة لبنان الكبير»
(الأعمال النثرية، ص188).
وفي نصّين مهمين في دلالاتهما السياسية، يسجل الأخطل الصغير موقفاً من قضيتين، تتعلق الأولى منهما بالموقف من الوحدة بين سورية ولبنان، وفي الثانية إشارة إلى أسس الخلاف، وهما أقرب إلى التسويغ الذي يبرّئ - برأيه - حالة الانفكاك بين السوريين واللبنانيين، في النص الأول، يقول صراحة: إن الطائفية، أيّا كان شكلها ومضمونها، هي مرفوضة، وهو لا يقبلها: «أجل، ليس من العقل، بل ليس من الوطنية أن يستمر هذا النزاع بين فريقين من أبناء الوطن، على قضية أساسية كقضية الوحدة والتجزئة، حتى لبست أو كادت ثوباً طائفياً كريهاً، ثم يقول في فقرة أخرى: «لا نكران أن الفريق المنادي بالانفصال عن لبنان، للالتحاق بسورية، يشكو إجحافاً، فهو يقول إنه كطائفة كبيرة يغذّي الخزينة اللبنانية تغذية كبيرة، ولا يناله من هذه الخزينة ما يقابل تلك التغذية - هذا هو جوهر القضية - في عرفنا - وكل ما يقال غير ذلك فهو طلاءٌ، ثم يعلّق بقوله: «إنه لقولٌ حق، وإنه لطلب عدل ولكن هذا الأمر يعترضه خوف الفئة القائلة باللاطائفية، الحالمة بالحكومة الديمقراطية (...)، أجل يعترض هذا الأمر خوف الفئة التي لا تبالي، أتولى هذا المنصب مسلم أو مسيحي أو دهري، على شرط أن يكون نزيهاً وأبياً. وفي ختام المقال يدعو إلى حوار، و«إلى اجتماعات الإخوان ندعو بني أمتنا، وإلى تصافح الإخوان! وإلى تفاهم الإخوان» (البرق، 1926، 24 يناير، العدد 2509)،.
(الأعمال النثرية، ص269).
أما النص الثاني، فيجعل عنوانه: «الشقيقان المتعانقان... بماذا يستقلّ لبنان عن سورية!»، ويرى أن «الجهل» هو الداء في هذا الانفصال: «لقد اقترف الجهل جناياته فينا، ولكن العقل يأبى أن يستمر الجهل في غيّه، ولاسيما بعد ما مرّ بنا من التجارب، فكانت جميعها ويلاً على جميعنا»، ثم يختم مقاله باستنهاض الجميع لدرء هذا المصاب: «وعينا جميعنا أن ننهض لنكفّر عن الماضي، فنصل حيث فصلنا، ونلام حيث جرحنا» (البرق، 1927، 19 نوفمبر، العدد 2892).
(الأعمال النثرية، ص271).
ثم، يطالعنا الأخطل الصغير بعبارة وجيزة، تبدو موقفاً يضادّ ما قرأناه له من ابتهاج بالانتداب الفرنسي، إذ يقول: «فنحن هنا ننشد اتحاداً قومياً، علّمتنا التجارب أن لا كرامة لنا، ولا مصلحة لنا إلا به، ولقد استيقظ له أبناء البلاد بعد غفلة، ونهضوا يعملون له، فيجدر بنا، ونحن من قضبان هذه الحزمة، أن نعمل مع العاملين» (البرق، 1927، 19 أكتوبر، العدد 2892).
(الأعمال النثرية، ص272).
ومن قبيل المفارقات، بين أمس لبنان وحاضره في الانتداب الفرنسي، يرى الغدر بلبنان:
لبنان، يا جنة الأرواح، ما فعلت
بك الليالي؟ فعاد العُرْسُ مأساتا
قد كبّروك لأمرٍ صغّروك به
قد فخّموا الاسم، لكنْ حقّروا الذاتا
(...)
فتيان لبنان، هبّوا من رقادكم
سيّان من نام عن حقّ ومن ماتا
(الديوان الكامل: ص 359).
فهل ذاق الأخطل الصغير مرارة الانتداب الفرنسي، بعد سنوات من الممارسة والتجربة؟ لقد خاب أمله بـ«الأم الحنون»، وطاب له أن ينتقد ويتبرّأ، فتوسل مناسبة رثاء الملك فيصل الأول، ليعلي من العلاقة بالحركة العربية الاستقلالية، وما كان لهذه العلاقة من ارتباط بوعود «الحلفاء» الغربيين وعهودهم للعرب، ثم ما اقترفه هؤلاء «الحلفاء» من نكث لهاتيك الوعود والعهود.
وفي هذا المسار يتحول الإحساس الشاعري من نطاق الرثاء في حدوده التقليدية إلى نطاق الموقف القومي، فينشد في «مصرع النسر»:
قُلْ لتلكَ العهود في رهج الحر
ب، وفي سكرة القنا والغلاصِمْ
قد لمحناك في عيون الثعالي
ولمسناك في جلود الأراقِمْ
حدّثونا عن الحقوق، فلمّا
كبّر النصر، أعوزتنا التراجمْ
قل - وقِيتَ العِثارَ - في ندوة القو
م، متى أصبح الحليف مخاصِمْ
أين ذاك الهيامُ في أوّلِ الحبْ
بِ، وتلك الموشّحات النواعم؟
(الديوان الكامل: ص316).
وتوجّه إلى وطنه، وقد كثرت عليه الأمهات والأوصياء الأعداء، وكلّهم ضياغم ووحوش تتكالب على خيرات البلاد، فيقول:
كَثُرتْ عليكَ الأمّهات وما درت
أرحامهن، وكلّ أُمّ ضيغم
وفي تعبير يحمل «فعل الندامة» والتذمّر من الانتداب الفرنسي، يخاطب أديبنا أولي الأمر في لبنان وفرنسا بقول ملؤه المرارة والخسران: «يا أم الحرية! (...) أعيدي علينا لبناننا الصغير، وهناءنا الصغير، وسيادتنا الصغيرة. أعيديها إلينا فتبقي في هذا الشرق ذلك الخمير الذي فعل ويفعل فعله العجيب في نفوس أبنائه (...)» (البرق 1927، العدد 2900)،
(الأعمال النثرية، ص211).
ويرى في مناسبة رثاء فوزي الغزي (البرق، يونيو 1930، العدد 3368، ص9) فرصة أخرى ليفرغ في كأس نقمته على الانتداب الفرنسي مزيداً من اللوم والمناوأة:
الأماني التي افترّت لنا
بدّلت أبيضها الزاهي بنقسِ
والجراحات التي تحملها
بسمات الهزء من آمال أمسِ
كم حشوا أذناً بوعدٍ كاذبٍ
مثلما يُحشى فم الميت ببرسِ
نكبوا (المصلوب) في موطنه
ورموا خمسته القرحى بخمس
زعموا إنقاذه حتى إذا
زغرد الناقوس باعوه بِفلْسِ
(الديوان الكامل: ص260).
فهل تغفر، هذا الذرائعية الخاصة، مواقف الأخطل الصغير تجاه قضيتين مصيريتين: الموقف من الاحتلال العثماني، قبولاً ثم رفضاً، والموقف من الانتداب الفرنسي، ابتهاجاً ثم حصاد الخيبة والمرارة؟ لعل التأريخ التصاعدي للأحداث السياسية التي عصفت ببلاد الشام، وما كان يرصده هذا الأديب في تحولات مجتمعه، ومعاناة الناس، قد يسوّغ ما كتبه شعراً ونثراً.
«العروبة السياسية» في أدب الأخطل الصغير
في مشهد مغاير لتلك الذرائعية الخاصة التي اعتمدها أديبنا، وأجراها مواقف متباينة الشكل، ومسوّغة في تأريخ التعامل مع الأحداث، يقدّم لنا صورة نقيّة في نهجه العروبي، مبتدئاً بنص وجيز نشره في جريدة «البرق» في العام 1927، إذ يقول: «نحن هنا ننشد اتحاداً قومياً، علّمتنا التجارب أن لا كرامة لنا، ولا مصلحة لنا، إلاّ به» (البرق 1927، العدد 2892)، (الأعمال النثرية، ص272).
وللنص دلالته من حيث استخدام مصطلح «القومية» في النص، فنادراً ما استخدم الأخطل الصغير هذا المصطلح، بهذا الوضوح الصريح، إذ كان جلّ تركيزه على «الوطن» و«الأمة» و«العروبة».
وقد نال مفهوم «العروبة» مساحة كبيرة في كثير من نصوصه النثرية والشعرية، وهو متجّه سياسي أصيل، تكوّن في عمارته الشعرية من ثلاثة روابط، هي: رابط اللغة العربية، ورابط الماضي المشترك، أو الانتماء إلى حضارة عربية مجيدة، ورابط المشاعر الواحدة، مع ما يرافق ذلك كلّه من حنين وجداني إلى التلاقي العربي في ظل مُتَّحدٍ يجمع الإرادة، ويجبه طمع الطامعين والغزاة، ويُعلي من شأن المجتمع العربي علماً وحضارة، وثقافة انفتاح على الفكر العالمي، ولاسيما الغربي، ليتحرر الإنسان العربي من جهله، وتعصبه. وهو كثيراً ما يردّد عبارة مبدأ الوعي العربي القائم على ضرورة شعور العرب بتردّي أحوالهم، والعمل حثيثاً على الخلاص من الاستبداد، والتحوّل من حالة التبعية والخمول إلى حالة الاستقلال والنهضة الشاملة.
وقد تجسّدت «ثقافة العروبة» في نصوص أديبنا عبر ما يمكن أن نسمّيه: رموز المكان (من مدن وعواصم عربية) وأنهار (بردى والنيل ودجلة والفرات) ورمز لغة الضاد، ورمز التغنّي بالماضي التليد، ورمز الرجال الأعلام (من قادة عسكريين، وقادة سياسيين، ورجال فكر)، وها هو يستشف من معاناة فلسطين (سنة 1936) ركن قضايا الأمة العربية، ما يتألق في المكان المقدّس، ويطلق باسم العرب أجمعين صوتاً، يستنهض الهمم، ويدعو إلى شد أزر الثوار في فلسطين بالمال والسلاح:
سائِل العلياءَ عنّا والزّمانا
هل خفرنا ذمّة مُذْ عرفانا
المروءات التي عاشت بنا
لم تزل تجري سعيراً في دمانا
ضجّت الصحراء تشكو عُرْيها
فكسوناها زئيراً ودخاناً
مُذْ سقيناها العلى من دمنا
أيقنت أن معدّاً قد نمانا
(...)
قُمْ إلى الأبطال نلمس جرحهم
لمسة تسبح بالطيب يدانا
قم نجعُ يوماً من العمر لهم
هَبْهُ فصحَ الصومِ، هَبْهُ رمضانا
إنما الحقُّ الذي ماتوا له
حقنا نمشي إليه أين كانا
(الديوان الكامل، ص 389-391).
ويستنطق نهر بردى (في غوطة دمشق) ويناجيه، ليُسِرّ عمّا في قلبه من هوى عروبي تمثّل في عشق الشام وأهلها:
سَلْ عن قديم هوايَ هذا الوادي
هل كان يخفق فيه غير فؤادي؟
(الديوان الكامل، ص300).
وهو إذ يسأل بردى، ودُمَّر (بلدة قرب دمشق) عن فتى عربي من آل جفنة، نجد أن رمز المكان يردّه إلى حالة من الشغف إلى الماضي التليد، موصولاً بجهاد أهل العلى:
إني وقفتُ بها أُسَائِلُ عن فتىً
من آلِ جَفْنََةَ رائحٍ أو غادي
الحاملينَ الشمسَ فوق وجوههم
والحاملينَ الشُّهُبَ في الأغمادِ
وزها القنا بأَكُفِّهِم متذكّراً
عهدَ الغدير بها وعهدَ الوادي
(...)
تِيهاً دمشقُ، هل المفاخِرُ والعُلى
غير الجهادِ وَصَلْتِه بجهاد
تلكَ الشمائلُ من شيوخ أميّةٍ
عبَّاقَةُ النفحات في الأحفادِ
(...)
قالوا: تحبُّ الشامَ؟ قلتُ جوانحي
مقصوصةٌ فيها، وقلتُ فؤادي
(الديوان الكامل، ص 296، 298، 299).
أما في مدح قادة من الأمة، أو في رثاء من رثى، فالعروبة تبقى معياراً لسموّهم وذكراهم، وهو في سبيل بيان ذلك يعمد إلى المقارنة بأبطال الماضي المجيد، مستحضراً وجودهم، في سعي منه إلى إضفاء لون من القدسية على حاضرٍ يودّ وصله بماضٍ يكتنز بالسجايا السامية، من ذلك قول شاعرنا مستثمراً ذلك، إذ مدح الرئيس السوري شكري القوتلي:
حملَ اللواءَ، يقود تحت جناحِهِ
وطناً على الأيام غير مباح
نادى، فلبّى من أميةَ فتيةٌ
خلقوا ليومٍ كريهةٍ وسماح
نسلَتْهمُ أمضى السيوف، فهذه
لابن الوليد، وتلك للجرّاحِ
فكأن (حطّين) استعاد زمانَه
وكأن يومك فيه يوم صلاح
(...)
والشمس فوق سهوله ونجوده
عربية الإمساء والإصباح
(الديوان الكامل، ص 458)
ويعلو مقام الملك فيصل الأول، ملك العراق، في يوم وفاته، إذ يتمثله نسراً يجثم على ذروة العروبة:
حَشَدَ العربُ تحت رايته السمـ
ــحاء والعدل والعُلى والمكارم
(...)
واشْرَأَبَّ الوجودُ ينظرُ للنَّسْ
رِ، على ذروة العروبة، جاثم
(الديوان الكامل، ص318)
وهو يرى العروبة، أيضاً، جامعاً بين مصر ولبنان، إذ يقول في مناسبة رثاء حافظ إبراهيم:
ما نسينا إذ مصر، أو بعض مصر
آذَن الشامُ جفوةٌ وفراقا
فغسلت الجراحَ بالسلسلِ العذْ
بِ، وصَيَّرْتَ كُلَّ خِلْفٍ وفاقا
(...)
نحن فرعان للعروبة، يا مِصْـــ
ـــرُ، شََأَوْنا الفروعَ والأعراقا
(الديوان الكامل، ص 349، 350).
ويبقى حنينه إلى العروبة، التي تجمع ما بين العرب، وتحفظ ما بينهم من الذِّمَم الغوالي:
مَنْ مُبْلِغٌ مِصْرَ عنّا وما نُكابِدُه
أنَّ العروبةَ في ما بيننا ذَِممُ
ركنان للضاد لم تفصم عرى لهما
هم نحن إن رزئت يوماً، ونحن هُمُ
(الديوان الكامل، ص 249).
وأمّا لغة الضّاد، فهي في أدب الأخطل الصغير أيقونة، كاد يصلي في محرابها ففي وَجيْبِ رايات النَّشْءِ، وفي ظلالها تعلو ألحان العربية في أهزوجة الفداء:
غَنَّتِ الضَّادُ تحتها أعرب الشِّعْـ
ـــرِ، فأعلى قَدْرَ البيانِ وأَغْلى
(...)
فَخْرُ أُمِّ اللغاتِ أن تَحضُنَ الرا
ياتِ مهما اخْتَلَفْنَ لوناً وشكلا
(الديوان الكامل، ص 497).
ثمّ، إنّ الأمَّةَ التي تُنْبِتُ النِّصال، وتسقيها ليوم الوغى إباءٌ، هي:
أُمَّةٌ تُنْزِلُ البلاغةَ قرآ
ناً، وتبني فوق النجومِ محلاّ
(الديوان الكامل، ص 351).
***
ما يسجّل على الأخطل الصغير في أدبه السياسي، عموماً، أنه حضور في الحدث، من حيث الشكل الذي يخضع لمؤثرات المناسبة وثقل دلالتها النفسية والاجتماعية، والذي يبحث فيه الأديب، غالباً، عن تبرير «بروتوكولي» آنيّ، مميّز، وأنه تلقائي، وحذر، في آن، إذ تستغرقه متطلبات الصحافة اليومية، بحساسية علاقتها بالقرّاء، وبالمسؤولين، وبقية فاعليات المجتمع المدني، وأنه مثقل بدلالات ازدواجية الموقف، إذ يحاول الانتماء إلى اتجاهين متعاكسين، كما هي الحال في موقفه من العلاقة بين سورية ولبنان، وأنه يبحث عن بديل حسّي، لمسألة الوحدة العربية، أو الجهر بها، فلا يسعفه إلا اللجوء إلى بدائل، لا تشكّل كياناً سياسياً، بقدر ما تشكّل حنيناً إلى ماضٍ يتغنّى بأمجاده، أو اندفاعاً إلى نصرة الثورات العربية، أو إعلاء لغة الضاد، التي تبدو جامعاً لما تفرّق، وكأن الأخطل الصغير يرى في هذه «المكونات» ما يمكن أن يشكّل وطناً عربياً جامعاً!.

