سبع سماوات قراءة في نص «رحلات في الجزائر والعراق والهند والمغرب وهولندا ومصر»
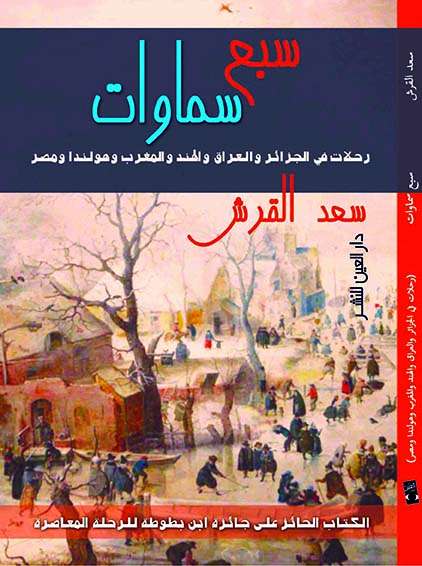
في كتاب سعد القرش «سبع سماوات رحلات في الجزائر والعراق والهند والمغرب وهولندا ومصر»، نصوص عن رحلات قام بها الكاتب إلى بلدان عربية وآسيوية وأوربية. في هذه النصوص خطاب نقدي للواقع المصري، وتحليل لجملة من العلل التي تكالبت على هذا البلد طوال سنين أفضت به إلى حال البلدان الضعيفة المتخلفة عن ركب التطوّر.
بناء على هذا لم تكن رحلات الكاتب في هذه البلدان سوى مطية لسرد الرّحلة الذهنية الحقيقية التي قام بها في بلده مصر الذي لم يغادر عقله ووجدانه طوال إقامته في تلك البلدان. وجملة القول: ليست الرّحلة أو الحديث عن الآخر في هذا الكتاب سوى حافز أو مثير للرحلة في الوطن الأم والحديث عن الذات، فالكاتب لم يوظّف هنا مقام الرّحلة لإنتاج خطاب في تعرّف الآخر وفهمه فقط، ولكنه وظفه لإنتاج خطاب في تعرّف الذات وفهمها ونقدها، وبذلك تنضمّ الرّحلة إلى غيرها من النصوص الثقافية وأنواع الخطاب التي تسهم جميعها في نقد الذات.
النص الرّحلي وتعدد الخطابات
تنصهر في كتاب سعد القرش مجموعة من الخطابات لتصنع نصاً لا يمكن نعته بأنه أدبي دون أن نسارع إلى إعادة تحديد مدلول هذه الصفة التي اختُزلت هنا في حدودها الدنيا المتمثلة في استعارة بعض تقنيات السرد التخييلي، مثل اختيار عنوان مجازي يوحي بالبُعد السّحيق، واعتماد أسلوب تقطيع الحكي، والجملة الاستهلالية التي ابتدأ بها الكاتب سرد رحلته إلى العراق على سبيل المثال:
«ست ليال كأنها حلم، دخلتها ليلاً، وغادرتها ليلاً. كانت كمية الضباب كثيفة، تحول دون أن تكشف التفاصيل عن نفسها، شغلني السؤال والملاحظة، واختلطت المشاهد بالانطباعات، التي توثق بعضها، وانتفى بعضها الآخر». (ص21).
واضح أن هذا الاستهلال لا يكاد يختلف عن أي استهلال في نص روائي تخييلي، سواء بطريقة تقطيع الفقرة أو باستخدام لغة الإيحاء وتكثيف الموقف الكلي الذي يكتنف علاقة السارد بالعالم الذي رحل إليه، عالم يماثل عوالم الأحلام غير الواضحة.
لكن من دون هذه العلامات يغدو إسناد «الأدبية» إلى نصوص الكتاب ضرباً من الاتساع في استخدام المفهوم؛ فالكاتب لم يكن معنياً في المقام الأول بالسرد والوصف واستثمار شاعرية اللغة، بقدر ما كان معنياً بالتأمل والتحليل والتقرير متوسّلاً بمزيج من الخطابات التاريخية والسياسية والصّحفية والمعرفية؛ ففي بنية النص الرحلي الواحد يتنقّل الكاتب بين التحليل السياسي والتقرير الصّحفي واستعادة وقائع التاريخ، وتقديم المعرفة والتحليل الثقافي لهوية الأمكنة، ولعلّ هذه البنية الخطابية القائمة على تنوع الخطابات تستدعي إلى ذهننا مفهوم الأدب الذي ساد في الثقافة الكلاسيكية، حيث كان النص الأدبي وعاءً لإنتاج كل الخطابات؛ فالرحلة ليست سوى إطار خارجي لإنتاج خطابات متنوعة.
في هذا السياق ينبغي قراءة وتقييم نص «سبع سماوات»؛ فالقارئ لا يواجه نصاً أدبياً بالمعنى المتعارف عليه، كما أنه لا يواجه نصاً رحلياً تقليدياً؛ ولعل هذا ما دفع الكاتب إلى الحديث عن وجهة نظره عن الرحلة قائلاً: «إن العالم أصبح مفتوحاً ومكشوفاً، لم يبق فيه شيء من دون اكتشاف (...) الآن لم يبق أمام أي رحالة إلا أن يرى العالم من وجهة نظره يكتشفه ويلمسه برؤية لا يشاركه فيها أحد، ويظل الإنسان قارة وحيدة مجهولة، يعاد اكتشافها كل رحلة». (ص119).
يقرّ الكاتب بتحوّلٍ في وظيفة جنس الرّحلة الذي لم يعد قائماً على بنية الاكتشاف ووصف الأعاجيب والغرائب وسرد عوالم مجهولة، لقد أدرك الكاتب هذا التحوّل في بنية خطاب الرحلة المعاصرة، فجاءت نصوصه الرّحلية ترجمة لهذا الإدراك؛ إذ كشفت لنا عن شخصية تستثمر السَّفر لتوصيل رؤية عن البلد الذي ينتمي إليه، وموقف من أوضاعه السياسية والاجتماعية والثقافية؛ فالسّفر هنا أشبه بمرآة تجلو له الحقائق التي ينبغي قولها، أو حافز يثير لديه حاسّة النقد والتقييم وإجراء المقارنات بين أمور يعيشها في موطنه الأصلي، وبين ما يراه في البلدان التي سافر إليها، لقد تحوّلت الأمكنة الأجنبية التي سافر إليها إلى مناسبة لصياغة رؤيته للعالم الذي يعيش فيه؛ فالكاتب ليس معنياً بنقد ما قد يراه من مظاهر اجتماعية وثقافية في تلك البلدان، بقدر ما يعنيه نقد المظاهر السائدة في بلده، فليست الرحلة وتعرّف الآخر، سواء أكان أجنبياً أم عربياً، سوى تعرّفٍ للذات ونقدِها، فخطاب الرحلة عنده ليس تعلّقاً رومانسياً بالأمكنة، أو بحثاً عن إثارة الاستطراف والتعجيب، أو مناسبة لنبش العيوب وتتبّع النقائص.
إن خطاب الرحلة كما شكّلته معظم نصوص «سبع سماوات» يترجّح بين فهم ونقد الذات (مصر) وفهم ونقد الآخر (العراق والهند والمغرب وهولندا والجزائر) واستخلاص سمات أمكنته، وبينهما تنتصب صورة السارد الرحّالة بمجموعة من السمات التي تقدّمه بوصفه كاتباً جديراً بالقراءة.
صورة الرحّالة
تفترض هذه الدراسة أنّ بنية الرحلة مثل أي خطاب تواصلي تقوم على أنّ الرحّالة يشكّل في نص رحلته صورة عن ذاته، وأنه يروم بهذه الصورة تعزيز خطابه القائم في النهاية على موقف يدين فيه الواقع الذي آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر، ومادام هذا الموقف يتشكّل في خطاب لا يخلو أحياناً من امتداحٍ للآخر الأجنبي والعربي وما وصل إليه من مظاهر التطور، وتحاشياً لأي اتهام محتمل بالتجرّد من الوطنية أو دفعا لشبهة كراهية الوطن، استشهد الكاتب بأبيات شعرية لصلاح جاهين تكشف عن حب مصر القائم على المفارقة والتضاد مطلعها:
أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء
يتماهى الكاتب الرحّالة في شاعر حجة يحظى بتقدير المصريين ولا يمكن الغمز أبداً في وطنيته، وهو الذي اشتُهر بنقد الواقع والاحتجاج على الأوضاع؛ وكأنه بهذا التماهي يتوخى تسويغ موقفه النقدي من مظاهر الحياة في مصر.
يروم الكاتب بهذا الشاهد الشعري إثبات حبه لمصر وهو الذي ترك لقارئ كتابه انطباعاً بأنه غير راضٍ عن بلده؛ لكن ثمة فرقاً بين الحب الواعي المدرك لحقائق الأمور، وبين الرضا الأعمى الذي لا يبصر ما يجري في العالم؛ وهنا لم يفت الكاتب أن يشير على لسان شعوب أخرى إلى «شوفينية المصريين الذين لا يرون غيرهم»، معتقدين أن «التاريخ يبدأ بمصر، والجغرافية تنتهي عند حدودها» (ص109)، ويقول أيضاً على لسانه هذه المرة: إن المصري «أسير (أفعل التفضيل) فيما يخص أول كل شيء في التاريخ: أول دولة، أقدم هرم، أول طبيب، أول طبيبة، أول ملكة». (ص134).
الرحّالة إذن شخصية محبّة لبلدها، لكنه حبٌّ لا يتعامى عن رؤية الحقائق، لأجل ذلك سادت في النص مقارنات بين البلاد التي سافر إليها وبين بلده؛ وهي مقارنات أراد منها نقد الأوضاع التي تسبّبت فيها سياسات حكومية تراكمت لسنوات طوال. ومثلما يفضي الإصغاء إلى الآخر وقراءة أعماله إلى الاعتراف به، في مقابل إعادة النظر في الذات وما تنتجه من أعمال، فإنّ الرحلة إلى الأماكن الأخرى تعدّ فرصة لتقييم الذات؛ يقول في رحلته إلى المغرب أيضا: «وقدرت لو أن مصر عادت للمصريين، لكنا في مستوى المغرب، هناك تعد رحلة القطار متعة، هو قطار يصلح لسفر الآدميين، وليس كقطارات مصر التي تتحول، حين تريد الحكومة التخلص من الأعداد الزائدة من البشر، إلى أفران وعلب للحريق (...)»
(ص116). بيد أنّ هذا لم يمنعه أيضاً من البوح بما شعر به من فرق طبيعي بين بلده وبلاد حباها الله بنعم تُحسد عليها؛ يقول في سياق مقارنته بين المغرب ومصر: «ساعات السفر بالقطار سياحة للعين، لرؤية جمال الخالق الذي يعاقبنا مرتين: الأولى بأن جعل صحراء مصر رمالاً صفراء تؤذي العين وتقتل الخيال، والثاني بألا يرحل حكامنا إلا بيد عزرائيل...». (ص117).
يضاف إلى هذا البُعد في شخصية الرحّالة، بُعد القومية؛ يقول في خاتمة رحلته إلى العراق: «تغادر بغداد كأنك تغادر جزءاً منك، تخاف عليه، ولا تملك أن تفعل شيئاً» (ص42) وقوله: «ستحب، مثلي، هذا الشعب» (ص21)، وقوله أيضاً: «في بغداد، أحسست بأنني في القاهرة» (ص22). وفي حاشية لنص الرحلة التي كتبها عن هذا البلد أشار إلى ما يمثّل تضامنه مع شعراء وكتاب قصة عراقيين يعانون النشر في بلدهم؛ إذ قام بنشر نصوصهم مصحوبة بصورهم الفوتوغرافية في مصر.
لكن بُعد القومية يتسع في شخصية الرحّالة لبُعد آخر وهو مكافحة الامبريالية والانحياز لحركات التحرّر الوطنية التي كافحت الاستعمار في العالم؛ وفي هذا السياق يشير إلى تعلقه بزعماء أمثال غاندي ونهرو؛ يقول في رحلته إلى الهند: «تحمست للذهاب إلى بلد (الأيقونة) غاندي، في نفسي يتردد اسم الثلاثي نهرو وتيتو وناصر...» (ص92)، وأمثال الدالاي لاما في كفاحه السلمي لأجل استعادة بلاده التبت من الصين.
لكن لماذا هيمن الخطاب التاريخي على نصوص الكتاب؟
ثمة فكرة محورية تتردّد في نصوص الكِتاب وتمثِّل عمود رؤية الكاتب للبلدان والأوطان، والمعيار الذي يرجع إليه في تحديد موقفه منها، وفهم الظواهر والسلوكات السائدة فيها، تتجسد هذه الفكرة وهذا المعيار في «ذاكرة» البلدان؛ هذه الذاكرة هي المسؤولة عن تشكيل وعي الشعوب، والمتحكمة في إرادتها ومواقفها، والموجِّهة لقراراتها، بل والمترجمة لأبسط السلوكات التي يقوم بها أفرادها. يقول الكاتب عن دور التاريخ في نهضة الشعوب في فقرة دالّة عن الهند لا تخلو من نقد ضمني للشعب المصري: «في الهند شعب مسكون بالتاريخ، تاريخه ليس عبئا عليه، لا يتبرأ منه، ولا يباهي به أحداً، لكنه ذخيرة نفسية مهمة، تغنيه عن استعارة ذاكرة غيره، ليتفرغ لإبداع المستقبل». (ص 106).
وبناء على هذا أجرى الكاتب فصلاً في مفهوم البلد؛ بين البلد باعتباره مجرد مسكن أو مأوى أو حيز جغرافي، وبين البلد باعتباره ذاكرة وتاريخاً وحياة؛ وقد عبّر الكاتب عن هذه الفكرة بوضوح عندما قال: «الدول نوعان: دولة مقيمة، وأخرى عابرة تجتازها مكرهاً، ولا تحرص على أن تحمل منها ذكرى، أو تشرب فيها كوب ماء، أو يجتازها التاريخ باعتبارها نتوءاً فعله زمن خاص يكفر عنه زمن لاحق، فتصير كأنها لم تكن، أما النوع الأول من الدول فلا يكون فيها الشعب مجرد سكان يهاجرون إذا استشعروا خطراً، ويعلنون من منفاهم استعدادهم للدفاع عن السكنى حتى آخر جندي أجنبي». (ص25).
هذا الفصل الذي أجراه الكاتب في مفهوم البلدان والأوطان؛ بين بلدان حقيقية تستند إلى الذاكرة، وبلدان زائفة ليس لها سند من التاريخ، هو الذي ارتكز عليه في رؤيته للعراق؛ يقول: «العراقيون ليسوا سكاناً، بل شعب مقيم في دولة مقيمة، ومثل هذا الشعب يستدعي حضارته، وتاريخه يمنحه طاقة هائلة (...) بهذه الطاقة يرفض الهزيمة والاستسلام، ويجتاز أي محنة (...) هناك دائماً بدائل أخرى لا تجعل الحياة مستحيلة، هناك ثقافة الحياة، وإبداعها، وفق قانون يصنعه عشاق الحياة». (ص25).
الإيمان بالتاريخ في تشكيل البلدان بعدٌ آخر يُضاف إلى الأبعاد المشار إليها في رسم صورة كاتب لم يتخذ الرحلة مجالاً لسرد مغامرات شخصية أو رواية عجائب البلدان؛ بل اتخذها مجالاً لتأمل الأمكنة وقراءة السمات المحدّدة لهويتها. يقوم الكاتب بهذه المهمة الثقافية وعينه على مصر التي لا تغادره وإن غادرها؛ فنحن بإزاء كاتب لا يخفي التزامه بنقد واقعه المعيش، ويغتنم في سبيل ذلك كل الفرص المتاحة له؛ لأجل ذلك لم يكن اختياره الحديث عن بعض السمات الإيجابية في بعض البلدان سوى وسيلة لتنبيه القارئ إلى ما يقابلها من سمات سلبية في بلده.
صورة مصر
لم تكن إذن الصورة التي شكّلها الكاتب لذاته في خطاب رحلاته سوى أحد أبعاد هذا الخطاب الذي رام منه في الأساس نقد واقع بلده من خلال تقديم قراءة للأمكنة التي سافر إليها؛ أو بعبارة أخرى تحديد هوية الأمكنة والغوص في استخلاص سماتها المميزة باعتبار ذلك جسراً يعبر منه لتأمل الذات.
إذا أردنا اختزال نصوص هذه الرحلات في دعوى رئيسة؛ فإننا نجسدها في إدانة الواقع الذي آلت إليه مصر سياسياً واجتماعياً وثقافياً، وذلك بوضعها في سياق من المقارنة بين ملامحها وملامح غيرها من البلدان التي سافر إليها الكاتب، وعمل بعد ذلك على قراءة ملامحها، فليست الرحلة والحديث عن الآخر في الكتاب سوى خطاب عن الذات. يقول في رحلته إلى هولندا: «تحزن على مصر، بعد أن تغادر القاهرة التي لا تغادرك، وتظل تلعن مائتي عام من التحديث ضاعت هباء، وفي كل نوبة نبدأ من الصفر، ونلغي التاريخ والذاكرة، ومع كل حاكم يبدأ التاريخ، وبه ينتهي، وليذهب الخيال إلى الجحيم (...)» (ص45).
ولم يكن الحديث عن سمات الهند غير النمطية؛ مثل الدقة التنظيمية، والشياكة في التعامل، والاختلاف الخلاق، والذوق الرفيع، والابتسام غير المصطنع، وانخفاض الصوت، والصبر، وحب الرقص والموسيقى، والإيمان بقيمة العمل ورفض الثراء الزائف، والتفاعل بين الأديان في وطن واحد، والإيمان الحقيقي بالتاريخ، سوى حديث عن المقابل الإيجابي لسمات سلبية علقت بالمصريين فأثقلت خطاهم نحو التطور.
خلاصة
لم يكن كتاب سعد القرش «سبع سماوات» مجرد رحلات استكشافية في بلدان أصبحت معروفة للجميع، فالرّحلة هنا ليست سوى إطار خارجي أو بنية شكلية عمل الكاتب على تشكيلها على النحو الذي اختاره، فإذا تجاوزنا بعض الإشارات التي تدلّ على هوية النص الجنسية؛ فإنّ معظم الخطاب الذي شكّل مساحة الكتاب، لا صلة له ببنية السفر من قبيل سرد الوقائع، أو وصف المشاهد، أو نقل الحوارات، فقد تحوّلت الرّحلات هنا إلى خطابات في التحليل والتأمّل والنقد والمقارنة، وقد فُسِّر هذا المنحى بالرؤية التي تحكّمت في نسيج هذا الكتاب، والمتمثلة في اختيار الرِّحلة وسيلة أو شكلاً خطابياً لتأمّل الذات؛ وهذه الوظيفة ليست غريبة عن الرحّالة العربي منذ القدم، لكن ثمة فرقاً بين كاتب عاش صدمة الاكتشاف فعبّر عن نتيجتها مُظهراً الإعجاب أو الاستهجان، وبين كاتب لم يعش الصّدمة، ولكنه يعيش هموم وطن لا يغادره حتى في لحظات ابتعاده عنه؛ فيعمل على استثمار مقام الرّحلة لإنتاج خطاب نقدي للذات.

