الحُصَري يحاور سلامة موسى
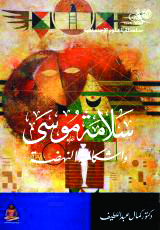
نحن هنا أمام عملاقين من عمالقة الفكر في الوطن العربي في القرن العشرين، كل منهما يمثل طرفاً مناقضاً للطرف الآخر في الرأي، لكن المناخ الحاكم خلال فترة ما يسمى بعصر النهضة العربية الحديثة، إذ كان يحفل بالعديد من الآراء والأفكار التي قد يشكل بعضها موقفاً مناقضاً ومضاداً لطرف آخر، يظل الخلاف محصوراً في «الكلمة»، وسيادة «الحوار» بالأفكار، وتلك علامة دالة على درجة من التحضّر.
نحن إذ نعرض لصورة من صور ما كان يجري من حوارات نبتغي من ذلك أن ننبه إلى صورة مشرفة للاختلاف بين الآراء، فمهما تباينت وتضادت، قلّما نجد دعوة للإقصاء والنفي، فضلاً عن الإعدام، سواء بشكله المعنوي أو المادي، حتى أننا نتذكر كيف أن علمانياً متطرفاً مثل إسماعيل مظهر كتب دراسة عنوانها الماذا أنا ملحد؟ب، فلا تُرفع عليه الدعاوى، ولا تصدر فتاوى بإهدار دمه، وإنما يبادر صاحب فكر مغاير وهو محمد فريد وجدي، ليعبر عن موقفه المغاير بدراسة عنوانها الماذا أنا مسلم؟ب.
ولا نقصد بالحوار في قضيتنا الحالية بين ساطع الحصري وسلامة موسى توافر أركان الحوار كلها، وإنما هي جملة آراء ساقها الحصري، ضمّنها كتابه اأحاديث في التربية والاجتماعب، مناقشاً فيها ما سبق أن كتبه سلامة موسى، من دون مواجهة شخصية مباشرة.
وساطع الحصري، من الشخصيات العجيبة حقا، حيث إنه قد توافرت له ظروف تجعله، لا زعيماً مرموقاً في الدعوة إلى االقومية العربيةب فترة حياته، حتى وفاته عام 1968، وإنما هو عاش هذه العروبة في نشأته وتكوينه، حيث توزع بين عدة بيئات عربية وإسلامية: فقد انتمى إلى عائلة أصلها من الحجاز، ولكنه وُلد في صنعاء باليمن، وتقلبت حياته، تعلماً وتعليماً وعملاً بين القاهرة، والأستانة، ودمشق، وبغداد، وفي كل موقع من هذه المواقع لم يكن مجرد اسائحب لفترة قصيرة، بل كان عنصراً قيادياً يعيش سنوات، ويحتل موقعاً مرموقاً، ويترك بصمات مؤثرة، تستمر زمناً طويلاً.
وسلامة موسى، مصري اقحب، من الشخصيات النادرة، مثل عباس محمود العقاد، ممن لم يتلقوا قدراً ولو متوسطاً من التعليم في معاهده النظامية المعروفة، بل اعتمد على التثقف الذاتي، مثلما كان الأمر لدى الكثرة الغالبة من علماء ومفكري الحضارة العربية الإسلامية.
وفي الوقت الذي كان فيه الحصري موغلاً في التشيع للاتجاه القومي العربي، كان موسى موغلاً في تشيعه لاتجاه التغريب.
كان سلامة موسى قد دُعي إلى محاضرة ألقاها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونشرتها جريدة السياسة الأسبوعية التي كان يرأس تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل، عن اأسس التجديد الاجتماعيب.
وعلى الرغم من أن الجهة الداعية جامعة اأمريكيةب، فإن سلامة موسى لم يجد أي حرج في أن يتحدث في الإطار الأيديولوجي الذي كان متشيعاً له، وهو االاشتراكيةب، فيؤكد أن العامل الاقتصادي هو القوة الدافعة والمهيمنة على جملة ما يشهده المجتمع من وقائع، وما يسير عليه من تنظيمات وتطورات، وهي المقولة الماركسية الشهيرة.
وهو يفسر ما كان ذ ولايزال طبعاً - من فروق هائلة بيننا في مختلف دول العالم العربي، بإرجاعها إلى درجة التقدم الاقتصادي، فحيثما يكون تقدم من هذا النوع، يكون نهوض وتطور إيجابي في مختلف مناحي الحياة المجتمعية.
من هنا استنتج سلامة موسى، أننا إذا أردنا تجديداً، حتى في الأدب والأخلاق، فلا مفر لنا من أن نُحدث تجديداً مسبقاً في الحال الاقتصادي.
وهنا ينسب الحصري رأي سلامة موسى - بحق - إلى وجهة النظر الماركسية، التي وُسمت أحياناً بالمادية التاريخية، وكذلك االجبر الاقتصاديب.
ولم تكن تلك مجرد امرةب يذهب فيها موسى إلى هذا المذهب، وقد أشار الحصري إلى سبق كتابة سلامة موسى عن التشيع لمثل هذا الاتجاه، في مجلة الهلال، وإن حملت بعض التخفيف، حيث لم يكن هناك حتم وجزم في فاعلية العامل الاقتصادي، وإنما تأكيد على أولويته، وأسبقيته، وقوة في التأثير تفوق ما يمكن الاعتراف به من عوامل أخرى.
وهنا نجد الحصري لا ينفي قوة العامل الاقتصادي وفاعليته، لكن ينكر أن يكون هو العامل الوحيد، كما ثبت أخيراً بعد تجربة تطبيق النظرية الماركسية فترة ما يزيد على سبعين عاماً، ومن ثم لم تعد هناك مناقشات وحوارات حول هذه القضية، وإن كانت الكثرة الغالبة لا تستطيع التقليل من قدر وقيمة وفاعلية القوة الاقتصادية في مسيرة الحضارة الإنسانية.
لكن سلامة موسى وجد أمامه في وقائع التطور الحضاري مثالاً قد يهز ما كان عليه من يقين بالنسبة للفاعلية الاقتصادية، ألا وهو ما كانت عليه حضارة الإغريق قديماً من تألق لا يمكن أن ينكره أحد، حيث نظرات كل من سقراط، وأفلاطون، وأرسطو، وغيرهم، ومع ذلك، فلم تكن لديهم اآلاتب، كما ظهر لها من قوة تأثير وفاعلية في الحضارة الغربية الحديثة، تطبع الاقتصاد القديم بالسرعة والازدهار، والانتشار، فكيف يمكن تفسير هذا؟
هنا يشير سلامة موسى إلى ما كان من اعبيدب كانوا هم الذين يقومون مقام الآلات في العصر الحديث.
لكن الحصري سرعان ما يلاحق هذا التفسير بما ينقضه، بالإشارة إلى أن العبيد كانوا منتشرين في الكثرة الغالبة من البلدان، فلِمَ لم تقم بها حضارة مثل حضارة الإغريق؟
إن السر وراء مأزق هذا التفسير، هو الانحباس في ركن واحد من أركان الحياة الإنسانية، ألا وهو الركن الاقتصادي.
هذا الحوار غير المباشر بين الحصري وسلامة موسى حول فاعلية العامل الاقتصادي في تطور الأمم، والتقدم البشري، حسمته الوقائع التاريخية الكبرى التي شهدناها بدءاً من عام 1989، عند تحطيم جدار برلين الذي كان يفصل بين مجموعتي منظومة ما كان يُعرف بالمنظومة الاشتراكية، والمنظومة الغربية الرأسمالية، ثم تُوج الأمر بتفكيك القوة العظمى التي كانت تسمى االاتحاد السوفييتيب.
قضية أخرى ناقشها الحصري، كان سلامة موسى قد أثارها على صفحات مجلة كان يصدرها ما كان يسمى في القاهرة في عقود ما قبل الحرب العالمية الثانية، وهي االرابطة الشرقيةب، حيث أظهر سلامة موسى معارضته الحادة لمن كان ينسب مصر إلى الرابطة الشرقية، حاكماً عليها بالتخلف والرجعية، وأن الأقرب إلى مصر أن ترنو بأبصارها إلى ما وراء البحر المتوسط، حيث الغرب عامة وأوربا خاصة، وهي الفكرة نفسها التي ألح عليها الدكتور طه حسين في كتابه الشهير امستقبل الثقافة في مصرب.
وكان سلامة موسى قد أرجع ما أكده من تخلف بلدان الشرق، إلى أن حضارته ازراعيةب، بينما حضارة الغرب اصناعيةب، فالزراعة، في تصوره بطبيعتها راكدة لا تتقدم، وإن تقدمت، فإنها تتقدم ببطء شديد، على عكس الأمر بالنسبة للصناعة، التي يكون تطورها في صورة قفزات، وبسرعات مذهلة.
ولم يكن سلامة موسى قد شهد ما شهدته الزراعة في العقود الأخيرة للقرن العشرين من اقتحام التقنيات العلمية المتقدمة، والتي بُنيت على أسس علمية متقدمة أيضا، فضلاً عما عاشته العلوم البيولوجية من طفرات في الهندسة الوراثية، وآثارها التي يصعب حصرها، في إنتاج سلالات نباتية وحيوانية جديدة، وتضاعف الإنتاج، مما أكد أنه لم يعد من المقبول القول بحضارة زراعية في مقابل حضارة صناعية، من كثرة وتعدد وتنوع صور االغزوب الصناعي، لعالم الزراعة.
ودعم الحصري رأيه بإحصاءات متعددة عن كثير من الدول الأوربية التي تشيع فيها الزراعة، ومع ذلك، فإنها تُعد من الدول المتقدمة، مثل إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا وبولندا وغيرها.
ويخلص الحصري إلى قولة حق نتفق معه فيها بأن حالة الركود والجمود ليست من خصائص الأدب والزراعة، ولا من لوازمهما، كما أن حالة التحول والتقدم أيضاً ليست من الخصائص التي لم تفارق الصناعة والعلم، فالتجدد والجمود، لا ينتج أي منهما من طبيعة العلم أو الأدب وحدهما، ولا من طبيعة الزراعة أو الصناعة، بل من حالة المجتمع الذي يتعاطاها ويتوغل بها. صحيح أن الصناعة سريعة التحول أكثر مما هو في الزراعة، لكن هذا لا ينهض دليلاً قوياً على أن الصناعة تكون دائمة التحول، أو أن الزراعة تكون دائمة الركود.
وكان أعجب ما ذهب إليه سلامة موسى، زعمه بأن الأدب مثله مثل الزراعة، لا يقبل التطور والتقدم، وهو قول غريب حقاً، لا بالنسبة للحصري وحده، وإنما بالنسبة لكثيرين منا، فالنهضة الأوربية في مبدأ نشأتها كانت تحفل بأعمال أدبية شكلت اعلامةب على طريق التطور الحضاري، ويضيق المقام عن مجرد الإشارة العابرة إلى أبرز هذه الأعمال.
كذلك فإن الحضارة العربية الإسلامية نفسها، كانت صفحات الأدب فيها زاهرة، وثرية، مع أن هذه الحضارة لم يصفها أحد بأنها حضارة صناعية.
ويضع الحصري يده على أبرز العوامل، وهو البنية المجتمعية نفسها، من حيث الأسس التي تقوم عليها، وعلاقات الأبنية الداخلية بعضها ببعض، ومدى حرية الحركة المتاحة، فضلاً عن المناخ العام، كما أكدت ذلك أيضاً مدرسة افرانكفورتب، صاحبة النظرية النقدية في علم الاجتماع. وينتقد الحصري أحد عناصر البنية المجتمعية، مركزاً عليها مبضع التحليل والنقد، ألا وهو موضوع المرأة العربية، حتى أواسط القرن الماضي، حيث شاعت نظرة متدنية للمرأة، تحرمها من القيام بدور رائد وملحوظ في الحركة الاجتماعية، فضلاً عن شيوع الأمية بينها، وانعزالها عن عالم العمل الذي يمكن أن يكون ابيئة مُربيةب وامُثقفةب، وفرصة لاكتسابها كثيراً من القيم والمفاهيم اللازمة لحسن التفاعل الاجتماعي.
ولا يتوقف سلامة موسى عن أطروحاته المباينة والمناقضة لكثير مما تعارف عليه الناس، ولعل أبرز تلك الأفكار التي استثارت الحصري، من خلال ما كتبه سلامة موسى في مجلة كانت تسمى بـاالحديثب، دعوته إلى القطيعة مع الماضي، من دون أن يدرك الفارق بين أن يرضى فريق من الناس أن يكونوا أسرى الماضي، يريدون عودته كما هو، لوهم أننا لن نتقدم إلا وفق هذا السبيل، وبين أن يكون التاريخ، كما ذهب ابن خلدون، اللعظة والاعتبارب، وهي الوظيفة التي يستطيع أن يلاحظها كل من يقرأ آيات القرآن الكريم التي تشير إلى أقوام في العصور القديمة، وأحداث غابرة، حيث إن ذكر هذا وذاك كان مشفوعاً دائماً بدعوة للاتعاظ والتفكر، والاعتبار... وأمة تهمل تاريخها، لهي أشبه بإنسان يفقد ذاكرته؟!
ومن أبلغ عبارات الحصري تعبيراً عن هذا الذي نذهب إليه قوله إن المطلوب هو أن نغير أسلوب نظرتنا إلى التاريخ، لا تحويل أذهاننا عنه!!
إن التاريخ الأوربي لا يخلو من عدد غير قليل من االسخافاتب التي ركز على مثلها سلامة موسى، من حيث وجودها في تاريخنا العربي، ومع ذلك لا نجد الأوربيين يهملون دراسة هذا التاريخ، بل إن أي خطة تخطوها أمة من الأمم إلى الأمام، قد لا يستقيم أمر سيرها ويصح، إلا بالاستفادة مما سبق من خطوات، حتى لا تكرر الأخطاء، ويكون البلاء الحقيقي، هو ذ مرة أخرى - أن نقف عند حد التغني والإشادة بأمجاد الماضي، ومن هنا كان القول المأثور، الذي ذهب إلى أن الفتى ليس هو من قال: أبي، ولكن هو من يقول: ها أنا ذا!!
وكان سلامة موسى قد ساق أمثلة، بحيث إذا أردنا أن نشرع في خطط جديدة في الأخلاق والآداب والعلوم، مثل الحديث عن الزواج، وجب ألا نلتفت إلى ما كان يفعله أسلافنا قبل ألف عام، وإذا كتبنا في الأدب، وجب ألا نذكر ما كان يرتئيه الجاحظ أو الجرجاني، أما في
العلوم، فيجب أن نعرف أننا نحرث أرضاً
بكراً بالنسبة لبلادنا، لم تشقها بعد سكة المحراث!!
وعود على ذي بدء... ليس الجوهري في هذا الحديث مجرد العلم بما قاله سلامة موسى، وما ذهب إليه ساطع الحصري بالنسبة إليه، وإنما يهمنا بالدرجة الأولى أن نشعر ببعض الخجل أن يتحاور مفكران، بالكلمة والمنطق، منذ ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن، حيث كانت أوطاننا على ما كانت عليه من تواضع التقدم المعرفي والحضاري، بينما يشيع في بلداننا اليوم، أيضاً، بعد ما أصبح من صور مذهلة من التقدم الحضارى، من يتحاور بألفاظ خشنة، كأضعف الإيمان، إن جاز لنا أن نحل مثل هذا أصلاً في أي مرتبة من مراتب الإيمان! أما أشهره، فهو التحاور بالتكفير أو التخوين، فضلاً عن إزاحة التحاور بالكلمات ليحل محل هذا النهج تحاور بالسكين والمتفجرات! >

