السيَّاب.. سيرةُ الوهمِ والظمأ انكسارُ النسقِ وهزيمةُ الفحولةِ الشعريَّة
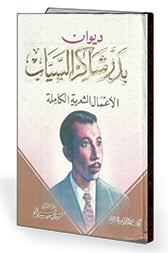
تتداخل علاقةُ الشعرِ بالوهمِ تداخلًا حميمًا، إذ لا يمكن للشعر أنْ يقيمَ إلّا في منزل الوهم، ولا يمكن للوهم إلّا أنْ يحتويَ الشعرَ ويقدّمَ له كلّ الرعاية الأبويّة والأموميّة معًا، على النحو الذي يصنع بينهما أُلفةً لا يمكن محوها أو التفريط بها مهما كانت الأسباب، فالشعر متخيّلٌ رحبٌ أوسع من الأفق ولا حدود لتجلّياته وتحليقاته وانفتاحاته القصوى، وهو ما لا يمكن احتواؤه إلّا في دائرة مهشّمة الحدود تسمّى (الوهم)، بوصفه المساحة الأكثر انفتاحًا لتقبّل تموّجات اللغة واصطداماتها وتفاعلاتها وتمظهراتها وتدفقاتها الباحثة عن مصير، نحو الوصول إلى مرحلة بناء القصيدة وتكوينها وتشكيلها وتشييد عمارتها.
القصيدةُ هي مشروعٌ مادّيّ وروحيّ وثقافيّ خلّاق من أهمّ المشاريع التي يتبنّاها الشاعر في حياته، وهذا المشروع مستمرّ في حركة دائبةٍ من أجل البحث عن وهم الاكتمال، لذا فهو في فعاليةِ بحثٍ دائمةٍ رغبةً في الارتقاء إلى لحظة اكتمالٍ لن تتحقق، لأنّ هذا الاكتمالَ المُتمنّى لا يمكن إنجازه إلّا بموتِ الشاعر كما حصل للسياب فعلًا حيث اكتملتْ قصيدته بموته، والقصيدة اللغة أو اللغة القصيدة هنا هي صدى لسانيّ للتجربة وهي في صورة بحثٍ وتقصٍّ وحراكٍ باللغة وفيها، وتتمثّل بوصفها كيانًا مرآويًّا متموّجًا يعكس إشعاعًا من ذلك الحياء والحرج والومضات.
يعدّ (الموتُ) الموضوعَ الأكثر حضورًا وتجلّيًا واستئثارًا في لغة السياب، فدالّ الموت بتمظهراته المتنوّعة والمختلفة والمتعدّدة يسري في جسد لغة السياب كما تسري النار في الهشيم، ويكلّل قصائده بنورٍ أسودٍ كثيفٍ ولزجٍ يستحيل تفادي إزعاجهِ وترويعهِ مهما أُحيطت القراءةُ بحراسةٍ مشدّدةٍ تمنعُ تأثيرَه عن القارئ، دالّ الموت هو دالّ طوّافٌ وباحثٌ وأصيلٌ في شعر السياب لا يكلّ ولا يتوقف ولا يستقرّ ولا يكتمل.
وطالما أنّ الحياة السيابية الخارج شعرية ملغومةٌ بمعايير تفتقر إلى أبسط الشروط الإنسانية في تقويم اجتماعية البشر على النحو الحضاريّ المطلوب، وبذلك يكون السياب من أكبر صنّاع الحلم أو الوهم في الشعرية العربية، وحياته القصيرة خارج الشعر هي طويلة جدًا داخله، فتجربته الشعرية وقد اكتملت بموته جاءت على قدرٍ عالٍ من الكثافة والخصوصية والخصب والندرة، فزميلته الرائدة نازك الملائكة عاشت بعده أكثر من حياة سيابية ثانية، أي ما يقرب من أربعة عقود، لكنّها لم تنجز أكثر ممّا أنجزته في حياة مماثلة زمنيًا لحياة السياب، وربما يكون السياب قد أعطى كلّ ما عنده داخل الشعر فيما أُتيح له من حياة خارج الشعر، ولم يمت إلّا بعد أن قال آخر ما عنده من ذخيرة شعرية ظلّ الشعراء ينهلون منها، والنقاد يدرسونها حتى هذا اليوم.
عتبة العنونة: الأمريّة والشحاذة
فلسفة بناء العنونة الشعريّة هي فلسفةُ تكوينٍ وإنشاءٍ وتشييدٍ وإحاطةٍ واستجابةٍ مركزيّة لمقولة الخطاب ورؤيته وحساسيته، لذا صارت أهمّ عتبةٍ لابدّ من مقاربتها نحو مَهمّة نوعية للكشف عن ثقافة الخطاب وفلسفته ونظرته إلى الآخر، وقصيدة الشاعر بدر شاكر السيّاب الموسومة بـ«أحبيني ..!» تؤسس لعتبة عنونة جُمَليّة لا يمكن حسم وجهتها بسهولة، في ظلّ وجودها الكتابيّ لا الصوتيّ، على النحو الذي يستوجب قراءة بَصَريّة تتوسّل بمحيطِ البياضِ، والنقطتين اللتين تسيران رمزيًا بجملة العنوان إلى أمام، ومن ثمّ الإقفال الذي تتعرّض له الجملة بعلامة التعجّب (!) لتحيلَ على حالة تنغيمٍ بَصَريّةٍ تعوّض عن فقدان حالة التنغيم الصوتيّة، وقد كانت ستحسم أمر القراءة لو كانت حاضرة. ظلّت فلسفةُ الشحاذة مهيمنة على العقل الشعريّ العربيّ حتى الوقت الراهن، لكنّ الثورة الشعرية الجديدة قدّمت فلسفة جديدة مقابلة هي «شحاذة الحبّ»، قد يكون السياب أوّل من ابتكرها في تاريخ الشعــــرية الـــعـــربية، وبقــدر ما تفتقر فلسفة الشحاذة المادية إلى الـــشروط الإنــسانية المرتبطة بالشاعر، فإنّ فلسفة شحاذة الحبّ تتعالى لتبلغ أعلى هذه الشروط، على النحو الذي يقـتـضي ولادة فلسفة نقدية تقارب هذه الإشكالية بوصفها واحدة من أهم إشكاليات الشعرية العربية على مرّ العصور.
قصيدة «أحبيني..!» ذات عتبة عنوانية تتحرّى الخصوصية في هيمنتها على قمّة الهرم الشعريّ في القصيدة، لتستقلّ في كيانها العتباتيّ العنوانيّ على النحو الذي يكون بوسعها تقديم أطروحتها على نحو ما، لكنّها في الوقت نفسه تندغم بمتنِ القصيدةِ ابتداءً من عتبة الاستهلال إيقاعيًا ودلاليًا اندغامًا يكاد يكون كليًّا. فعلى الصعيد الإيقاعيّ فإنّ جملة «أحبيني» العنوانية تؤلّف إيقاعيتها الوزنية على تفعيلة الوافر المعصوبة (مُفاعلْتن)، وهو الوزن الشعريّ الذي اشتغلت القصيدة عليه، أمّا على الصعيد الدلاليّ فإنّ جملة العنونة (أحبّيني) وهي تتمثّل خطابًا استجدائيًا ساطعًا موجّهًا إلى الآخر (الأنثى/الحبيبة)، تنحدر للتواصل مع أوّل جملة في المتن الشعريّ «وما من عادتي نكرانُ ماضيّ الذي كانا،»، وكأنهما جملة واحدة بدلالة الواو العاطفة التي تحيل ما بعدها على ما قبلها إحالة شبه مطلقة، وبهذا تكون عتبة العنوان (أحبّيني) على هذا النحو عتبة متداخلة تشتغل في سياقين، خاصّ وعام، استقلاليّ واندماجيّ في آن.
عتبة الاستهلال: جوهر الخطاب الشعريّ
عتبة الاستهلال وقد سحبت عتبةَ العنونة إلى منطقتها تضمّنت الحكاية الأصل التي تسعى القصيدة إلى ضخّ مفاصلها في أرجاء القصيدة، فخطاب الراوي الذاتيّ الشعريّ يهيمن على الحكاية ويرويها رواية ذاتية تتقلّب بين النشوى والفجيعة، الأمل والوهم، الحلم الجميل والواقع المرّ، في صيغة حواريّة ظاهرها التوجّه بالخطاب نحو الآخر (الأنثى)، لكنّ باطنه حوار ذاتيّ أشبه بنشيج قاسٍ تتجلّى الذات الراوية في التغنّي به على نحو مأساويّ، ويتمظهر خطابُ عتبة الاستهلال بصيغةٍ سرد - دراميّة يحضر فيها السرد والوصف والمشهديّة والعرض الفيلميّ، وذلك للارتفاع بجوهر الحكاية إلى مقام شعريّ بالغ الكثافة والتبئير والكشف والتكامل السرديّ والدراميّ، وصولًا إلى كينونة تعبيرية وتشكيلية تتعدّى الوظيفة الاستهلالية التقليدية، وهي تجتهد في الإبلاغ والتوصيل وتفعيل الحراك الشعريّ من عتبة العنونة إلى طبقات المتن:
وما من عادتي نكرانُ ماضيّ الذي كانا،
ولكنْ .. كلُّ من أحببْتُ قبلك ما أحبّوني
ولا عطفوا عليّ؛ عشقتُ سبعًا كنّ أحيانا
ترفّ شعورهنّ عليّ، تحملني إلى الصينِ
سفائنُ من عطور نهودهنّ، أغوصُ في بحرٍ من الأوهام والوجدِ
فألتقط المحار أظنُّ فيه الدُرَّ، ثمّ تظلُّني وحدي
جدائلُ نخلةٍ فرعاءْ
فأبحثُ بين أكوام المحار، لعلّ لؤلؤة ستبزغُ فيه كالنّجمة،
وإذ تدمى يداي وتُنزع الأظفار عنها، لا ينزُّ هناك غيرُ الماء
وغير الطين من صَدَفِ المحار، فتقطر البسمة
على ثغري دموعًا من قرار القلب تنبثقُ،
لأنّ جميع من أحببتُ قبلك ما أحبّوني
العتبة الاستهلالية في القصيدة عتبة حكائية واسعة ومفتوحة تبدو وكأنها قصيدة كاملة، إذ تبدأ باستهلال داخليّ موجز أشبه بالمانشيت الصحفيّ يلخّص الفكرة الجوهريّة في الحكاية «وما من عادتي نكرانُ ماضيّ الذي كانا،/ولكنْ .. كلُّ من أحببْتُ قبلك ما أحبّوني/ولا عطفوا عليّ؛»، وثمّة جدل علائقيّ بين طرفي معادلة الاستهلال الداخليّ الموجز يتمثّل بالجملة المنفيّة (وما من عادتي..)، إذ تقابلها الجملة الاستدراكية (ولكن.. كلّ من أحببت ..) وتدعمها الجملة المعطوفة عليها (ولا عطفوا عليّ)، وكأن هذا الجدل يقول كلّ شيء على النحو الذي ينتهي الكلام فيه ولم يعد ثمّة ما يقال.
غير أنّ الطبيعة السردية (الحكائية) للكلام الشعريّ هنا تتطلّب التفصيل وفتح الحكاية على طبقاتها التي لا تكتفي بمجرّد المانشيت، وهو يؤدي الوظيفة الانتباهية والإغرائية، بل تدفع المتلقي إلى البحث عن مزيد من التفصيل لإشباع التطلّع السرديّ والفضول الحكائيّ، إذ يتنكّب الراوي الشعريّ الذاتيّ مهمة التفصيل الحكائيّ واستعراض الطبقات السردية طبقة طبقة، بحسب تسلسل مجريات الحكاية المرتبط بجملة سرد شعرية تمثّل لحظة تنويرٍ مركزيّ فيها «عشقتُ سبعًا»، ثم ما يلبث العرض السرديّ المتداخل والمتشابك والمشبع بالتصوير والتمثيل وتجسيد الفاعلية الأنوية للذات الشاعرة بأوسع وأكثف وأعمق ما يستوعبه الفضاء الشعريّ الاستهلاليّ، بطريقة يتعاضد فيها الأسى بالانفعال، والتطلّع الجميل بالخيبة المريرة، وحرِفة الصورة بآليّة التصوير، وتمازج وتعالق الشعر بالدراما بالسرد بالتشكيل بالعرض السينمائيّ، وصولًا إلى النتيجة الفجائعية في أقصى بلوغها المأساويّ «لأنّ جميع من أحببتُ قبلك ما أحبّوني».، وهو ما يمثّل جوهر الخطاب الشعريّ في هذه القصيدة.
سينمائيّة التشكيل الشعريّ
يستخدم السيّاب آليّات العَرض السينمائيّ لتشكيل فضائه الشعريّ، ويلعب دور المخرج والبطل والمُشاهد معًا، فيحوّل الخيال إلى شاشة تعرض حكايته عرضًا تفصيليًا في مجموعة من اللقطات، تنهض كلّ لقطة بعرضِ معشوقةٍ من المعشوقات السبع عرضًا حكائيًا مصوّرًا من البداية حتى النهاية على نحو كثيف ومركّز:
وأجلسهنّ في شُرَف الخيال .. وتكشف الحُرَق
ظلالًا من ملامحهنّ: آهٍ فتلك باعتني بمأفونِ
لأجل المال، ثم صحا فطلّقها وخلّاها
يتكشّف الدور الإخراجيّ بقوّة في جملة «وأجلسهنّ في شُرَف الخيال» لأنّ فعل الإجلاس هو فعل توزيع الأدوار، ومساحة العرض (شُرَف الخيال) تمزج بين مكانية الشاشة المعلّقة وأرضية المسرح المفتوحة، وبما أنّ الخيال لا يسمح باستظهار الصور كاملة على هذا النحو الاسترجاعيّ لكلّ حكاية من حكايات المعشوقات وصورهنّ، فإنّ ما يظهر منهنّ على شاشة العرض هو ظلال من ملامحهنّ «وتكشف الحُرَق/ظلالًا من ملامحهنّ»، وهذه الظلال من الملامح تكفي لكي يروي الراوي السينمائيّ أمام مُشاهدِهِ الحكايات تباعًا، وهي طريقـــة إخراجية متقصَّدة من طرف الراوي إمعانًا في تسليط قوّة الغياب عليهن أكثر من الحضور، لأنهنّ في موقع الخصم أو الآخر المعادي الذي لا يستحق أكثر من أن يظهر بوصفه مجرّد ظلال.
اللقطة الأولى تخصّ المرأة الأولى وقد أخرجها الراوي الشعريّ المُخرج داخل موسيقى تصويريّة يهيمن عليها صوت «آهٍ»، لتنفتح اللقطة على فضاء دراميّ تتسارع الأفعال فيه من أجل إنجاز المشهد بأسرع وقت ممكن «فتلك باعتني بمأفونِ/لأجل المال، ثم صحا فطلّقها وخلّاها,»، تنطلق الإشارة الأولى في المشهد بتعيين المكان القريب للمرأة (تلك)، ومن ثمّ تبدأ سلسلة الأفعال الدرامية بالتحرّك (باعتني/صحا/طلقها/خلاها)، وإذا كان الفعل الأول (باعتني) يحكي مأساة الراوي الشعريّ الواصف والمُخرج للمشهد، فإنّ العقوبة التي تنتظر المرأة البائعة تتمثّل في قيام ثلاثة أفعال متلاحقة ومترابطة سرديًا ودراميًا بفعل إنتاج فجيعتها، فضلًا عن أنّ وصف «الآخر» الغريم بـ «مأفون» يأتي في سياق مضاعفة العقوبة وتكبير لحظة التنوير الدرامية في المشهد.
أمّا الثانية فإنّ الراوي الشعريّ الذاتيّ يتوسع في إخراج لقطتها مُبتدئًا بتمهيد استفهاميّ يستعرض طبيعة الحال الثقافية والاجتماعية، بعد أن يحددها بالإشارة السابقة نفسها «وتلك» من أجل أن يُفقِدها صفتها الإنسانية المميّزة حين يكتفي باسم الإشارة، بمعنى أنّ الصورة العامة متشابهة، لذا فهو يُضطرّ إلى مقاربة بعض الصفات الخاصة لدى كلّ واحدة منهنّ من أجل التمييز والتفريق بينهنّ:
وتلك .. لأنّها في العمر أكبرُ أم لأنّ الحُسنَ أغراها
بأنّي غير كفءٍ، خلّفتني كلما شرب الندى ورَقُ
وفتّح برعمٌ مثّلتها وشممتُ ريّاها؟
وأمسِ رأيتُها في موقف للباصِ تنتظرُ
فباعدتُ الخطى ونأيتُ عنها؛ لا أريدُ القربَ منها،
هذه الشمطاء
لها الويلات؟ ثم عرفتُها: أحسبتِ أنّ الحسنَ ينتصرُ
على زمن تحطّم سور بابلَ منه، والعنقاء
رمادُ منه لا يذكيه بعث فهو يستعر؟
ثمّة احتمالان يعرضهما الراوي لعدم استجابة الثانية لحبّه، الأوّل «لأنّها في العمر أكبر»، والثانية «لأنّ الحُسنَ أغراها»، وهو ما يحيل على إحساس الراوي بالصغر وانعدام الحُسن، على النحو الذي ينتهي إلى «بأنّي غير كفءٍ»، كي ينتهي إلى العزلة والاكتفاء بتنسّم عطر الذاكرة كلّ صباح «خلّفتني كلما شرب الندى ورَقُ/وفتّح برعمٌ مثّلتها وشممتُ ريّاها؟»، وهو ما يفتح نافذة الذكرى على مشهد سينمائيّ داخل المشهد الشعريّ العام الممثّل لـ (تلك) الثانية، تتجلّى فيه حوارية يراها المتلقون من زاوية الراوي وطبيعة روايته «وأمسِ رأيتُها في موقف للباصِ تنتظرُ/فباعدتُ الخطى ونأيتُ عنها؛ لا أريدُ القربَ منها،/هذه الشمطاء»، إذ يُظهِر المشهد الراوي وهو في مركز القوّة والقدرة على اتخاذ القرار والتفوّق على غريمته «لها الويلات؟»، حين يذكّرها بماضيها الذي كانت تراه غير كفء لها، وحالها بعد أن ذهب الحُسن ولم يبق منها سوى آثار سور بابل ورماد العنقاء «أحسبتِ أنّ الحسنَ ينتصرُ/على زمن تحطّم سور بابلَ منه، والعنقاء/رمادُ منه لا يذكيه بعث فهو يستعر؟»، فهي ليست أسطورة لكي تنبعث من جديد بعد أن ذهب عنها كلّ ما يميزها ويجعله غير كفء لها، بمعنى أنه عاقبها عقوبة شديدة بأن حوّلها إلى «شمطاء» جزاء غرورها وإهمالها لحبّه.
إذن فالراوي يضع نهاية مفجعة للثانية مثلما وضع نهاية مفجعة للأولى، ضمن سيناريو عقابيّ يحاسب فيه نساءه على أنهنّ لم يحببنه وانتهت حياتهنّ إلى خسارات فاجعة، في نوعٍ من التعويض النفسيّ الذي يسهم فيه الخيال وهو يعرض هذه الصور بكاميرا الراوي، مع غياب كاميرا «الآخر» على النحو الذي تظلّ المَشاهد فيه ذات خطاب ناقص يفتقر إلى التوازي المطلوب بين خطابين متضادّين، لا يحضر منها في فضاء المشهد على شاشة العرض سوى خطاب واحد هو خطاب الراوي ليرسم المشهد كما يشاء.
تتعرّض الثالثة لسيناريو مُشابهٍ بعد عرض وصفيّ خلاّب للجمال الذي تتمتّع به، ومن ثمّ يعرض الراوي الشعريّ الذاتيّ لغياب هذا الجمال عنه كي يشرق في مكان آخر فيه «قصر وسيّارة»، الذي ما يلبث أن يتعرّض للعقوبة الشعرية نفسها لينتهي السيناريو نهاية كئيبة، فتأخذ الحبيبة الثالثة جزاءها العادل على أنها تركته وانتهت إلى الضجر:
وتلك كأنّ في غمّازيتها يفتحُ السّحَرُ
عيونَ الفلّ واللبلاب، عافتني إلى قصر وسيّارة،
إلى زوج تغيّر منه حالٌ، فهو في الحارة
فقير يقرأ الصحف القديمةَ عند باب الدار في استحياء،
يحدّثُها عن الأمس الذي ولّى فيأكلُ قلبَها الضّجَرُ
يستخدم الشاعر اسم الإشارة المعطوف بطريقة أسلوبية مفعمة بالانتقاص واللامبالاة «وتلك»، نحو توفير دلالة مركزية تحيل على أنّ النساء اللواتي لم يحببنه هنّ الخاسرات في معادلته الشعريّة، على الرغم من أنّ الجملة المركزية في القصيدة «لأنّ جميع من أحببتُ قبلك ما أحبّوني». تأتي مشبعة بمعاناة أزليّة للذات حوّلت الجسد والروح والحياة كلّها إلى أزمة إحساس بالخذلان واللاجدوى والعبث، لكنّ الذات الشاعرة الراوية وهي تستعرض قصص الحبّ الفاشلة في أنّ كلّ الحبيبات أعرضنَ عن الشاعر وفضّلن عليه آخرين، لذا فإنّ الذات تسعى - ما وسعها ذلك - إلى تحقيق أكبر طاقة إسقاط عليهنّ جميعًا، بفضل هذه السيناريوهات الشعرية الزاخرة وقد رسم لكلّ واحدة منهنّ فيها مصيرًا شنيعًا.
ويختزل الرابعة بصورة زوجها المقامر وقد حوّلها إلى خادمة في ظلمة الخمر والقمار، بعيدة عن بهجة الحياة ونضارتها وحيويتها:
وتلك وزوجها عبدًا مظاهر ليلها سَهَرُ
وخمرٌ أو قمارٌ ثم يوصدُ صُبحَها الإغفاء
عن النّهر المكركر للشراع يرفّ تحت الشمس والأنداء
العقوبة الشعرية هنا مختصرة ومختزلة ولا تحتمل الإطالة السردية، على النحو الذي يعكس أهميتها المحدودة في المخيال العاطفيّ والوجدانيّ للذات الشاعرة، فيكتفي بهذا السيناريو الذي يعرض لصورتين متناقضتين، الأولى مظلمة تقبع فيها الحبيبة الرابعة «زوجها عبدًا مظاهرَ ليلها سَهَرُ/وخمرٌ أو قمارٌ ثم يوصدُ صُبحَها الإغفاء»، والثانية المشرقة الموازية لها «النّهر المكركر للشراع يرفّ تحت الشمس والأنداء»، وقد غابت عنها بعد أن سجنت نفسها في دائرة ليلٍ يابسٍ ومقفلٍ كله سهرٌ وخمرٌ وقمارٌ بلا حياة.
ثمّ يعلّق الخامسة في ذيل السادسة بطريقة تقفلها علامة الاستفهام «وتلك؟»، قبل أن ينفتح انفتاحًا باهراً على السادسة «وتلك شاعرتي التي كانت لي الدنيا وما فيها،»، وكأنه يريد أن يُلغي الخامسة تمامًا ويمحوها باختزالها باسم الإشارة المنتهي بعلامة استفهام مقفلة، بدلالة السادسة (الشاعرة) وقوّة حضورها في سيناريو واسع وشامل، يحظى برغبة عميقة في سردها، حيث شغلت أكبر مساحة كتابية في القصيدة تفوّقت من حيث سوادها اللفظيّ حتى على آخر الحبيبات (الزوجة)، بمعنى أنّ الحبيبة الشاعرة حضرت وكأنّها ملكة الحبيبات وتاجهنّ، على الرغم من سخطه الكبير عليها في نهاية السيناريو المخصّص لها:
وتلك؟ وتلك شاعرتي التي كانت لي الدنيا وما فيها،
شربتُ الشعر من أحداقها ونعستُ في أفياء
تنشِّرها قصائدها عليّ: فكلّ ماضيها
وكلّ شبابها كان انتظارًا لي على شطّ يهوّم فوقه القمرُ
وتنعس في حماه الطيرُ رشّ نُعاسَها المطرُ
فنبهها فطارت تملأ الآفاقَ بالأصداءِ ناعسةً
تؤج النور مرتعشًا قوادمُها، وتخفقُ في خوافيها
ظلالُ الليل . أين أصيلُنا الصيفيّ في جيكور؟
وسار بنا يوسوس زورقٌ في مائه البلّور؟
وأقرأُ وهي تصغي والربى والنّخل والأعناب تحلم في دواليها؟
تفرّقت الدروب بنا نسير لغير ما رجعة،
وغيّبها ظلامُ السجن تؤنس ليلَها شمعة
فتذكرني وتبكي. غير أني لستُ أبكيها
كفرت بأمّة الصحراء
ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكّةٍ أو عند واديها
ثمّة كثافة شعرية هائلة في مشهد الحبيبة الشاعرة، كثافة في التعبير السرديّ، والتمثيل الدراميّ، والتشكيل الشعريّ الصوريّ، على النحو الذي بدا المشهد فيها وكأنه قصيدة متكاملة داخل القصيدة الأم، ومع أنّ هذه الحبيبة لا تتعرّض للهجاء المرّ الذي تعرضنَ له سابقاتها، لكنّ الأنا الشاعرة لا تتفادى ذلك تمامًا «فتذكرني وتبكي. غير أني لستُ أبكيها»، إذ يبدو أن الطبيعة والحياة والظروف هي التي حالت دون أن يتحقق هذا الحبّ المتمنّى، على النحو الذي يدفع الذات الشاعرة لتبلغ أقصى درجات السخط، في السبيل إلى عزاءٍ خصبٍ يناسب المقام ويستجيب للحال.
ومع ذلك فالمشهد مكتظّ بصور الذاكرة وهي تختلط بالحلم، وبصور النداء المرّ وهي تختلط بالأمنيات المجهضة، فعلى مدى خمسة عشر سطرًا شعريًا تبدو الذات الشاعرة وكأنّها تطوّف في حلم جميل تعيشه بعمقٍ يقرّبه كثيرًا من الحقيقة، حقيقة الوهم وقد تصدّعت فيه الذات وتشظّت واتسعت جروحها حتى بلغت جوهر الروح، إذ على الرغم من أنّ المعجم المهيمن على حركة الدوال الشعرية في المشهد مشحون بالطاقة الدلالية الإيجابية، فإنّ الفضاء الشعريّ العام يحيل على النقيض، فكلّ صورة من صور المشهد تعزف لحنها الشعريّ بقوّة الحلم والتمنّي، غير أنّها تنتهي إلى مجرّد نشيج قاسٍ، ولعلّ هذا الجدل الشعريّ داخل المشهد الواحد هو من أبرز خصائص القصيدة السيابيّة، وهي تقدّم بهجة الوهم محاصرةً بمرارة الحقيقة التي تختفي في منطقة ما خلفها، بما يعكس طاقة شعرية خلّاقة على دمج الأبيض والأسود، الفرح والحزن، الأنا والآخر، وجهيّ الصورة الأماميّ والخلفيّ، في صياغة شعرية واحدة يندر أن تحدث، تفرض على المتلقي قراءة مزدوجة تستعين بالثقافيّ لفكّ شفرة الجماليّ.
أمّا مشهد الحبيبة السابعة فهو مشهد يصوّر الواقع الشعريّ للذات الشاعرة، تتخلّى الذات في رسمها له عن آليّات الفعل التشكيليّ وأدواته التي استخدمتها في بناء المشاهد الستة السابقات، كي تعود إلى خطاب ذاتيّ تحضر الحبيبة/الزوجة فيه حضورًا شفافًا تعويضيًا مزدحمًا بالأسى والقهر والرغبة الصارخة للخلاص.
تبدأ لوحة المشهد بعبارة «وآخرهنّ؟؟» المشفوعة بعلامتي استفهام، وكأنها بداية لنهاية مستعجلة تقود إلى «موت» ما، تعقبها جملة أخرى معزّزة بتعريف الحبيبة السابعة، وهي الحبيبة الوحيدة التي أحبّته «آهٍ .. زوجتي، قَدَري»، إذ انطلقت من صوت مأساويّ مشبعٍ بالحسرة الضارية كي تتصل بالتعريف الأوّل (زوجتي)، والتعريف الثاني النعتيّ (قَدَري)، حيث تؤول الأمور كلّها إلى مستقرّها النهائيّ الحاسم.
الحبيبة الأخيرة، الزوجة، القدَر، هي خلاصة التجربة، تجربة الوهم وتجربة الحقيقة، تجربة الانكسار الإنسانيّ العنيف الممتدّ على مسافة إنسانية متعثّرة طولها ست حبيبات ذاقت الذات الشاعرة فيها أقسى العذابات وأمرّ «الفقدانات»، وآلت أخيرًا إلى هذه المحطّة، جاءت بوصفها ردّ اعتبارٍ ثقافيًا يقودها إلى خلاصٍ ما يمكن أن ينقذها من محنتها، وهي تصرخ بوحشية منذ عتبة عنوان القصيدة «أحبيني..!» لتوكيد هذا الخلاص المحلوم به، فهي جملة إنقاذ من «موت» كامن في كلّ مشهد حبّ فاشل من المشاهد الستة السابقات، إذ في أعماق كلّ مشهد خسارة تنحّي جزءًا من الحياة كي تقرّبها من مسرح الموت، ولم يكن من أمل متاحٍ يقلّل من حجم الخسائر ويؤجّل بروز شخصية الموت على مسرح القصيدة سوى ذلك.
ويبدو - حتى على الصعيد الفنيّ التشكيليّ - أن الذات الشاعرة وصلت هنا إلى مرحلة بالغة من الإرهاق الشعريّ، على النحو الذي بدا فيه المقطع الأخير (المشهد الأخير) من القصيدة متعَبًا في لغته وصورِهِ وندائه، بما يحيل على الموت أكثر من إحالته على خلاص محتمل، إنّه المشهد الذي تظهر صورة الذات الشاعرة فيه وقد نهشتها أسنانُ التجربة الذئبية، وتركتها حطامًا لا سبيل أمامها سوى انتظار موت قادم لا محالة.
ومع أنّ جملة الخاتمة المشهدية الأخيرة - «أحبّيني/لأنّي كلُّ من أحبــــبتُ قبــــلك لم يحبّوني» - تعيد إنتاج اللازمة المركزية في القصيدة، إلاّ أنّها توحي على صعيد سيميائيّ بأنّ هذا الحبّ المخلّص الذي بحثت الذات الشاعرة عنه من أوّل القصيدة حتى آخرها لم يحصل، بدليل أن الدعوة للحبّ ظلّت قائمة حتى آخر القصيدة، وبمعنى أنّ الذات الشاعرة تدرك تمام الإدراك بأنّ حلم هذا الحبّ المخلّص ليس أكثر من تعلّق بأذيال الوهم، الوهم المشتبك مع الظمأ، وهو المكوّن الرئيس لتجربة السيّاب الشعرية في مرحلة المرض/الموت، وقد ذيّل السيّاب زمن كتابة القصيدة بـ «باريس 19/3/1963» قبل سنة ونصف السنة تقريبًا من رحيله.

