العودة إلى جيكور.. أو فضاء الـحلم السيَّابي
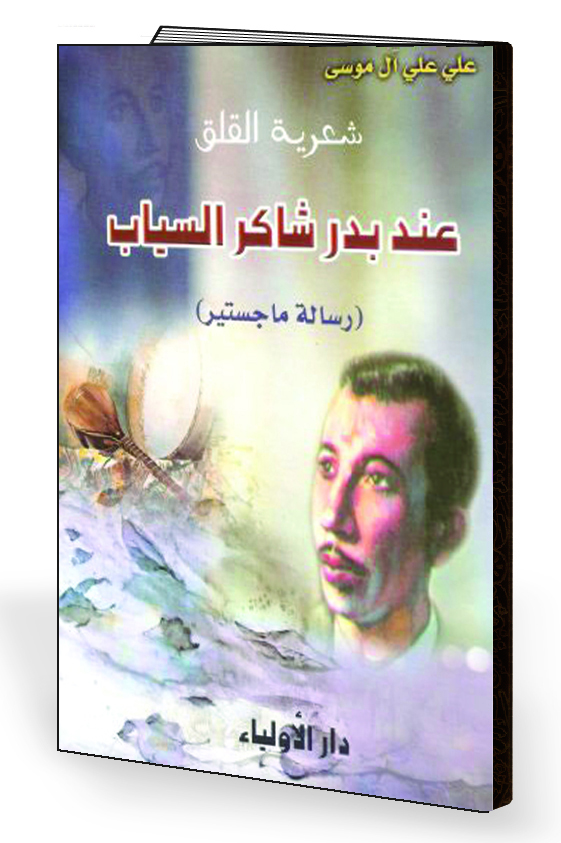
جاءت العودة إلى جيكور في التجربة الشعرية للشاعر بدر شاكر السياب أقرب إلى الرحلة في مملكة خيالية البناء والتكوين، بما كشف عنه من أسرار كانت مخبأة بين نهرها (بويب) وغابات نخيلها، ودورها العتيقة التي صمدت معالمها أمام اندثارات الزمن.. وهي أسرار عوالم، منها ما عاشه الشاعر، ومنها ما اصطنعه خياله الفذ. فهو لم يكن ينقل ما يرى بقدر ما كان يعيد نسجه على نول الخَلْق الشعري، معيدًا إياه إلى مجالات التصور. فهو، وإن كان يقع ضمن مستوى، أو سطح، مكاني معروف، فإن «رؤيته الشعرية» جعلته في حالة حركة: تتصاعد بما كان لها/ ومنها، وتمضي مسارًا بما جعل لها من خطوات على الأرض تمرّ بها على دروب الذكريات المستعادة.. وقد يرسمها بخطوط تقارب اندماجه بها ذاتًا، لا تباعد فيها إلا ذلك التباعد الزماني الذي يدركه وهو يمضي بين «حلمه» وترقّب «الولادة الثانية».. متيقنًا، أو رائيًا، أنّ «جيكور» ستولد من جرحه، أو «من خضة» ميلاده، وإن كان موقنًا بأنْ:
«لا رجاءَ لها بأن يُبعث الموتى، ولا مأملٌ لها بالخلودِ» ومتسائلًا تساؤل بحث عن «أيامها الخُضْر وليلات صيفها المفقودِ؟»، منتظرًا قيامتها من جديد، ودعواه أن الحضارات قامت «في الأرض كعنقاء من رماد اللحودِ».
الأصول.. والدوافع
جاءت هذه العودة من الشاعر إثر خيبتين: خيبة الغربة في البلد الغريب والتي عبّرت عنها أجلى تعبير قصيدة «غريب على الخليج» (1953).. والخيبة من المدينة التي اغتالت «حلمه التموزيّ» الروح والتطلع. وسواء في «غريب..» أو في «جيكور والمدينة» (1959). والقصيدتان تمثلان قراره بنهاية العلاقة، وجودًا وذاتًا، بكل من «الغربة» و«المدينة» فإننا نجد فيهما ما يمكن أن ندعوه «إيقاعًا صلبًا» للذات الشاعرة. فهناك علاقة تفاعل ضدّي مع الواقع هو نتاج صِدام الذات مع هذا الواقع، وهو صِدامٌ يتصاعد حركةً ليولّد في كل منهما طاقة تعبيرية كبيرة نتيجة تقابل الأضداد ذاتيًا...
وفي القصيدتين (الحالتين الموقفين) نجد ما يمكن تعيينه حالةً بـ «صياغة المكان»، وهي صياغة نبذ - إذا جاز التعبير - للغربة مكانًا، وللمدينة دلالة وجود متعيّن بحركته، كما هي صياغة للمكان/ الحلم (متمثلًا بالعودة إلى جيكور). ونجد الشاعر، في ما يتّبع من أساليب الصياغة، يعتمد التشكيلات البَصَريّة، وإن كانت بمنزلة «ترجمة تشكيلية» لمشاهد داخلية التكوين من خلال التفاعل الضدي بين «الذات» و«الواقع»، والتي يمكن وضعها في إطار «علاقة التنافر».
وإذا كنا نجد في قصائده التموزية ضربًا عميقًا من ضروب التفاعل التكويني بين «الرؤيا الزمانية» (الأسطورة) و«الرؤية المكانية».. والتقدّم بالرؤيا الزمانية نحوها للانتقال بها، واقعًا، من خلال ما يتضمنه الرمز الأسطوري من بُعد تغييري (بحكم فاعلية الحركة التي يتفجر بها هذا الرمز).. فإنه في جيكورياته سيتعامل مع «الأرض - المكان» بوصفها قوّة وجود نامية بما يحكم وجودها من علاقات، وتفاعل، حي وحيوي، (كانت البداية معه من خلال التذكّر والاستعادة)، إذ يجيئها ابنها (الشاعر) طارقًا بابها بعد أن يتساءل تساؤلًا استفهاميًا عمّن «غلَّقَ الدور فيها... دونها ومن حوّلَ الدربَ عنها»، وقد وجد «جيكور خضراء مسَّ الأصيل ذرى النخل فيها/ بشمسٍ حزينة»؟.. متمثلًا نفسه، وقد غادرها إلى المدينة، ذلك الشاب الذي «أراد أن يُنيرَ، أن يُبدّد الظلامَ.. فاندحرْ». وأما دربها فيلوح له «كومضِ البروقِ/ بدا واختفى، ثم عادَ الضياءُ فأذكاه حتى أنار المدينة»... المدينة التي بحث عمّن «يخرق السورَ» منها، «من يفتحُ البابَ؟» بعد أن وجد يمناه بلا «مخلب للصراع» ليسعى «بها في دروب المدينة/ ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين..».
وكما دافع عن «قضيته» بالأسطورة، مستعينًا برموزها، فإنه دافع عن نفسه ذاتًا من خلال جيكور (التي جعل منها رمزًا كونيّ المعنى والمدار).. فهي هويته، وهي ذاكرته، وراح يرى مصيره إنسانًا من خلالها، فيأخذ نفسه بحركيتها وسكونها، ليظل حضورها عنده مشحونًا بدلالاته (وقد أخذت بعض قصائده فيها سمة ميثولوجية).
وإذا كان دوره ، هو الشاعر، مع الأسطورة دورًا تمثيليًا، من خلال امتزاج الأسطورة بالواقع، فإن دوره مع جيكور جاء تمثُّليًّا.. فهو يتمثّل، ويعبّر عن هذا التمثّل بإعادة تكوينه وإن وجدنا هذا التمثّل يجري في حالتين هما حالتا المكان اللتان تتمثّل في كل منهما طبيعة مختلفة، جوهرًا، عن الأخرى. ففي لحظة القرب/ الوجود في المكان يكتب متمثّلًا، فيغرق القصيدة بالتفاصيل.. ويصف، ويذهب مع الماضي المستعاد من خلال المشاهدة والعيان. أما حين يكتب من بُعد فإنه يكتب متأملًا، تتمازج في هذا التأمل رؤيته ورؤياه وقد أشبعهما بما هو ذاتي/ رؤيوي التكوين. فما كان يأخذ باهتمام الشاعر في هذه «العودة»، والبحث عنها/ عن ذاته في فضاءاتها الأولى، مرتبط بالدلالة الذاتية/ الروحية للمكان بالنسبة له. وكلما جاءت هذه العودة مرتبطة بـ «إدراك الموجود» وهو على أرض الواقع، اعتمدت، أو اعتمد الشاعر فيها بناء فضاء مختلف، وذلك وفاقًا لرؤية مختلفة، في بنائها، عن الرؤية الأخرى. وهنا تتداخل «الرؤيا الأسطورية» مع «الرؤية الجيكورية»، فيجعل، هذا التداخل، لـ«الرؤية» أفقًا رؤيويًا.
وفي جيكور، وأمام جيكور هناك رمزان/ بُعدان ستكون لهما فاعليتهما في قصيدة الشاعر في هذه الحقبة من حياته/ شعره، وهما: الماء (متمثلًا بنهر بويب، وبالمطر)، والشجر (الذي طغى فيه النخيل على سواه بحكم الواقع)، وهو ما سيجعل النمو في قصيدته «نموًّا بَصَريًّا» غالبًا ما يكون في اتجاه واحد، ومن خلال تحريك ما يمكن أن نسميه «المركز الكليّ» متمثلًا بجيكور، محيطها وعالمها.. وهو بخلاف ما كانت عليه الحال في القصيدة/ الحقبة التموزية، حيث النمو في القصيدة «رؤيوي التكوين»، متمثلًا في صياغة متنامية في غير اتجاه، وبحركية شاملة (يلتقي فيها الإنسان والواقع والحلم في تكوين رؤوي كوني التجانس) تتعيّن في اتجاهين:
اتجاه تكوّنه الرؤيا/ التجربة، وتنبثّ فيه أبعاد العلاقة بين الذات والواقع على النحو الذي يكون فيه دور الذات هو المتغلب، فتهزّ الواقع بحركة انتقال وصيرورة، أو بحركة تحوّل وكلاهما مرتبط بالمستقبل...
واتجاه آخر تمثله حركة يمكن تعيينها في كونها حركة منقولة عن الواقع المكاني، ومتكونة به/ ومن خلاله.. وهي حركة لها طبيعتها الخاصة المتعينة من خلال الارتباط ذاكرةً بالمكان مع رؤية متحصلة من الحاضر/ وبه.. وفيها نجد الواقع هو من يهزّ الذات فيحركها حركة في اتجاهين: استعادة الماضي، والتطلّع إلى تأكيد هذه الذات في الحاضر.
وفي الحالتين نجد ما يؤكد حضور المكان حضورًا زمانيًا. فالشاعر وهو يتذكر ويستعيد الوجود قائمًا بما يمتلئ به، (كما هو في محمول الذاكرة) لا يلبث أن يدركه وجودًا مفرغًا من كل ما كان أسبغ عليه من محتوى «خرائبُ، فانزع الأبوابَ عنها تغدو أطلالا...» فيصدمه الفراغ، وهو الذي أدرك المكان بالمكين، ليجده، في لحظة اللقاء به، خاليًا من مكينه ذاك «خوالٍ قد تصكّ الريحُ نافذةً فتُشرعُها إلى الريحِ».
ولكن طاقة الوجود/ الحضور الكامن في داخله تستقيظ لتقيم الحوار بين الحضور (وإن في إطار الذكرى) والعدم (واقعًا). فهو إذ يعود إلى الماضي إنما ليُغني مصادر التأمل عنده، وإن كان ينظر إليها بـ «عين الذاكرة»، ما يضعنا أمام بناء رؤوي يتمثّل في «المشهد» المتكوّن، وفي حركته. فهو في قصيدة «العودة لجيكور» يسري «على جواد الحُلُمِ الأشهبِ»، طاويًا دربه النائي «بين الندى والزهر والماءِ»، باحثًا «في الآفاق عن كوكبِ» يأمل أن يعرف فيه المخلّص. ومن أفقه هذا يناديها نداء المستغيث بها:
- «جيكور، جيكور: أين الخبزُ والماءُ؟/ الليلُ وافى وقد نامَ الأدلاّءُ/ والركبُ سهران من جوع ومن عطشٍ/ والريحُ صرٌّ، وكل الأُفق أصداءُ/ بيداءُ ما في مداها ما يبينُ به/ دربٌ لنا وسماءُ الليل عمياءُ/ جيكور مدّي لنا بابًا فندخلُهُ/ أو سامرينا بنجمٍ فيه أضواءُ».
فإذا ما استظلّ بـ «أفياء جيكور» ناداها:
- «جيكور مسّي جبيني فهو ملتهبُ/ مسّيه بالسَعَفِ/ والسنبلِ الترفِ/ مدّي عليَّ الظلالَ السمرَ، تنسحبُ/ ليلًا، فتُخفي هجيري في حناياها».
ومن خلالها يُدرك المدينة وقد أضحت فضاء موت:
- «في قلبي دمدمَ زلزالُ/ فجنائنُ بابلَ تندثرُ،/ وفي قلبي يصرُخُ أطفالُ،/ في قلبي يختنقُ القمرُ».
ولم يعد يحتمل العيش في عالمها المرتج أوصالًا:
- «نحنُ في بغداد؟ من طينِ/ يعجنه الخزّافُ تمثالا،/ دنيا كأحلام المجانينِ/ ونحنُ ألوانٌ على لُجّها المرتجّ أشلاءً وأوصالا».
لقد أصبح الجرح في نفسه مزدوجًا: جرح المدينة التي حاصرته، وطوقت حلمه، فخرج منها مخذولًا مهزوما.. وجرح جيكور التي عاد إليها حاملًا ذاكرته بها، فإذا الواقع الذي آلت إليه يبدد الكثير من الصور الأولى بفعل ما آلت إليه وهي تمضي في مسار التآكل والاندثار.
وهنا نلاحظ مسألة جوهرية أساسها الاختلاف القائم عنده بين «الرؤيا التموزية» و«الرؤية الجيكورية». فقد قامت «الرؤيا التموزية» على إثراء الواقع بالمعاني الكبيرة، وذلك من خلال التقنّع بقناع الأسطورة التي نجد العلاقة بينها، مبنىً للذات الشاعرة، وبين الواقع علاقة إثراء متبادل، فضلًا عما في الأسطورة من جموح القوة التي تكون، بدورها، قوة للذات في ما لها من جموح التغيير. بينما تقوم «الرؤية الجيكورية» على بُعدين: بُعد الواقع ماثلًا ومتمَثَلًا، وبُعد الحلم مستعادًا. لذلك نجده وهو يُقبل على المكان (جيكور)، الذي تغيّر به الزمان وبدّله حالةً وحالًا، يخشى السكون الذي هو فيه، فيروح ينسج أوهامًا، ويفترض رؤىً ومواقفَ، مستعيدًا ما يستثير به الحواس، حواسه هو...
وهنا يمكن تأكيد حقيقة تتصل بقصيدة السياب، أو تنبثق منها، وهي أن بداية كل قصيدة من قصائده هي ما يقرر طبيعة حركيتها الداخلية (التكوينية)، وفي أي اتجاه تذهب، وضمن أي توجّه تمضي. ففي «المسيح بعد الصَّلب» نتمثّل فكرة الموت - الفداء.. وفي «غريب على الخليج» تبرز الذات وتداعيات إحساساتها من خلال/ وبفعل الشعور بالغربة المكانية وقد تحولت إلى غربة زمانية، وهي ليست حركية تثبيت، وإنما حركة تحوّل تجمع من «العلامات» و«عناصر الفعل»، بما تحمل من معنى ويتحقق لها من دلالة، هما ما يجعل للرؤيا الشعرية مساراتها.. فهناك، في هذا الواقع، ما يتخطاه، وهناك ما يُصارعه، وهناك ما يجده قريبًا منه، وهناك ما يظل بعيدًا داخل المشهد يتطلع إلى بلوغه، وإن برؤيته ورؤياه.
هذه «الحركة - الحركية» تتحوّل في قصائد حقبة المرض لتُصبح تمحورًا حول الذات يتشكل في ضرب من ضروب الصراع تراجيدي الطابع، هو الصراع بين الحياة التي تسكنه والموت الذي يدهمها، فيستعير، للتعبير عن ذلك، «رموزًا» لها علاماتها الدالة، تتصاعد بتصاعد إحساسه بمحاصرة الموت الحياةَ داخله.
وهذه «الحركة - الحركية»، المتمثلة في غير قصيدة للشاعر، تدفعنا إلى ما يمكن أن نصطلح عليه: عملية اقتفاء الأثر أي تتبع الطريق الخاصة التي يتخذها «الإحساس الرؤوي» في القصيدة. ولعل البداية كانت من «شبّاك وفيقة»، وهو يدعوها إلى أن تُطلّ عليه منه بوجهها الأسمر، متمثلًا نفسه بـ «طائر بحر غريب/ طوى البحر» ليطوف بشباكها «الأزرق/ يُريدُ التجاءً إليه/ من الليل يربدّ عن جانبيه».. إلا أنها حين لا تفتح له، أو تُطلّ عليه، يُدرك الحقيقة التي يوجعه اكتشافها:
«ولو كان ما بيننا محضَ باب/ لألقيتُ نفسي لديكِ/ وحدّقتُ في ناظريكِ/ هو الموتُ والعالمُ الأسفلُ/ هو المستحيل الذي يُذهلُ..».
فالحركة هنا في وجود ذي بعدين: بُعد المكان في ثباته، وبُعد الزمان في ما يحمل من عوامل التغيير التي تُحدِث التغيّر في المكان، حالة وواقعًا. فـ «شبّاك وفيقة» يتمثل في واقع متعيّن منظورًا. فهنا واقع، وهناك إيهام بما وراء هذا الواقع الذي سيبدو على نحو أكثف في «شناشيل ابنة الجلبي» (القصيدة، لا الديوان). وسواء كانت الرؤية للشبّاك، أو الشناشيل فهي رؤية متعينة من خلال صبوة ذاتية ذات بُعد عاطفي إلى وجود معزول بنفسه ودلالته الزمانية (وفيقة، ابنة الجلبي)، والمكانية المرتبطة بوجود مكاني (دار وفيقة، ودار ابنة الجلبي).
وهو في «جيكورياته» هذه التي اتخذت من المكان مسرحًا لها، وجد «المشهد» فيها منتجًا لنفسه (بُعده ومعناه) في نطاق تعيّنه (منزل الأقنان، دار جدي، بويب، شبّاك وفيقة، الشناشيل). وهو في حركته في هذا الاتجاه (نحو المكان/ وفي المكان) إنما يجمع بين حركتين متواصلتين ومتزامنتين، وهما: حركة العين رؤية في ما يتصل بتشخيص المكان طبيعة وتكوينًا.. وحركة الذات التي تتمثل حضورها الزماني فيه، وتفسح للذاكرة أن تُعيد تكوينياته الأولى.. لنجد أن ما يجذب الشاعر إلى هذا أمران، وبحسب طبيعة القصيدة: فالقصيدة التي تقصد المكان بطاقة بَصَريّة عالية يتحول فيها المشهد المكاني إلى طاقة معادلة في مستوى التعبير: ففي دار جدّه، إذا ما قصدها، وجدها:
«مطفأة هي النوافذ الكثار/ وباب جدّي موصدٌ وبيتُه انتظار/ وأطرقُ البابَ، فمن يُجيبُ، يفتحُ؟/ تُجيبني الطفولة، الشباب منذ صار،/ تُجيبني الجرارُ جفّ ماؤها، فليسَ تنضحُ:/ «بويب»، غير أنها تُذرذرُ الغبار».
أما القصيدة التي يتمثل فيها حضور الذات، فإن حركة الذات هذه هي ما ينتج الصور الشعرية، وإن كانت العلاقة فيها غالبًا ما تقع بين هذه «الذات» و«الآخر» كما في «شناشيل ابنة الجلبي».
وهي ليست بعيدة عن قصيدته التي غالبًا ما تنطلق من «حركة» لتنبني، أبعادًا، على هذه الحركة (بعدما أنزلوني سمعتُ الرياح قصيدة: المسيح بعد الصلب)، أو مما يتشكل، ويتكوّن، من رؤية/ رؤيا تكوينية (عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السَحَرْ قصيدة: أنشودة المطر)، أو يُحدثها إيقاع مكاني برؤيا زمانية (بويب.. بويب.. أجراسُ برجٍ ضاعَ في قرارة البَحَرْ قصيدة: النهر والموت). ومع أن الطاقة الحركية فيها تتشكل على هذا النحو أو ذاك، فإنها تذهب في غير اتجاه وتوجّه.
الذاكرة والتفاعل مع مخزونها
كانت عودة السياب إلى «جيكور» قد ملأت الكثير من فراغات الذاكرة لديه، وقامت المخيلة بدور واضح في هذا المجال.. ولعل أهم ما تحقق في هذه «العودة» هو «استعادة الذكرى» التي ستتحول إلى «إعادة بناء» لما كان له من واقع عاشه بجميع تفاصيله، لتُصبح «الذاكرة» بما اختزنت، و«الواقع» كما أدركه إدراك مشاهدة، هما مصدر الصورة الشعرية في قصيدته هذه. فإذا كانت «صور الذاكرة» قد تمثلت حيوية الحياة من خلال استعادتها داخليًا، وقد منحها شيئًا من عجائبية التمظهر والتكوين، فإن صور «الواقع مشاهَدًا» جاءت صور تكثيف وإزاحة، وهي صور الموت الذي كان يغالب إرادة الحياة داخله. كما في قصيدة «منزل الأقنان في جيكور»: خرائبُ فانزع الأبواب عنها تغدو أطلالا،/ خوالٍ قد تصكّ الريحُ نافذةً فتُشرعها إلى الصُبْحِ/ تُطلّ عليكَ منها عينُ بومٍ دائبَ النّوْحِ./ وسُلّمها المحطّمُ مثلَ برجٍ دائرٍ، مالا/ يئنّ إذا أتته الريح تَصْعدُه إلى السطحِ، سفينٌ تعرك الأمواج ألواحَه.
وهو إذ راح يقطع أرض جيكور، ويخطو في مجاليها كان يفعل ذلك بذاكرته أكثر منه بقدميه. وهذا ما يضعنا أمام «إعادة تشكيل» لـ «مواقع» و«أشكال» غدت «داخلية الحضور»، (أو هكذا تمظهرت)، وإن استعادها من خلال أسمائها/ عناوينها الكبيرة. وفي الحالتين كانت تداعيات «فكره الواعي» هي ما يجمع أطراف الصورة الشعرية المتكونة، أساسًا، من «واقع ظاهر» معالم وتشخيصات، و«حلم» له سيرورته. وهنا يتحرك، شعريًا، ضمن بعدين/ دافعين أساسيين، وهما: اليقظة، والإدراك.. فبهما تتحدد صيغة القصيدة، وشكلها.
وستشهد قصائد حقبة المرض تحولات جوهرية في بناء الرؤيا الشعرية وأساسيات تكوينها عنده.. وخصوصًا أن مجالي الرؤيا في بعض من قصائد هذه الحقبة كانا نتاج حلم، أو وهمٍ وتصوّرٍ (كما في قصيدة «في الليل»: وسريتُ ستلقاني أمي/ في تلك المقبرة الثكلى/ ستقول: أتقتحمُ الليلا/ من دون رفيق... فهي قصيدة تتشكل في إطار استيهامات حلمية (أو كابوسية).. وقد تعاطى، ذاتيًا، مع وقائع هذا الحلم، أو رؤاه، كما لو كانت واقعًا متحقق الفعل والوجود.
غير أن صور العودة هذه هي مما يصنّفه «كارل يونغ» في عداد «الصور البدئية» التي تنتظم في سياق «الصور النمطية». وإذا كان لمثل هذه الصور تاريخها (أو تمثيلها لمكان ذي بعد تاريخي، ولـ«الذات» علاقة تاريخية به) فإن معنى هذا التاريخ/ بُعده يتعيّن من خلال الإحالة الواعية إلى الواقع، والإحالة الحلمية إلى الذات ولعل هذا هو ما جعل صوره الشعرية فيها ترقى إلى مستوى التعبير الأسطوري كما في قصيدته «أفياء جيكور»:
- «نافورةٌ من ظلال، من أزاهيرِ/ ومن عصافيرِ../ جيكورُ، جيكورُ يا حقلًا من النورِ/ يا جدولًا من فراشات نطاردها/ في الليل، في عالم الأحلام والقمرِ/ ينشرْنَ أجنحة أندى من المطرِ/ في أول الصيفِ./ يا باب الأساطيرِ/ يا باب ميلادنا الموصول بالرحِمِ».
ونجد الصورة الشعرية في قصائده هذه (التي كتبها في حقبة المرض) صورًا مشخصة التفاصيل، فهي نتاج إدراك بصَريّ مباشر، وإن كانت لا تحول دون تدخّل الخيال، أو ما هو تخييلي، إلى عناصر تكوينها، (وإن بدرجة أقل مما كان عليه في قصائده التموزية التي لعب فيها «المتخيَّل الأسطوري» دور الكشف عن العالم الداخلي للشاعر، وما يسكن رؤياه الشعرية، أو يشكل نسيج عالمها). فهو هنا، في جيكورياته، وإن كشف عن نسق آخر من التمثلات، ووضعها في سياق تمثيلات مغايرة، فإن «الموضوع الخارجي»، وإن اتصل بالذات الشاعرة، أصبح هو المتغلب الرؤية الشعرية عنده، وهو مصدر الصورة الشعرية فيها، مقدِّمًا من «جيكور» عالمًا تطوف فيه المشاهد الحلمية التي حرص فيها على عدم الابتعاد عن الأسطورة وعالمها. فهو هنا، وبعد أن هرب من المدينة، التي تفتحت له عن حقيقتها (بغداد مبغىً كبير)، يحاول استعادة «جيكور» والخروج بها من هامشيتها الزمانية، لينهض بها محاولًا، بها/ ومن خلالها، تحقيق ضرب من التطابق النسبي بين حلمه المنكسر، أو المهزوم، وبينها، متخذًا منها «النموذج الضدّي» للمدينة - بعد أن كانت، المدينة، هي النسق الوجودي المهيمن على رؤيته ورؤياه الشعرية:
«جئتها والضحى يزرع الشمس في كل حقلٍ وسطحِ/ مثلَ أعواد قمحِ./ فرَّ قلبي إليها كطيرٍ إلى عشّه في الغروبِ».
وسيكون المسار، مسار الشاعر، في هذا الاتجاه/ التوجّه باعثًا لصور أخرى ذات نسق دال على «موضوعية» هذه الرؤيا الجيكورية لديه، رافعًا من شأنها الواقعي، وواضعًا إياه في مدارات أخرى تتطابق نسبيًا مع حلمه، وقد وجد في واقعها، كما أدركه، نظيرًا لحلمه الذي ضاع، أو اندحر:
«جنّة كان الصبي فيها، وضاعت حين ضاعا..».
وكما وجدنا أنفسنا، (أو وضعنا الشاعر)، أمام نمطين مختلفين من الصورة (صورة المدينة، وصورة جيكور)، فإنه، بالضرورة، سيتخذ، في ذلك، نمطين من التعبير، بما يجعل الصورة في صلب مدلولاتها:
«أشجارها دائمة الخضره/ كأنها أعمدة من رخام/ لا عريَ يعروها ولا صُفره،/ وليلها لا ينام/ يُطلعُ من أقداحه فجره».
وهو ما يجعل من إعادة بناء صورة شعرية جديدة لكل من المكان والزمان الذي يمثله، أو يتمثل فيه، بناءً لفضاء شعري جديد: مغاير حركة، ومختلف بُعدًا، وتبرز فيه، في حالة الشاعر هذه، قوّة التضاد وعنفه بين «جيكور» و«المدينة» التي التفّت دروبها حوله وقد تمثلها «حبالًا من الطين» يمضغن قلبه «وينفينَ عن جمرة فيه طينه».. ليجد في «جيكور» البُعد المكاني التعويضي، وإن كانت قد «شابت وولى صباها/ وأمسى هواها/ رمادًا..». ومع ذلك فهو يهوى «أفياءها» فإذا ما تساءل أمامها: «أين جيكور؟» وجد الجواب يأتيه من نفسه:
«جيكور ديوان شعري،/ موعدٌ بين ألواح نعشي وقبري».
وهنا نجد لجيكور سيرورة تصاعدية وهي تُنتجُ من الصورة/ المشهد لا المعنى وحده، وإنما تنتج دلالته معه.
وقد تأخذ الصورة لديه «بُعدًا تشكيليًا» أقرب ما يكون إلى الأسلوب الانطباعي في الرسم.. فهي صورة تعتمد «الرؤية البصرية» والتفاصيل التي يتشكل منها المشهد:
«أأشتهيكِ يا حجارة الجدار، يا بلاط، يا حديد، يا طلاء؟/ أأشتهي التقاءكنّ مثلما انتهى إليَّ فيه؟/ أم الصبا، صباي، والطفولة اللعوب والهناء؟»
لكنه، في لحظة وعي بما يحيطه، يجدها وقد ضاعت منه جميعًا:
«طفولتي، صباي، أين.. أين كلُّ ذاك؟/ أين حياة لا يَحدّ من طريقها الطويل سورْ/ كشّرَ عن بوابةٍ كأعينِ الشِباك/ تُفضي إلى القبورْ؟»
وينتهي إلى السؤال:
«إيه جيكور، عندي سؤالٌ، أما تسمعينهْ؟/ هل تُرى أنتِ في ذكرياتي دفينهْ/ أم تُرى أنتِ قبرٌ لها؟ فابعثيها/ وابعثيني./ هيهات ما للصبا من رجوعِ».
وهنا بلغ اليقين، أو أن اليقين بلغه. أليس هو من تمثّل جسده، وقد هدّه المرض، «مثلَ دارٍ نخرَتْ جوانبَها الرياحُ وسقفَها سيلُ القَطارِ»؟
إن «صورة النهاية» لم تأته دفعة واحدة، أو في صيغة تُقرّ بمآله، وإنما أتته في أشتات مختلفات:
- فمرة في صيغة سؤال: «جيكور، أنمضي نحن في الزمنِ/ أم هو الماشي...؟».
- ومرة في ما يبدّد به، أو يبدد عنه وحشة عزلته الطارئة: «لولا الخيالات من ماضيَّ تنسربُ/ كأنها النومُ مغسولًا به التعبُ..».
- وثالثة يجد فيها حضوره، وجودًا وهوية: «جيكور ديوان شعري..».
- وقبل هذا وذاك، هي الصفاء والنقاء الذي يقابل به إثم المدينة وآثامها، فيرى في جيكور «جنّة كان الصبى فيها..».
خلاصة: شيء يخص الروح
وخلاصة نقول: إن قصيدة السياب، بوجه عام، تنفتح على/ عن ثلاثة مكونات أساسية، هي: الحقيقة واقعًا، والخيال عنصرًا تكوينيًا، والأسطورة مدلولًا رمزيًا. فإذا ما وجدناه يمزج الواقع بالأسطورة، فإن دور الخيال هنا هو صناعة الحياة على النحو الذي يريد، لنفسه وإنسانه، أن يراه، أو يكون، وعلى نحو ما في نفسه من توق إلى ذلك.
وهو إذ يتحدث عن جيكور ومشاهد واقعها المكاني إنما يتحدث عن «مشهدِ واقعٍ» قائم على/ ومن خلال ما يخلق له من روابط مع الذات.. وبما يجعل منه واقعًا قابلًا لإعادة التشكيل التي يصبح معها واقعًا مدركًا ذاتيًا.
إلى جانب هذه «الصورة الجيكورية» - إذا جاز التوصيف - وهي صورة تُحيل إلى فضائها (الذي حاول الشاعر أن يجعل منه فضاءً أسطوريًا)، فإن الحركة في هذا الفضاء ظلت محدودة بحدود المكان بزمنيه: الماضي - الذكرى الجميلة، والحاضر المتداعي تداعي جسده المريض. فنحن هنا لسنا أمام «إعادة تشكيل وجود»، وإنما أمام «انحلال وجود» في بُعديه: المكاني - التاريخي، والجسدي متمثلًا بحال جسد الشاعر الذي سيصبح النظير للمكان المتداعي على نفسه.
إن جيكور، وقد عاد إليها، أصبحت «التاريخ الشخصي» له، يعود إليها بذاته، ومن خلال استعادة رموزها الحيوية يحفز هذه الذات لتجمع بين واقعه ومصيره. وإذا كان هناك قد رفض المدينة باسمها مرة، وبمطلقها مرات، فإنه هنا يستعيد الأرض باسمها، متحسسًا ترابها، ومتجاوزًا واقعه من خلال جريان نهرها واستمرار الحياة فيه والحيوية، صاعدًا أشجارها (وهي الدائمة الخضرة) متقربًا بها من رموز الحياة. كما أعاد صياغة واقعها من خلال ما بقي منها، مستعينًا على ذلك بذاكرته، وكأنها الميراث الذي ترثه الروح. ولا غرابة في الأمر.. فما انشغل به الشاعر في عودته إلى جيكور، وبحثه في فضاءاتها الأولى، ليس إلا شيئًا يخص الروح.

