استراتيجية التفكيك في مقاربة النص الأدبي
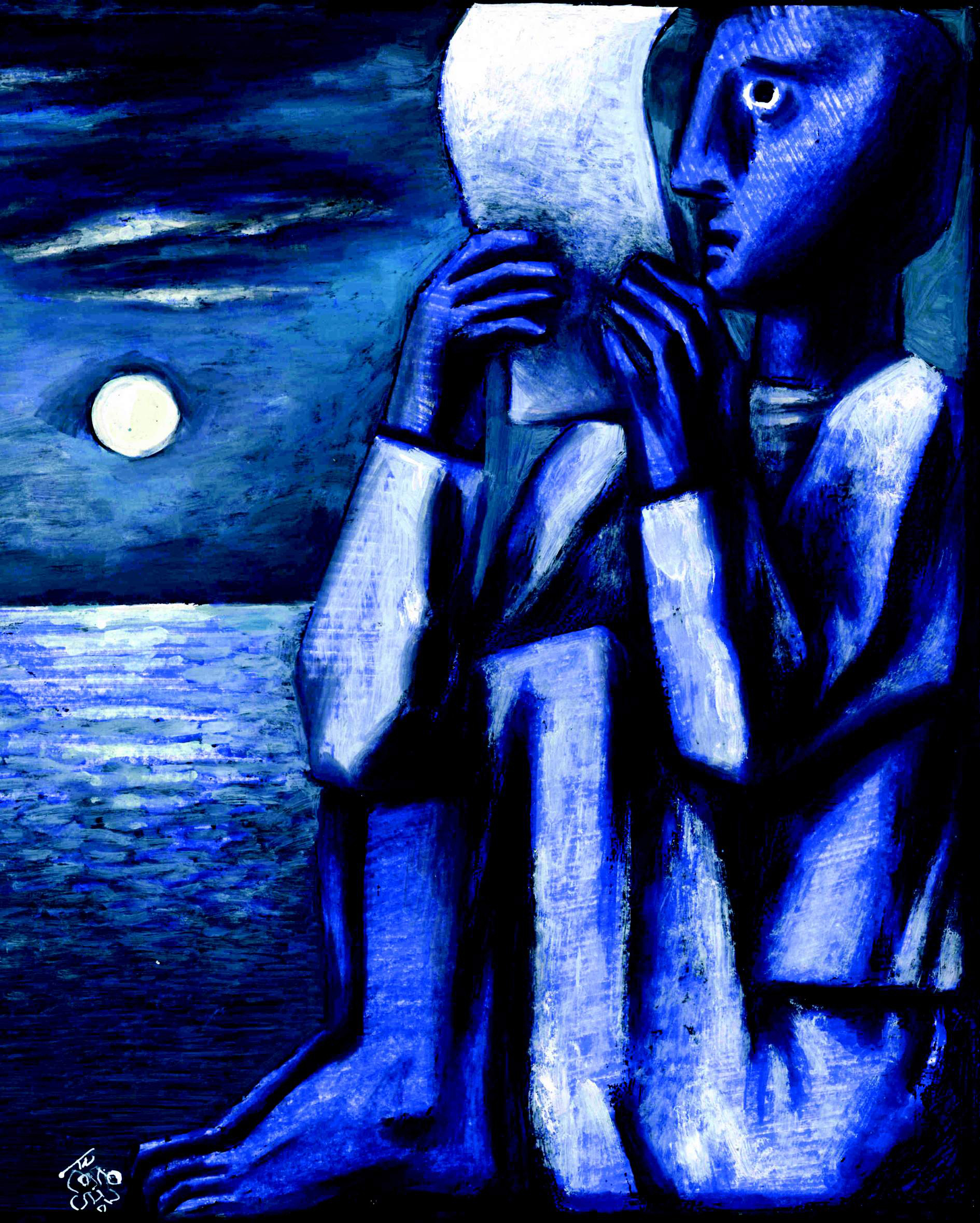
كان لتراجع «البنيوية» عن المشهد الثقافي الغربي منذ أواخر ستينيات القرن العشرين - نتيجة انهيار الدعائم التي شكلت مشروعها النقدي، مثل تأسيس دراسة علمية للنص الأدبي عن طريق تبني النموذج اللغوي الذي قدمته اللسانيات البنيوية، ومحاولة صوغ أنساق كونية تصنف في ضوئها النصوص الأدبية - أثر عميق في ظهور التفكيكية، وتحول مجموعة من النقاد الذين كانوا ألمع رموز الحركة البنيوية إلى اعتماد آليات جديدة في تحليل الخطاب الأدبي، كما هو الشأن مع رولان بارت في فرنسا، وجوناثان كلر في أمريكا.
يعد الناقد الفرنسي جاك دريدا المؤسس الحقيقي لهذا التيار، ولعديد من المفاهيم النقدية التي ستشكل الجهاز المفاهيمي لهذه الاستراتيجية النقدية، حيث أعلن عن مجموعة من المقولات التي تعتبر مرجعية أساسية لاستراتيجية التفكيك، يمكن إيجازها في عنصرين أساسيين:
أولهما: استحالة إرجاع النص الأدبي إلى مركزية ثابتة يقف عندها التحليل النقدي.
وثانيهما: أن نسق العلامات اللغوية هو في مراوغة مستمرة يستحيل معها التوقف عند تفسير نهائي.
ولما كانت المفاهيم النقدية التي طرحتها التفكيكية على قدر كبير من التداخل والتلاحم، بل والتكرار أحيانا، فإننا سنقف عند أبرزها، مركزين أيضاً على الامتداد الذي عرفته هذه المفاهيم، والتنويعات التي أدخلت عليها من طرف النقاد الأمريكيين الذين تحمسوا للمشروع الدريدي، وعملوا على إغنائه وتعميقه في حقل الممارسة النقدية، كما هو الشأن مع نقاد جامعة «ييل»: بول دي مان، هيلز ميللر، جيفوري هارتمان، هارولد بلوم، وآخرين تأثروا بإشعاعها الثقافي، مثل: جوناثان كلر، وفنسنت ليتش. ويأتي في مقدمة هذه المفاهيم التي استندت إليها التفكيكية في مقاربة النص الأدبي، «مفهوم اللعب الحر للدلالة»، وهو مفهوم أساس تتفرع عنه بقية المفاهيم النقدية الأخرى التي ستشكل صلب استراتيجية التفكيك، ومفاده عند دريدا أن النص الأدبي لا يتمتع بداخله بوحدة تامة، كما كان الشأن مع المناهج النقدية السابقة، بل هو سلسلة من الاختلافات التي تشير بدورها إلى اختلافات أخرى، مما يجعل تثبيت دلالة نهائية للنص الأدبي عملية مستحيلة.
مفهوم الحضور والغياب
من هذا المنطلق، إذا كان النص القديم – وفق التصور التقليدي – يحـظى بتناغم داخلي بين مكوناته، ويمتلك معالم واضحة تحدد هويته، فإن النص الأدبي الذي أعلن التفكيكيون عن ميلاده نصا مختلفاً يرفض التثبيت، ويقاوم كل المحاولات الرامية إلى ربطه بمرجعية ثابتة، أو رده إلى أصل نهائي، وهو ما يفضي إلى مفهوم نقدي جديد يتداخل إلى حد كبير مع المفهوم السابق هو «الحضور والغياب»، وتعزى معالمه عند دريدا إلى رفضه وجود مركز أو سلطة خارجية موثوقة اتخذت أشكالاً مختلفة من الحضور عبر التاريخ الثقافي للإنسانية مثل العقل أو الإنسانية أو الكينونة أو التقاليد عند النقاد الجدد أو النظام العام عند البنيويين، فإنه لم يعد بداخل النص الأدبي سوى اللغة التي يقاربها التفكيكيون باعتبارها تؤسس على ثنائية الحضور والغياب، حيث إن كل مدلول يتحول دائما إلى دال يرفض بدوره تثبيت معناه إلا في علاقتـه مع المدلولات الغائبة. ومعلوم أن دريدا هنا ينتقد ويطور في الوقت نفسه تصور فرديناند دي سوسير للغـة، لأنه إذا كان عالم اللسانيات البنيوية، ونتيجة لتزامن نظريته مع تنامي الروح العلمية في الثقافة الغربية يؤسس نموذجاً لغوياً يتسم بالانغلاق رغم كونه يؤمن بالاختلاف، ﻷن كل لفظ دال في معادلة «سوسير» لا يحمل صفة جوهرية في حد ذاته، بل يكتسب دلالته بالاختلاف مع الألفاظ الأخرى داخل المنظومة اللغوية، فإنه يفضي في نهاية المطاف إلى حدوث الدلالة، حيث ترتبط العلامة اللغوية بمفهوم أو شيء محدد، إلا أن دريدا، وتماشياً مع رفضه لميتافيزيقيا الحضور التي انبنت عليها الفلسفة الغربية، يعيد قراءة معادلة «سوسير»، ليخرج بتصور جديد يحول الدلائل اللغوية إلى سلسلة الاختلافات التي تراوغ باستمرار مدلولاتها، وتفضي إلى إرجاء مستمر للدلالة.
من الجلي، إذن، أن دريدا وهو يعيد تفكيك العلاقة بين الدال والمدلول، يستدعي تاريخاً فلسفياً مترعاً بالشك في وحدة العلامة، وهو تراث عمل أكثر على تفعيله خلال فترة سبعينيات القرن العشرين، مستغلاً في ذلك انهيار كل اليقينيات التي بنيت عليها الحضارة الغربية، بما فيها العلم الذي تمخض عن دمار وخراب للإنسانية، وقد كشفت الناقدة جيثاري سبيفاك عن الروافد الفلسفية التي كانت وراء رفض دريدا لوحدة العلامة اللغوية، ولميتافيزيقيا الحضور، تقول: «وهؤلاء الثلاثة هم أول الجراماتولوجيين: نيتشه فيلسوف يمزق رواسب المعرفة، وفرويد سيكولوجي يضع النفس موضوع سؤال، وهيدجر أنطولوجي يضع الوجود تحت كشطة، ودريدا هو الذي «أنتج» قوتهم الجوهرية و«اكتشف» الجراماتولوجيا، علم تحت الكشطة»، ولكن للوقوف أكثر عند مغزى المقولة السابقة واكتشاف دريدا لأهمية الكتابة Grammatology سنقف عند هده الإشكالية بتفصيل أكثر.
لقد لاحظ دريدا أن التفكير الغربي في بعده الفلسفي أو النقدي قد منح أهمية قصوى للكلام على الكتابة، تماشياً مع إيمانه بوجود مركزية موثوقة وراء كل نشاط ثقافي يبدعه الإنسان، وذلك ﻷن الكلام يتطلب حضوراً بين طرفين ويستلزم وجود مرجعية واضحة يمثلها المتلقي، حتى يحقق التواصل فاعليته. بالإضافة إلى أن المناهج النقدية السابقة ظلت تعتبر دائماً اللغة مجرد واسطة وأداة نقل للمعاني، مما جعلها – وفق دريدا – تقع في شراك اللوغوستريرم، (ميتافيزيقيا الحضور)، ولذلك فدريدا يعيد في مشروعه النقدي استبدال تراتبية كلام/ الكتابة، بتراتبية جديدة تنسجم واستراتيجيته النقدية الرافضة لكل تثبيت للدلالة هي كتابة/ كلام، لأن الكتابة لا يمكن أن تحكمها دائماً مقاصد مؤلفيها وغاياتهم المعلنة.
ومن الأمثلة التي ساقها دريدا لنقد كل تراتب قهري ينتج عن تكريس ثنائية كلام/كتابة، ثنائية الخطاب الفلسفي والخطاب الأدبي، حيث لاحظ دريدا أن الخطاب الفلسفي كان ينظر دائماً إلى الخطاب الأدبي باعتباره ثانويا، لما يعتمده من بلاغة ومجاز وتخييل يشكل تهديداً للخطاب الفلسفي الذي ينشد دائماً حقائق واضحة، ويبتعد عن الكتابة وميولاتها الاستعارية، وفي هذا النطاق يقول جوناثان كلر: «إن التعارض بين الأدبي والفلسفي ما هو إلا صيغة أخرى من التعارض بين الكتابة والكلام، إذ تعزى خصائص معينة من خصائص اللغة للكتابة/للأدب، بحيث يمكن التعامل معها على أنها غير طفيلية أو غير مستقلة بذاتها، من أجل الإبقاء على صلة الكلام/الفلسفة بالفكر أو الحقيقة خالصة مباشرة».
لذلك يعيد دريدا عكس الترتيب بإظهار أن الخطاب الفلسفي نفسه الذي حاول دائما الهرب من البلاغي أو الشعري، يتضمن بدوره بنية بلاغية تولدها اللغة. وهو ما أشار إليه نيتشه بمناداته أن الحقائق التي اعتبرها بعض الفلاسفة طويلاً حقائق ثابتة، ليست إلا مجازات تآكلت من طول الاستخدام، كما أن الخطاب الأدبي بدوره يتوفر أحياناً على إمكان تفكيك الخطاب الفلسفي بمجرد الاعتراف أحياناً بأهمية التفكير المنطقي.
وقد استخدم رامان سلدن مصطلحاً جديداً للتعبير عن عملية التفكيك المستمرة هذه التي تقوم بها هذه الاستراتيجية النقدية، لكل دلالة يقينية قد تقف عندها قراءة نقدية لنص إبداعي. ويتعلق الأمر ببول دي مان الذي نادى بأن كل قراءة نقدية هي إساءة قراءة، مشيراً من وراء هذه المقولة النقدية إلى إثبات أن ما قد تفرزه مقاربة نقدية لنص إبداعي من نتائج ليست نتائج نهائية ومغلقة، بل تتضمن بداخلها بعض مواطن الضعف والفراغ والعمى مما يفسح المشروعية لقراءة جديدة تحاول انطلاقا من هذه الفراغات، تقديم قراءة جديدة ليست بدورها نهائية.
لعل هذا الطرح الذي أدى بالتفكيكيين إلى اجتثاث كل أصل قد تقف عنده العملية الإبداعية أو النقدية، هو الذي كان وراء تغير رؤية التفكيكيين لوظيفة النشاط النقدي من جهة، ولطرائق تشكل النصوص الإبداعية من جهة ثانية، ففيما يخص العنصر الأول المتعلق بتغير وظيفة الخطاب النقدي مع التفكيكيين، يمكن القول إن الوظيفة التي درج النقاد على إسنادها للنشاط النقدي، رغم تباين منطلقاتهم الفلسفية وتوجهاتهم النقدية، هي تقريب القارئ من النص الأدبي، وتسهيل عملية فهمه لما يزخر به من معان ودلالات.
إن هذه الرؤية التي كانت تجعل من النشاط النقدي مجرد أداة لإنارة النص الأدبي وفتح مغالقه، بدأت تتغير في مسار النظرية النقدية الغربية، حيث أخد الخطاب النقدي بدوره يتحول إلى خطاب إبداعي، ويوظف لغة شديدة الإبداعية تلفت النظر إلى نفسها أكثر مما تلتفت إلى النص الأدبي وتنيره. وهو الأمر الذي يمليه القارئ مع الشعرية البنيوية في فترة الستينيات وخصوصاً عند أحد أبرز أقطابها آنذاك رولان بارت في كتابه « S/Z» الذي حلل من خلاله قصة قصيرة لبلزاك، وأبان عن إمكانات متعددة لتوليد الدلالة داخل مستوياتها التركيبية والخطابية، أو في فصله بين صنفين من النصوص الأدبية، نص القراءة الذي يكون من خلاله القارئ مجرد متلق سلبي للنص الأدبي ومستهلك لمعانيه، ونص الكتابة الذي يمارس من خلاله دوراً ايجابياً، ويشارك في إعادة إنتاج كتابته من جديد.
ويعرف تيري إيجلتون خصائصه «البارتية» انطلاقا من كونه «نصاً حداثياً، ليـس له أي معنى محدد،أو أي مدلولات ثابتة ومستقرة، وإنما هو متعدد ومنتشر، نسيج لا ينفد أو مجرة من الدوال، قماش متصل من السنن وأجزاء السنن، يمكن للناقد أن يقطع عبره درب ضياعه الخاص. فليس ثمة بدايات، ولا نهايات، ولا متتاليات إلا ويمكن عكسها، وليس ثمة تراتبية للمستويات النصية».
لقد كانت النتيجة الأساسية لتبني إبداعية النقد عند التفكيكيين، ابتعاد كتابتهم النقدية عن الغاية الأساسية من النقد وهي إضاءة النصوص الأدبية، وتحولها إلى كتابة نقدية شديدة الاحتفاء بلغتها، وبممارسة حيل وأساليب متعددة في تفكيك الخطاب النقدي، بل امتدت هذه الإبداعية إلى تفكيك الخطاب النقدي نفسه. وهو الأمر الذي مارسه دريدا في مشروعه النقدي، حيث لم يقف فقط عند إبداعات بلزاك أو جان جينيه، بل وأيضاً كتابة روسو ونيتشه وهوسرل وهايدجر، وامتد تأثيره أيضاً إلى الناقد الأمريكي بول دي مان، وهو أحد نقاد جامعة ييل البارزين من خلال كتابه «العمى والبصيرة». الذي حاول من خلاله تحليل مجموعة من الكتابات النقدية لكل من لوكاتش، ودريدا، وموريش بلانشو، والنقاد الجدد أمثال ويمساط برنسلي، وكلنيت بروكس.
ومن الواضح مدى توسيع دريدا لسلطة النص وتجاوز المفاهيم التي استقرت عليها بعض المناهج السابقة، التي كانت ترسم إطارا محددا، فـ«دريدا» يلغي كينونته بالكامل، ويحوله من كيان ثابت إلى مجرد شبكة من الآثار التي تحيل إلى آثار سابقة تستعصي معها محاولات إلزام النص بأصول معينة، لأن في هذا الإلزام تعارضاً مع الاستراتيجية التفكيكية نفسها التي قامت على التفكيك المستمر لكل اليقينيات، وزعزعة وتدمير الثوابت، وذلك خلافاً لبعض التوجهات النقدية السابقة التي كانت تنشد من وراء تبني استراتيجية التناص في مقاربة النص الأدبي، البحث عن مدى قدرة النص الأدبي على تحويل النصوص السابقة، وتسخيرها لخدمة مرجعية جديدة يحاول من خلالها النص الأدبي معانقة قضايا عصره. كما هو الشأن مع بيير زيما الذي انتقد في تناوله لهذا المفهوم المناهج الشكلانية السابقة، إضافة إلى حوارية باختين لكونها تفرغ التناص من الإنتاجية، وتجعله مجرد آلية تضيء طرائق البناء وتشكل العملية الأدبية أكثر مما تستهدف إبراز الحمولة الجديدة التي تتخلق عن طريق تضافر جملة من النصوص الغائبة داخل النص الحاضن.
ورغم الضجة النقدية التي أثارتها التفكيكية طوال سبعينيات القرن العشرين، ورغم الصخب الذي أحدثه في الأوساط النقدية إلى درجة جعلت بعض النقاد المسترفدين لخلفيات فلسفية تتعارض مع خلفيات التفكيك المترعة بالشك والعدمية يستفيدون من مفاهيمها لتعميق مناهجهم النقدية، كما هو الشأن مع بعض النقاد السوسيولوجيين مثل: تيري إيجلتون، وبيير زيما، وفريدريك جيمسون، وكريستوفر بطلر، فإن المتتبع لمسار التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر يلمس بداية تراجعها منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وتوالي الهجوم عليها من طرف مجموعة من النقاد الغربيين، وذلك يعود - وفق رأينا - إلى إفراط التفكيكية في إلغاء سلطة النص الأدبي وإفراغه من مرجعية محددة يعانق من خلالها قضايا الوجود نتيجة تمسكها بمفاهيم تصب كلها في بؤرة واحدة هي استحالة تثبيت نهائية للنص الأدبي كما هو الشأن مع «اللعب الحر للدلالة»، «الاختلاف»، «التأجيل»، «الحضور والغياب»، «التناص»، «الانتشار»، «المراوغة».
وفي هذا السياق يقول بيير زيما: «إذ يؤكد النقد التفكيكي أن كل النصوص مأزقية وأنها تنتهي بتفكيك نفسها بنفسها، ينزع إلى الحد من البعد التاريخي والسوسيولوجي لتحليلاته. ذلك أن تنوع النصوص وسياقاتها التاريخية يجعل الفرضية التي تقول إن كل النص هي بنى مأزقية غير قابلة للتصديق إطلاقاً».
هذا بالإضافة إلى أن التفكيكية رغم كونها تقدم جملة من المفاهيم المثيرة التي تدعي من خلالها تجاوز تصورات المناهج النقدية السابقة، إلا أنه يمكن الاتفاق مع الناقد الأمريكي جون أليس الذي يعتبر من أشد خصوم التفكيكية على أن هذه الاستراتيجية النقدية لا تحمل طروحات جديدة، إذ إن كل ما تتقنه هو الصياغة الميلودرامية لمفاهيم متداولة سلفاً، وإثارة أسئلة حول قضايا تمت معالجتها سابقاً بشكل واضح وهادئ من طرف مجموعة من النقاد والدارسين.
ومن الأمثلة التي يمكن إيرادها تعزيزاً لمواطن الانتقاد هذه التي يوجهها جون أليس للتفكيكية الأمثلة التالية: فالآلية التفكيكية المستفزة والمثيرة التي تقول إن كل قراءة هي إساءة قراءة لا تعدو أن تكون صياغة شديدة الميلودرامية لمفهوم عادي ومطروق، هو أنه لا يمكن اعتبار أي رأي حول نص أدبي هو القول الفصل حول ذلك النص، كما أن مفاهيم الانتشار أو المراوغة بدورها ليست إلا تغييراً في المصطلحات لمفهوم سابق التفتت إليه النماذج النقدية السابقة هو تعددية الدلالة داخل النصوص الأدبية.
ولذلك، لم يكن من المثير أن يشهد الوسط النقدي الغربي منذ بداية الثمانينيات تألق مناهج نقدية سابقة تجاوزت التفكيكية ونادت بضرورة ربط النص الأدبي بالسياق وإلزامه بتخليق مقصدية يتلاحم فيها مع قضايا العصر مسترفدة خلفيات تم تعميقها مثل: الماركسية والتحليل النفسي، كما هو الشأن مع التاريخية الجديدة، والمادية الثقافية، والنقد ما بعد الكولونيالي، والنقد النسائي، والنقد الثقافي الذي يكشف تيري إيجلتون عن توجهاته الجديدة في فهم وظيفة الأدب باعتباره «مرتبطاً ذلك الارتباط الحيوي بأوضاع البشر الحياتية: فهو ملموس وليس مجرداً، يبدي الحياة بكل تنوعها الخصب، وينبذ البحث المفاهيمي العقيم لكي يشعر بما هو حي ويتذوقه» .

