«تاريخ الغُرَف»
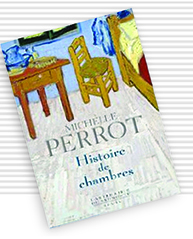
كل الطرق تؤدي إلى الغرفة... فهي المسرح، الذي تدور على خشبته أغلب مشاهد حياتنا، فمن المتعة إلى العذاب، ومن القراءة إلى التأمل، ومن النوم إلى المرض، ومن الولادة إلى الاحتضار، وبخاصة العزلة... اختيارية كانت أم إجبارية... إنها الغرفة، حيث يتعرى الجسد، وتتحرر الروح، تاركة مخاوفها من فضول الأعين، ومتابعة المحيطين! فهي ليست إلا مظهرًا من مظاهر الحق في الخصوصية.
«يعيد نظام الغرفة إنتاج نظام العالم... فهي عنصره الجزئي». هذا ما كتبته ميشيل بيرو، المؤرخة الفرنسية القديرة، في ختام دراستها الفكرية الجديدة حول تاريخ الغرف، فيما ينفي كتابها أو يتجاوز، على الأقل، هذه العبارة العامة، عبر تعقيد ملتو لتحولات الغرف، ليعيد الكتاب رسم الطريق التاريخي للغرف. طالما أرادت المجتمعات تجاهل تعبير الخصوصية الذي تنعت به الغرفة؛ حيث عرفت جموع المزارعين الفقراء، حتى القرن العشرين، نظام الغرفة الوحيدة، التى تستخدم حجرة معيشة نهارًا، ومكانًا للنوم ليلًا. فيما أدمج الحرفيون مكان المعيشة ومكان العمل في مكان واحد.
حتى المنازل الواسعة، بما فيها قصور العصور الوسطى، وسرايات عصر النهضة، خلت من غرف تصلح للانعزال والخصوصية الفردية. ليس إلا في بدايات القرن السابع عشر، حيث ابتكرت القصور الإنجليزية، تصميم الممرات المؤدية إلى كل غرفة، دون الحاجة إلى المرور ببقية الغرف. وسريعًا ما منح لورانس ستون النخبة الإنجليزية ميزة الريادة في الفردانية المكانية. وهو الابتكارُ الذي ولّد وعياً جديدًا، أعني الاحتياج للخصوصية، الذي سينتشر، تدريجيًا، إلى أن يصل لأولى درجات السلم الاجتماعي، وإلا فكيف نفسر دعوة فيرجينيا وولف، بعد ذلك بثلاثة قرون، وهي سيدة تنتمي للطبقة الأرستقراطية اللندنية، مناداتها بـ«الحق في غرفة فردية»؟
فالغرفة الفردية لم تــــبتـــــكر مــرة واحــــدة، بل عبر مســــيرة طــــويلــــة الأمـــد للتصــــميم المعــــماري الداخلي الذي أراد للمتعايشين معًا التـــمتع بقـــــدر من الاستقلالـــــية والخـــصوصـــــية. وبعد مئات التحولات الابتكارية، استقرت الغرفة على شكلها الحالي: مكان للعيش في مأمن من النظرات! ولأن بيرو تربط بقوة بين تاريخ الغرفة، وتاريخ الخصوصية والفردية، فهي لم تكتف برؤية لورانس ستون الخطــــية التقسـيمية للطبقات الاجتماعية وعلاقــــتها بنظام الغرف.
وكي تبرز بيرو فكرة الخصوصية تنقلت بين الممرات لتنزلق بعدستها المكبرة من حجرة لحجرة؛ فإذا طرقنا الباب ومررنا داخل الكتاب، استقبلتنا بيرو في غرفة الملوك، التي خصصت لها الجزء الأول، إذ جعل الملك، لويس الرابع عشر، الملقب بالملك الشمس، من غرفته التي ينام فيها بمفرده، مكانا يُعرض فيه جسده أمام العامة، منذ لحظة الاستيقاظ، مستخدمًا معكوسية واجب الشفافية والظهور العلني، ليدخل إلى سرية الغرفة بتفاصيلها المتعددة. وهذا الامتصاص لمجتمع الرعية بأسره، وإدماجه في حيز خصوصية الملك، لا يخلو من المنطق؛ إذ إنه نتيجة للوعي بالحق الرباني في الحكم الديكتاتوري المطلق، والذي ظهر من خلال صورة السلطة الشمسية التي وصف بها لويس الرابع عشر حكمه وسلطته.
بينما لم تقل الصفحات المخصصة لحجرة المحتضر أهمية ووصفًا دقيقًا من جانب الكاتبة، فما أفردته من سطور لوصف الحجرة التي ماتت فيها الكاتبة جورج صاند (1804-1876)، يعتبر صدى بعيدًا لمستهل الكتاب الذي تضمن بداية اليوم ولحظات الاستيقاظ. فصاند التي كانت بمنزلة رائدة الحركة النسوية قبل أن تعرف بشكلها المعاصر، ماتت على الطريقة التقليدية المعروفة لنساء الطبقة الأرستقراطية في ذلك العصر، حيث أحاطت العائلة بالجزء الأعلى من السرير الذي ترقد عليه صاند، لإعانتها على الذهاب في رحلتها الأخيرة، وإبان لحظاتها الأخيرة وافقت صاند على أن يشاهد العامة مشهد موتها، وتدهورها الجسدي، بغرض إهداء هذه اللحظة الفارقة إلى مجمل ذكريات القرن الذي ولدت فيه وماتت فيه. وهو المشهد الذي سريعًا ما سيتغير، حيث انتقلت صاند إلى المشفى، وحل الأطباء وأدواتهم محل أفراد العائلة وصلواتهم، فشهدوا على لحظات أنينها وعذابها الأخيرة، وسط حالة من الوحدة المريرة والمؤلمة.
ومع استعراض تعددية استخدامات الغرف تبعًا للطبقات الاجتماعية، والمراحل العمرية، والنوع بدقة دؤوبة، تكشف بيرو في مواضع مختلفة من الكتاب التناقض ذاته: أن ما نؤسسه باعتباره مأوى وملجأ لنا، قد يصبح مكانًا للشعور بالوحدة، وما نهرب إليه طالبين بعض العزلة بعيدا عن نظرات ومطاردات الآخرين، من الممكن أن يتحول إلى حبس انفرادي اختياري.
ومع تقدير مكانة ميشيل بيرو باعتبارها أهم مؤرخة تحدثت عن المرأة، وأكثر من طرح قضايا النوع في فرنسا على ساحة الجدل، فلا عجب إذا كرست بـــــيرو، للــدور المميز للمرأة في دراستها التأريخية الجديدة عن الغرف، ولكن دون الإخلال بمهنية البحث والكتابة، حيث لم تقحم المرأة على الموضوع، إذ إن ارتباط المرأة بجوانيات الشعور، وخصوصيات المكان لهو ملمح ثقافي وتاريخي عايشته أغلب الحضارات.
ولكنه ارتباط إشكالي، ويشهد على ذلك، الجزء المخصص لصالون المبجلات، حيث عانت الماركيز رومبويي من متاعب صحية، فلم تعد تستطيع الاجتماع بصديقاتها في البلاط، وأصبحت تستقبلهن في غرفتها الخاصة، حيث تحولت غرفة النوم إلى صالون تجتمع فيه نساء الطبقة الأرستقراطية، مطلقات نقدًا عامًا موجهًا نحو المجتمع والخارج، نقداً يتخذ من سلطتهن الداخلية على أمور القصر نقطة الارتكاز، مبتكرات لموديل جديد للمدنية والتحضر النسائي، والذي انتشر شيئًا فشيئًا، مستعمرًا البلاط ومن ثم الطبقات الوسطى، حيث ذكر ودرس في المدارس المتوسطة في ما بعد.
وفي طبقات العمال في فرنسا في القرن التاسع عشر، لم يختلف الأمر كثيرًا؛ إذ اتصفت علاقة المرأة بالخصوصية بالتناقض ذاته، حيث اقتدوا بنمط الحياة البرجوازي، ونموذج المرأة ربة المنزل. ودعم ذلك رؤية أنصار الأبوية والدور الذكوري في الأسرة الذين روجوا لتفضيل المرأة للمنزل المريح الآمن وتقديمه كأفضل ما يمكن تقديمه لها، على اعتبار أنها تفضل الخصوصية في الداخل أكثر من استغراق الوقت في أنشطة خارجية.
يتكون هذا الكتاب من مشاهد متتالية، بشكل يجعل من الصعب مقاومة قراءته وكأنه رواية مترابطة بشكل طبيعي. وهو مع ذلك لا يعد رواية، حيث تجاهلت الكاتبة الشك القديم في تاريخ وبنية المجموعات والأفراد إزاء الشهادات الأدبية، فيما اقتبست من الرواية جزئية التوثيق. فالغرف التى تدخلنا إليها بيرو دافعة بأبوابها واحدًا بعد الآخر، تلك الأبواب التي تحمي خصوصية من وراءها، ليست متحفًا خياليًا للفضاء الخاص، وإنما هي تاريخ! ولكن... أي تاريخ؟
إذ إن المسيرة التي اختارتها المؤلفة لبناء هذه الدراسة الفكرية تعتمد على شهادات الفاعلين أنفسهم، أي ساكني الغرف، وعلى الروايات التي كتبت عن العصر الذي عايشوه.
ولا تفوتنا الإشادة بحرص الكاتبة على إبراز المشاعر الدقيقة والأفكار المختبئة أسفل ذكريات الفاعلين، والتي دثرها تعاقب الحقب الزمنية. ولكنه تخليد لا يعطل تكريس الذاكرة الجماعية، باعتبارها تفعيلا للماضي يمحو الحاضر. وهو ما يجعلنا نميز إرهاصات للمستقبل بين خطوط الماضي، بمعاونة ما تتيحه لنا الدلالة الإجمالية لحركة التاريخ.
تتفحص الكاتبة المجتمع من خلال هوامشه. فتبتكر عرضًا جديدًا لخبرات شخصية عادية متراكمة، يحيلنا نحو نظرة واستخدام جديدين لفضاء الغرفة الخاص، من دون أن يؤثر في مفاهيم الذاكرة الجماعية التي نتفق من خلالها ونتوافق مع من حولنا، مخلصة تلك الذكريات من مخزون لاشعوري هائل ومندثر، فتضع الكاتبة إشارات حمراء تحدد بها خط السير الذي نفهم من خلاله ماهيتنا عبر مجموع العادات التي شكلتنا والتي تساعدنا على تقبُّل حقائق حياتنا المادية.

