سُقراط ... أو واجب الظلال في الصيف
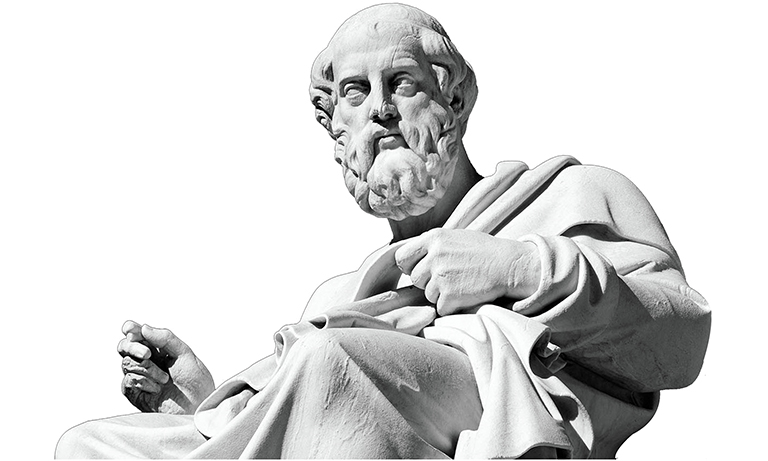
كانت الحضارة الإغريقية، أو «الغربية» بشكل عام، تمرّ بفترة عصيبة من التاريخ حين ظهر الفيلسوف «العُمدة» سقراط على الساحة، فهو – طبقاً لبعض الآراء – لم ينهض بحضارة أمته فقط، ولكنه كان «المُخلّص» للحضارة الغربية في عصره. ولد سقراط حوالي سنة 469 أو 470 ق.م، وكانت تلك الحقبة مهمة جداً في التاريخ اليوناني القديم لأن سقراط ولد ونشأ في أثينا وعاش خلال ما يُطلق عليه العصر الذهبي للأمة اليونانية، وصولاً إلى تلك الفترة التي وقعت فيها الحروب بين (دولة – مدينة) أثينا و(دولة – مدينة) إسبرطة، أو ما تسمى بالحرب البلوبونيزيّة.
ما حدث خلال حياة سقراط هو أن إسبرطة هزمت أثينا، وتلت تلك الحرب فترة انهيار للثقافة الإغريقية، وفترة شكّ كبير، وخيبة أمل أصابت سكّان أثينا. علماً بأن ارْتخاء الظروف السياسية والعسكرية لم يكن هو الذي سبَّب تلك المتاعب لمجتمع أثينا فقط، ولكن المأزق الذي ظهر بين المفكِّرين الكبيرين – قبل سقراط – بارمنيدس (504 - 470 ق.م) وهيراقليطس (535 - 475 ق.م) أيضاً. إلى ذلك، كان عديد الناس العاديين يُردّدون التساؤل الآتي: ماذا عن ذلك المسعى إلى البحث حول «الحقيقة» السامية، أو الواقع الأساس؟ إن هذا الأمر كان يبدو لأكثرية الناس مثل مُهمّة لا يمكن إنجازها، وهنا يمكن الاتِّفاق مع جماعة المُشكِّكين على أن «الحقيقة» تتخطّى قُدرتنا على اكتشافها. لقد كان كبار المفكّرين من أمثال بارمنيدس وهيراقليطس يُفكّران بهذه الطريقة أيضاً، لكنهما فشلا في الاتفاق حول عدد من المسائل الصَّميمة، فكيف يمكن لنا – الناس – أن نتوقّع وَعي كل تلك المسائل الميتافيزيقية المُعقّدة؟!
إذاً، ما جرى مع تدهور القوة العسكرية والاقتصادية، وضعف السّطوة السياسية في أثينا المُقترن بالشعور بهذا الإحباط الناتج عن محاولة معرفة «الحقيقة» السامية هو أن الثقافة تفَككَت نوعاً ما، ونمت داخلياً في اهتماماتها، وبدأت تُركّز تفكيرها على هذه الدنيا وعلى الشؤون العملية المعيشة، فإذا لم يكن في استطاعة الناس فهم مسائل «الحقيقة»، فإنهم لايزالون يُواجهون الشؤون اليومية المتعلّقة بكيفية كسب عَيشهم، وطريقة مواجهة الحاجات المُلحّة التي تفرضها عليهم دنياهم.
وهنا، يمكن أن نرصد بدايات ولادة الحقبة أو «الحركة الإنسانية» القديمة، ولاسيما مع ظهور خيبة أمل إزاء ديانة الشعب الإغريقي، وذلك لأن آلهتهم القديمة خذلتهم. إذن، يمكن القول إن أثينا شرعت بمرحلة من «العَلمانية» ما قبل سقراط.
الجماعة السّفسطائية
في ضوء ما تقدَّم، واستغلالاً للفراغ الناتج عن انحطاط الحضارة الإغريقية اقتحمت الساحة مجموعة من «المُعلمين المُحترفين» الذين أصبحوا محوريِّين جداً أُطلق عليهم «السفسطائيون Sophists»؛ وهي تسمية مشتقَّة من الكلمة اليونانية «صوفيا Sophia» وتعني الحِكمة. كان «السفسطائيون» يعتبرون أنفسهم - طبقاً للكلمة - حُكماء، وفي بداية حركتهم كانت مساعيهم تلقى نوعاً من التقدير والاحترام والاهتمام، فلقد كانوا معلِّمين مُحترفين؛ أي إنهم كانوا يفرضون رسوماً مالية على تعليمهم، كما أنهم معلِّمون متجوّلون؛ أي كانوا يتنقّلون من قرية إلى أخرى، ومن مدينة إلى ثانية ليعطوا دروسهم وتعاليمهم، غير أن ما حدث في البنية الأساس لأثينا ترافق معه «فساد» الجماعة السفسطائية.
كانت الجماعة قد اتّخذت المنحى «الديمقراطي» شيئاً فشيئاً، ولما لم يكن القادة ملوكاً قاموا بنقل سلطتهم إلى سُلالتهم أو إلى النبلاء، فقد كانوا يبرزون أكثر فأكثر نتيجة الانتخابات الشعبية. كذلك، حدثت تغيّرات مهمة في النظام القضائي لأثينا – حينذاك – مع تطوّر نظام «هيئة المُحلّفين» التي تضطلع بالتصويت للحُكم على المتهم. غير أن ثقافة جديدة قد برزت يحتلّ فيها «فنّ الخطابة» مرتبة عالية، لأن الأشخاص الأكثر بروزاً/وضوحاً في الكلام، والأكثر إقناعاً أيضاً، من الذين يستطيعون أن يُحرّكوا مشاعر الشعب وعواطفه يتمتّعون بأفضلِ فرصة لينالوا أصوات المواطنين في الانتخابات، ومن ثم ليصبحوا حُكّاماً للشعب. كما أن المُحامين القادرين على أن يُحرّكوا مشاعر أعضاء «هيئة المحلفين» يتمتّعون أيضاً بالقدرة على إقناع هذه الهيئة بإصدار الحُكم الذي يُريدونه. هذه الأمور كلها – وربما أكثر – شكّلت جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات الغربية والعربية أيضاً التي نجد أنفسنا فيها راهناً.
بالنسبة إليهم كان السفسطائيون - في تعليمهم - يهتمّون بالمسائل النفعيّة (البراغماتية)؛ فلا يتمّ تحديد «الحقيقة» على أساس تطابق غيبيّ، أو مُطلق مع الواقع المعيش، بل يتمّ تحديدها – أي «الحقيقة» – على أساس ما يتم من الناحية النفعيّة في السوق التجارية - مثالاً- حيث نعيش. لقد كان السفسطائيون أول من عمل في صناعة الدعاية والإعلان – إذا جاز
التعبير – واختبارهم لفعالية إعلاناتهم لم يكن مبنيّاً على أساس أن المطالبة بالمُنتَج حقيقية، وإنما أساسها مدى فعاليتهم في دَفع الناس إلى شراء المُنتَج. إذاً، لم تكن «الحقيقة» تهمّهم، بل كان الإقناع هدفهم، والأهم – ربما – هو أن المدرسة التي طوَّروها، وهي مدرسة «البلاغة Rhetoric» لانزال نرصد حضورها في ثقافتنا المعاصرة، بل نُعرِّفها بأنها «فن الخطابة»، لكن بالنسبة إلى السفسطائيين كانت براعة الخطابة تعتمد على قدرة المُتكلّم على تحريك مشاعر السامع لكي يُقنعه بأمرٍ ما.
في وقتنا الراهن، لايزال الناس مهتمّين بالإقناع، فكلّ متحدّث - أياً كان منصبه أو مستواه - يهدف إلى سَبْي أفكار الطرف الآخر، وإقناعه بصحّة مبادئه وآرائه. غير أن ما جرى مع السفسطائيين هو أن تركيزهم الكامل في الإقناع كان لغايات نفعيّة صِرْفة. فعلى سبيل العَيِّنة يمكن أن أذكر ديموستيني (384 - 322 ق.م) الخطيب الشهير الذي كان يتمرّن على خطبه عبر ملء فمه بالحَصى لكي يُدرّب شفتيه ولسانه على التكلّم بأقصى وُضوح أثناء تركيب الجُملة. كذلك، نرصد ظهور فيلسوف مهم جداً في مرحلة ما قبل سقراط يُدعى بروتاغوراس (490 - 420 ق.م) الذي يُعتبر رأس الحقبة/الحركة الإنسانية، لأنه مَنَحنا العبارة اللاتينية الشهيرة «Homo Mensura» أي «الإنسان المقياس»، وهو يقصد بذلك أن «الإنسان مقياس كلّ الأشياء»، داعياً إلى تركيز اهتمام الناس ليس على مكان خياليّ خلال التأمّل الفلسفي في الماورائيات، بل ترسيخ وعْينا على رَفاه البشر.
وثمة فيلسوف آخر مهم أيضاً في تلك المرحلة وهو رجل يُدعى غورجياس
(487 - 380 ق.م)، وتنبع أهميته من كونه أول أعضاء جماعة «المُشكّكين». ومما يُذكر عنه قوله: إن الصَّالِح - أي ما هو صائِب - هو ما يُدرك الناس أنه يعمل لمصلحتهم. بعبارة ثانية، إن الصالح أو الصائِب يتم تحديده من حيث هو ما يُحسِّن عملك الخاص ومصالحك الشخصية.
إن الحديث عن «النِّسْبية Relativisme» يُفيد بأنه لا يوجد صالح مُطلق، كما لا يوجد صواب أو خطأ مُطلق يتعلّق بكيفية تصوّرك له، أو كيف تُفضّل أن يكون. وبعبارة أخرى أوضح «لا وجود لحقيقةٍ مُطلقة وعالمية. إنّ معارفنا وقِيمنا وأذواقنا هي نتيجة وجهة نظر خاصّة بنا». إن أطروحة «النسبية» تعود جذورها إلى أعماق تاريخ الوَعي الغربي، وتحديداً مع الفلسفة «الشُّكوكيّة Skepticism» لأفراد مثل غورجياس.
الحاجة إلى «الفضيلة»
في هذا المكان، وفي هذه البيئة والظروف خَطا سقراط خطواته، فقد كان قلقاً جداً من أن يكون ما يدور من حوله مُهْلكاً للعلم وللسعي وراء «الحقيقة» من جانب، ولهَيْبة النظام القضائي وللبِنية السياسية بحدّ ذاتها من جانب ثان، وفي الصّميم من مَخاوفه هذه كان ما اعتبره سقراط خسارة كاملة لـ «الفضيلة Virtue» من جانب أخير. إنه لم يرضَ بتقبّل ذلك على أنه مصير أثينا الحَتْمي، فأخذ يجول في أثينا داعياً الطلاب والناس عموماً إلى محادثات عَميقة محاولاً إيقاظهم على مسائل أعْمق مُتعلّقة بـ «الحقيقة»، وبالشؤون الجليلة التي تواجه الإنسانية في عصره.
لقد قرّر سقراط العزوف عن الاكتفاء بفَحْص حياته الخاصة، وأراد حثّ الآخرين على البدء بالاعتراض على افتراضات ثقافتهم؛ عاداتهم وتقاليدهم، ومن ثم الشُّروع الواعي في فَحْص أفكارهم ومواقفهم الشخصية. ومن هنا اشتُهر سقراط بأمور عدة ليس أقلّها ابتكاره لما يُطلق عليه «المنهج السُّقراطي» أو طريقة سقراط لاكتشاف الحقيقة؛ وهي طريقة الحوار عبر المُساءلة الدَّؤوبة، فقد كان يدخل في حوار مع الناس ويطرح عليهم أسئلة «تَحْقيق» (اسْتِجواب)، ومتى ما قام أحدهم بإعطاء جواب كان سقراط يُساعده على المُضي قُدماً في الفَحْص الذاتي الحُر عبر طَرح مزيد من الأسئلة الأكثر عُمقاً. بعبارة ثانية قد تقولُ أكثر، لم يقف سقراط في مُنتصف ساحة مدينته لكي يَعِظْ، أو ليُلقي محاضرات، لقد كان يُشبه – بمعنى ما – «المُلازم كولومبو COLUMBO» فكان يقول: هل تُمانع إنْ طرحتُ عليك سؤالاً شخصياً؟ ثم يَلِج في الحوار مع شتى الناس. ها هنا، يمكن أن نلحظ قِيمة ذلك «المنهج» التعليمي عندما نرصد تلك المجموعة الواسعة من الكتابات بقلم أشهر تلاميذ سقراط على الإطلاق وهو أفلاطون. وقد ناقش عدد من الكُتّاب والشُّراح كتابات أفلاطون وتساءلوا عن الاسم الذي يمكن أن يُطلقوه على هذه الطريقة في عرض أفكاره، فتوصلوا إلى أنها حوارات أو «محاورات» أفلاطون. وتقوم طريقة أفلاطون في المحاورات على وجود مسألة يتمّ تقديمها في بداية الحوار، ثم تدور مناقشات بين مُمثّلي مدارس الفكر المُتباينة، ثم يتدخَّل سقراط في الحوار ويكشف لغز أيّ مسألة يُناقشونها.
النموذج الأصلي للتعليم
إذاً، ظنّ سقراط أنه عبر حَثّ الناس على التفكير سوف يتمكَّن من نَقْلِهم من مستوى التفكير السفسطائي النَّفعي/السَّطحي، إلى مستوى أرفع يجعلهم يُدقِّقون النّظر في مسألة «الحقيقة». لقد كان سقراط يمثّل ما يمكن أن يُسمّى النموذج الأصلي للتعليم، حيث كان التعليم هو هدفه الوحيد. علماً بأن المعنى الاشتقاقي لكلمة «يُعلّم» تعني حَرفياً «الإخْراج من..»، فهو كان يُعلّم للإخْراج من..، ولكن السؤال: الإخْراج من ماذا؟ إنه الإخْراجُ من «الجَهل». ومما يُنسب إلى سقراط في هذا الصدد، ما ذُكر من أن أول أمر ينبغي أن يحدث لاكتساب أيّ معرفة «حقيقية»، ولكي يصبح أحدهم حَسَن الاطِّلاع، وليكتسب فَهْماً للفضيلة، ويكون مُتعلماً حقّاً أيضاً، هو الاعتراف بالجَهل. ومن المعلوم أن الجَهل هو أحد أكثر الأمور التي يصعب على أيّ منّا الاعتراف بها؛ أي جَهلنا بأمر ما. لكن سقراط قرّر أنه ما إنْ يعترف أحدهم بجَهله، عندئذ، يصبح من الممكن إخْراجه مما هو فيه، وقيادته إلى اكتساب فَهْم أعْمق للحقيقة.
وهناك شيء آخر مهم أيضاً، ذلك أن «هَمّ» سقراط الأول كان التوصّل إلى فَهْم «الفضيلة» وهي معرفة ما هو صالح أو صائِب، علماً بأنّ سقراط لم يعتقد بذلك بطريقة نظرية فقط، بل بأسلوب ملموس جداً أيضاً. فقد كان يعتقد أن طريقة تصرّفنا أو سلوكنا تتوقّف في المقام الأول على المعرفة الصَّحيحة. لقد كان يُردّد أنّ جزءاً من المشكلة التي نواجهها في سلوكنا هو أننا لا نعرف ما السلوك الصحيح، وقبل أن نتمكّن من التصرّف بطريقة صائبة علينا أن نفهم أولاً ماهية الصورة الجيدة للسلوك. لذا ركّز سقراط على مساعدة الآخرين على إدراك ماهيّة الفضيلة، ومن مثال ذلك: ما الأمانة؟ ما المُثابرة؟ ما العدالة؟ وقد كان يدفع الناس إلى تجاوز فكرة المصالح أو المنافع الشخصية ليتوصّلوا إلى فهم أعْمق لهذه الأسئلة/المفاهيم التي بموجبها تنجح أو تفشل الحياة البشرية والفضيلة الإنسانية.
غير أن أحداً قد ينظر إلى سقراط، ويقول: إن حياته كانت فاشلة، فقد حُكم عليه بالإعدام بشرب السم في سنة (399 ق.م)، لقد وُجِّهت إليه ثلاث تُهم، تقدَّم بها إلى القضاء ثلاثة من أعدائه، هم: «مليتس» و«لِيكون» و«أنيتس». أما التُّهم، فهي: أولاً، إنكار الآلهة. ثانياً، الدّعوة إلى آلهة جديدة. ثالثاً، إفْساد الشباب الذي فُتن به والْتَفّ حوله الْتِفافاً شديداً مأخوذاً بسِحْر حواره وقوله. لكن القادم من الوقت أثبت للجميع بُطْلان هذه التُّهم المُفْتَراة، فسُقراط كان ولايزال في أذهان كثير من الناس مِثالاً أعلى للأخلاق الماجِدَة، وللفضيلة الخَيِّرة، وللإيمان المُخْلِص. فبعد نحو من 2500 سنة على إدانته الجائرة، أعادت مدينة أثينا في اليونان مُحاكمة الفيلسوف العظيم وأتى الحُكم بالبَراءة. وتفصيل هذا النبأ تناقلته وكالات الأنباء العالمية، فقد احتضن بيت الأدب والفنون التابع لمؤسسة «أوناسيس» بتاريخ 25 مايو 2012 إعادة محاكمة سقراط، ورغم تعادل أصوات عشرة من كبار القُضاة المتميّزين في أوربا وأمريكا، خمسة ضدّ حُكم الإعدام وخمسة معه، فلم يصدر الحُكم بإدانة سُقراط، إلا أن الحماسة لفيلسوف أثينا كانت أوضح وسط الحضور، حيث صوَّت 584 لمصلحة بَراءته، قُبالة 281 صوّتوا لمصلحة إدانته.
ولابــــدّ مــــــن الإشارة إلــــــى أن التُّهــــــم التي وُجِّهَت لسُقــراط كانــــــت تُهماً واضحة البُطْــــلان – وفـــــــق المُؤرِّخ الإنجليــــــزي البــــــارز آرثـــــــــر آرمسترونغ
(1997 – 1909) A.H. Armstrong بحيث لم تكن سوى غطاء للتَّمْويه على تُهم أخرى لم يكن بالإمكان التصريح بها علناً، ومن هنا «يكمنُ وراء الاتّهام الرّسمي العَداء الأثينيّ القديم للمُثقَّفين، الذين كان يعتبرهم الإنسان العادي مسؤولين على نحو ما عن الكوارث والمَصائب التي حلّت بالمدينة. إذاً، فقد كان هناك اسْتِياء من الشخصيات البارِزة ممّن أظهر منهج سُقراط في البحث والتساؤل مدى فراغهم، ولذلك اعتبروه ذا أثرٍ تَخْريبي» ■

