التمثيل الشعري
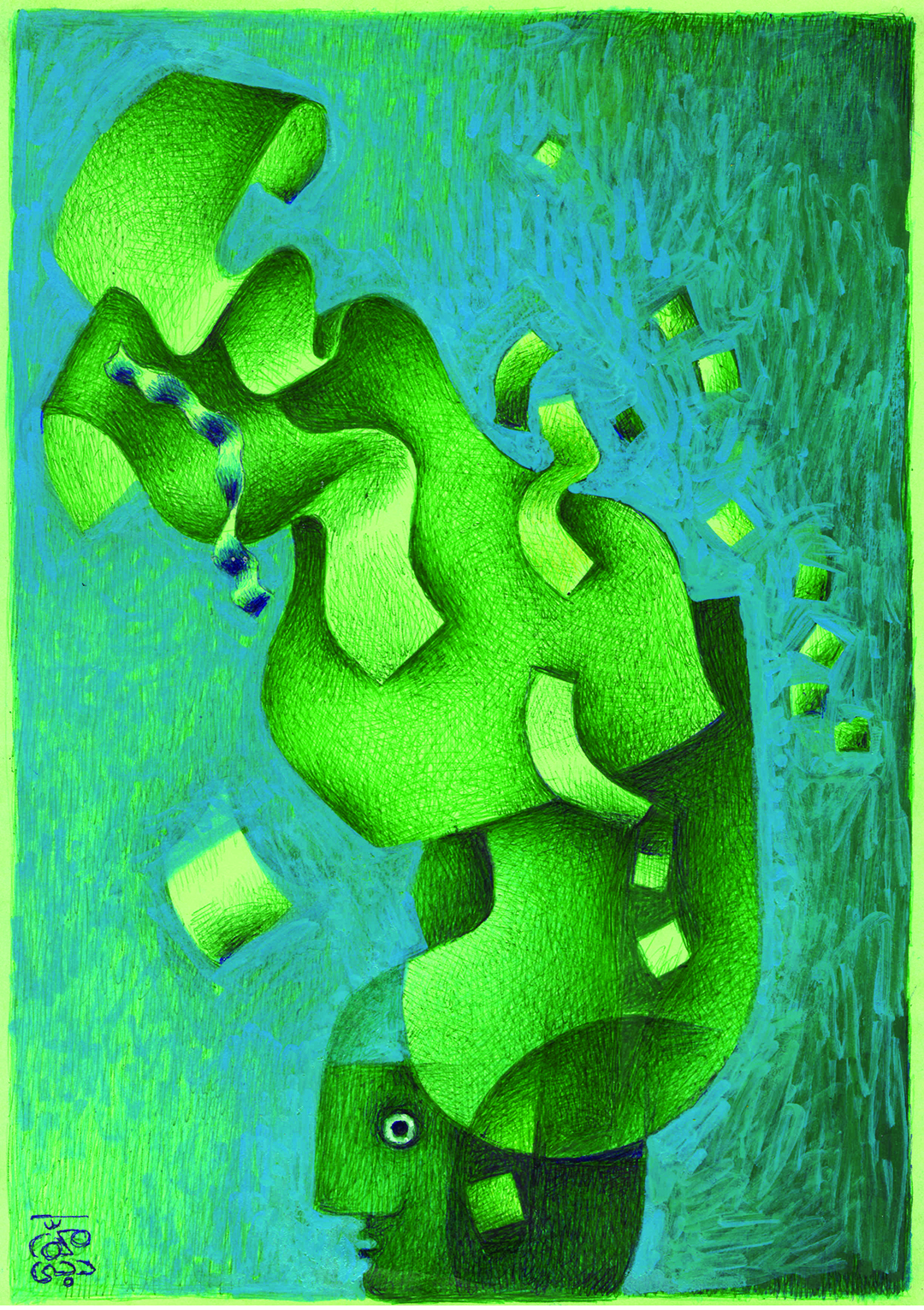
يقع التمثيل في البلاغة العربية القديمة مـا بين التشبيه والاستعارة في البيان، ولذلك عرّفه قدامة بن جعفر في كتابه «نقد الشعر» بأنه إرادة الشاعر لمعنى، فيضع كلاماً يدل على معنى آخر، وذلك المعنى الآخر منبئ عما أراد أن يشير إليه. ولذلك وصل أبو هلال العسكري والباقلاني وابن رشيق التمثيل بالاستعارة، وجعلوه ضرباً منها، بينما اقترن التمثيل عند عبدالقاهر الجرجاني والسكاكي والقزويني وغيرهم بما أسموه «التشبيه التمثيلي». والمسافة بين التشبيه والاستعارة ليست كبيرة، فالأصل في الاستعارة التشبيه الذي يؤدي معنى المماثلة بدوره، وذلك لا يبعد كثيراً عن معنى المثل أو ضرب المثل. ويقترن الأخير، في القرآن الكريم، بحكاية مجازية أو حقيقية، يرويها النص القرآني تدليلاً على معنى أو معانٍ مقصودة.
في هذا السياق يقع الاستدلال بالمحسوس على غير المحسوس، أو التمثيل بالمعروف على غير المعروف، كما ورد في القرآن الكريم في سورة «يس» على سبيل المثال: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17)} (يس 13-17).
وقد استخدم الشعراء التمثيل كما استخدمه القرآن الكريم، لكنهم تفننوا في استخدامه على نحو يستحق دراسة مستقلة. وأظن أن الشاعر صلاح عبدالصبور بمعرفته العميقة بالتراث الشعري كان واعياً بهذا الميراث البلاغي، كما كان واعياً بما كتبه الشاعر البريطاني الأمريكي الأصل ت. إس. إليوت عن التقاليد والموهبة الفنية، لذلك لجأ إلى استخدام التمثيل الشعري في كتابته الشعرية، وأتوقف منها عند نموذج لاستخدام التمثيل الشعري في الشعر الحديث أو الحداثي بلا فارق كبير، والقصيدة بعنوان «رسالة إلى سيدة
طيبة».
القصيدة تبدأ بثلاث حكايات، هي أمثولات أو أمثال تُضرب لأغراض يمكن الاقتراب منها بعد قراءة الحكايات الثلاث التي تتتابع على النحو التالي:
في يوم كانت وردة
تغفو في كم الليل
الشمس رعتها
حتى دبَّت فيها الروح
والشمس،
الشمس أماتتها
وقداً وتباريح
...
في يوم حَلّق طائر
ألقاه الحظ العاثر
في حب الآفاق الممتدة
فمضى يصاعد منطلقاً
هبت ريحٌ ألقته للسفح
وهوى في جوف الآفاق الممتدة
ورعاه السفح فلمَّ عظامه
حتى دبَّت فيه الروح
لكن هل يأمن حضنَ الريح
طير مقصوصُ الريش جريح
حتى والريح رخيّة
...
في ليلة صيف
وقع أحد الشعراء البسطاء
أنغاماً ساذجة خضراء
ليناجي قلب الإلف
لكن كفَّا معشوقته قد مزّقتا أوتاره
صارت أنغام الشاعر خرساء
فإذا نطقت صارت سوداوية
وإذا أعدنا قراءة الحكايات الثلاث في تأنٍ وجدنا أن النص نفسه يلفتنا إلى تشابهات تجمع الحكايات الثلاث، فكل حكاية تبدأ بشبه جملة، جار ومجرور على وجه التحديد: في يوم كانت وردة، في يوم حلَّق طائر، في ليلة صيف. وثانياً: تشير كل حكاية إلى ما يرمز لعنصر من عناصر الكون، فتشير الوردة إلى عالم النبات، والطائر إلى عالم الحيوان، والشاعر إلى عالم الإنسان. وكل حكاية تشبه غيرها بنائياً، فالقوة التي تمنح الموجب هي نفسها التي تمنح السالب. بعبارة أخرى الشمس الرقيقة الصباحية التي تفتحت بها براعم الوردة، هي نفسها التي أحرقت الوردة في وقدة الظهيرة. والريح الرخية اللينة التي أغرت الطائر بالطيران، وأغوته بحب الآفاق الممتدة، هي نفسها التي تحوَّلت إلى ريح عاصفة عاتية، لم يقوَ على مواجهتها وتحمُّلها جناحا الطائر فانكسرا، وهوى الطائر إلى السفح الذي رعاه، إلى أن عادت إلى الجناحين القوة، لكن من الصعب أن يغامر الطائر مرة أخرى، ويترك نفسه لغواية الريح حتى ولو كانت الريح رخية. أما الحكاية الأخيرة فهي عن الإنسان، ولكن مرموزاً إليه في هذا السياق بمجاز مرسل، يتخذ صورة شاعر بسيط بريء، تفتنه امرأة تغويه في ليلة صيف، كما أغوت الريح الطائر وأوقعته في حب الآفاق الممتدة، فيقع الشاعر البريء في حب المرأة الغاوية، ويعزف لها على أوتار قصائد جميلة من الحب، لكن الحبيبة غادرة كالريح، متحولة كالشمس، فتنقلب الأشياء، وتتغير أغنية الشاعر، وتتحول إلى أغنية حزينة الإيقاع، سوداوية المزاج. ويمكن للمرء ملاحظة أن حكاية الطائر كحكاية المغني تنتهي، إيقاعياً، بقافية تتماثل في الحكايتين: والريح رخية. سوداوية.
والتكرار لافت للانتباه في الحكايات الثلاث التي هي حكاية واحدة، لكنها جاءت عبر تنويعات ثلاثة إلى مدلول يتصل بكونية الدلالة ووجودية المغزى. ورغم أن الوزن العروضي واحد، لكن التنويع المضاف إليه التكرار والتلاعب بأحرف المد واللين يتموج بالإيقاع النغمي. فيحاكي المبنى الإيقاعي الدلالات والمدلولات الخاصة بتعاقب الكلمات. المهم أنه بعد أن تنتهي الحكايات الثلاث، يأتي صلاح عبدالصبور بما يكمل القصيدة، ويكون بمنزلة تنوير على المعنى الكلي، فنقرأ:
يا سيدتي، عذراً
فأنا أتكلم بالأمثال لأن الألفاظ العريانة
هي أقسى من أن تلقيها شفتان
لكن الألفاظ الملتفة في الأسمال
كشفت جسد الواقع
وبدت كالصدق العريان
أشقى ما مر بقلبي أن الأيام الجهمة
سلبته موهبة الحب
وأنا لا أعرف كيف أحبك
وبأضلاعي، هذا القلب
وواضح أن الشاعر في المقطعين الأخيرين من القصيدة يشرح ما غمض، قائلاً بصريح العبارة: إنه يتحدث بالأمثال، وإن كل حكاية من الحكايات الثلاث التي حكاها هي «مَثَل»، والحكايات كلها «أمثال». ولكن لماذا لجأ إلى المجاز أو المثل ولم يكتب الحقيقة عارية؟ أولاً: لأن الحقيقة العارية التي يقصد إليها مخيفة، غير مفرحة، صادمة، هي أقسى من أن تلقيها شفتان، لكن الإيماء إلى هذه الحقيقة بالأمثال يقربها من الأذهان، ويجعلها مفهومة من كل العقول، خصوصاً إذا كانت هذه الحقيقة متعالية خاصة بسر من أسرار الوجود والكون، أو متعلقة بالقوة التي تقف وراء الكون والكائنات: تتحكم في حركتهم، وتحدد مصائرهم. وهذا مجال ينتقل بنا من الطبيعة إلى ما وراء الطبيعة، أو من الفيزيقا إلى الميتافيزيقا، من العالم الذي نراه ونلمسه إلى ما وراء هذا العالم، حيث الوجود الكلي المجرد للمطلق أو القوة الخالقة والمحركة لكل الكون والكائنات. هذه القوة ليس لنا نحن- البشر الفانين- علم بما تخططه لنا، أو بما رسمته من مصائر. كل ما نعلمه أنها القوة التي تمنح الحياة أو تسلب الحياة. ولكن كيف ولمَ؟. هذه أسئلة ليس من ورائها سوى الحزن الذي نعرفه، خصوصاً حين ندرك جهامة القوة التي تغلق أمامنا الأبواب إلى الحب. وعندما ينشغل القلب بالهموم الكونية على هذا النحو فإن السعادة تفارقه، ويهرب الحب من بين أضلاعه، حيث القلب الذي يستبدل حزن الوعي الميتافيزيقي بفرحة الجسد الفيزيقي المحسوس.
يمكن طبعاً تفسير القصيدة تفسيراً اجتماعياً سياسياً بدل هذا التفسير الميتافيزيقي، فنقول إن القوة التي تمنح قوة الحضور في العالم هي نفسها القوة الباطشة وهي السلطة بمعناها السياسي والاجتماعي، فهذه السلطة تحقق للإنسان الأمن والأمان والحياة البهيجة، إذا حكمت الناس بالعدل، واحترمت كرامتهم وحقهم في الاختلاف، وعندما تذوب السلطة فيحكم الناس أنفسهم بأنفسهم عبر نظام برلماني قائم على الفصل بين السلطات. عندئذ تتبرعم الزهور، ويشرق الورد، ويغدو الإنسان حراً كالطير الذي يقع في حب الآفاق الممتدة، غير خائف من هوج الرياح. لكن أي التفسيرين أقرب إلى القصيدة؟ الأمر متروك للقارئ كي يمارس حريته في الاختيار. أما عني؟ فأنا أقرب إلى تقبُّل التفسير الميتافيزيقي بحكم معرفتي بشعر صلاح عبدالصبور وثقافاته والهموم الوجودية التي كانت تؤرقه ويجسدها شعره في آن.
لقد سبق لي أن أشرت إلى تأثر صلاح عبدالصبور العميق بشعر ت. إس. إليوت. وفي اعتقادي أن إليوت هو الذي قاد صلاح إلى الإعجاب مثله بالشعراء الميتافيزيقيين في الشعر الإنجليزي. والشعراء الميتافيزيقيون هم مجموعة من الشعراء الإنجليز في القرن السابع عشر، اشتركوا في الاهتمام بالقضايا الميتافيزيقية وبالأساليب الخاصة بمعالجتها، يمتاز أسلوبهم بالعقلانية في المعالجة والصيغ غير المألوفة في التشبيه والمجاز، كما في تشبيه أندرو مارﭬيل للروح بقطرة ندى، وقد تأثروا بالحركة الأفلاطونية كما فعل جون دن (1572-1631). والحق أن عنوان قصيدة صلاح عبدالصبور «رسالة إلى سيدة طيبة» يذكِّرني بقصيدة أندرو مارﭬيل (1621-1678) «إلى سيدته الخجول» to his coy mistress. وهي رسالة تتحدث عن الزمن ووطأته، وعربة الموت المجنحة التي تصلصل أجراسها وراءنا، كي ندرك أننا مطاردون في زمن يخاتلنا فيه الموت، ولذا لا يبقى أمامنا سوى أن نعب من اللذة بقدر ما نستطيع، قبل أن يدركنا الموت مسرع الخطو.
صحيح أن موضوع قصيدة أندرو مارﭬيل في القرن السابع عشر مختلف عن الهم الذي يثقل قصيدة صلاح عبدالصبور، ولكن ميتافيزيقية الهم واحدة، وأسئلة المصير ملحة على القصيدة، وهو الأمر الذي يجعلني أجزم بتأثر صلاح بقصيدة مارﭬيل، في دائرة تأثره بالشعر الإنجليزي بوجه عام، وتأثره بما كان يؤثره إليوت في تراثه بوجه خاص. وهذا هو السر في التجريد الذي تتميز به قصيدة صلاح عبدالصبور، والتنكير الذي نراه في العنوان.
أعني أن «رسالة إلى سيدة طيبة» هو عنوان عام، يمكن أن يتجه إلى أي سيدة. والصفة (طيبة) تؤمي إلى البراءة وعدم المعرفة بالأسرار الميتافيزيقية التي تتكشف في نهاية القصيدة، أو لحظة تنويرها. أما عنوان قصيدة مارﭬيل «إلى سيدته الخجول» والذي يحتمل معنى «إلى عشيقته الخجول» فهو عنوان ينبئ عن ما بعده من محاولة إزالة الخجل للدخول إلى عالم اللذة، والقصيدة في مجملها، خصوصاً في إلحاحها على قصر الزمن، إغواء للسيدة الخجول بمفارقة خجلها. أما قصيدة صلاح عبدالصبور، فالأمر مختلف لأنها قصيدة معرفية، تسعى إلى تعريف كل السذج الأبرياء، حسني الطوية، بما لا يعرفونه عن الوجود الذي يحتويهم، الذي لا يعرفون فيه إلا ما يقع في دائرة حواسهم، أما ما بعد هذا الوجود فلم يسبق لهم التفكير، لأنهم لم يعتادوا على ذلك. ولذلك فهي قصيدة إلى كل سيدة وكل رجل يقنع بما قسم له، ولا يشغل باله بما هو أبعد من ذلك، فالطيبة تقرن بين البراءة والسذاجة بهذا المعنى.
ويتبع ذلك العلاقة بالتراث، فالقصيدة تنطوي في أسطرها، خصوصاً الأخيرة، على نزعة أبيقورية، نجدها في رباعيات الخيام. أما في قصيدة صلاح عبدالصبور فالأمر مختلف، لأن قصيدته تفيد من فكرة إليوت عن التراث والموهبة الفردية، فهو يستوعب تراثه الإبداعي، ويأخذ منه فكرة التمثيل، لكنه يضيف إلى هذا التراث وعيه بالتراث الإنساني الذي يحتوي شعر إليوت، ويكتب في موازاته قصيدة تمثيل شعري، أراها فريدة في نوعها، ثرية في أبعادها، رمزية في تقنيتها، كما أنها نموذج واضح على صياغة إليوت للعلاقة بين التراث والموهبة الفردية، ولكن من منظور صلاح عبد
الصبور .

