حسام محيي الدين الآلوسي... وسؤال الفلسفة
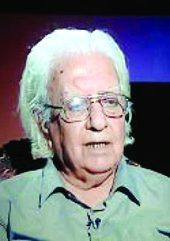
شهدت الأعوام الماضية رحيل علماء عرب كبار في ميادين علمية عدة، شكّلت أطروحاتهم الفكرية/النقدية حول الاجتماع والدين والثقافة أرضية معرفية تحتاج قراءتها إلى فعل تأسيس.
في مرمى التحولات الكبرى التي يمر بها العالم العربي، وعلى غفلة من الذاكرة الجمعية العربية المثقلة بهواجس الماضي وتناسي النتاج الفكري لمبدعينا، أتت وفاة الفيلسوف العراقي حسام محيي الدين الآلوسي (1936-2013)، الذي قدم للمكتبة العربية مؤلفات فلسفية مهمة، لتطرح سؤالين إشكاليين: كيف يمكن سد الفراغ المعرفي إثر غياب الجيل المؤسس؟ وما الدور الذي يجب أن تضطلع به الفلسفة أم العلوم في تفسير وتحليل وتفكيك ومقاربة أزمات مجتمعاتنا ماضيًا وحاضرًا؟
ليس الآلوسي، شيخ الفلسفة في العراق المعاصر، وأحد أساطين فلاسفة الجيل الثالث في بلاد الرافدين، كما يصفه معاصروه، عالمًا عاديًا، بل هو صاحب مدرسة ومنهج فلسفي. أعماله على كثافتها لم تقتصر على الفلسفة، فكان له إبداعه محققًا وشاعرًا.
يمثل هذا الفيلسوف العتيق القادم من جرحنا الوجودي في أزمنة القلق والانزياحات الكبرى بقعة ضوء تضيء عتمة الطريق في ظل تهافت المتفيهقين ودعاة التفلسف. هل يمكن أن تلخص هذه المقالة سيرة فيلسوفنا الحياتية والعلمية لا نجرؤ على الادّعاء؟
من رحاب بغداد إلى العالم
دخل الآلوسي قسم الفلسفة في جامعة بغداد في العام 1952 وتخرج في العام 1956. تابع دراسته في بريطانيا وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كامبردج في العام 1965، حيث تخصص في الفلسفة الإسلامية، وكان عنوان أطروحته المهمة التي أشرف عليها المستشرق الألماني - الإنجليزي إرفن روزنتال تحت عنوان (The Problem of Creation in Islamic Thought: Quran, Hadith, Commentaries, and Kalam). وقد طُبعت في بغداد بنصها الإنجليزي في العام 1968 وطواها النسيان على مدار أعوام طويلة، حتى أبصرت النور في اللغة العربية في العام 2008 (را: الآلوسي، حسام الدين... مشكلة الخلق في الفكر الإسلامي: القرآن - الحديث - التفسير - علم التفسير، تعريب باسمة جاسم الشمري، بيت الحكمة، 2008). لم يشأ الآلوسي - كما يؤكد أستاذ الفلسفة وتاريخها في جامعة المستنصرية (العراق) حسن مجيد العبيدي، الذي صادقه وكانت له تجربته الفلسفية معه على مدار ثلاثين عامًا - ترجمتها بنفسه إلى «العربية» لأسباب عدة، من بينها خوفه أن يتهم بتهم شتى من السلطات الفكرية والدينية والسياسية في زمانه. بعد عودته من بريطانيا عمل الآلوسي أستاذًا للفلسفة في جامعات بغداد وليبيا والكويت وصنعاء، وشغل منصب مستشار للعديد من المجلات العلمية.
فيلسوف ومحقق وشاعر
وضع حسام الدين الآلوسي عشرات المؤلفات الفلسفية، وقام بتحقيق النصوص الفلسفية مثل كتاب «الأسرار الخفية في العلوم العقلية»، للعلاّمة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (648 هـ - 726هـ)، وهو عمل مشترك مع الدكتور صالح مهدي الهاشم (ت 2007). وإلى جانب الهم الفلسفي كانت له تجربة شعرية ضمنها في ديوانه «زمن البوح» (بغداد - 2009).
من مؤلفاته في الفلسفة: «حوار بين الفلاسفة والمتكلمين» (1967) «من الميثولوجيا إلى الفلسفة» (1973) «الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم» (1980) «دراسات في الفكر الفلسفي العربي الإسلامي» (1980) «فلسفة الكندي، وآراء القدامى والمحدثين فيه» (1985) «التطور والنسبية في الأخلاق» (1989) «الفلسفة والإنسان» (1990) «الفلسفة اليونانية قبل أرسطو» (1990) «مدخل إلى الفلسفة» (2005) «حول العقل والعقلانية العربية طبيعة ومستقبلاً وتناولاً» (2005) «ابن رشد، دراسة نقدية» (2005) «تقييم العقل العربي ودوره من خلال نقاده ومنتقديه» (2007) «الفن... البعد الثالث لفهم الإنسان» (2008) «في الحرية... مقاربات نظرية وتطبيقية» (2010) «نقد المناهج المعاصرة لدراسة التراث الفلسفي العربي الإسلامي» (2011).
نشر الآلوسي بالإضافة إلى المؤلفات التي ذكرناها مجموعة من الأبحاث في المجلات العلمية العراقية والعربية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: «البنية والعلاقة» (المجلة الفلسفية العربية، الأردن، شتاء 1990) «الفلسفة والعلوم الأخرى» (ضمن كتاب سلسلة المائدة المستديرة، بيت الحكمة، مارس 1998) «الأنسنة عند ابن رشد» (مجلة مقابسات البغدادية، العدد الأول 2005).
لدى فيلسوفنا مخطوطات لم تنشر بعد، وكانت أمنيته، كما يقول صديقه العبيدي «أن يرى أعماله الكاملة منشورة في حياته». من هذه الكتب المخطوطة «موسوعة في الفكر الفلسفي الإسلامي، الكلامي منه والفلسفي حتى ابن رشد»، وتقع هذه الموسوعة في ثلاثة أجزاء كبرى، و«بحوث نقدية على ضوء المنهج التكاملي»، و«مواجهات في فلسفة الوجود والمجتمع والأدب»، و«فلسفة التطور»، و«نظرية التطور».
وقد كُتبت عن الفيلسوف جملة دراسات وأبحاث ورسائل جامعية، منها: أطروحة حسين عبدالزهرة عن التجربة الفلسفية عند حسام محيي الدين الآلوسي (بيت الحكمة، بغداد 2009), وأطروحة صباح حمودي نصيف عن نظرية المعرفة في الفكر العربي المعاصر، خصص فيها فصلاً عن الفيلسوف الآلوسي، وبحث الدكتور علي حسين الجابري عن «أصالة التجربة الفلسفية عند الآلوسي» (المجلة الفلسفية، عمان، الأردن)، وأعيد نشره في مجلة الجمعية الفلسفية المصرية (العدد 9، 2004)، وهذا العدد خصص محورًا من محاوره للحديث عن الفيلسوف ببحثين آخرين، الأول للآلوسي نفسه، يتحدث عن تجربته الفلسفة، والثاني بحث أحمد عبدالحليم عطية، بعنوان «حسام الآلوسي.. الرؤية والمنهج»، وقد أعيد نشر هذا البحث ضمن كتاب تذكاري حمل عنوان «الآلوسي المفكر والإنسان» (بيت الحكمة، بغداد، 2011). (را: العبيدي، حسن مجيد، الفيلسوف العراقي حسام محيي الدين الآلوسي (1936-2013) دراسة في السيرة والمنهج).
في المنهج التكاملي (التاريخي الجدلي) حدد فيلسوفنا منهجه من خلال الخطوات الآتية: أولاً، دراسة المعلومة بحسب منهجية تقوم على ربط النص أو الموضوع بالأساس الاجتماعي والمطروح العلمي والتراكم المعرفي، ثانيًا: الالتفات إلى الكل أو البنية عند دراسة الجزء أو النظرية للشخص أو النص. ثالثًا: الحذر من التعامل الجزيئي، رابعًا: الابتعاد عن الأسلوب الانتقائي من التراث المدروس أو الفكر المدروس، والمقصود هنا ليس الفيلسوف الواحد، بل المنظورات الفلسفية السائدة في زمان ومكان ما، خامسًا: الجدلية، وهذا واضح في سياقات نظرتنا إلى تراثنا الفلسفي الفكري، سادسًا: التكاملية، وبعض عناصرها الاستعانة بكل العلوم، سابعًا: التواصل، ضد الشوفينية مثل أكذوبة المعجزة اليونانية أو المغالاة في عقلنة الفلاسفة اليونان. (حسام الدين الآلوسي، تجربتي الفلسفية، جريدة الأديب، السنة الثانية، العدد 75، 8 يونيو 2005).
عرض الآلوسي منهجه الذي أطلق عليه «المنهج التكاملي: التاريخي الجدلي» بشكل أوسع في كتابه «دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي» (1980) وطبقه على بقية كتبه وأبحاثه، ولاسيما كتبه «الميثولوجيا إلى الفلسفة»، و«حوار بين الفلاسفة والمتكلمين»، و«الزمان في الفكر الديني والفلسفي». ويمكن تحديد ملامح المنهج التكاملي عنده، في أنه يقوم على جملة ضوابط، هي: أن التراث الفلسفي العربي الإسلامي يجب أن ينظر إليه من خلال العلاقات المتبادلة بين الطبقات (الفئات الاجتماعية) ومستوى النضال الطبقي في هذا المجتمع أو ذاك، فضلاً عن النظر في مستوى تطور العلوم، وتحديدًا العلوم الطبيعية، في هذا المجتمع أو ذاك، مع الاهتمام بالتواصل الفلسفي والفكري، أو ما يسمى بالاحتياطي المتراكم من التصورات والمواد الفكرية، مع الأخذ بالاعتبار الخصائص القومية والوطنية للمجتمع. وهذه الضوابط المنهجية بنظر الفيلسوف الآلوسي تعدّ أساسية في كل مجال من مجالات العلوم الإنسانية، فضلاً عن الفلسفة، لأن الفلسفة وفق الآلوسي هي نظرة عن العالم، وهي نظام لأكثر المفاهيم شمولاً عن العالم، ولعلاقة الإنسان بهذا العالم، وتعبِّر عن الفئات والطبقات الاجتماعية المعينة، وهي شكل من أشكال الوعي الاجتماعي، ولذلك فإن مهمة التفكير الفلسفي عند الفيلسوف الآلوسي وفق هذا المنهج ليست معرفة الآراء فقط، ولا رصد الظاهر فقط، بل معرفة الأسباب التي تجعل ظروفًا معينة تلد بالضرورة هذه الأفكار أو تلك الآراء. وذلك بأن نمضي من الواقع إلى الأفكار لا من الأفكار إلى الواقع. أما المرجعيات التي استقى منها الآلوسي ملامح منهجه هذا وحدد منطقه وتطبيقاته على الفكر الفلسفي عمومًا والإسلامي خصوصًا، فهي مؤلفات كيللي وكوفالزون، المادية التاريخية، وكورنفورث، العلم ضد المثالية، ويوفتشول، موجز تاريخ الفلسفة، وبيوري، حرية الفكر، وجون لويسو المدخل إلى الفسلفة، وفرديريك إنغلز، الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية، وغيرها، ما يعني أن الفيلسوف الآلوسي كان قد تبنى مصادر المنهج المادي التاريخي الجدلي الكلاسيكية، مع تطوير قام به بنفسه على هذا المنهج عبر به إلى حقل الفلسفة العربية الإسلامية. (را: العبيدي، حسن مجيد، الفيلسوف العراقي حسام محيي الدين الآلوسي (1936-2013) دراسة في السيرة والمنهج).
لمحات خاطفة من فلسفة الآلوسي
يُعد كتاب الآلوسي «حوار بين الفلاسفة والمتكلمين» أول بداية فلسفية محكمة في اللغة العربية للفيلسوف العراقي، عالج فيه موضوعات الفلسفة الإلهية والميتافيزيقية في واحدة من أعمق المشكلات الفلسفية في تاريخ الفلسفة إلى اليوم، فعرض فيه لآراء الفلاسفة واللاهوتيين، ولاسيما آراء أرسطو والمدرسة الفيضية الإسلامية وموقف المتكلمين من مشكلة الوجود ونقد الغزالي للفلاسفة وردود ابن رشد. (العبيدي، حسن مجيد، شيخ فلاسفة العراق المعاصرين وعميدهم حسام الآلوسي، موقع كتابات، 12 أكتوبر 2013).
اهتمام الآلوسي بالفكر الفلسفي العربي الإسلامي الوسيط، لم يمنعه من النظر في العلم والفلسفة في الغرب، وقد اطلع على أهم النظريات العلمية والفلسفية كالداروينية والمادية الجدلية والتاريخية لدى الماركسيين. آمن عميد فلاسفة العراق بدور الفلسفة في العلم، فـ«الرؤية العلمية الجزئية لا تفيد في تفسير الظاهرة بنيويًا وكليًا... لهذا نجده يصرح بأن رؤية الجزء من الظاهرة فقط لا تفسر حتى هذا الجزء ولا المعرفة به، إن معرفة الجزء إنما تستمد قيمتها من بنية الكل... إذن، لا يمكن أن يكتفي الإنسان برؤية الكون ونفسه والمجتمع بعين العالم فقط، وما يمتلكه من معرفة علمية متخصصة في مجاله، وهنا تظهر الحاجة إلى الفيلسوف ودور الفلسفة في ما ينتجه العلم، وكيف تقدم للعلم المنهج الأمثل للوصول إلى الحقيقة الكلية؟ وذلك لأن العلوم معنية بالجزئيات، وبأشياء مخصوصة، تدرس وقائع محددة، وفق كل علم، بينما رؤية الأشياء بكليتها ومنطقها وأبعادها المعرفية والكونية والقيمية، تكون من مهمات الفلسفة». (الآلوسي، راجح جمال الدين، تكامل الفلسفة والعلم، ملحق جريدة المدى العراقية، 23 أكتوبر 2013).
نادى الآلوسي بالعلاقة التواصلية أو «التواصل الفلسفي» بين الفكرين الإسلامي والغربي التي ضمنها في كتابه «الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم». آمن بمفهوم التقدم «الخطي» للإنسانية، وعارض مقولة المركزية الأوربية، وأن الفكر الإسلامي لم ينطو على فكر فلسفي أصيل، وأن قيمته تتركز في حفظه للفلسفة اليونانية في العصر الوسيط. رأى أن كلا من الفكر الغربي الحديث والفكر المسيحي الوسيط أخذ الكثير من التصورات الفلسفية عن الفلسفة الإسلامية، وخصوصًا في قضية الزمان وأدلة وجود الله وقدم العالم. يقول في مقدمة كتابه المذكور «فكرت طويلاً في هذا التماثل الكامل للفكر القديم حول الزمان، أو بالأحرى مشكلته بقدر ما يتعلق الأمر بتناهيه أو لاتناهيه، وبقدر ما يتعلق الأمر بعلاقة الزمان بالله، وبأهمية رأي وحجة أوغسطين في تصور الزمان التي ستكون مفتاح التصور لكثير من الناظرين في حقيقة الزمان من المحدثين. أقول نظرت وفكرت في هذا التماثل الصارخ، فوجدت أن الهوّة مازالت كبيرة تاريخيًا بين الفكر الفلسفي القديم والوسيط وبين الفكر الحديث منذ ديكارت وليبنتز في ما بعد، وأعني بالضبط، أنه لم توجه عناية كافية لدراسة أثر الفكر الفلسفي الوسيط وعلى الأخص الإسلامي في الفلسفة الحديثة.
قدَّم الآلوسي قراءة نقدية لعدد من أطروحات المفكرين العرب من الذين عاصرهم، بينهم حسن حنفي ومحمد عابد الجابري وصادق جلال العظم وحسين مروة وطيب تيزيني وغيرهم. أخذ على صاحب «النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية» - على سبيل المثال لا الحصر - خروجه من المنهج الماركسي، وقال في إحدى المقابلات التي أجريت معه إن كتاب مروة «فيه مادة لو تعزل الأدلجة والتوفيق يبقى، كتاب جيد من حيث المصادر، والمراجع».
انتقد فيلسوفنا أيضًا أيديولوجيات النهايات، معتبرًا أن التاريخ يتقدم ويتغير ولا يقف عند النظريات التي تبشر بوجود أنموذج واحد، وعلى هذا الأساس رفض نظرية نهاية التاريخ عند فرنسيس فوكوياما التي قصد بها إعلاء النظام الرأسمالي الأمريكي بالذات، وحتى نهاية التاريخ عند هيغل - كما يقول - تتعلق بـ«الدولة البروسية»، «وهذه أدلجة، وليست رؤية علمية، يريدون أن يقولوا ما يخص مذهبًا معينًا، أو دولة معينة أو نظامًا معينًا». (را: موقع الحوار المتمدن، حوار الآلوسي مع سعدون هليل).
سجال العقل
لم تلق أطروحة الآلوسي «مشكلة الخلق في الفكر الإسلامي» الاهتمام الكافي على المستويين الأكاديمي والإعلامي، وقد تناولت فكرة الخلق في القرآن والحديث الشريف والتفاسير ومقارنة الآراء.
ونظرًا لأهمية هذا الكتاب الذي هو في الأساس أطروحة دكتوراه نالها الآلوسي من جامعة كامبردج في العام 1956 كما أشرنا سابقًا، نرى من المهم الإضاءة الموجزة على مضمونها. استعرض فيلسوفنا في الجزء الأول رأي القرآن الكريم في الخلق ومعنى كلمة خلق الواردة في الآيات الكريمة، وبيّن مصطلحات الخلق ومفرداته بكل معانيها الواردة في الكتاب العزيز، وكذلك تقدُّم الله على العالم وفقًا لآراء الفلاسفة والمتكلمين. تناول بعد ذلك صدور العالم عن الله، وطريقة تعامل القرآن الكريم مع مسائل الخلق والعدم، وهل قال القرآن بها أم لا؟ ثم استعرض مملكة الكون وتنزيه الله عن الخلق المادي وخلق الكون بما فيه خلق السماوات السبع والخلق الزماني، لينتهي إلى مجمل الخلق وهو الغاية منه، وخلص بخلاف الأغلبية إلى أن القرآن الكريم يبين أن الله خلق العالم من مادة، وأن ما رآه المتكلمون والمفسرون من أن الله خلق العالم من عدم هو اجتهاد منهم في قراءة النص. وتناول فكرة الخلق في الحديث الشريف، وبدأ بتعريف الحديث لغة واصطلاحًا ومكانته عند المسلمين وبيان أنواعه، ويستعرض مجموعة أحاديث نبوية في الخلق، ومن ذلك نجد عشرة أحاديث تركزت على كيفية وجود الله وحده قبل خلق العالم وخلق الأرض، ليدخل إلى أهم الفصول التي قارنت وقاربت النصوص اليهودية والمسيحية، ويعتبر أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون قد أخذ شيئًا من التوراة، وإن كان هناك تشابه كبير، لأن القرآن والتوراة منزلان من عند الله، فلا يعجز الله أن ينزل كتابًا على رسوله الذي اصطفاه. في الجزء الثاني تناول المؤلف الخلق من العدم، وفيه رأي المعتزلة كاملاً حول مسألة الخلق من العدم، موضحًا أن المعتزلة مخلصون للخلق من عدم، والتوحيد، بخلاف جميع الباحثين، قدامى ومحدثين، الذين اتهموهم بالقول بقدم العالم. كما حلل مسألة صفة الإرادة والفاعل، والتأكيد هنا أيضًا على المعتزلة مقارنة بالأشاعرة، كما أخذ بمدارس الكلام في خلق العالم، وهي مدرسة الخلق المستمر عند المعتزلة ومدرسة الخلق المتجدد عند الأشاعرة، متحققًا من إشكالية: هل الخلق دفعة واحدة أم بتدرج؟ إلى أن قارب الأدلة الكلامية التي قدمها المتكلمون حول إثبات وجود الله تعالى وقِدم العالم وحدوثه وقدم المادة وغيرها من الأدلة التي تصب في الفكر الإسلامي. (را: الآلوسي، حسام محيي الدين، مشكلة الخلق في الفكر الإسلامي، ص21 وما بعدها).
الفلسفة شعرًا: الغربة... الوطن... الموت
في ديوانه «زمن البوح» وهو قصائد بدأ في كتابتها منذ الخمسينيات، يكشف لنا الآلوسي عن شعرية فلسفية وتجربة حياة ومعاناة وطن ووجدانيات. كتب في ديوانه يقول: «إنني في شعري، أعبِّر عن نفسي، بشكل مباشر وواضح وأكثر شفافية... وهذه القصائد التي أقدم لها، تعبّر عنّي منذ صباي، وإلى الآن، وجدانيًا وفكريًا، وفي كل منحى وناحية، من الفكر والشعور والعاطفة والموقف، نعم الموقف... وهنا أحب أن أسجل لقضية تطبع شعري وقصائدي، هي أنها حتى عندما تعبّر عن موقف وجداني وانفعالي عاطفي عن الطبيعة أو الوطن أو الأهل، فإن الموقف أو الفكر أو المعاناة الفكرية، تبقى واضحة بيّنة، تتوسع أحيانًا، بحيث تكاد تقضي على براءة الشعر، وطفولته، ومباشرته وانفعالاته الوجدانية».
إن عدد قصائد الآلوسي المنشورة في ديوانه هو 244 قصيدة مختلفة الطول والبحر والموضوع، غطت 740 صفحة. يبدو شديد الانشغال بتأملاته حول الموت والمصير ونهاية الأشياء. من عناوين قصائده في الموت: «موَّتك الموت»، «المفكر والموت»، «الموت خارج الوطن»، «صراع الأحياء أو تعانق الموت والحياة»، «الميت الحي»، «رقي للموت وأغنيات للحياة»، «في حضرة اقتراب الموت». (را: الجابري، علي حسين: حسام الدين الآلوسي ولعبة الهروب من الموت بالخلود، صحيفة الزمان، 18 نوفمبر 2013).
لم تعبِّر قصائد الآلوسي عن أسئلة الخلود والموت فقط، إذ حملت في طياتها المآسي التي تعرضت لها بلاده، نقتبس جزءًا منها:
«يا غائبين وعن بُعد أشاهدهم
أنتم معي ها هنا في قلبي الصادي
أقمتُ في وحدتي في الروح معبدكم
إليه أرفع أذكاري وأورادي
يا حادي الركب حدّثني بلا ملل عنهم
ففي ذاك إيناسي وإسعادي»
من جملة القصائد الأخيرة التي نشرها الآلوسي الفيلسوف والشاعر نورد هذه القصيدة (ملحق جريدة المدى العراقية «23/10/2013»):
نخلةُ العراقِ
كلُّ نخلة هي ملكُ العراقِ
هي ملكي، هي ملكٌ لشعبِ العراقِ
كلُّ نخلةٍ في الجنوبِ أو في الوسطِ
هي أم العراق
وفي أي وادٍ بكردستان عبر شمال العراقِ
هي رمزٌ لمن سكنوا، يسكنون العراقَ
لوحدةِ شعبٍ بكل دماءِ بنيه اختلط
***
كلُّ نخلةٍِ
هي تأريخُنا هي تاريخ كل البشرِ
هي بدء المسيرةِ بدء الحضارة وبدء الصعودِ
لكلِّ البشرِ
فمن سعفِها ساقها،
أوقد ابن العراقيين نارًا
على ضوئها طارد الجهل
قال هنا يبدأ الدرب
مفترق الدربِ نحو التحضر
بدء الكتابة طقوس التواصل وضع الحروف
ابتداء التمدّن رصف الشوارعِ، وضع التقاويم،
سر الخسوف وسر الكسوف
ومن ساقها خيشها، سعفها
صنعوا زورقًا، عبروا الشاطئين
وفي فيئها ابتكروا، دجّنوا، عرشوا، خضعوا
أعمروا الشاطئين
أقاموا الصناعات
أتقنوا مهنةَ السلمِ والحربِ
زرعوا السهولَ ووضع السدودِ
بناء الجيوشِ وصنع السيوفِ.
زمن الآلوسي... وأزمنة العرب
عاصر الآلوسي في أعوامه السبعة والسبعين أبرز المتغيرات التاريخية والسياسية التي شهدها العالم العربي. فيلسوفنا المخضرم كان شاهدًا على الحراك العربي وعلى مقاتل العرب ونكستهم ونكبتهم وآمالهم ومآسيهم وتطلعاتهم واضطراباتهم وقلقهم.
مع غياب هذه القامة الفلسفية الكبيرة نستعيد أحد الأسئلة المطروحة في بداية المقال: ما الدور الذي يجب أن تضطلع به الفلسفية (أمُّ العلوم) في تفسير وتحليل وتفكيك ومقاربة أزمات مجتمعاتنا ماضيًا وحاضرًا؟ نترك باب الإجابة مفتوحًا علّنا نتدارك في لحظة تاريخية قادمة وعينا لذاتنا وماضينا ومستقبلنا انطلاقًا من هذا الإرث الفلسفي الضخم الذي تركه عميد فلاسفة العراق حسام محيي الدين الآلوسي وأبناء جيله من المبدعين العرب النقديين المؤسسين .

