المرشد التشيكي
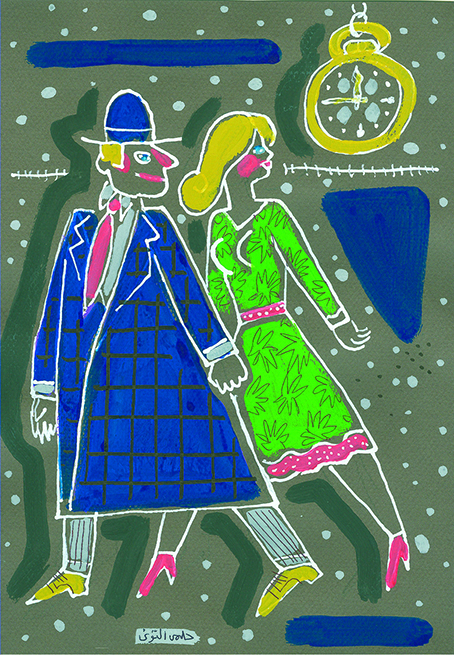
لا أظن أن أحداً يستطيع أن يلعب دور المرشد السياحي بمثل ما لعبه وأداه ذلك الشاب التشيكي الظريف المثقف الذي رافقنا من مطار براغ حتى كارلوفي فاري ثم من كارلوفي فاري إلى براغ مرة أخرى، حيث أقمنا أياماً في فندق الأوليمبك ومنه إلى مطار براغ من جديد. وهناك لم يشأ أن يتركنا لحظة حتى انتهينا تماماً من كل إجراءات الجوازات والجمارك ولحقنا بطائرة «ك.ل.م» التي أقلتنا إلى أمستردام بهولندا. أقول لا أظن أن أحداً كان قادراً على أن يفعل ذلك بمثل ما فعله بكفاءة عالية مندوب شركة شيروك للسياحة.
ومع ذلك فلم يكن الرجل مرشداً سياحياً محترفاً. كان مجرد مهندس معماري متخصص في العمارة الإسلامية، محاضراً في جامعة براغ، درس اللغة العربية في أزهر القاهرة، سافر إلى معظم الدول العربية والإسلامية، وربما لأنه لم يكن محترفاً فقد كان مثالاً ونموذجاً، لم تكن المسألة بالنسبة له حرفة يتكسب منها بقدر ما كانت هواية ومتعة ومصدراً للثقافة والمعرفة من خلال لقاءاته بالناس.
كان يهمه أن يلتقي بالعرب لينمو حواره اللغوي والفكري معهم كما ينمو فهمه لهم ومعرفته بهم. وكان حريصاً على أن يتخذ منا أصدقاء يعطينا أكثر مما يأخذ مع أننا كنا نحن الذين في حاجة إليه بدرجة أكبر. ولقد عبر هو عن ذلك في لحظة غضب من بعض تصرفات صدرت من بعــض أفراد المجموعة المصرية عندما صاح ذات مـــساء محـــتداً ومنفعلاً يقول:
كان من الممكن منذ اللحظة الأولى أن أتحدث إليكم بالإنجليزية من دون أن يفطن أحد إلى أني أجيد لغتكم، لكنني لم أستطع، ذلك لأني أعتبر نفسي صديقاً لكم لا مرشداً.
كان حقيقة سريع الغضب، لكنه كان أيضاً سريع الصفح عما يبدو من واحد أو أكثر منا. وأعترف أننا ضايقناه كثيراً، لكننا أسأنا إلى أنفسنا بدرجة أكبر مما أسأنا إليه.
الغريب أن إساءاتنا إليه لم تكن تنبع في أغلب الأحيان من سوء خلق أو تصرف واحد منا بقدر ما كانت تنبع من أخطاء في تركيبتنا كشعب. إن الشخصية المصرية برغم امتيازها وتفرُّدها بصفات حلوة، فإنها شخصية لا يظهر مرضها إلا من خلال التجــمعـــــات. عندما يجتمع خمسة أو عشرة أو عشرون أو ثلاثون أو أكثر، يبدو الداء واضحاً موروثاً عبر مئات السنين.
لعل أهم ما نعانيه من دون مواراة ومهما أخفيناه، تلك الأزمة التي في داخلنا تجاه الكلمة، نحن لا نثق بالكلمة، نتشكك دائماً في قيمتها، وصار جزءاً من تركيبة الرأس الذي يحمله كل منا ألا يعير اهتماماً بصحة كلمة تقال أو وعد يقطعه واحد على نفسه، مع أن تراثنا مملوء بالأقوال الساخنة والعبارات التي تدوي مثل «وعد الحر دين عليه».
غير أن حياتنا الحقيقية والعملية لم تتعد مجرد هذه الأقوال وتلك العبارات... بدا ذلك واضحاً بمجرد أن وصلنا كارلوفي فاري وراح الرجل يجمعنا في إحدى قاعات الفندق الكبير، يحدثنا عن مواعيد وجبات الطعام وعن خطة الرحلة داخل المدينة الجميلة ذات الاثنتي عشرة عيناً من عيون المياه المعدنية.
بدا له وهو يتحدث إلينا أننا لا نعيره اهتماماً، فراح يكرر كلمة «يا جماعة... يا جماعة» بعربية فصيحة أو محاولاً هو - من جانبه على الأقل - أن يجعلها فصيحة من ناحية النطق، حتى استطاع في آخر الأمر أن ينتزع منا ابتساماتنا ويشدنا إليه، فبدأ يعلن عن مواعيد وجبات الطعام.
ولما كان معظم أفراد المجموعة قد رحلوا قبل ذلك إلى أوربا في رحلات مماثلة، فقد صارت مواعيد وجبات الطعام المبكرة نسبياً مألوفة لدينا من دون أدنى تردد أو لحظة اعتراض، ولم ينس الرجل وهو يحدثنا عن الطعام أن يعلن أن اللحم الذي يقدَّم لنا كسياح عرب يخلو تماماً من لحم الخنزير، وأنهم هنا في تشيكوسلوفاكيا يعلمون جيداً أن العرب لا يأكلون لحم الخنزير أياً كان نوعه. ومن هنا أيضاً
- وعلى حد تعبيره هو - كان اللحم المقدم لنا مع أطباق الخضر السوتيه أو المطبوخة ليس لحماً خنزيرياً. كذلك لم ندهش عندما علمنا أن شعب تشيكوسلوفاكيا يأكل لحوم الخنزير بل يفضلها على لحوم أخرى كثيرة، لكننا دهشنا جداً - وكانت دهشتنا عظيمة - عندما رحنا ظهر اليوم التالي نتناول طعام الغداء في إحدى قاعات الفندق الفاخر، فأبصرناه أحمر الوجه، غضوباً، يقوم من مقعده القابع إلى جوار المرشد المصري وكان جالساً إلى مائدته ذاتها، ثم ينتزع نفسه في غضب وانفعال شديدين، وذلك على أثر سؤال وجهه أحد أفراد المجموعة.
كان السؤال الذي أثار تلك الغضبة الغريبة يدور عما إذا كانت قطعة اللحم التي تقبع أمام كل منا هي نوع من أنواع لحم الخنزير أو ما شابه ذلك. صحيح أن قطعة اللحم كانت تشبه فعلاً وإلى حد كبير في لونها وشكلها قطعة جامبون، وصحيح أيضاً أن كلاً منا راح يفكر للحظة أنه ربما كانت قطعة اللحم التي وضعت أمامه هي فعلاً لحم خنزير. غير أن كل ذلك لم يشفع للرجل الذي أثار السؤال، لم يشفع له عند المرشد الغاضب الذي راح يصرخ ويصرخ، مكرراً كلمته المفضلة عنده «يا جماعة. يا جماعة» ثم يصيح: قلت لكم أمس إننا لا نقدم لحم الخنزير للعرب، نحن نعلم أنكم لا تأكلون الخنزير، ولقد سبق أن صرحت بذلك، فإذا جئت اليوم وسمحت لهم بأن يقدموا لكم لحم الخنزير، فمعناه أني أكذب وأني تبعاً لذلك لا أصلح أن أكون مرشداً.
كان منفعلاً في صدق، يحس تماماً أنه أُهين أو مُسَّت كرامته، غير أنه سرعان ما بدأت غضبته تفتر وحدة انفعاله تخف عندما لمح على شفاهنا نبتات ابتسامات متفرقة ومتناثرة ما لبثت أن تحولت آخر الأمر إلى ضحكات كأنها اعتذارات... وهدأ الجو.. وصرنا معاً في لحظة «صافي يا لبن»، وجلس هو من جديد إلى مائدته، بينما رحنا نحن نسرع في تناول طعامنا الشهي خشية أن تكون سخونته قد فترت مع دقائق التوتر التي مرت.
تلك كانت قصتنا مع كلمة قالها المرشد، ووعد قطعه هو على نفسه، دون أن نأخذه نحن في الاعتبار بدرجة من الجدية جديرة به.
وكما سبق أن قلت، كان الرجل حقيقة سريع الغضب، لكنه كان إلى جانب ذلك سريع الصفح والنسيان، أشبه برجل مصري طيب القلب، ومع أنه كان يبدو لنا كثيراً أنه يعرف المصري جيداً وأن المدة التي قضاها في القاهرة وغيرها من عواصم العرب كانت تكفي ليتشرب خلالها خصائص الشعب المصري إذا صح التعبير، لكن بدا أنه لا يفهمنا، ولا يغفر لنا طبيعتنا المرحة السخية في عطائها الفكاهي خلال أي لحظة من لحظات النهار أو الليل.
ومع ذلك فقد كان هو نفسه مرحاً في بعض الأحيان. مرحاً بقدر، كأنما هي جرعة مرح داخل كبسولة تناولها خلال لحظة لينتهي مفعولها تماماً بعد مدة، أو على الأصح بين ساعات لهوه ولحظات عمله، ليصنع منها كلها مزيجاً يبدو لمن لم يألفوه شاذاً وغريباً، لكنه بالنسبة لنا مألوف جداً.
ولعل فهمنا للسياحة، الذي يختلف عن فهم غيرنا لها، هو سبب اختلافنا مع الرجل. نحن نفهم السياحة على أنها لهو وفرجة وهم يفهمونها على أنها دراسة وتأمل، هو بحكم تركيبته الثقافية وبحكم عمله يريد أن يشرح لنا كل شيء.. كل تمثال يراه، كل كنيسة، كل معبد، كل طراز معماري يجده أمامه، يتحدث عنه، يصنع سبباً لوجوده هنا، أو هناك، يمنحنا تفسيراً له إذا استطاع، أو يعتذر إذا لم يستطع، وكم من مرة قطع حديثه لنا عندما يجدنا مجتمعين حول مبنى كنيسة نتأمله متفرجين، من دون أن تشدنا قصة وجوده في مكانــــه وزمانه ومن دون أن يهمنا في شيء أن نلم ببعض تاريخه وكم من مرة تأملنا وهو صامت يتصفح وجوهنا, بينما رحنا نحن, غير مبالين به ولا بأحاديثه، نحرك عدسات كاميراتنا، نلتقط صورة التمثال لمجرد أن واحدة أو واحداً من أفراد المجموعة راح إلى جوار التمثال ممسكاً بلحيته الطويلة البيضاء ويضحك بملء فمه، أشياء تعكس مفهومنا الساذج للسياحة على أنها ليست أبداً دراسة عقلية بقدر ما هي لهو ومتعة وتأمل سطحي سريع غير متأنٍّ.
حدث خلال عودتنا من مارينباد إلى كارلوفي فاري – وكنا متعبين بعد يوم حافل باللهو والفرجة على طريقتنا – أن راح البعض منا يغني ونحن في الأوتوبيس الذي يقلنا، ولست أدري سر ذلك الانتقاء غير الموفق لأغنياتنا ذلك اليوم، بدأ الكل يغني تلك الأغنية الهزلية التي تبدأ كلماتها «العتبة جزاز... والسلم نايلو في نايلو»، ثم تحولوا إلى أغنية أخرى مطلعها.. «أمَّا نعيمة»، وراحوا يطالبون الرجل بأن يغني معهم، ولما كان هو يجيد العربية، فقد طلب منهم أن يعيدوا كلمات الأغنية ليستوعبها قبل أن يرددها بالغناء.
فأعادوها عليه، غير أنه لم يفهم من كلماتها شيئاً، وطلب من واحد أن يعيدها عليه ثانية كلمة كلمة حتى يفهم معناها، فلما حدث ذلك نظر إليه وهو يبتسم ويعلن مرة أخرى أنه لم يفهم شيئاً، هنا طلب من آخر أن يمنحه تفسيراً لكلمات الأغنية، غير أن هذا الأخير لم يستطع أن يفعل، كل الذي حدث بعد ذلك أن الجميع راحوا ثانية يرددون الأغنية كأن ترديدهم لها مرة ومرات سوف يمنحهم ذلك التفسير المفقود للكلمات، لكن الرجل لم يستطع أن يسكت, فصاح فيهم: يا جماعة... يا جماعة كيف ترددون أغنية لا تفهمون كلماتها بينما لديكم أغنيات حلوة تعبر عن حياتكم وبيئتكم... ثم أضاف أنه هو نفسه في إحدى زياراته لمدينتيْ الأقصر وأسوان استمع إلى أغنيات كورالية جميلة من أفواه عمال وفلاحين، واستطاع -وهو الغريب عنهم- أن يتذوق ألحانها وكلماتها. ورغم أنواع من الحساسيات السياسية والاجتماعية التي تصيب عادة أي مواطن بالنسبة لبلده فإن المرشد التشيكي كان جريئاً وشجاعاً في تناوله للأمور... ينقد، يعلن رأيه من دون لحظة تردد يتخذها، ومع ذلك فقد كنت أحس أحياناً أنه يحاول أن يسيطر على نفسه ليقاوم شيئاً في داخله... شيئاً ليس نابعاً تماماً من تلك الحساسيات التي أشرت إليها، بقدر ما هو نابع من أسلوب حوارنا معه، فقد كان هو من طراز الرجال الأقوياء، يفهم تماما، وبمنهج علمي، ظروف التحول الاجتماعي الذي يجتازه بلده.
وفي السطور التالية بعض المواقف لعلها قادرة على أن تجمع شتات ضوء مبعثر أحاول أن ألقيه على شخصية الرجل، لتتضح أكثر وتبين:
في إحدى جولاتنا بالأوتوبيس السياحي المعد لتنقلاتنا، كان يرتدي قميصاً يحمل مانشتات لجرائد مصرية وعربية، ولما أبدينا إعجابنا به أخبرنا أنه ابتاعه من أحد متاجر القاهرة، وسكت قليلاً ثم مال برأسه وهو يهمس إلى مجموعة منا كانت تجلس قريبة منه، وقال لهم: أريكم آخر نكتة... وراح يشير بإصبعه إلى مانشيت ضخم على قميصه، يعلن ويقول: الجمهورية العربية تملك أكبر قوة ضاربة في الشرق الأوسط، كان ذلك بعد هزيمة 1967 وقبل أن تبدأ معارك أكتوبر 1973.
لما رآني أكتب ملاحظاتي ومشاهداتي عن الرحلة، سألني عما إذا كنت أعمل صحفياً أو مراسلاً لإحدى الصحف، فلما أجبته بالنفي أخبرني أني إذن أكتب أيامي في الرحلة، على غرار أيام طه حسين، وضحكنا.
عندما عثر على واحد من المجموعة متخصص في الهندسة المعمارية مثله، حاول أن يكون دائماً بالقرب منه، لعل كلاً منهما يأخذ من الآخر ويمنح، غير أنه عندما اكتشف أن المهندس المصري تعوزه المعرفة الشاملة في فلسفة العمارة، وأنه ملم بالتفاصيل الفنية الدقيقة التي تهمه كمهندس معماري أكثر من إلمامه بالعمارة كوظيفة لها فلسفة وطراز وظروف تاريخية واجتماعية، عندما أدرك ذلك لم يعد يهمه أن يبحث عنه أو يتحدث إليه، واكتفى بالصدفة التي تدفعهـــما معاً إلى اللقاء.
في مارينباد – أو ماريا لانسكي لازني كما يطلقون عليها – أشار إلى كتاب باللغة التشيكية معروض في إحدى مكتبات المدينة، وقال: هذا الكتاب هو ترجمة لكتاب في العمارة الإسلامية، مؤلفه مصري، لكنه للأسف غير متخصص فوقع في أخطاء كثيرة، ثم تساءل: لماذا يقحم الإنسان نفسه في أمور لا يدري عنها شيئاً؟ لماذا لا يتركها للمتخصصين؟ وختم حديثه وهو يقول: عندما قرأت الكتاب واكتشفت عدم إلمام مؤلفه بالموضوع الذي يتناوله، أمسكت بالقلم وكتبت مقالاً هاجمت فيه الكتاب وما جاء فيه من أخطاء، وأعترف أني كنت قاسياً، غير أني دافعت عن ضرورة أن تترك الأمور للمتخصصين فيها.
في خلال زيارتنا الثانية المتأنية لمدينة براغ، ووسط ميــدان الساعة وأمام برج الكنيسة العجيب، حيث تظهر في تتابع صور المسيح وحوارييه، كنا واقــفين مع مئــــات السياح من كل بلاد العالم، منتظرين ذلك الحدث الغريب ومتطلعين بعــيون ثابتــــــة إلى النافــــذة التــي سيطل منها تمثـــال المسيح، هو وحواريوه، واحداً وراء الآخر، كانــــــت الساعة توشك أن تعلن الخامسة بعد الظهر، العيون مثبــــتة بلا حراك على نافذة الكنيــــسة العجيبة، الكل ركزوا عدسات كاميراتهم وبدأوا يتأهبون لالتقاط المنظر الفريد لحظة أن تنتهي الساعة من دقاتها الخمس، وتمضي الدقـــائق والثواني، ويسود الميدان صمت، تتطاول خلاله الأعــــناق، تتأهب الآذان مثل أجهــزة رادار، بينما تروح العيون تجحظ، يحاول كل منا ألا يرمش بها لحظة واحدة حتى لا تفوته الفرصة، ويمضي الزمن، وتدق الساعة دقة، دقتين .. ثلاثاً، خمساً، إلى أن تتوقف تماماً، والزمن يمـــضي من دون أن تظهر أي صورة، والجمــوع تقـــف تنتظر الأمل في رؤية السيد يداعبها، لكن السيد لا يطل من نافذته بينما نطل نحن بعيوننا. بآذاننا... بكاميراتنا... بأيادينا، من دون أن يظهر لنا شيء ويتساءل الجميع عما حدث.. وتعلو الأصوات. تستفسر... تتساءل، لكن نكتة تنتشر بين أفراد المجموعة المصرية المتناثرة وسط جموع السياح وعبر الميدان الضيق المزدحم، تعلن أنه لا بد أن ذلك قد حدث ابتهاجاً بنا وترحيباً، أو أننا قد حملنا معنا من مصر بعض التعويذات التي أدت إلى ذلك، ويضحك الكثيــــرون ويقهقهون، لكن المرشد التشيكي لا يضحك، ينظر إلينا ولا يضحك، صحيح أن شفتيه تنفرجان عن ابتسامة صغيرة باهتة، لكنه أبداً لا يضحك، فقط ينظر إلينا في تساؤل: كيف حدث ذلك؟ بل كيف يحدث بعد أكثر من ثلاثين عاماً ظلت الساعة خلالها تعــمل من دون أن تتـــــوقف لحظــــة صــــورة المسيح مع حوارييه عن أن تظهر للجموع المتطلعة إليها والتي يزدحم بها الميدان العتيق الضيق? ■

