تأملات في اللوحة الاستهلالية لـ «المومياء»

سنحاول في السطور التالية تأمل ملمح من ملامح الوعي الجمالي والتاريخي العميقين للمخرج المصري شادي عبدالسلام في فيلمه الروائي الطويل (المومياء... يوم أن تحصى السنين، إنتاج 1969، عُرض في 1975)، وذلك من خلال تبين بعض دلالات اللوحة الاستهلالية التي يفتتح بها شادي الفيلم، حتى قبل نزول تترات البداية.
على صورة قناع لتابوت فاقد لإحدى عينيه، ومنزوع عنه الذهب الذي يزينه، تظهر اللوحة الاستهلالية التالية من نصوص امتون التوابيتب:
يَا مَنْ تَذْهَبْ سَتَعُودْ
يَا مَنْ تَنَامُ سَوْفَ تَنْهَضْ
يَا مَنْ تَمْضِي سَوْفَ تُبْعَثْ
فَالْمَجْدُ لَكْ
لِلسَّمَاءِ وَشُمُوخِها
لِلأَرضِ وَعَرْضِهَا
لِلْبِحَارِ وَعُمْقِهَا
تلخيص للحبكة
بعد اللوحة الاستهلالية، يبدأ الفيلم باجتماع لجاستون ماسبيرو (1846 - 1916م)، مدير الآثار المصرية، مع بعض علماء المصريات في المتحف المصري، ومعهم محمد أفندي كمال (1851 - 1923م)، أول عالم آثار مصري، لبحث موضوع ظهور بعض قطع الآثار المصرية المسروقة، التي تعود إلى الأسرة الحادية والعشرين، في أسواق الآثار العالمية، ويستنتجون أن لصوص الآثار قد عثروا على مقابر لهذه الأسرة. ويتطوع أحمد كمال بالذهاب إلى طيبة (الأقصر) في موسم إجازة المتحف بالصيف، في محاولة للعثور على خيط قد يؤدي إلى كشف اللصوص.
ثم ينتقل الفيلم إلى طيبة، ونشهد جنازة سليم، زعيم قبيلة الحربات؛ الذي كان يبيع الآثار المسروقة إلى التاجر أيوب. ويقوم شقيق سليم بإخبار ابني أخيه؛ ونيس وشقيقه الأكبر، عن سر الخبيئة (أي الآثار التي أخفاها الكهنة المصريون القدماء عن أعين اللصوص، بإعادة دفنها في أماكن سرية).
يرفض الأخ الأكبر بيع الموتى، فيتم قتله بأمر من العم. ويظل ونيس متردداً، غير قادر على حسم أمره، معانياً من ثقل السر الذي عرفه، وفي هذه الأثناء يصل أحمد كمال إلى طيبة، ليتعاون مع الحرس المُكلف بحماية المنطقة، بقيادة الضابط البدوي بك (ويُسمُّون جميعاً: الأفندية)، في محاولة لكشف اللصوص.
من ناحية أخرى، يرفض ونيس إغواء زينة؛ التي يجلبها مراد (المساعد السابق لأيوب التاجر) لإغواء شباب القبيلة مقابل قطع من الآثار المسروقة، ويرفض بيع الخبيئة إلى أيوب التاجر. يكشف مراد لونيس عن سر مقتل أخيه، فيذهب ونيس إلى أفندية القاهرة، ويخبر أحمد كمال بمكان الخبيئة.
وأخيراً، يستخرج أحمد كمال والبدوي بك الخبيئة بمساعدة الجنود وبعض من اأهل الواديب (الفلاحين) الموثوق بهم. ويتم نقل الخبيئة إلى السفينة، التي ترحل إلى القاهرة وعلى متنها توابيت 40 من أشهر وأهم فراعين مصر في خمس أسرات؛ من الأسرة 17 إلى الأسرة 21. إن شادي حين يستدعي قصة خبيئة المومياوات، وحكاية أسرة عبدالرسول وقبيلة الحربات، فإنه في الحقيقة لا يقدم لنا القصة الواقعية تسجيلياً كما حدثت بالفعل، بل يخوض نزالاً فنياً طويلاً مع الحكاية الواقعية، فيضيف ويحذف، ويبتدع خطوطاً درامية، وتخييلات جديدة، تضيف أبعاداً وجودية للقصة، وتحقق هدف الفيلم في نقل المعاني الكبرى التي أراد إيصالها لنا.
إن ما وصل إلينا من أوراق شادي، إضافة إلى شهادات زملائه وأصدقائه، يؤكد أنه عمل على السيناريو لفترة طويلة حتى وصل إلى شكله النهائي (من بدايات 1965 إلى مارس 1968 وقت تصوير الفيلم)، لدرجة قيامه بتعديل السيناريو ثلاث مرات، وعلى نحو يختلف اختلافاً بيناً في كل مرة.
كان السيناريو الأول تسجيلياً يُسمى ادُفنوا مرة ثانيةب، ثم أعاد كتابته في دراما كلاسيكية تدور حول قصة حب بين ونيس وزينة، تحت اسم اونيسب، ثم استقر أخيراً على الشكل النهائي الذي صوَّر به االمومياءب.
إنه الأسلوب نفسه الذي كان ينتهجه تاركوفسكي في عمله، والذي كان يمتلك، كشادي، إرادة جبارة في العمل طويلاً على التعديلات والتنقيحات للمادة الخام (السيناريو)، وخصوصاً في فيلمه االمرآةب، (1975) الذي أعاد كتابته ثلاث مرات، وفيلمه االطوافب، (1979)، الذي أعاد تصويره أيضاَ ثلاث مرات.
المعاني التي قصدها شادي
يتضح، حتى من المشاهدة الأولى، أن االمومياءب يصارع فكرة البعث والإحياء لعناصر القوة في حضارتنا، واستلهام تلك العناصر التي صنعت الأمجاد القديمة، من أجل الصحوة الجديدة للوعي. وبتعبيرات شادي نفسه: اأردت أن أعبر عن شخصية الإنسان المصري الذي يستعيد أصوله التاريخية وينهض من جديد، وأتصور أن الأفلام التاريخية التي أصر على تقديمها، هي نوع من البحث التاريخي بلغة الكاميرا عن هموم وأشواق الحاضر. أنا أرى الحياة في استمراريتها، وإذا أردت أن أرى ما يجري اليوم جيداً، فلا يمكن أن أعزل اليوم عن الأمس، فما نحن فيه اليوم هو نتاج لتاريخناب.
إن لوحة البداية هي دلالة ونبوءة عن ما سيحدث بعد ذلك في الفيلم. ومهمة االأفنديةب في المومياء (أحمد كمال والبدوي الضابط) - أي الجانب المتنور في الشخصية المصرية -، هي المهمة نفسها التي كان شادي يضعها على عاتقه هو شخصياً. إن إنقاذ مومياوات الأجداد، الفراعنة العظماء، ليس من أجل إعادة إحياء الأجداد، ولكنه وسيلة لإعادة بعث الأحياء الهائمين الضائعين. إن المعرفة، والوعي بعناصر القوة التي كانت للمصريين القدماء، هما شرط لتحقيق البعث والنهضة لأحفادهم.
وعلى نقيض الكتب الدينية والعلمية التي تبدأ بالتكوين وبداية الخلق، يبدأ االمومياءب بالموت. موت الإنسان الذي يمكن أن نقرأه بوصفه المكافئ لفوضى الهيولي. الموت الروحي للإنسان الجاهل بتاريخ أسلافه، الذي ينتزع لقمة عيشه ببيع جثث موتاه، وماضيه، وتاريخه.
إن الفيلم يبدأ بالنهاية وليس البداية. وينتهي إلى البداية؛ أي البعث. إن عملية البعث هي عملية خلق، تماماً مثل الانفجار الكبير الذي يؤسس النظام من رحم الفوضى. فقبل الانفجار الكبير لم تكن هناك لا قوانين علم ولا معرفة، لأنها جميعاً تنهار في حالة الهيولي. ومع بداية حالة الانتظام والاستواء بعد الانفجار الكبير، يبدأ الكون المنتظم كما نعرفه، والزمان كما نعرفه، والحياة الذكية؛ أي الحضارة.
أهمية اللوحة الاستهلالية
الفعل المضارع الذي يهيمن على نبرة اللوحة الاستهلالية يُطالب المُشاهد باعتبار أحداث الفيلم في الحاضر، وليس في الماضي، بالرغم من أن أصل القصة تاريخي، أي وقعت في زمن سابق بالمعنى الكرونولوجي. وبسبب الإرادة الواعية لشادي في جعل زمن الفيلم في زمن التكلم، يخلو الفيلم من أي لقطات لـ االفلاش باكب.
أما في لوحة النهاية، فإن فعل الأمر اانهضب يسمح لنا بافتراض التمني أيضاً. إن الوعي بالاسم؛ أي بالتاريخ والماضي والأسلاف، هو شرط النهوض.
اللوحة الختامية
انْهَضْ
فَلَنْ تَفْنَى
لَقَدْ نُودِيتَ بِاسْمِكْ
لَقَدْ بُعِثْتْ
يبدو من الحرص على تشكيل النص بدقة أن صانع الفيلم يُطالب المُشاهد بالانتباه الشديد والتركيز. فتشكيل كل حرف في لوحة المقدمة (والخاتمة) يترك لدينا الانطباع برغبة الفنان، وإرادته، في أن يحكم الأمور إحكاماً واعياً، وحرصه على تحقيق أثر معين في النفس.
إن الأمر مدروس جيداً، وحسابات شادي في الفيلم محسوبة بدقة، والفكرة واضحة جلية في ذهنه. ولذلك فإن الفيلم يمسك بالمُشاهد مسكة قوية منذ البداية، ثم يتقدم إلى الأمام وقد سيطرت عليه روح الوحدة والتماسك.
ونحن نعرف بالخبرة أن من طبيعة فنان السينما أنه دائماً ما يسعى إلى أن يكون في أفضل حالات الوعي في الافتتاحيات، لأنه يكون تواقاً إلى التأثير، راغباً في لفت نظر المُشاهد. وشادي هنا يفتتح الفيلم بنص مكتوب، بالرغم من أنه قد يكون موضع انتقاد من حزب التعبير الدرامي بالصورة. لكنه، وهو العليم بالأهمية الروحية للنصوص في الحضارة الفرعونية (وكذا العربية)، يوفق للغاية في استخدام وسيلة غير سينمائية للتعبير بأصالة عن فكرته، في فيلم هو الأكثر رقياً في تاريخ السينما العربية من حيث جماليات الصورة والتصميم الفني، والتعبير التشكيلي عن المعاني الوجودية للدراما.
إن النصوص المكتوبة في الحضارة الفرعونية لم تكن مجرد وسيلة للقراءة والكتابة، أو لتدوين النصوص الأدبية، أو حتى فقط لنقل الحكمة والرسائل الأخلاقية والتعليمية عبر نصوص الحكايات، والحكم والوصايا، ولكنها كانت، في الأساس والأهم، تعبر عن قوة روحية ودينية لم يعرفها أي نظام كتابة آخر. فالنصوص التي وصلت إلينا من اكتاب الموتىب وامتون الأهرامب وامتون التوابيتب هي أدلة على قوة اعتقاد المصري القديم في قدرة النصوص الكتابية على تقديم العون والمساعدة للمتوفى، لدرجة أن محو الاسم المكتوب للشخص، لا يمثل فقط محواً لذكرى الميت، ولكنه محو لوجوده الأبدي.
والنص الاستهلالي للفيلم يوحي لنا بأنه يعمل كما لو كانت له هذه القوة نفسها. وسرعان ما سيحتشد له بقية الفيلم بالصدى والتكرار، وعلى نحو يعزز قوة النص الاستهلالي في الافتتاحية، حتى أنه يستحيل حذف اللوحة الاستهلالية (والختامية) من دون أن يفقد الفيلم كثيراً من معناه.
ومع ذلك فإن شادي يختار اللغة العربية الفصحى، عن قصد وتصميم، لكتابة النصين الاستهلالي والختامي، ولم يختر مثلاً اللغة الهيروغليفية، مع إرفاق ترجمة عربية مصاحبة لها. بالرغم من أنه لو فعل لأعطى تأثيراً أقوى من الناحية التسجيلية، لكننا نعلم أن اهتمام شادي في االمومياءب لم يكن التسجيل، وتشهد على ذلك الفروق السردية الضخمة بين المادة الخام للفيلم (السيناريو)، والمادة الخام للواقع (حادثة خبيئة الأقصر وأسرة عبدالرسول). إن اختيار شادي للغة العربية الفصحى ليعبر بها عن معاني الفيلم المتضمنة في النصين الاستهلالي والختامي، علاوة على اختياره لها، وليس اللهجة المصرية، لغة للحوار بين الشخصيات، يسمح لنا بالقول إنه لم يكن من الشوفينيين الذين يؤمنون بالطلاق بين الحضارتين الفرعونية والعربية، وإن نهضة مصر لن تتحقق إلا بتبني الأولى، ونبذ الثانية، وهو موقف ليس مستغرباً من فنان عاش مشغولاً ومسكوناً بالفنون البصرية والتشكيلية.
نحن نعرف، بالخبرة، أن معظم الفنانين التشكيليين المصريين يؤمنون فطرياً بتكامل الحضارتين الفرعونية والعربية، ويحملون إجلالاً للاثنتين. فمجال الفنون التشكيلية يُعرّف الفنان على أقوى وأجمل عناصر الحضارتين، فيعز عليه الانحياز، ويتوق فطرياً إلى التكامل.
فما بالك وإن كانت الفطرة السليمة للفنان مدعومة بثقافة عميقة للتاريخ الحضاري والفني لأمته؟ وفي السيرة الذاتية لشادي، وفي تصاميمه الفنية، ما يسمح لنا بالاعتقاد بأنه كان فخوراً بالحضارتين، تواقاً إلى تكاملهما، مؤمناً بأن البعث الحضاري لأسس قوة الحضارة الفرعونية، من شأنه أن يكون مصدراً للنهضة العربية الشاملة.
لماذا الخط الكوفي؟
اللوحتان الافتتاحية والختامية مكتوبتان بخط كلاسيكي يغلفه الوقار، ويحترم الموضوع والأجواء. والخط المستخدم مُصمَّم اعتماداً على السمات الجمالية لأقدم الخطوط العربية وأجملها: الخط الكوفي المصحفي على طراز المشق. ولكي نحاول تفسير اختيار الخط الكوفي في هذين الموضعين المهمين بالفيلم، ودلالة الإرادة الواعية للفنان في هذا الاختيار، نحتاج أولاً إلى إشارات سريعة إلى تاريخ الخط الكوفي وتطوره.
كانت الخطوط في الجزيرة العربية في البدء تُكتب بنوعين: مبسوط هندسي (وتطوره الأرقى هو الكوفي)، ويتميز هذا النوع بالهندسية، والتربيع، والزوايا المستقيمة، والنوع الآخر هو المقور اللين (وتطوره الأرقى في خطوط النسخ، والثلث، ثم النستعليق.. إلخ)، وحروفه تميل إلى اللين، والميل، والاستدارة.
والكلام في أصول الخط الكوفي كثير ومتشعب، ولكن يمكن تلخيص تطوره، وفقاً للأقوال الموثوقة في كتابات المؤرخين العرب (ومنهم: أبوحيان التوحيدي في اعلم الكتابةب، وابن خلدون في االمقدمةب، والألوسي في ابلوغ الأربب، واخططب المقريزي، واتحفة أولي الألبابب لابن الصائغ)، وكذا ما اطلعنا عليه من الكشوف الأجنبية الحديثة للنقوش القديمة في المنطقة العربية، إلا أن أصل الخط الكوفي كان الخط الحجازي (المكي اليثربي)، المأخوذ عن الخط الحيري، عن النبطي، عن الحميري، عن المسند، عن الفينيقي، المأخوذ عن خط طور سيناء؛ والذي بات معلوماً الآن أنه أصل الأبجدية العربية، والعبرانية، والبهلوية، واللاتينية، وكثير من الأبجديات الأخرى.
ولذا فإن الخط الكوفي أقدم من اسمه. فهو أقدم من مدينة الكوفة التي بُنيت في عهد عمر بن الخطاب، ]، عام (18هـ/ 639م).
وقد سُمي بالكوفي أيام كانت الكوفة مركزاً إدارياً وسياسياً للدولة العربية، ومقراً لخلافة الإمام علي بن أبي طالب، كرّم الله وجهه، والذي كان هو نفسه يكتب بالخط الكوفي، ويشجع على كتابته، وكذلك الإمامان الحسن والحسين، رضي الله عنهما.
ففي الكوفة بدأ هذا الخط في الترقي تدريجياً، وأدخلت عليه التحسينات؛ ومنها التنقيط والتشكيل الذي بدأ بإدخاله أبوالأسود الدؤلي، بطلب من الإمام علي بن أبي طالب، ]، ثم تبعه تلميذاه النابهان؛ نصر بن عاصم الليثي، ويحيى بن يعمر العدواني.
وأصبح الخط الكوفي هو المعتمد في تدوين القرآن الكريم، والحديث، ونسخ الكتب، وتزيين المساجد، والقصور، وكتابات الدواوين، ورسائل الحكام وتوقيعاتهم.
ومن الكوفة أيضاً انتشر واشتهر، لدرجة أنه حين حلّت العربية محل القبطية في مصر مثلاً، واحتفظ بعض أهلها باللغة القبطية، كتبوها بالخط الكوفي.
وأكثر ما يعنينا في تاريخ تطور الخط الكوفي هو أنه بلغ أوجه في العصر الأموي (41 - 132هـ / 661 - 750م)، والعصر العباسي الأول (132 - 232هـ/750 - 847م)، وأصبح ينتشر مع انتشار الدولة إلى بقية الأمصار، فيحل في الكتابة محل خطوطها القومية، معبراً عن قوة الدولة العربية، وعن الشخصية العربية الجديدة.
واستمر الخط الكوفي هو الخط الأساس في الكتابة العربية، حتى في العصر الفاطمي (300 - 567هـ/913 - 1171م)، ولم تسعَ الدولة الفاطمية (الشيعية) إلى فرض أنواع أخرى من الخطوط لتعبّر عن شخصيتها الجديدة، ولا حتى في المكاتبات الرسمية في دواوينها.
لكن الأمر اختلف مع خلفائهم الأيوبيين (567 - 657هـ/1171 - 1260م)، الذين أعادوا المذهب السني محل الشيعي، حيث شهد عصر الدولة الأيوبية الاعتناء بخط النسخ على حساب الخط الكوفي، ومحاولة نشره في البلاد العربية التي وقعت تحت سيطرتهم.
لكن الخطوط الكوفية ظلت مع ذلك تصارع رأساً برأس الخطوط الرسمية في الدواوين، وظلت هي المفضلة للخطاطين في الكتابة، وتزيين المساجد والقصور. ولم يحد من نموها وانتشارها إلا الاحتلال العثماني للبلدان العربية، حيث عملت الدولة العثمانية (698 - 1341هـ/1299 - 1922م) على فرض شخصيتها الجديدة (حتى في الخطوط) على المجتمعات العربية، ففرضت الخطوط التي هي من أصل عثماني (الديواني، والطغرا، والرقعة، والياقوتي، والقرمة... إلخ)، كما شجعت أيضاً أنواع الخطوط اللينة الأخرى (ومعظمها من أصل فارسي) الصالحة للكتابة السريعة في الدواوين والمراسلات الرسمية التي تضخمت (الحاجة إلى سرعة الكتابة، والربط أكثر بين الحروف، على عكس الكوفي الذي يحتاج إلى التمهل والاعتناء والدقة والركوز).
وكانت الضربة القاضية للخط الكوفي في عملية نقل كبار أساتذته وأمهرهم إلى الأستانة، - فيمن نقلوا من الحرفيين والفنانين والصناع العرب لبناء الأستانة - فحُرمت الكتابة العربية من جهودهم، وتم استخدامهم هم أنفسهم ليسهموا في تطوير الخطوط العثمانية الجديدة، وبقية الخطوط اللينة.
إن شادي حين يختار الخط الكوفي، يختار أول وأقدم خطوط الكتابة العربية، وواجهة القوة في الحضارة العربية، وسفيرها إلى العالم، ولا يختار خطاً من الخطوط التي طورها أو ابتكرها الفنانون على هوامش المركز العربي؛ كخطوط التعليق والنستعليق والمكسر الإيرانية، أو خطوط الرقعة والديواني والطغرا التركية. إن الخط الكوفي يحمل الرسالة التي أرادها شادي، كما حمل من قبل صورة القوة في الحضارة العربية في أوجها.
ويجدر بنا أن نلاحظ أن شادي حين يختار الكتابة بالخط الكوفي، يختار النمط الأرقى منه (وهو أكثر من 70 نوعاً وشكلاً)، والصالح للكتابة العادية (وليس الكوفي المزهر، أو المورق، أو المشجر، أو المغربي، أو المعماري، أو المضفور، مثلاً، أو غيرها من الأشكال الصالحة للزخرفة وتزيين واجهات المساجد والقصور). بل يختار الكوفي المصحفي بأسلوب المشق (والمشق هو أحد أنواع الأقلام التي يُكتب بها الخط. ويعني في اللغة: جذب الشيء ليمتد ويطول. ومَشَقَ الخط أي مدَّ حروفه). وهو النمط نفسه الذي يُذكرنا بالمخطوطات في العصرين الأموي والعباسي الأول؛ بعد اختراع التنقيط والتشكيل. والمدهش، والذي يؤكد الإرادة الواعية، والقصدية في اختياراته، هو إحجامه عن الفصل بين الجمل في الفقرة المكتوبة: بالفاصلة، أو الفاصلة المنقوطة، أو النقطة، أو النقطتين، أو علامة التعجب، أو غيرها من علامات الترقيم. ونحن نعلم أن علامات الترقيم قد دخلت الكتابة العربية بعد فوز الخطاط المصري محمد أفندي محفوظ عام 1928م في مسابقة بين الخطاطين، أقيمت بناءً على رغبة الملك أحمد فؤاد الأول (1868 - 1936م)، بغية إرشاد القارئ العربي أثناء القراءة، على غرار ما هو معمول به في الكتابات اللاتينية، وهو ما عممته وزارة المعارف العمومية المصرية على مدارسها عام 1930م. إن شادي هنا يهمل هذا التطور االجديدب في الكتابة، ويحافظ على الخط الكوفي كما كان يُكتب في عصر القوة العربية، تأكيداً للمعنى الذي أراده.
الانسجام مع القيم الجمالية الفرعونية
تأبى الغريزة الفنية لشادي إلا أن تقتدي بالفنان المصري القديم في أسلوبه الفني، حين كان يختار تصوير موضوعاته على نحو تكون معها في ريعان الصحة والقوة والجمال.
فنحن نعلم أن أسس الفن المصري الفرعوني ظلت ثابتة لأكثر من ثلاثة آلاف عام، محتفظة بأسلوب أصيل ومميز. وقد كان النحات، مثلاً، يعتقد أن تمثال الشخص هو مسكن دائم لروحه، وعلى صورة ذلك التمثال إنما يُبعث بعد الموت.
ولذلك حرص على نحت الإنسان على الصورة التي يرغب في تخليد نفسه فيها. أي وهو في ريعان الصحة والقوة والجمال، وبالنسب القياسية لجمال الشكل الإنساني؛ فيظهر الرجال بصدور عريضة وقوية، وتظهر السيدات نحيفات وذوات سيقان طويلة (وتمثال نفرتيتي هو نموذج للمثالية في نسب الجسد الإنساني).
ومن النادر أن نعثر في الفن الفرعوني على رسم أو منحوت يُصوّر التقدم في العمر، أو البدانة، أو الضعف الجسدي، أو الانحراف عن المثالية في الجمال، لدرجة أننا نعرف الفرق، مثلاً، بين زوجة صاحب المقبرة وأمه من التعليقات الهيروغليفية المصاحبة للرسم، لا من الرسم نفسه.
واقتداءً بهذا الأسلوب الفني، فإن شادي يكتب لوحة البداية (والنهاية) بأكثر الخطوط العربية تعبيراً عن الصحة والقوة والجمال: الخط الكوفي المصحفي بقلم المشق مع التشكيل. إنه نفس ما كان العربي يكتب به مخطوطاته ونصوصه في أوج قوة الدولة العربية؛ أي في العصرين الأموي والعباسي الأول. صحيح أن فكرة االعصر الذهبيب للحضارة العربية هي فكرة ذهنية أكثر منها حقيقة تاريخية، بمعنى أنها تجميع لعناصر القوة في الدولة العربية في عهود شتى؛ فيجمع االعصر الذهبيب، مثلاً، بين: العدالة في عصر عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، والازدهار الاقتصادي في عهد عمر بن عبدالعزيز، واتساع الدولة في العصر الأموي، وازدهار الفنون والآداب في العصور العباسية، والتلاقح الحضاري في الأندلس، ونبوغ جابر بن حيان في الكيمياء، وابن الهيثم في الفيزياء، وابن سينا والرازي وابن النفيس في الطب، وابن خلدون في علم الاجتماع، والموصلي وزرياب في الموسيقى، وموسوعية الفارابي والبيروني... إلخ.
وبرغم ذلك، يتجه الذهن العربي، عند ذكر مفهوم االعصر الذهبيب، إلى كلا العصرين, الأموي والعباسي الأول، حيث كانت الدولة العربية في أوج قوتها، وكانت الخلافات والتناحرات البينية مُحجَّمة، وتحت سيطرة مركز واحد قوي، قادر على حسم الأمور، وفرض توجهات وسياسات عامة واحدة.
أما القناع الذي نراه في خلفية النص الاستهلالي، الفاقد لإحدى عينيه، والمنزوع عنه ذهبه على نحو مؤسف (إشارة إلى ما فعله الآباء بالأجداد، وينتظر الإنقاذ والبعث على أيدي الأحفاد)، فهو قناع لأحد التوابيت من العصر الوسيط؛ أزهى عصور الحضارة الفرعونية. ونحن نعلم أن الحضارة المصرية القديمة تُقسَّم لدى الباحثين إلى: العصر القديم المبكر، والوسيط، والمتأخر، فالديموطيقي، ثم القبطي.
وعلى ذلك يكون وعي الفنان لدى شادي قد جمع ذروة الفنين الفرعوني والعربي في افتتاحية الفيلم: القناع من فن العصر الوسيط الفرعوني، والخط الكوفي في أوج قوة الدولة العربية .
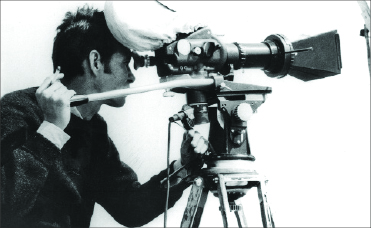
المخرج شادي عبدالسلام أثناء التصوير

