«بغداديات» الفنان ستار لقمان ... أو البحث عن العجائبي في الحكاية الشعبية
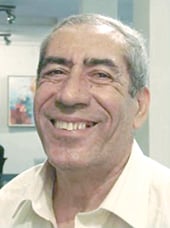
إذا كان الفنان التشكيلي ستار لقمان يعدّ نفسه امتداداً للمدرسة البغدادية في الفن العراقي الحديث، فإنه يجد في المؤسس لهذه المدرسة، الفنان جواد سليم (1919-1961)، معلمه الأول، وحارس خطواته على دربها.
وإن كان قد ذهب في «مغامرته الفنية» إلى ما يؤكد به مساره الشخصي فناناً، فــي تعالق أوسع، وأشمل مع ذلك «الكون الجمــيل» الذي ابتنـــاه أستاذ الجيل.. فإذا هو يبحث عما هو أكـــثر إثارة من مجالي الحياة التي تنفرد بخصوصـــــية التسمــــــية هذه، فاتحاً باب رؤيته الفنية على كل ما يكشف ما لهذا العالم من تعدد المعطيات، مكاناً وزماناً.. مع احتفاء خاص منه بنشوة الخط واللون، تلك النــــشوة التي نجدها في «بغداديات» الأستاذ المعلّم جواد، معمِّقاً إحساسه بالانتماء إلى تقليد فني، إن كان له عمقه التاريخي عند جواد فإنه يجيء بتركيز أوسع، ورؤية أشمل واقعاً عند ستار لقمان، مشحوناً بما للحياة الفولكلورية من طابع، وعالم خاص هو عالم الحكايات الشعبية، بما لها من مرجعيات لعل أكثرها حضوراً وثراءً «ألف ليلة وليلة».
وإذا كنا نجد للحياة البغدادية، في بُعدها الشعبي الأسطوري هذا، وقعها السحري في نفس الفنان وفي عمله الفني، فإنه سيجعل، كما جعل جواد، لـ «فعل اللون» خصوصيته وعمقه، وخصوصاً في الأعمال التي ركز على ما لها من «حقيقة» في الوجدان الشعبي، معتمداً ما يمكن أن نصفه
بـ «الإفاضة» في تفصيلات الشكل المكوِّن للعمل إزاء غيابين: غياب تلك الحياة من بعد تقلّص حضورها في واقع المدينة الاجتماعي الراهن، وغياب ناس تلك الحياة ممن مثلوا، وتتمثّل فيهم، معطياتها الحية.
فما أصبح غائباً، أو في حكم الغياب، يستعيده الفن، لنجد الفنان، في عملية الاستعادة هذه، يركز على ما للأشياء من «أثر إنساني»، فيقبض على الحلم أو ما هو من عالمه، مستجمعاً شظايا ما تبدد، خارجاً برؤاه هذه عبر «الشكل»، ومن خلال «اللون»... فالشكل، في عمل هذا الفنان، يؤلف/ ويتألف من هيئة متكاملة الحضور. ولعل الأكثر أهمية في هذا التكوين هو: الانتقال الذي يعتمده من «المرئي» عيناً، وبرؤية العين، إلى «الإحساس» بهذا المرئي.. ما يجعله يوزع رؤيته، الفنية، في غير اتجاه، شاحناً ذاته بما يستعين به، ويعينه، في عمله هذا: الرؤية التخييلية، واللون المتواشج مع عوالمها الزمانية والمكانية، جاعلاً منها منطلقه في «تكوين» لوحته. وبذلك أوجد لأعماله نسقها الخاص الدال على شخصيته الفنية. أما اللون عنده، والمستخدم من قبله، فهو ما يُعطي الحيوية لهذا كله، بما يجعل من اللوحة نسيجاً خشناً قوياً.
قراءات فنية للواقع
وكان الفنان قد اتخذ من هذا منطلقاً قائماً على التواصل مع ما لهذا التوجه في الفن من أصول كان جواد قد أكد عليها يوم التأسيس لـ «جماعة بغداد للفن الحديث» (1951)، إذ شدد على أن ما يثيرهم، كفنانين، هو «ما في طبيعتنا ومحيطنا المحض.. وأنهم، «جماعةً»، إنما «يُهيئون الأسس للأجيال الشابة القادمة». فإذا ما نظرنا إلى عمله من خلال ذلك فسنجد تأثير جواد عليه، هو «تأثير المولّد» للرؤية/ الرؤيا، لا «استجابة المقلّد». وإذا كان جواد قد أكد أن «الفن لغة، وهذه اللغة يجب أن نتعرّف عليها ولو قليلاً»، فسنجد لمثل هذا التوجه انعكاساته في عمل فناننا، وإن لم يكن كما كان في ما له في عمل جواد الذي وضع هذه اللغة «في قالب جديد يتبع مؤثرات العصر الحديث»، إذ شدّد على أن «الفنان الحق يجب أن يعرف ماذا يرسم ولماذا هو يرسم».
وتأسيساً على هذا يمكن القول إن رؤية الفنان هذه رؤية غنية بالتفاصيل. فهو في «قراءاته الفنية» للواقع كمن يعمد إلى إيقاظ ما للإنسان من تاريخ اجتماعي، حاملاً ذلك التاريخ على مستويين: مستوى الواقع المتمثِّل فيه، ومستوى الحلم الذي يرتقي به إلى ما يأمل أن يرى.. ونجد للمستويين أصداءهما في لوحته. وهو هنا يتصيَّد الأحلام والرؤى أكثر مما يثير التساؤلات. فقراءته هذه كما تجد الواقع الذي تتأسس به/ وعليه، فإنها تُوجد الواقع الذي تؤسس بـ «الشكل» الذي تتخذ، ومن خلال «اللون» الذي يستخدم، وهو فيهما كليهما، «حسّي» يبلغ أعلى درجات الحسيّة.. وفي الوقت نفسه نجده يؤكد على الموضوع الحديث والحي، بما له من تجانس خاص مع حياتنا، فضلاً عن تمكنه من تحقيق هذا التعبير في صور وأشكال مجسِّدة لطبيعته. فإذا كنا نجده يضع «موضوعه» في سياقات متقاربة التعبير، فإن ذلك هو ما يحقق لأسلوبه نزعة الاسترسال التي تُعمّق حضور موضوعاته هذه من دون أن تكرر نفسها.
فكلما توغّل أكثر في تفاصيل عالم لوحاته أصبح أكثر انفتاحاً على هذا العالم الذي يتشكل منه عمله.. فإذا هو عمل متصل بما للحياة من مستويات الرؤية والنظر، وفي ما يحفّ بها من حقائق مرئية.
آفاق الموضوع واستخدام اللون
غير أن قراءتنا عمل الفنان لا تحاصر نفسها بمثل هذا «التعيّن المرجعي» للعمل، وإنما تخرج منه إلى ما تفتح به أفقاً آخر لرؤية عمل هذا الفنان الذي امتاز بخصوصيته في مستويين: الموضوع، واستخدام اللون (وهذا ما ينبغي للعمل الفني أن يكون به)، ما يعني في أخص ما يعنيه أنه فنان يعمل وفقاً لما يتبنى من مُثُل فنية وأخرى موضوعية، فهناك:
- لغة العمل الفني التي تعتمد، عنده، استعادة الماضي استعادة تخيلية، معيدة تعيينه في صور وأشكال دالة تعتمد، أكثر ما تعتمد، «حسيّة المتخيَّل».
- وهناك المعنى المتولد من تشكيلات الماضي التاريخي المجتمعي الذي يتفاعل معها تفاعلاً ذاتياً، كما هو تفاعل متخيَّل الفنان في ما يجمع/ أو يجتمع له من رؤى، بما يشير إلى/ ويؤكد «مبنى» وعي الفنان القائم على فعل ثنائي الحركة، وإن صبَّا في اتجاه/ توجّه واحد، وهما: الاستعادة (متمثَّلَة).. وإحياء ما للمكان، في وجوده الفعلي المتعيِّن فيه، من «دلالة مفترضة».
- ومن اجتماع «اللغة» في إطارها الفني هذا، و«المعنى» الذي تؤلّفه، يتشكل المشهد الذي يتحرك، تشكيلياً، من خلال/ وبثلاثة عناصر: الموضوع القائم، أساساً، على الحكاية في ما لها من أصول فانتازية.. والتناسب بين الشكل واللون.. والتواصل الذي ينبني على ما ندعوه بـ «المغامرة الفنية»، فهو، هنا، لا يُحاكي، وإنما يتمثّل من خلال عملية تخييل لا تبتعد عن الواقع، فإن حصل وابتعدت قليلاً، أو جزئياً، فلكي تعود بعناصر تخييلية تقترب بها من العجائبي تشكيلاً وصورة.. تعزز هذا كله جمالية لها طابعها الخاص، جمالية تتألف من توالي الأشكال والألوان التي تتداخل في نسيج اللوحة لتؤلفها تكويناً.
فإذا ما قلنا إن عين الفنان عين مثقفة «ثقافة صورة»، بما لهذه الصورة من تكوينات، و«ثقافة مكانية»، بما للمكان من حضور زماني هو اليوم، بالنسبة له، «حضور مستعاد» استعادة تخيلية.. فإن خيال الفنان، وحسيّة هذا الخيال هي ما يجعل من أعماله صوراً قائمة، في ما لها من تكوين، على/ وبما يستجمعه هذا الخيال من رؤى أكثر مما هو تجسيد لمشاهد قائمة، أو تعبير عن «تمثيلات» متعينة وجوداً زمانياً ومكانياً. فاللوحة قائمة على ما تجتمع به من «وجود افتراضي» لعناصرها التكوينية، كما أنها تجلٍ لواقع هو، بدوره، التجلي لـ «ذات الفنان» التي تستجمع هذا الواقع في ما تتخيله وتضعه فيه.
فتنة المكان
فهل «فتنة المكان» الذي يعود إليه مرجعاً، و«فتنة الزمان»، الذي يـــــتألف فيه، همــــا ما يشد الفنان ويغــــويه بدخـــــول ما يؤلّف منه عالماً أقرب ما يكون إلى العالم العجــائبي، يأخذه بعيداً في تشكيلاته أكثر مما تأخذه معانيه؟ هذا من جانب.. ومن جانب آخر: هل للمكان، والارتباط المتحقق به على هـــذا النحـــو من طرف الفنان هو ما يــــجعل لعمله هـــويـــته المكانية الزمانــية هذه وهي هويّة متشكلة، بُعداً ومعـــنى ودلالــــة، فيما يعتــــمد في تكوينها، عـــملاً فـــنياً، من مقاربات في قراءة هــــذا الواقع الذي يتدافع به في مدينة زحفت إليه بحداثتها المموهة التي تعمل على إلغاء ما له من خصائص الحضور والتكوين؟
فإذا ما قلنا عن الفنان إنه مــتـــون بواقع قرأ عنه وتمثله تمثلاً تخيـــــيلياً أكثر من تحقق معاينته واقعاً مشخصاً، فإن عمله الفني جاء مرتوياً من روح هذه الفتنة بما لها من جوهر متحرك.. وهذه الحركة ليست حــركة تبدّل وتغيّر بقدر ما هي حركة تعدد وتنوّع: فإذا كنا نجد في عمل فنيّ له المرأة تتكئ إلى آلتها الموسيقية (العود مثلاً)، نجده في لوحة أخرى يفتح لها فضاء أوسع لتكون بحركة جسدها، وبمعايير هذه الحركة، أو ما يُضفي عليها من تشكيلات، محققاً اللقاء بين حالتين/ ذاتين: ذات الرائي، وذات المرئي.. في الوقت الذي يضعنا فيه أمام لحظتين متخيلتين: لحظة الواقع كما تمثله من خلال ما قرأ عنه.. ولحظة تمثيل هذا الواقع في «عمل فني» له خصوصيته الموضوعية. فعتبة الفنان في عمله هذا هي عتبة بغداد القديمة: بأحيائها التي لكل حي منها حالة تكاثف مع نفسه، وبأناسه في ما يُعرفون به من خلال انتمائهم إليه.. ولهذا الحضور حيواته وحيويته التي تجتمع لتتواشج في نسيج فني يرمز إلى/ ويُجسد التفاعل بين المكان قائماً بذاته وما هو منه، والحركة التي يمثلها الإنسان بدلالة حضوره في هذا المكان (الذي فتح الفنان أبوابه المرصودة على ما في داخلها وكأنه يكشف عما هنالك من عالم يعيش فتنته الخاصة بما وراء تلك الأبواب من «أسرار»!
وعلى هذا، نجد «الموضوع»، بما له من بُعد تشكيلي، يتقدم فيكتسب «بُعد حــضور الذات» من خلال علاقة هذه الذات بالمكان فــي ما لها من «زمانية العلاقة» به، التي هي عــــلاقة «الرائي» بـ «المرئي»، كون هذا «المرئي موضوعاً»، محققاً ضرباً من حركية التراسل بين المستوى الرؤوي/ التخييلي والمستوى التعبيري عند الفنان.
فنحن، في أعمال هذا الفـــنان، أمام لوحة إن كانت تجسد «إطاراً مكانياً» حاضراً (هو البيت البغدادي بتكوينه التراثي الدال على ما كان لهذه المدينة من واقع معماري)، فإن «الزمانية المتمثَّلة» في هذا المكان/ ومن خلاله هي «زمانية المتخيَّل» في بُعده الاجتماعي، وفي ما له من خصائص الحضور الإنساني.
والفنان، هنا، وهو يتابع هذا المتخيَّل، ويُعنى بتفاصيله ويشدد على تأكيد ما له من دلالات، يبدو حريصاً على أن يحقق حدّاً معيناً مما ندعوه «شعرية العمل الفني» التي لا تنفصل عن طبيعة المكان، ولا عن الحالة الإنسانية (الزمانية) التي «يتأثث» بها هذا المكان.. فبالنسبة لموضوعاته، في هذا المسار الفني الذي اتخذ، نجده كمن يجعل من الشخوص، في تشكيلات حضورهم، «مُسنداً»، ومن المكان «المُسند إليه». ولعل هذا هو ما قد يجعل مشاهد لوحته (الرائي للعمل الفني) يبقى، في مشاهدته هذه، منشغلاً بعناصرها المكوِّنة، وبما تتفجر به من «عناصر التكوين الموضوعي»، لما تحتازه من «مشهد حياتي» يتوافر على عناصر الجذب والفتنة، ولا نقول الإثارة.
فالفنان ستار لقمان، شأنه شأن معلمه الفنان الــــكبــــير جــــواد سليم، فنان يُمجِّد الحــــيـــاة فــــي فنّه، ويُقبــــل عليها بانفـــتاح كبـــــير .

