مشهــد التاريــخ
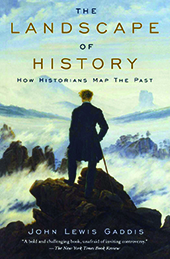
ما التاريخ؟ وما الوعي التاريخي؟ وما طبيعة عمل المؤرخ؟ هل توجد حقيقة تاريخية؟ هل التاريخ علم؟ ما أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين كل من العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية؟
يناقش جون لويس غاديس في كتاب «مشهد التاريخ» هذه الأسئلة إلى جانب أسئلة وقضايا أخرى، تتعلق بمناهج البحث التاريخي والزمان والمكان وإمكان وجود نظرة موضوعية إلى الماضي، وأثر النظريات العلمية الحديثة على البحث التاريخي، وغيرها من القضايا والإشكاليات. ومن ثم، فهو كتاب عن مناهج دراسة التاريخ وروايته، عن عمل المؤرخ ووظيفته، عن طرق الرؤية والنظر، لا عن مجرد المعرفة والمعلومات التاريخية. ومن هنا تأتي أهمية الكتاب وميزته الأساسية؛ حيث يجد القارئ نفسه مدفوعاً إلى مزيد من التفكير والتأمل في الموضوعات التي يطرحها الكتاب ويناقشها.
يقع كتاب «مشهد التاريخ» الصادر عن دار نشر جامعة أكسفورد في 192 صفحة، ويضم مقدمة وثمانية فصول. الفصل الأول بمنزلة مدخل عام عن دراسة التاريخ والوعي التاريخي، ويشير الفصل الثاني إلى موقع التاريخ والمؤرخين بين الفن والعلم وضرورة حفاظ المؤرخين على الموازنة بينهما من حيث معالجة الزمان والمكان. أما الفصول من الثالث إلى السادس، فيناقش المؤلف فيها القضية المحورية؛ هل التاريخ علم أم لا؟ وذلك من منظورات مختلفة؛ فيبدأ بمفهومي البنية والصيرورة واختلاف صورتيهما بين كل من التاريخ والعلوم الطبيعية، ويتابع مقارنة التاريخ بالعلوم الاجتماعية وأيهما أقرب إلى العلوم الطبيعية، ثم يناقش بعض المفاهيم والنظريات العلمية الحديثة مثل الفوضى وعدم التحديد والنسبية والاحتمال والسببية والحتمية والوقائع المضادة ومدى صلة الفكر التاريخي بهذه المفاهيم. أما الفصل السابع، فيؤكد أهمية معايشة المؤرخ لموضوعه، وتزداد أهمية هذا الأمر في حالة كتابة سيرة الأشخاص والترجمة لهم، إذ ترقى هذه المعايشة إلى درجة تقمص الشخصية والتعاطف معها.
ويختتم الكتاب بالفصل الثامن، الذي يعود إلى ما جاء في بداية الكتاب عن الوعي التاريخي، فيشير إلى فكرة النظر بعين المؤرخ التي تسعى إلى تمثيل الواقع وتصويره، وهي في ذلك تتسم بالاشتباك مع الحدث والابتعاد عنه في الوقت ذاته، كما أنها عين ناقدة تسعى إلى تحرير الحاضر مما يتركه الماضي من قيود وأخطاء وأفكار قطعية صارمة.
مؤلف الكتاب هو المؤرخ جون لويس غاديس، أستاذ التاريخ بجامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعد أبرز مؤرخي الحرب الباردة، حيث صدرت له كتب عدة عن الحرب الباردة واستراتيجية الاحتواء التي طبقتها الولايات المتحدة إزاء الاتحاد السوفييتي، ومن هذه الكتب: «الولايات المتحدة وجذور الحرب الباردة» 1972، «روسيا والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة» 1978، «استراتيجيات الاحتواء» 1982، «السلام الطويل» 1987، «الولايات المتحدة ونهاية الحرب الباردة» 1992، و«الحرب الباردة: تاريخ جديد» 2005.
كذلك كتب غاديس سيرة السياسي الأمريكي الشهير جورج كينان، وحصل بها على جائزة بوليتزر لأفضل سيرة حياة عام 2012. ومن ثم، يمكن القول إن كتاب «مشهد التاريخ» يمثل حلقة جديدة في سلسلة الكتب التي يضعها مؤرخون بارزون يضمنونها خلاصة خبراتهم بعد ممارستهم للتدوين التاريخي، وهي كتب تتناول طبيعة التاريخ ومهنة المؤرخ والقضايا المنهجية والفلسفية المتعلقة بالتاريخ وتدوينه. وهذا ما سبق أن قدمه، على سبيل المثال، مارك بلوخ في كتابه «دفاعا عن التاريخ أو مهنة المؤرخ» 1949، وروبين كولنغوود في «فكرة التاريخ» 1956، وجوفري إلتون في «ممارسة التاريخ» 1967، وإدوارد كار في «ما التاريخ؟» 1961.
الوعي التاريخي... المؤرخون وتصوير الماضي
يستلهم غاديس في كتابه هذا كلا من مارك بلوخ وإدوارد كار، ويشير إليهما باستمرار على امتداد الكتاب، موضحا أنه يقدم تطويراً لأطروحتيهما من خلال ما استجد من نظريات علمية، ويحاول تبسيط وتوضيح بعض الأمور المعقدة والغامضة في مناهج البحث التاريخي بطريقة تعليمية. ومن أجل توضيح رؤيته لماهية الوعي التاريخي ونظرة المؤرخ إلى الماضي، يستخدم المؤلف لوحة من أعمال الرسَّام الألماني كاسبر ديفيد فريدريك، وهي لوحة «متجوِّل فوق بحر من الضباب» التي يرجع تاريخها إلى عام 1818. يصف غاديس اللوحة قائلا: «رجل شاب يقف حاسر الرأس مرتدياً معطفاً داكناً فوق حافة صخرية مرتفعة. يولينا الرجل ظهره، ويثبت نفسه بعصا مشي في مواجهة الرياح التي تعصف بشعره الملبَّد. يمتد أمامه مشهد يغلفه الضباب، وفيه تلوح جزئياً الأشكال العجيبة لنتوءات صخرية على مسافة أبعد. كما يكشف الأفق البعيد عن جبال جهة اليسار، وأرض منبسطة جهة اليمين، وربما يظهر بعيداً جداً - لا يمكن للمرء تأكيد ذلك - أحد المحيطات. إلا أنه قد لا يكون سوى مزيد من الضباب وقد اندمج مع السحب بصورة دقيقة غير محسوسة... تترك اللوحة انطباعًا متناقضًا؛ حيث توحي بسيادة شخص ما على المشهد، وتوحي في الوقت ذاته بعدم أهميته داخله. لا نرى أي وجه في اللوحة، ومن ثم فمن المستحيل معرفة ما إذا كان المنظر المواجه للرجل الشاب مبهجاً أو مرعباً أو كليهما معاً». إن الوعي بمشهد التاريخ يشبه ما تصوره اللوحة، الابتعاد عن المشهد بمسافة ما وعدم الانغماس فيه، التوتر القائم بين شعور الشخص بالضخامة والسيطرة على المشهد وشعوره في الوقت ذاته بالتفاهة والصغر مقارنة بما يتجلى له، التوتر بين التجريد والتعميم من ناحية والتخصيص والتمثيل الحرفي من ناحية أخرى، الإحساس بالفضول الممتزج بالرهبة والتصميم على اكتشاف الأشياء ووصفها وتصويرها.
وهكذا، يعمل التاريخ على توسيع الأفق واتساع الرؤية، فإذا كان الماضي بمنزلة المشهد، فإن التاريخ هو طريقة رؤيتنا وتمثلنا لهذا المشهد، وهو ما يرفعنا ويرتقي بنا فوق العادي والدارج لندرك ما لا يمكننا رؤيته مباشرة وعن قرب. إن الخبرة المباشرة بالأحداث والافتقار إلى الوعي التاريخي ليسا بالضرورة أفضل طريقة لفهمها واستيعابها، حيث لا يتعدى مجال رؤية الإنسان وإدراكه حدود حواسه المباشرة وما يصل إليه من جزئيات ومعلومات آنية متفرقة، إنه يفتقد ما يمنحه التاريخ من اتساع الرؤية والأفق وملاحظة الأنماط المتكررة والقدرة على المقارنة بين الأحداث من خلال خبرات تمتد في الزمان والمكان. بل يؤكد المؤلف أن المؤرخ أفضل فهماً واستيعاباً للحاضر من المشاركين فيه مباشرة، وذلك انطلاقاً من حقيقة بسيطة هي أنه لديه أفق ورؤية أوسع.
كذلك، يُشبِّه المؤلف ما يقوم به المؤرخون من تجريد وتمثيل بعلم أو فن رسم الخرائط، فكما أن الخرائط ليست هي الطبيعة والتضاريس ذاتها، وإنما تمثيل وتصوير لها، فكذلك التاريخ هو طريقة تمثلنا لمشهد الماضي وتصويره. ويزيد غاديس هذه النقطة توضيحاً بقوله إنه كما يقوم واضعو الخرائط ومصمموها بتصوير ورسم البلاد والطرق والسمات الجيولوجية للمكان ومحاكاتها، فكذلك على المؤرخين تمثيل الماضي ومحاكاته وليس إعادة إنتاجه حرفياً.
وهنا تبرز براعة المؤرخ في معالجة الزمان والمكان والتلاعب بهما اقتراباً وابتعاداً من أجل تكوين صورة كلية للحدث التاريخي. وخلال ملاحظته ورصده لمشهد الماضي، يقوم المؤلف بعمليات انتقاء واختيار وتركيز على أحداث بعينها أو أماكن وأوقات دون غيرها، وهنا فإن موقع الملاحظة والرصد يؤثر في رؤية المؤرخ للأحداث والموضوعات التي يلاحظها، مما ينشأ عنه القول بصعوبة وجود الموضوعية والحقيقة التاريخية، وهذا يشبه إلى حد كبير مبدأ «عدم التحديد» في الفيزياء الحديثة، الذي صاغه الفيزيائي الألماني هيزنبرج.
هل التاريخ علم؟
للإجابة عن هذا السؤال ومحاولة توضيح العلاقة بين التاريخ والعلم، يسلك المؤلف مساراً عكسياً من العلم إلى التاريخ، حيث يستدعي نظريات ومفاهيم علمية حديثة ليقيم الدليل على أن التاريخ، خلافاً للتصور الشائع، يستخدم المناهج ذاتها الموجودة في العلوم الطبيعية.
وتفسير ذلك ليس أن التاريخ قد تغير بمرور السنين ليأخذ طابعاً علمياً أكثر، وإنما العلم هو الذي تغير ليقترب أكثر من الطابع التاريخي. لقد غيَّرت الفيزياء الحديثة طبيعة العلم، حيث تخلى عن طابعه الخطي الحتمي الذي اتسم به في الماضي مع فيزياء نيوتن، ليصبح ذا طبيعة مختلفة تسودها مفاهيم مثل النسبية والاحتمال وعدم التحديد والفوضى والتعقيد. فنجد علماء الفيزياء النظرية مثل أينشتاين وعلماء الفلك مثلاً يعتمدون في المقام الأول على ما يطلق عليه غاديس «تجارب الفكر» وليس تجارب المعمل، وتجارب الفكر هذه تشبه الحكاية التاريخية، وكلاهما يقوم على العمل الذهني والسرد من أجل الفحص وتوضيح كيفية حدوث الأشياء، وبالتالي تحديد أسبابها وعللها.
من ناحية أخرى، يلتقي التاريخ مع العلم الطبيعي في آلية حدوث الاكتشافات الجديدة، حيث يستلزم الاكتشاف الجديد المقارنة مع ما هو قائم بالفعل، وخلال هذه المقارنة يلجأ الباحث، سواء في التاريخ أو في العلوم الطبيعية، إلى استخدام منهج الاستنباط ومنهج الاستقراء. إن دراسة التاريخ ينبغي أن تحذو حذو العلوم الطبيعية ومناهجها، سواء في الخطوات والإجراءات النظرية أو العملية.
من ناحية أخرى، يؤكد غاديس أن المناهج التي يستخدمها المؤرخون أقرب إلى مناهج العلوم الطبيعية الصارمة منها إلى مناهج العلوم الاجتماعية، فالباحثون في مجال العلوم الاجتماعية يركزون على انفصال المتغيرات واستقلال بعضها عن بعض، ما يؤدي بهم إلى الوقوع في عمليات اختزال وتسطيح للمجتمعات الإنسانية ومشكلاتها، التي تنطوي على علاقات وظواهر مركبة يتداخل فيها السياسي والاقتصادي والديني. هذا الاختزال للظواهر الإنسانية وردها إلى عوامل مستقلة بعضها عن بعض، مهما تعددت تلك العوامل، يبتعد بمناهج العلوم الاجتماعية عن مناهج العلوم الطبيعية.
أما المؤرخون فيفترضون ارتباط المتغيرات والعوامل المؤثرة وتشابكها، وأن المجتمع الإنساني أكبر من مجموع أجزائه، وأن ما يبدو خطياً وقابلاً للتنبؤ به يدخل، عند البحث والتحقيق، في دائرة الاحتمال وعدم التنبؤ؛ وهم في ذلك أقرب إلى نظريات علمية مثل نظريات الفوضى (الشواش) والتركيب التي تبحث في سلوك الأنظمة الديناميكية والظواهر المركبة.
أما عن السببية وعلاقة الأسباب بالنتائج والتحقق من دقتها، فبالإضافة إلى الربط بين الأسباب المباشرة والمتوسطة والبعيدة، أي البدء بالبنية ومحاولة استخلاص العمليات التي أنتجتها، فهناك أسلوب إضافي يسلكه المؤرخون لعدم إمكان عرض الأحداث التاريخية، وهو التفكير عن طريق الوقائع المضادة، أي افتراض عكس ما حدث بالفعل واستخلاص نتائج مختلفة، وهو ما يطلق عليه أسلوب «ماذا لو؟»، وذلك في محاولة للوصول إلى أقرب تفسير عقلي مقبول وتعميمات مقنعة ودروس مستفادة.
أما عند التأريخ لحياة شخص ما، فإن غاديس يؤكد أهمية تقمص المؤرخ شخصية مَن يؤرخ له، أن يدخل عقله وروحه ويتعاطف معه ليفهم دوافعه ويفسر سلوكه. فهناك أنماط من السلوك الإنساني تمتد وتتكرر مع اختلاف الزمان والمكان، وهو ما يجب على المؤرخ الانتباه إليه وهو يكتب عن شخص بعينه. إن المؤرخ بإمكانه إصدار حكم أخلاقي نهائي على شخص بعينه، ورغم أنه ينبغي أن يكون حكما غير متحيز، فإنه غالبا ما يكون كذلك.
أخيراً، يمكن القول إن هذا الكتاب بمنزلة مشهد يصور للقارئ عمل المؤرخين ونظرتهم إلى الماضي ومناهج البحث التاريخي وعلاقة التاريخ بالعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، ومن ثم فإنه يكتسب أهمية خاصة لدى الباحثين في التاريخ والطلاب الذين يدرسون التاريخ، وكذلك القارئ العام غير المتخصص، وذلك لتميزه بالوضوح والشمول والبساطة والإيجاز.

