الاقتباس من المحكي الروائي إلى المحكي الفيلمي
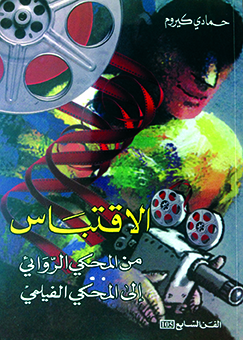
للوهلة الأولى تحيلنا كلمة «اقتباس» إلى وجود نص أصلي، ونص آخر مأخوذ عنه، سواء كان ذلك النص الأول مكتوباً أو مصوراً، طويلاً أو قصيراً. لكن الناقد والباحث السينمائي المغربي حمادي كيروم يتعمق في كتابه «الاقتباس من المحكي الروائي إلى المحكي الفيلمي» الصادر في دمشق ضمن سلسلة الفن السابع (107)، ليأخذنا إلى أدغال هذا المفهوم. ففي الفصل الأول، يتناول المؤلف جماليات الاقتباس، مشيراً إلى حيرة كاتب وسيناريست فرنسي كبير، هو جان كلود كاريير، في تحويل نص أدبي، ومدى حق أو حرية المخرج أو كاتب السيناريو في التعامل مع الاقتباس:
«إذا كتب مارسيل بروست أن دوقة كيرمونت كانت شقراء ولها أنف أقني، وتتحدث بطريقة خاصة، فهل لنا «الحق» - وبما أننا نستعمل اسمه - أن نتصورها سمراء وتتكلم بطريقة أخرى؟».
زاوية أخرى في الاقتباس يطرحها الكاتب والمخرج باولو بازوليني، وهي كيف أن الانتقال من الرواية إلى السينما يطرح مسألة تقنية وأسلوبية؟ لأننا بهذا ننتقل من لسان، أي من لغة وطنية، إلى لغة غير وطنية، بمعنى أن المسألة هنا تتعلق بالبحث عن تقنية عامة، عالمية، وكونية، أي البحث عن لغة «إسبرنتو» يفهمها كل الناس وتتجاوز الحدود الوطنية والجغرافية.
الاقتباس الحرفي والاقتباس الحر
وطبقا للمؤلف، فإن أغلب الدراسات تستخدم «الاقتباس» في مجالي «الاقتباس السينمائي» و«الاقتباس المسرحي»، لكن هناك وجهين للمصطلح يتمثلان في الاقتباس الحرفي (الاقتباس الأمين) والاقتباس الحُر (الاقتباس غير الأمين).
والنوع الأول - كما حددته مبادئ المؤسسة الهوليوودية - يحترم فيه السيناريست، أو المخرج المقتبس المعطى الروائي، ويقتصر دوره على تحويل كلمات الرواية إلى صور الفيلم، وعدم التدخل - قدر المستطاع - في العمل الأصلي، كما ينبغي ألا يبتكر أحداثاً قد تحرِّف الفيلم عن الخط الذي رسمته الرواية.
وتركز هذه النظرية السردية السينمائية الهوليوودية على بنية الصراع المركزي بين الأبطال، وقد ظهــــرت كصيــــغة عمل اختيارية - في البداية - قبل أن تتحول إلى قانون ملزم.
أما في الاقتباس الحر، فقد أصبح من الممكن القول إن الكتابات لا يمكن اختزالها، لأنه ليس هناك تطابق بين الرواية والفيلم، ومن ثم يعد أنصار هذا المذهب الاقتباسَ تشخيصاً دالاً على إنتاج المعنى.
ويستشهد المؤلف بقول المخرج أوجست سترينبرج إن «قراءة النص الروائي بهدف اقتباسه هي بمنزلة قراءة لنوتة موسيقية، فهي مهارة صعبة».
والصعوبة تكمن في أنها مرحلة اختبار، بحث عن أسئلة وإجابات، وحذَّر المخرج ستلانسلافسكي من الانطباع الأولي لدى المخرج المقتبِس، لأنه انطباع يؤدي إلى التسطيح، وفضل اعتماد رؤية عميقة ومتروية مشبّعة بالاجتهاد.
ويُعرِّف الكاتب في فصله الثاني (ضمن المبحث الأول) تحت عنوان «المحكي الفيلمي» مجموعة من الاصطلاحات تبدأ مع السينما المبكرة، وإذا كانت السينما بدأت بفيلم «وصول القطار إلى المحطة» للأخوين لوميير عام 1895م، بمشهد بدا حقيقياً وجعل المشاهدين يهربون من القطار القادم نحوهم، فإن آندريه تاركوفسكي، شاعر وفيلسوف السينما السوفييتية، يقول إن ولادة «الفن السينمائي» تمت في تلك اللحظة بالذات، حيث لم يتعلق الأمر بوجود تقنية سينمائية فحسب، وإنما بولادة مبدأ جمالي جديد.
إن هذا المبدأ يعني - بالنسبة لتاركوفسكي - أن الإنسان تمكن، ولأول مرة في تاريخ الثقافة والفن، من العثور على أسلوب يمكنه مباشرة من تسجيل الزمن المرئي وتخزينه، وإمكان إعادة عرضه مرات عدة.
في المبحث الثاني، وتحت عنوان «مادة تعبير المحكي الفيلمي»، يحدد المؤلف مجموعة عناصر أساسية تساعد الوسيط السينمائي على إنتاج السرد، وهي جهاز السينماتوغراف، الذي يخلق طقوس العرض، ويتحكم في عملية التلقي/ الإدراك، للصورة والصوت. ثم جهاز الشاشة، منبع الانسياب البصري،
وأخيراً النجومية، التي تغري المشاهد وتستدرجه إلى التماهي مع ممثله المفضل، ولولا هذه الظاهرة لما أخذ أشخاص أمثال فالنتينو وجيمس دين ومارلين مونرو وكلارك جيبل وعمر الشريف وفاتن حمامة أبعاداً اسطورية جعلتهم خالدين في متخيل الجماهير.
في الفصل الثالث، يتناول المؤلف مكونات المحكي السينمائي، الذي ينقل التلفظ إلى السرد، والمكتوب إلى المشاهد المتتابعة، ويحدد أركان الفيلم السردية بالراوي الظاهر والمصور الأكبر، والمحكي الشفوي، عندما تحكي الشخصيات، والمحكي السمعي البصري، عندما يظهر لنا من خلال الصور المتحركة والأنغام المتدفقة ما يكمل المحكي الأول، حين تتلاشى صورة الراوي، ليصبح ما يقوله مجسداً على الشاشة.
وإذا كانت السينما، شكلاً، خليطاً من المواد التعبيرية، فإن الركن الأساس للمحكي الفيلمي غير موحد. لذلك تأتي اللغة السينمائية في ثلاث مجموعات، أيقونية ولفظية وموسيقية، تؤسس معاً الخطاب الفيلمي.
فضاء المحكي السينمائي
إن الفضاء العربي أو الأوربــــي أو الأمــــريكي اللاتيني ليس له حقــيقة فيـــزيقــــية، ولكــــنه نتــــاج تكوين وتشكيل جغرافي واقـــتصادي وســــكاني وســـياسي وأنثروبــــــولوجــي، لذلــــك فإن ما يعرضه الفيلم هـــو عبارة عــــن أمكــــنة تسعى سماتها التكوينيـــة إلى تمــــثيل وتشخيــــص الفضاء الذي يظل دائماً افتراضياً، فالســـيــنما عليها ألا تكتفي بعرض الأمكنة الواقعيــــة، وإنــــما عليها أن تبني فضاء تخييلياً لا يمكن اختزاله في مقاطع سمعية ومرئية عدة، إنما هو عالم متكامل يسمى فضاء المحكـــي السينمائي.
لهذا تتجـــلى أهـــميــة بناء الديكــــورات لخـــــلق هذا العالـــم الجديد، الذي يستلهمه صنَّاع السينما من واقع النص المكتوب، وتاريخ المكان المختار لرواية النص السينمائي الجديد.
في المبحث الرابع، وضمن الفصل الثالث، يختار المؤلف الحديث عن الزمنية السردية، وهي ما تعبر عنها ثنائية «زمن الحكاية وزمن الفاعل».
وإذا كانت الفوتوغرافيـــا تقدم لنا شيئا حدث، فإن السينما على العكس تعطي الإحساس بالواقع الحي أو «الهُنا الحي»، وفق تعبير كريستيان مـــيتـــز، حيث لا تقبل السينما إلا الزمن الحاضر، لأن الصورة السينمائيــة تقدم «الآن» ما اختارته مما «حدث في الماضي».
يخصص المؤلف مبحثه الخامس للشخصيات، ويرى أن الشخصية الفيلمية تختلف عن نظيرتها الروائية، فإذا كانت في الرواية مجرد كائن من ورق، نمطي، فإن الشخصية الفيلمية السينمائية «كائن أيقوني»، تشبه الشخصيات الحية في الواقع، تحمل جسد الممثل، ومن ثم هي هجين بين ما هو مكتوب، وبين ما هو مصور، بين الرواية، والشخصية الحقيقية للممثل. ويرى أن النجوم حين يدخلون إلى عالم الفيلم من أجل تجسيد شخصية معينة، فإنهم في الوقت نفسه يمثلون هذه الشخصية وكل الشخصيات الأخرى التي سبق أن شخصوها. بهذا المعنى، يحمل الممثل قدراً كبيراً من التناص، وتتغذى صورته حسب منطق النجوم بخطابات صحفية ولدى الجماهير.
رواية/فيلم «بداية ونهاية» نموذج للاقتباس
في الباب الثاني، يبدأ المؤلف الحديث عن كرونولوجيا (تسلسل) المشاهد، ففي فيلم «بداية ونهاية»، المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ، هناك 92 فصلاً، في النص المكتوب، تتحول إلى سبعين مشهداً كتبها السيناريست صلاح عز الدين، وأخرجها صلاح أبوسيف، وصورها كمال كريم، وأعد لها الديكور حلمي عزب، ووضع موسيقاها فؤاد الطاهري، وقام بالمونتاج إميل بحري، وشخص الأدوار أمينة رزق، في دور الأم، وعمر الشريف، في دور حسنين، وفريد شوقي، في دور حسن، وحسين كمال في دور حسين، وسناء جميل، في دور الأخت نفيسة.
ويوثق الكتاب المشاهد التي تبدأ بلقطة عامة لإحدى حارات القاهرة القديمة، مع عنوان 1936، يحدد الحقبة التاريخية للرواية، وصولا للمشهد الأخير الذي يصفع فيه حسنين شقيقته وهما يخرجان من باب قسم الشرطة، وتمنعه من قتلها، إشفاقاً عليه، يأخذها بسيارة أجرة إلى كوبري الزمالك حيث تلقي بنفسها في النيل، ويؤنبه ضميره لأول مرة، حيث يعرف حقيقة نفسه، ما يدفعه إلى الانتحار بعدها مباشرة.
وفي الفصول التالية، يحلل الكاتب الفيلم نفسه، محدداً الراوي الفيلمي، والراوي الثانوي، والفضاء الذي تم بناؤه في فيلم «بداية ونهاية»، حيث تأخذ الحارة أهمية كبيرة في أدب نجيب محفوظ، وقد استطاع أن يكثف الوصف ويعطي العلامات المكانية والبصرية بدقة ليحدد هوية الحارة المصرية، ومن هنا أعاد المخرج بناء وتشخيص الحارة، معتمداً على وعي نجيب محفوظ الوصفي والسردي، لتنشأ حارة «بداية ونهاية» من خلال وعيين: وعي الكاتب ووعي المخرج.
ويتضح للمؤلف، في خاتمة الكتاب، أن صلاح أبوسيف لم يخن الرواية ولم يخن السينما، لأن موهبته الإبداعية مكنته من خلق نسق من التناظرات معادل لما استعملته الرواية.
ويشير الكاتب إلى نـــــوع من التواطــــؤ الفكــري والفني، يجمع بيــــن حســــاسية نجيب محفوظ وحساسية صلاح أبوسيف، ولهذا فإن الرواية أصبحت رواية بسبب أدبيتها، وأصبح الفيلم فيلماً بفضل سينمائيته، أو سينماتوغرافيته.
ويخلص المؤلف إلى أن الاقتباس يمكن أن يكـــــون علــــماً قائماً بذاتـــه، يسميه Ldaptologie، أو علم الاقتباس، يمكن أن توضع له قواعد وقوانين إجرائية تحدد وضعه الاعتباري.
إن التعايش والتفاعل بين الرواية والسينما أصبحا ضروريين، لأن أحدهما في حاجة إلى الآخر؛ فعلى السينما أن تستفيد من الرواية التي سبقتها وفتحت عوالم وتجارب إنسانية عميقة، مما سيساعدها على الانعتاق من قــبضة المفهوم التجاري، كما أن السينما بدورها استطاعت أن تقدم خدمات مهمة لكثير من الأعمال الروائية التي أخرجتها من رفوف المكتبات وقدمتها لجمهور أوسع لا يمكن أبدا أن يقرأها، كما قدمت السينما تقنيات جديدة في عالم الحكي ساعدت الرواية على تجديد أسلوبها، ما جعلها تساير عصر الحكي السينمائي الذي يعتمد على الفرجة المشهدية والإبهار .

