الغناء اللبناني في القرن العشرين
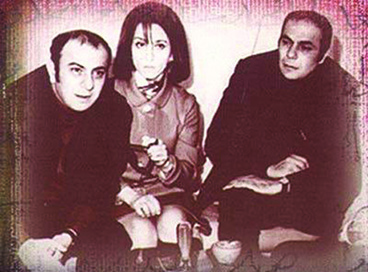
الغناء اللبناني في القرن العشرين من أروع وأجمل ما غنّى العرب في العصر الحديث. وقد امتاز هذا الغناء بالحرص على الأصالة والحداثة في آن، فجمع بينهما. انفتح على التراث الفولكلوري للبنان وبقية بلاد الشام، ونهل منه وأحياه بنكهة عصرية وتوزيع موسيقي جديد. ولكن جهد هذا الغناء لم يقتصر على إحياء التراث، والتنويع عليه، بل ابتدع فنونًا لم يتطرق
إليها الغناء في أي بلد عربي آخر.
من هذه الفنون «المسرحية الغنائية» التي اشتهر بها الرحابنة، التي تشتمل على موسيقى وغناء فردي وجماعي ورقص، وقصة، وتاريخ، وتضارع أفضل ما لدى الغربيين منها، فيشيد بها هؤلاء الغربيون، كما يشيد العرب سواء بسواء. فها هو علي الراعي، أحد عُمُد المسرح في مصر يقول لي مرة إن ما حققه اللبنانيون في موضوع «المسرح الغنائي» لم ينجزه المصريون ولا أي شعب عربي آخر. وكان علي الراعي يضيف إلى ذلك معدّدًا إنجازات هذا المسرح اللبناني, فيقول إنه مسرح «هادف» أيضًا يلتزم فيه مبدعوه بهدف وطني أو اجتماعي أو أخلاقي، وليس مجرد مسرح عابث أو فكاهي يتقصد الترفيه وما إليه.
وقد بدأ هذا الغناء اللبناني المعاصر مع إطلالة العصر الحديث وتداخل فيه المصري واللبناني. فها هو ديوان أمير الشعراء أحمد شوقي يتضمن غزلية قالها شوقي، كما يرد في متن القصيدة, في مطربة لبنانية اسمها ليلى لزمي، كان شوقي يتقاسم الإعجاب بها مع شاعر القطرين خليل مطران. مطلع هذه القصيدة التي يغنيها محمد عبدالوهاب:
رُدّت الروحُ على المضنى معَكْ
أحسنُ الأيام يوم أرجَعكْ
مرّ من بُعدِكَ ما روّعني
أتُرى يا حلوُ بُعدي روّعكْ
تاريخ القصيدة في «الشوقيات» يعود إلى عام 1911، أي إلى ما قبل مائة عام. وهذا يعني أن التفاعل الفني والغنائي بين القطرين يعود إلى مرحلة مبكرة. ولا نعرف بالضبط لون الغناء الذي كانت تغنّيه ليلى لزمي. الأرجح أنها كانت بـ«المصري» لا بـ«اللبناني»، الذي لم يكن قد تجاوز بعد حدود الجبل اللبناني، في حين كان الغناء المصري في مرحلة نهوض يومها، مع أبوالعلا محمد وسيد درويش ورفاقهما.
ولكن إذا ثبت أن هذه المطربة اللبنانية غنّت بـ«المصري»، فإن الغناء اللبناني كان يغزو مصر عن طريق آخر غير تجاري. فالذين كتبوا عن الأديبة اللبنانية المتمصرة مي زيادة صاحبة الصالون الأدبي الشهير في القاهرة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، يروون أن مي كانت تستبقي بعد انفضاض هذا الصالون، نخبة من الأدباء والشعراء كانت تغني لهم أغاني لبنانية تراثية ذكروا منها أغنية «عالروزنا الروزانا.. كل الهنا فيها»، وهذا إن دل على شيء فيدل على بداية التلاقي الفني بين البلدين اللذين ستلقي الأقدار عليهما معا مسئولية قيادة الغناء العربي الحديث وتطويره ونشره في كل صقع عربي.
شخصية مستقلة
على أن الغناء اللبناني لا يُذكر الآن إلا بشخصيته الخاصة المستقلة عن الغناء المصري، على الرغم من الوشائج القوية التي تربطه به. فهو غناء خاص مختلف عن الغناء المصري في مسائل كثيرة منها اللغة، أو اللهجة المعتمدة في الغناء، على الأصح. فالغناء اللبناني يعتمد اللهجة اللبنانية مبدئيًا، كما لا يتنكر للعربية الفصحى. أما اللهجة المصرية فقد غزت هذا الغناء في مرحلة من المراحل، قبل أن يقف على قدميه ويؤكد استقلاليته. كان المغني اللبناني يغني بالمصرية في مرابع لبنان ولياليه، إما مقلّدا لأغنيات مصرية مشهورة، أو موضوعًا له، ومن قبل مؤلفين مصريين أو لبنانيين، نصوصًا بالمصرية.
ولكن الخمسينيات شهدت ما يشبه الانقلاب الذي ربما تقصّدته جهات فنية لبنانية، كمؤسسة الرحابنة على الخصوص. كانت وجهة نظر هذه الجهات أنه لا لزوم لتقليد المغنين المصريين في لهجتهم، فكما أن من حقهم أن يغنّوا بلهجتهم، من حقنا - نحن اللبنانيين - أن نغني بلهجتنا. وشكّل هذا التوجه، كما أشرنا، نوعًا من انقلاب كانت له نتائجه الخطيرة لاحقًا.
وقد نجح هذا الانقلاب «اللغوي»، إن جاز التعبير، نجاحًا مذهلاً، فالأغنية اللبنانية، شكلاً وموضوعًا، تجاوزت حدود الإقليم اللبناني، وأصبحت على كل لسان في الجزائر والمغرب وتونس والخليج والعراق وحتى في مصر نفسها. وقد ساعد الأغنية اللبنانية هذه توافر مناخ لبناني ملائم، وبيئة حاضنة، ومؤسسات تُعنى عناية منهجية بنمو وتطور هذه الأغنية. فـ«الماكينة» الرحبانية لم توجد ماكينة مماثلة أو مشابهة لها إلا في مصر مع أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب. ومع الوقت باتت فيروز تُقرن بأم كلثوم سيدة الغناء العربي وتُحسب في مصافها. وكانت الرحبانية في واقع أمرها حزبًا فنيًا أكثر مما كانت نصوصًا وألحانًا وغناء. وقد أطلق هذه «الرحبانية» أخوان ملهمان موهوبان هما عاصي ومنصور الرحباني، اللذان كانا مجموعة مواهب لا تتوافر عادة في شخص أو شخصين: ذلك أن كلا منهما كان شاعراً كما كان ملحنًا وموزعًا موسيقيًا. وقد وجدا أنه آن الأوان لتحرير الأغنية اللبنانية من اللهجة المصرية وإطلاقها كأغنية لها مواصفاتها ومميزاتها الخاصة.. وهكذا كان.
ربيع لا تصنعه سنونوة واحدة
يمكن للمرء أن يعدد - ودون أن يقع في المبالغة - فضائل الحركة الرحبانية هذه وما قدّمته للأغنية اللبنانية والأغنية العربية. ولكن الربيع كما هو معروف لا تصنعه سنونوة واحدة أو زهرة واحدة، وإنما تصنعه سنونوات وأزهار بلا حصر. فالرحابنة لم يكونوا وحدهم، وإنما كان هناك مطربون وملحنون وموسيقيون ومؤلفون كثيرون شاركوا جميعًا في هذا النشيد الفني العظيم. وحتى في إطار «الرحبانية» بالذات، كان هناك آخرون غير رحابنة منهم شعراء كسعيد عقل وسواه كتبوا لفيروز، وملحنون لحّنوا لها مثل محمد عبدالوهاب نفسه. أما في غير إطار «الرحبانية»، فقد كان هناك جهد كبير لفنانين كبار منهم وديع الصافي وصباح ونور الهدى ونصري شمس الدين ونجاح سلام وسميرة توفيق وسهام رفقي وزكية حمدان وآخرون. فالحركة الغنائية الكبرى التي أشعّت من لبنان ابتداء من الأربعينيات والخمسينيات شملت الرحابنة، كما شملت غير الرحابنة. ولكن لأننا اعتدنا الاختزال، فقد جرى التركيز على فيروز والرحابنة وإهمال الآخرين. الرحابنة كانوا عنوانًا كبيرًا من عناوين هذه النهضة العظيمة، ولكنهم لم يكونوا وحدهم.
ومن أجل توكيد ذلك نشير إلى دور مهم لعبه وديع الصافي الذي رحل حديثًا، والذي يعود إليه فضل كبير في إحياء «البلدي» اللبناني. قبل وديع، كان البلدي منظورًا إليه على أنه غناء أهل الجبل والريف. أما المدينة، أو الحاضرة، فلها غناء آخر. تجاهل وديع الصافي هذا النظر، أو رفضه على الأصح، معتبرًا أن «العتابا والميجانا وأبو الزلف والمواويل والمعنى والشروقي وبقية هذه الألوان اللصيقة بتراثنا وأفراحنا هي لكل لبنان، لا لناحية أو جهة فيه». فهي ألوان من الغناء اللبناني كله لا ألوان من بلاد الشوف أو سواه من أنحاء الجبل. وقد ساعد وديع في مهمته هذه صوته الذي يشبه صوت «الكروان» من حيث قوته وأثره، كما ساعدته محبة الجمهور لهذا اللون واحتضانه له. أخذت الأغنية الريفية تنتشر منذ هبط وديع الصافي من قريته نيحا إلى بيروت، وبدأ المسئولون في الإذاعة اللبنانية ينظرون نظرة مختلفة إليها. وكان وديع الصافي هو حامل راية هذه الأغنية الأول والمبشّر بها، والذي تجرّأ أولا على النزول بشرواله الجبلي إلى المدينة، مفتخرًا بتراثه ومعتزًا به. ومن يومها بدأ مسار الأغنية العربية يتعدّل. فلم يعد ممثلها الشرعي الوحيد - إن جاز التعبير - هو الغناء المصري. أصبح هناك من يزاحم هذا الغناء، وهذا المزاحم لا تقتصر مزاحمته على قطر واحد من بلاد العرب، بل شملت وتشمل كل قطر.
وكان لآخرين دورهم وإسهامهم في شيوع هذا «اللبناني», حيث يقتضي الإنصاف الإشارة إلى دور المطربة الكبيرة صباح التي كانت موزعة في آن معًا على «اللبناني» وعلى «المصري». تغني في مصر بالمصرية وفي لبنان باللبنانية، وكثيرًا ما تجمع بينهما. ومن بين الذين غنّوا باللهجتين نور الهدى التي كان اسمها أو صوتها ذات يوم يرنّ كالذهب. وقد استمر شهر العسل قويًا بين الساحة المصرية وهاتين المطربتين حتى قيام ثورة 23 يوليو عام 1952، التي تركت نور الهدى على إثرها مصر وعادت إلى لبنان، في حين تأخرت عنها صباح سنوات عدة.
بين البدوي والبغدادي
على أن الغناء اللبناني عرف فنونًا غنائية كثيرة غير «اللبناني» التقليدي، من هذه الفنون التي عرفت ازدهارًا واسعًا في البلاد العربية، الغناء البدوي، كالغناء الذي كانت تغنيه سهام رفقي وغنته من بعدها سميرة توفيق.
ومن هذه الفنون المواويل المسمّاة «بغدادية» التي اشتهر بها مطربون تخصصوا بها مثل إيليا بيضا الذي اغترب في ما بعد ومات في مغتربه.
وقد بقيت الأغنية بالفصحى تغنّى على الدوام وتلقى اهتمامًا كبيرًا. إن ما لا يقل عن ربع أو ثلث ما غنته فيروز مكتوب باللغة الفصحى. وفي هذه اللغة جرى التعبير عن مواجد العرب الوطنية والقومية ومناسباتهم وأيامهم. غنى اللبنانيون للقدس ولفلسطين ولدمشق وسورية ولمكة ويثرب ولمصر ولسوى هذه الرموز العربية أغاني لاتزال تتردّد إلى اليوم. كما غنّوا للفقراء والمظلومين التائقين إلى العدالة والإنصاف. فالغناء اللبناني لم يكن مجرد نشيد للقلب، وإنما كان أيضًا نشيدًا للحق والعدالة والعروبة.
وقد أحيا هذا الغناء اللبناني رموز الشعر اللبناني سواء بالفصحى أو بالعامية. أعيد إحياء رشيد نخلة وشحرور الوادي والأخطل الصغير الذي كانت له حصة وافرة في هذا الغناء. وعندما التفتت صباح إلى تراث شحرور الوادي، وهو عمّها، تذكّر الناس جوقة الشحرور الذائعة الصيت في الثلاثينيات، والتي كانت، مع سواها، من رموز الفولكلور الشعبي اللبناني وبواكيره الأولى.
ومن بين الذين أنعم عليهم هذا الغناء الشاعر الكبير سعيد عقل، الذي غنّت له فيروز حوالي عشرين قصيدة ذات نفس شامي وعروبي، كان من شأنها إعادة الروح إلى هذا الشاعر الذي سجن نفسه في معتقل «الفينيقية»، فإذا بالرحابنة ينتشلونه من هذا المعتقل ويهبونه للحرية والهواء الطلق، وينشرون شعره في كل مكان.
وغنّت فيروز للشاعر السوري الكبير بدوي الجبل جزءًا من قصيدته الخالدة «إلى خالقة» ومطلعها:
من نعمياتِكِ لي ألفٌ منوّعةٌ
وكلُّ واحدةٍ دنيا من النورِ
فوهبت هذا الشاعر ما يستحقه من اهتمام لم يُولِهِ إياه المطربون الآخرون.
ووجد محمود درويش وهارون هاشم رشيد، الشاعران الفلسطينيان، سبيلهما إلى الغناء اللبناني، بواسطة فيروز أو بواسطة سواها، فأثبت هذا الغناء انتماءه إلى أمته العربية وقضاياها العادلة. إنه غناء صادر من لبنان، ولكنه مثل لبنان، عربي الهوى والهوية.
قد يتساءل البعض عن جذور هذه النهضة الغنائية والفنية اللبنانية ولماذا أعطي للبنان مجد الاضطلاع بها وعبئها في الوقت نفسه، ولم يُعْط لسواها من العواصم والأقطار المجاورة لها؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي الإحاطة بالنهضة الثقافية والاجتماعية والفكرية والعمرانية التي عرفتها بيروت، وبالتالي لبنان، ابتداء من الثلاثينيات من القرن الماضي. ازدهرت مدينة بيروت أيما ازدهار، وتحوّلت بفضل ظروف كثيرة، منها الحرية والانفتاح، من مدينة صغيرة ذات شأن محدود، إلى مدينة كبرى من مدن البحر الأبيض المتوسط، لا يقل نفوذها الثقافي والحضاري عن أثينا أو سواها من حواضر هذا البحر، بل عن حواضر العالم الكبرى. كان من الطبيعي لهذا الازدهار اللبناني أن يشمل الأدب والشعر والفن والغناء، لأن رياح الحداثة والتغيير والتنوير هبّت على كل ناحية من نواحي الحياة اللبنانية. ولا شك في أنه لولا تلك النهضة لما حصل هذا الازدهار في الفن وفي الغناء، ولبقيت رموزهما تعمل في إطارهما الضيق السابق، فالغناء اللبناني كما هو نتاج تراث لبنان ومروّياته وحكاياته وأزجاله المحلية، هو أيضًا نتاج هذه النهضة اللبنانية العامة التي امتدت نعمها وبركاتها إلى مجالات كثيرة، منها الفن والغناء. لقد عملت وسائل الحضارة الحديثة في خدمة الفن والغناء، ولكن الفن والغناء لم يكن بإمكانهما أن يعطيا هذا الحصاد الوفير، لولا إحياؤهما للتراث الشعبي وإعادة نشره. أحيا هذا التراث الحنين إلى الماضي اللبناني الجميل عند المتلقي، وأحيا، بوجه خاص، ما يمكن أن نُطلق عليه تجوّزا، حضارة القرية اللبنانية الغابرة، وهي حضارة لم يبق منها شيء تقريبًا في الوقت الراهن، إذ سقطت تحت سنابك الحضارة الحديثة، ولكنها لاتزال تنبض في ذاكرة اللبناني وتثير فيه أعظم المشاعر والأحاسيس. ولا شك في أنه يعود لحضارة القرية اللبنانية الصديقة هذه فضل كبير في ازدهار الأغنية اللبنانية. وعندما تعاونت مناخات هذه القرية القديمة مع صوت عبقري كصوت فيروز وألحان فائقة الجودة للأخوين رحباني، أمكننا أن نفسّر أحد الأسباب الرئيسة لنجاح وازدهار الأغنية اللبنانية في العصر الحديث .

