هُويّة اللغة العربيّة... استيعاب «الآخَر» المفهوميّ وتمثُّل رؤيته
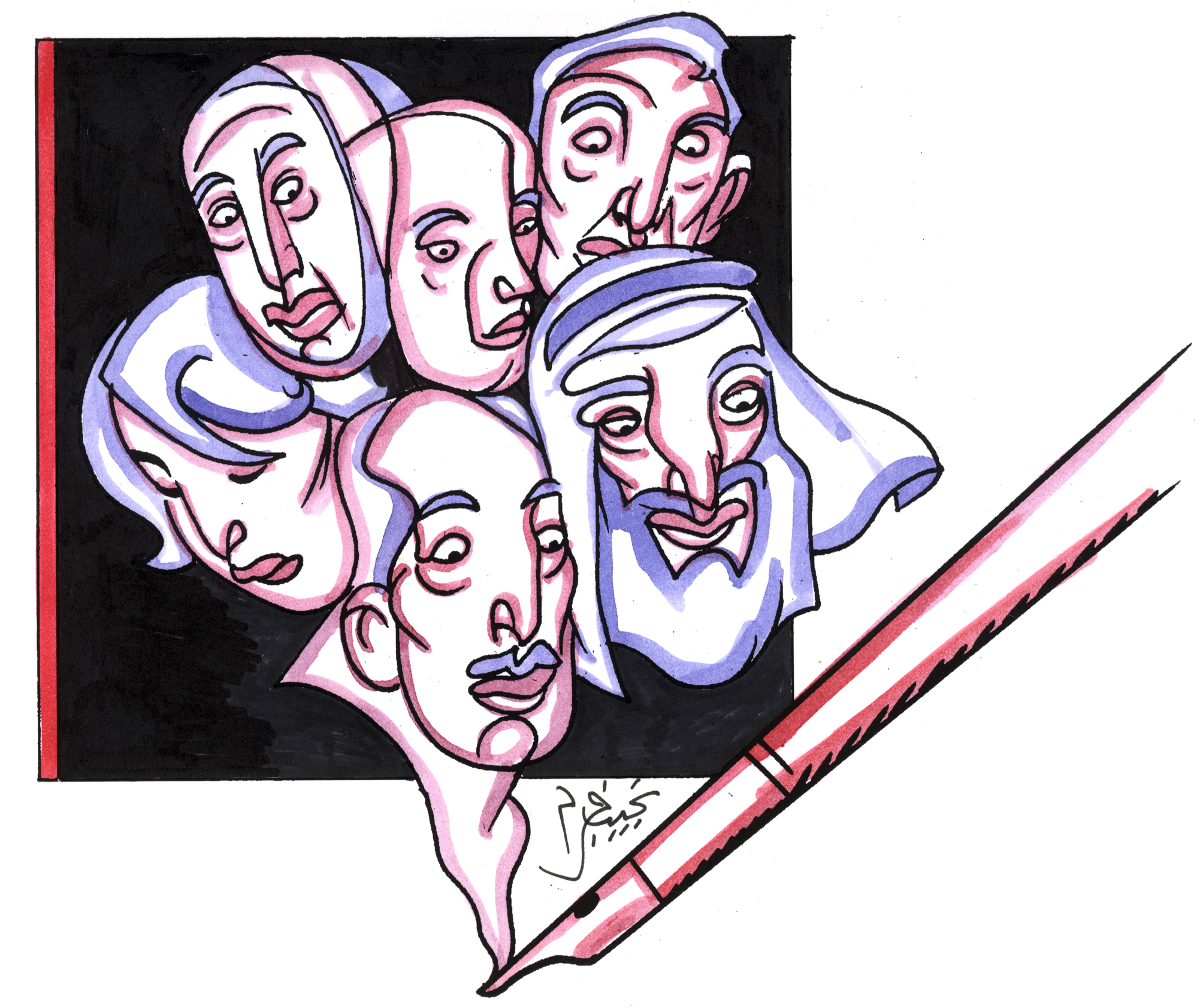
اللغة العربية بطبيعتها التكوينية لغةٌ مرنةٌ، وموقّعةٌ، ومتسامحةٌ ثقافياً، وثريّةٌ، وطيّعةٌ، بحكم ليونتها الوضعية والأدائية والتشكيلية، وهي طالما تفاعلت مع الآخر القادم من لغات أخرى على أكثر من مستوى، فاستوعبتْ مفاهيمَه وتمثّلتْ رؤيتَه بما انطوتْ عليه من رحابة وثقة وأصالة وقدرة على التحكّم بالوافد، وتكييفه، وتسييره على خطّها البنائيّ والصياغيّ، والتفاعل معها وفق تقاليدها اللسانية والنحوية والصرفية الناجزة، حتى أضحت من اللغات المركزية في العالم على هذا الصعيد.
لعلّ مقاربة هذا الموضوع منذ عصور ما قبل الإسلام وحتى الآن تكشف عن قيمة هذه الخاصيّة النوعية التي حظيت بها اللغة العربية، ولاسيّما في العصر الحديث، عصر النظرية والمنهج والمصطلح النقديّ، إذ حصلتْ ثورةٌ كبيرةٌ على مستوى المناهج النقدية الحديـــثة ونقلتْ العمل النقديّ من عتبة الانطباع والسياق وحكم القيمة إلى فضاء الانفتاح على الإشكاليات الكبرى في النصوص والظواهر الأدبية قراءةً وتحليلاً وتأويلاً، في السبيل إلى إنجاز قراءة نقدية حديثــــة ومتكاملة ومتماسكة ترتقي إلى طبقة النصّ ومنصّــــته وجوهريتــــه، وتجيب عن أسئلته الجمالية والثقافية والفــكرية والفلسفــية المعقّدة، نحو تطبيق إجرائيّ نقديّ حيّ لمنطلقات النظرية وتجلّياتها المنهجية والمفهومية والاصطلاحية.
المنهج النقديّ والتباس الرؤية
تعدّ إشكاليةُ المنهج في الدرس النقديّ الحديث واحدةً من أخطر إشكاليات الثقافة المعاصرة وأشدّها التباساً وغموضاً وتعقيداً، وذلك لانغماس الدرس النقديّ العربيّ الحديث بالمناهج النقدية الحديثة التي غزت هذا الدرس غزواً واسعاً شرساً من دون سابق إنذار، إذ راح الكثير من النقاد العرب يغرفون من مَعين هذه المناهج بمختلف أشكالها ورؤياتها ونظرياتها وأدوات عملها وإجراءاتها، وكأنّها لُقيةٌ نادرةٌ عثروا عليها على حين غرّة، وأصبح الناقد العربيّ الذي لا يُساجل ولا يتحدث ولا يشتغل على المناهج النقدية الحديثة يوصم بالتخلف والرجعية المنهجية والتقليدية والبعد عن روح العصر، ولم يعد ثمّة مناصٌ من المغامرة للدخول في معترك هذه المناهج مهما كانت الخسائر.
هكذا أضحت المناهج النقدية الحديثة مطيّة لكلّ من هبّ ودبّ، وصرنا نقرأ كلاماً أشبه بالطلاسم والتعويذات لكتّاب يعتقدون أنّ الاشتغال في حقل المناهج النقدية الحديثة ليس أكثر من «أنْ تهرفَ بما لا تعرف» كما يقال، ولعلّ الطامة الكبرى أنّ الصحف والمجلات الأدبية وبعض دور النشر انطلت عليها هذه الحيلة «الجاهلة»، وبدأت تنشر الكثير من هذا «الهرف» بدعوى الحداثة وخوفاً من التجهيل الذي يمارس ضدّ كلّ من يقف في وجه هذا السيل الكارثيّ المرعب من الكتابات التي لا يفهمها أصحابها أصلاً.
وعلى الرغم من خطورة هذا الوضع وصعوبته وتعقيده لأسباب كثيرة، فإننا لا نخشى كثيراً على مستقبل الدرس النقديّ العربيّ الأصيل والحقيقيّ من فوضى عميمة تضرب بأطنابها في كلّ حدب وصوب، إذ إنّ الكثير من هذه الأكاذيب النقدية قد أُهملتْ وكنستها الأقلام الجادّة التي قادت حركة الدرس النقديّ العربيّ الحديث ببسالة وجدارة وحققت نجاحات باهرة، وكشفت عن زيف الادّعاء الفارغ وجهل هذه الكتابات المزيّفة التي غابت الآن تقريباً مع نموّ الثقافة النقدية المنهجية الأصيلة وسطوع نجمها الحقيقيّ في سماء الثقافة العربية.
ثمة مشكلات منهجية كبيرة في هذا الإطار تنبغي مراجعتها والنظر المعمّق فيها وتحليلها، من أجل فهم دقيق للرؤية المنهجية التي أرستها طلائع المناهج النقدية الحديثة، وطبيعة هذه المناهج النظرية وحساسية إجراءاتها في ميدان التطبيق على إشكاليات النصوص والظواهر الأدبية (القديمة منها والحديثة) على حدّ سواء، لأنّ عدم إلقاء الضوء الكافي والكاشف عليها يبقي الكثير من طبقاتها طيّ الغموض والشكّ والالتباس، على نحو يستعصي على القارئ والباحث والمتلقّي العادي.
انقطاع النظرية وتواصل الإجراء
من الأولويات المركزية في تمثّل المنهج داخل العمل النقديّ هي القدرة على استظهار العلاقة الجدلية بين النظرية والإجراء، فعلى الرغم من أنّ النظريةَ تنطلقُ من عتبة الفلسفة بوصفها نشاطاً فلسفياً صرفاً، فإنها في الميدان الثقافيّ والأدبي تتطلّب مساحة تتحوّل فيها من منصّة النظرية إلى واقع الإجراء، بمعنى أنّ ثمة مستويين يحدّدان قوّة النظرية وقدرتها على أن تكون فاعلة ومؤثّرة ومغيّرة في الميدان الثقافيّ والأدبيّ ذي الطبيعة الاجتماعية، هما المستوى النظريّ في الطبقة العليا والمستوى الإجرائيّ على أرضية التفاعل مع النصوص والظواهر، وصولاً إلى شيوع النظرية شيوعاً إجرائياً يفعّل حضورها التداوليّ.
تتشكّل العلاقة بين النظرية والإجراء في سياق ثبات النظرية وحياة الإجراء، وإذا كانت علاقة النظرية بالإجراء تتحقّق بوساطة الرؤية النقدية المنبثقة من جوهر النظرية في تجلّيها داخل الشخصية النقدية، فإنّ المنهج النقديّ هو الآلةُ الإجرائيةُ الفاعلةُ في الميدان بما ينطوي عليه من عدّة عمل ترتبط بالشخصية الناقدة ارتباطاً وثيقاً، تفعّل الرؤيةَ النقديةَ على نحو خاصّ، إذ قد تلتقي الرؤية مع نقّاد آخرين لكنّ الافتراق معهم يكون في المنهج.
مرّت المنهجية النقدية بثلاث مراحل أساسية في الثقافة العالمية، المرحلة الأولى هي مرحلة المناهج السياقية، والمرحلة الثانية هي مرحلة المناهج النصّية الحداثيّة (البنيوية)، والمرحلة الثالثة هي مرحلة المناهج ما بعد الحداثية (ما بعد البنيوية)، ويمكن وصف العلاقة بين المناهج بأنّها علاقةٌ منفصلةٌ ومتصلةٌ في آن، ففي الاندفاعة الأولى يذهب المنهج بعيداً في سياق الانفصال والدفاع بحماسة عن خطاب الرؤية ومرجعية النظرية، ساعياً إلى التمركز حول الرؤية، سواء أكانت سياقية أم حداثية بنيوية أم ما بعد حداثية، إلّا أنّ هذا الاندفاع العالي الصوت ما يلبث أن تخفّ وطأتُهُ حين تتحوّل الآليّات من منطق النظرية إلى فعالية الإجراء، إذ إنّ الإجراء يحجّم الاندفاع ويسير باتجاه الاتصال والتحايث على نحو ما مع المناهج الأخرى، وذلك للحاجة الإجرائية التفصيلية في ميدان الفعل النقديّ العمليّ.
المناهج السياقية عمّرت طويلاً وكرّستْ قيمَها وأغنتْ جذورَها الأدبيةَ في سياق الاهتمام بمنطقة الناقد الشخصية (اجتماعية ونفسية وانطباعية وتاريخية)، وتدخّلت بوساطتها في تفاصيل النصوص والظواهر اعتماداً على فكرة الوصول إلى حكم القيمة، بوصفه هدفَ الرصد النقديّ ونتيجتَهُ المتوخاة من فعالية العملية النقدية ذات الطابع السياقيّ، بمعنى أنّها اشتغلت على النصوص ولم تغفل عن ممكناتها الفنية والجمالية كلّما كان ذلك ممكناً وضرورياً ومتاحاً، لكنّ ذلك كان لمصلحة حكم القيمة بوصفه المقصد المركزيّ والهدف الاستباقيّ من العملية النقدية في مستواها الإجرائيّ.
المناهج الحداثية، النصيّة، البنيوية، ابتداءً من حلقة براغ والحلقات اللغوية الأخرى والشكلانيين الروس مضتْ باتجاه علمنة النقد وتكريس معطياته الفلسفية، انطلاقاً من الطبيعة التكوينية الخاصة لهذه المناهج ذات الجذور الفلسفية العميقة، وجاءت بمقولة «موت المؤلّف» لتفصلَ الشخصيةَ المبدعةَ عن نصّها، وتهملَ السياقَ إهمالاً تاماً انتصاراً مطلقاً للنصّ بوصفه بنيةً ألسنيةً مغلقةً على ذاتها ومكتفيةً بذاتها، وإذا كان المنطق النظريّ لهذه المناهج يتمتّع بقوّة رؤيوية عالية على هذا الصعيد، فإنّ فحصَ الإجراءات النقدية يقلّلُ كثيراً من صلادة هذا المنطق، ويعكسُ شبكةً من الإضاءات النقدية الزاحفة من مظلّة المناهج السياقية، حين يجد الناقدُ الحداثيُّ البنيويُّ نفسَه أمام إشكال قرائيّ لا تسعفه أدواته المنهجية الحداثية كثيراً في مقاربته والتفاعل معه، على نحو يحرّضه لاستخدام فعالية منهجية ذات مرجعية سياقية، يكيّفها للتفاعل والتعامل والمحايثة مع منهجه النصّيّ، تساعده في بلوغ أفضل قراءة ممكنة ولا تسيء في الوقت نفسه إلى صفاء المنهج الحداثيّ أو تلوّثُهُ أو تهدّم من جُرف كفاءته.
أمّا ما بعد الحداثة فإنّ أيسر وصف لها هو أنّها ثورة على علمنة الأدب وتفكيك الأسس والقيم التي نهضت عليها الحداثة، والانطلاق نحو حرية الكتابة من دون تقييدها بقيم وأحكام وأسس ومعايير وثوابت، إذ هي في حقيقتها استجابة لفلسفة ما بعد الكولونيالية تمضي باتجاه ضرب الشعرية، وتفكيك المؤسسات، وتشتيت الخطابات، وتشظية النصوص، ودفع الرؤية نحو قراءة وحشيّة للنصوص ومقاربة ثوريّة للنصوص، لا تكتفي بما تختزنه النصوص من إمكانات، بل تنفتح على الخارج والمحيط والماحول، كي تكشف عن عمل النصوص فيها، ودرجة التأثير والتغيير التي يمكن أن تنجزها في الأشياء، معتمدة على كفاءة القارئ الفاعل المُنتج الاستثنائيّ، وفهمه وإيمانه بجدوى الأداء النقديّ النوعيّ خارج المقاييس والمواضعات المسبقة.
على هذا النحو تمكن معاينة المستوى النظريّ بوصفه دفاعاً فلسفياً منقطعاً عن رؤيته المنهجية قبل دخولها إلى ميدان الإجراء، أي أنّ حاضنة المقولات النظرية تسمح بالتجلّي النظريّ المتمركز حول ذاته النظرية الصرف، غير أنّ هذا التمركز يتهدّد ويفقد قدرتَه على الإحاطة النظرية الرؤيوية المستقلّة حين تتمّ مواجهة النصوص والظواهر الأدبية على أرض الميدان، وحين يتمّ الانتقال فعلياً إلى المستوى الإجرائيّ بوصفه اشتغالاً تطبيقاً للنظرية والرؤية والمنهج والمفهوم والمصطلح في حقل العمل، على نحو يتمظهر فيه الاضطرار إلى التخفيف من سلطة النظرية والتساهل مع قيودها المركزية نحو الاتصال مع ما هو متاح من قيم منهجــية تعــــود إلــــى حاضنات مناهج أخرى، كانت النظرية قـــبل ذلك لا تعترف بها وتُدين التواصل معها بحكم غرورها وتطلّعها إلى الهيمنة والاستعمار وفرض الهوية الخاصّة بها.
إنتاج النظرية وما يتضمّنه ضرورةً من إنتاج لفضاء الرؤية وآليّات المنهج وتمظهرات المفهوم وحيوية المصطلح بحاجة ماسّة لحاضنة ثقافية مثالية، تشهد تحوّلات حضارية على مختلف المستويات تفرض حلول النظرية والمنهج وتحفظ نموّهما وتطوّرهما، داخل سياقات لغويّة (تشكيلية وتعبيرية) تعبّر عن الهويّة وتعكس خصوصيتها، لكنّها لا تتحلّى بالصفة العالمية إلّا حين يُعاد إنتاجها في الحقل الإجرائيّ، كي تنتقل من حدود الانقطاع والغلق إلى فضاء الانفتاح والتواصل حين تتفاعل مع ما هو متاح من نظريات ورؤيات ومناهج، بحسب طبيعة الإجراء وحساسيته ومساحات عمله النابعة أساساً من الظواهر والنصوص موضوع الرصد والقراءة والتحليل والتأويل.
الناقد العربيّ والناقد الغربيّ
لا يمكن بأيّ حال من الأحوال معاينة الناقد العربيّ مُناظراً ومُوازياً للناقد الغربيّ، بسبب اختلافات عميقة في الإعداد والتكوين والحاضنة الثقافية والفكرية والفلسفية، فضلاً عن طبيعة المرجعيات الثقافية والفكرية والحضارية لكلّ منهما، وطبيعة المؤثّرات الفضائية (الزمكانية) ذات الطبيعة المجتمعية الراهنة في مجتمع كلّ منهما، على نحو يرتبط بطريقة التفكير وحساسية التلقّي والمزاج والممارسة الذوقية تجاه الأشياء، وحساسية الثقافة المكوّنة للشخصية النقدية خارج العمل النقديّ وداخله.
وإذا كانت النظرية بما تمتلكه من سلطة عابرة للثقافات والخصوصيات بوسعها أنْ تسمح للناقد الغربيّ والناقد العربيّ بالجلوس على مائدة واحدة مشتركة، فإنّ الممارسة الإجرائية تعيد كلّا منهما إلى حاضنته الحضارية والثقافية والفكرية والاجتماعية، ولاسيّما أنّ النصّ الغربيّ حيث يعمل الناقد الغربيّ، والنصّ العربيّ حيث يعمل الناقد العربيّ، يسهمان على نحو فعّال في فرض الخصوصية واللون والرائحة والطعم والمزاج والرؤية بما يُبعدُ مائدةَ كلّ منهما عن الآخر، ويحقّق لكلّ منهما الفرادة والتميّز والخصوصية التي ينشدها ويعبّر عن شخصيته بوساطتها، ليكون في النهاية ثمّة ناقد غربيّ وآخر عربيّ، وثّمة نقد غربيّ وآخر عربيّ.
المنظرون الغربيون اجتهدوا في ابتكار نظرياتهم النقدية ضمن أفق حاضنات فلسفية مؤسّسة تأسيساً صحيحاً مستجيباً لطبيعتهم، نظريات متصالحة ومتطابقة ومتفاعلة مع النماذج والسياقات الثقافية الأخرى ومتفاهمة معها على نحو يقود إلى وصفها بأنّها ذات ولادة طبيعية، أمّا النقّاد المشتغلون في حقل الثقافة والأدب على الظواهر والنصوص فَهُم مستلهمون للتنظير النقديّ الفلسفيّ، لكنهم يفرضون شخصياتهم وهوياتهم في حقول الإجراء بآليّات تُخضع الفلسفيّ للنقديّ قدر تعلّق الأمر بإنجاز أعلى وأمثل للقراءة، ولاسيّما حين نعرف أنّ المنظرين في حقول اشتغالهم الفلسفيّ هذا ليسوا بعيدين كثيراً عن الشأن النقديّ والأدبيّ، لذا لا تحصل انقطاعات عميقة سلبية في تأسيس فضاء العلاقة بين النظريّ الفلسفيّ والنظريّ النقديّ في إطار بناء النظرية النقدية الحديثة عند النقّاد الغربيين.
أمّا المنظّرون العرب فهم مستقبلون وملخّصون وشارحون للوافد النظريّ القادم من فضاء الآخر، لانعدام حواضن فلسفية عربية صحيحة متصالحة ومتفاهمة مع السياقات والنماذج، بمعنى أنّ لديهم مشكلةً فيهما معاً، وربّما نستطيع القول استناداً إلى هذه الرؤية أنّه لا يوجد منظّرون عرب بهذا المعنى، بل يوجد نقاد عرب يتساوون مع النقاد الغربيين في استلهام التنظير وفهمه وفرض شخصياتهم وهوياتهم، مع الأخذ بنظر الاعتبار المسافة المضاعفة التي تفصل النقّاد العرب عن المصدر النظريّ الغربيّ قياساً بالنقّاد الغربيين، وهي قضية ذات أهمية كبيرة وخطورة في كلّ مراحل تلقّي النظرية وفهمها وتكييفها وتحويلها إلى حقل الإجراء، فضلاً عن نتائجها في المسار القرائيّ من البداية إلى النهاية.
لا بدّ من ملاحظة أهمية النسق الثقافيّ وقيمته في بناء المنهج وتأسيس النظرية، إذ إنّ الثقافة الغربية هي ثقافة سرد، ومرجعية هذه الثقافة في الأساس هي مرجعية فلسفية تقود ضرورةً إلى النظرية، في حين توصف الثقافة العربية بأنّها ثقافة شعر ومرجعية هذه الثقافة هي مرجعية أدبية تقود إلى البلاغة، وحين تأثر العرب في ما بعد بالفلسفة اليونانية أنتج (علم الكلام) الذي يقوم على الجدل والسجال, وظلّتْ أدوات البلاغة عاملة وفاعلة في الميدان ولم ينته هذا التأثير إلى بناء منهج نقديّ خاصّ وتأسيس نظرية صافية، فقد ظلّ التردّد بين البلاغيّ والفلسفيّ عاملاً خطيراً من عوامل الحيلولة دون الوصول إلى فضاء ثقافيّ سَويّ يتيح إنتاج المعرفة ضمن مناخ عام من التفكير الليبراليّ الحرّ خارج المهيمنات والسلطات والمركزيات الضاغطة.
ثقافة السرد بطبيعتها ثقافة انفتاح التعبير وانطلاقه وتمظهره، إذ يتميّز بالجملة الطويلة والاسترسال والاستطراد على نحو يؤسّس لنوع من التعبير المولّد والمنتج، فضلاً عن أنّ الاستغراق في التفاصيل وما ينتج عنه من حوار وجدل وسجال يوفّر مجالاً أرحبَ لنمو الفكرة وتطورها وصيرورتها وبنائها، على نحو يضاعف من اتساع مساحة التواصل مع مجتمع التلقي ويزيد من حجم إقناعه وفاعليته الثقافية على جميع المستويات.
وفي سياق تلقي المنهج فإنّ المنهج في نموذجه الغربي المستورد والمترجم لا يصمد في حقل الإجراء النقديّ العربيّ، وهو ما يستلزم إجراء تكييف نوعيّ في شبكة المفاهيم والمصطلحات الحاملة للمنهج، إذ يسهم النقد العربيّ على هذا النحو بتحويل آليّات المنهج من مساره النظريّ في الحاضنة الغربية ليفتحها على مجال جديد داخل حقل العمل، وهو ما يحتاج إلى جهد استثنائيّ وكدّ ذهنيّ عال ومعرفة وحساسية وإدراك عميق، بوسعه أن ينتقل من مختبر المحاولة إلى فضاء الإنجاز، وذلك لأنّ المناهج الغربية ولدت في حواضن حضارية وفلسفية وسوسيوثقافية معقدة، قام الناقد العربيّ باقتطاع ثمرتها الناضجة من سياقاتها لإنباتها في أرض مختلفة وتشغيلها في حواضن مغايرة، ومن هنا حصلت المفارقة وتمظهر الإشكال بما يستوجب تكييفاً وإعادة إنتاج وتوجيهاً مناسباً للحاضنة الجديدة، من أجل تفادي أيّ خلل في مستوى التكييف يُفسد العملية برّمتها، لأنّ القضية بحاجة إلى عملية جراحية دقيقة جداً تستدعي توافر كادر نقديّ عالي الخبرة والمؤهل والمعرفة، هو في الحقيقة ليس متوافراً دائماً، ويمكن الالتفات إلى أنّ المترجمين لعبوا لعبتهم الفادحة ربما من غير قصد، وجعلوا فرص نجاح العملية محدودة للغاية، وهو ما يمكن تلمّسه في المشهد النقديّ العربيّ بقوّة ووضوح.
المزاج النقديّ والتجربة الذوقية
قد يبدو الحديث عن المزاج النقديّ والتجربة الذوقية في ظلّ هيمنة النظرية والرؤية والمنهج في الدرس النقديّ الحديث غير مناسب على نحو ما، وذلك لفرط الهيمنة الثقافية الإجرائية التي تفرضها معطيات النظرية على فعالية الرؤية، غير أنّ الخبرة النقدية تمثّل المساحة الأكثر أهمية في الوصول إلى مرحلة الكشف النقديّ، وما النظرية بمختلف اتجاهاتها، والرؤية بمختلف تمثّلاتها، والمنهج بمختلف أشكاله وتمظهراته، سوى وسائل وآليّات تحت تصرّف الخبرة النقدية وهي تسخّر إمكاناتها في خدمة القراءة.
الانصياع والإذعان والاستسلام لسلطة النظرية برؤياتها ومناهجها مفاهيمها ومصطلحاتها إنّما هي تمثّلٌ أعمى يحرص على قبول جفاف النظرية، والعمل وفــــق متطلباتها الشديدة الحرَفيّة والقسوة بحيث تنتجُ كتابةً نقديةً بلا ماء، وإذا كان النقّاد العرب القدامى قد وصفوا الشعر الخالي من الماء بأنّه مجرّد نظم, فقد نضيف إلى ذلك لوصف النقد الخالي من الماء أنّه مجرّد كلام علميّ تقانيّ يابس لا يليق بمقاربة نصوص أدبية، لها علاقة بالوجدان والعاطفة والخيال والرؤية الإنسانية الخلّاقة.
وهو ما يسبّب ضياع شخصية الناقد التي تمثّل أهمّ شكل من أشكال الحضور في مساحة العمل النقديّ، إذ يجب أن يتجلّى بقوّة وتعالٍ في جوهر هذه الكتابة، وعند الحديث عن الشخصية الناقدة لا بدّ من حضور شبكة من المكوّنات المركزية في مقدّمتها ما يمكن أن نصطلح عليه هنا بـ «المزاج النقديّ»، ويتكوّن هذا المزاج من طاقة الرغبة العالية في العمل النوعيّ، وإنشاء علاقة محبّة وتفاعل بين الناقد والنصّ، وتوفير فضاء إنسانيّ (زمكانيّ) أنموذجيّ يحيط بالعلاقة، واستعداد نفسيّ وجسديّ يؤهّل الناقد للخوض في طبقات النصّ وجيوبه وظلاله، فضلاً عن بهجة داخــــــلية تجعــل من العمل النقديّ عملاً لذّوياً يدفع الناقد نحو الانغماس فيه من أجل مزيد من الكشف والاكتشاف والمتعة.
كلّ ذلك إنّما يسهم في تكوين «المزاج النقديّ» خارج المفهوم التقليديّ للمزاج بوصفه حالة انفعالية وعاطفية عابرة غير مخصّبة، لأنّ «المزاج» هنا يرتبط بعمل «نقديّ» تحضر فيه الذاكرة والعقل والثقافة والمعرفة والمرجعيات، أي ما يشبه منظومة عمل تشبه المختبر، لذا فإنّ المزاج هنا سيكون مزاجاً كفوءاً محروساً بكلّ هذه الإمكانات وفاعلاً داخل شبكة منظومتها، على نحو يحفظه من الشطط المتوقّع أولاً، ويرفع طاقته لتكون جديرةً بهذا النوع من العمل الإجرائيّ العالي المستوى ثانياً، بحيث يتخلّى تماماً عن انفعاليته وعفويته ويدخل في جوهر الفاعلية النقدية على نحو خلّاق ومُنتج، مسهماً في تكوين الشخصية النقدية، وهي تتمتّع بفرادتها وأسلوبيتها ومنهجيتها المتلوّنة بلون الشخصية شكلاً وروحاً وكتابة.
المزاج النقديّ على هذا الأساس هو حصيلة تجربة ذوقية ثرية عميقة وواسعة تشتغل على تربية الذوق وتدريبه وتمرينه وتهذيبه، ودعمه بكلّ ما تيسّر من حظوظ الارتفاع بمستواه كي يبلغ أعلى قدرة على الفعل والتأثير والإنتاج، ويتعدّى ذلك إلى ابتكار سبل جديدة للتعامل والتفاهم والتفاعل مع الآليّات النقدية القادمة من حاضنة المنهج، وبناء تضافر نسيجيّ في منطقة الإجراء النقديّ يتيح لكلّ منهما (المزاج النقديّ وآليّات المنهج) أرفع قدر ممكن من التعاضد الفعليّ الكشفيّ، من أجل الوصول إلى أبلغ قراءة كاشفة ومكتشفة ومنتجة ومدهشة، تعمل الآليّات فيها بأعلى كفاءتها الإنتاجية مثلما يعمل الذوق بأسمى طاقته على تحسّس ما يستحيل على الآليّات وحدها استكناهه واكتشاف عمق الجمال ورهافته فيه .

