الذئب في «الفخ» قراءة في لوحات سردية
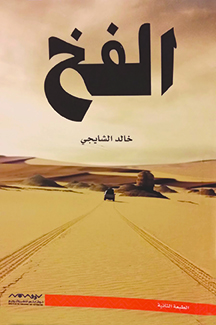
يستمد الفن مادته من الإنسان والطبيعة أو من الإنسان والكون والكائنات، والناظر في كتب الموسوعات الأدبية أو في المتخيل الإبداعي يجد أن الحيوان الأليف منها والضاري احتل مساحة من المشهد الإبداعي. والنظرة السائدة هي ضرب المثل بغدر الذئاب وشراستها (الدميري: حياة الحيوان الكبرى، 503 وحواشيه هناك، الجاحظ: «الحيوان» 1/213،
و 4/48)، والذئاب تسير في غدواتها وروحاتها صفاً واحداً، كتفاً لكتف، لئلا يغدر متأخرها بمتقدمها، ويُشّبه بها أشرار الناس والغادرون.
يقدّم الجاحظ والدميري مادة تلقي أضواء على طبائع الذئب، فإذا كدّه الجوع اجتمعت له الذئاب ووقف بعضها إلى بعض، فمن ولَّي منها وثب إليه الباقون وأكلوه. وإذا عرض للإنسان وخاف العجز منه عوى عواء استغاثة فتسمعه الذئاب فتقبل على الإنسان إقبالاً واحداً، وهي سواء في الحرص على أكله، فإن أدمى الإنسان واحداً منها وثب الباقون على المُدمَى فمزقوه وتركوا الإنسان. والذئب القوي إذا ناله الخدش اليسير يحدث للضعيف من الجرأة عليه حتى يثب عليه فيأكله، على نحو ما يصور الشاعر:
وكنت كذئب السوء لما رأى دمًا
بصاحبه يومًا أحال على الدم
وهذا الفريق من علماء الزولوجيا ذهب إلى أن الذئاب لا تتناظر؛ بل تتشارك وتتعاون. فالاشتراكية عندها أفضل من الاشتراكية التي ينادي بها علماء الاجتماع الإنساني، لأنها مبنية على الحقوق الطبيعية المحضة، وقد ترقّت وتمحصت بناموس بقاء الأصلح من غير تعمُّل ولا تصنُّع.
وقد مرَّ بنا في أدبيات طبائع علم اجتماع الحيوان أن الذئاب تسير في آجال (قطعان) وقائدها أكبرها جرماً، وأشدها بطشًا، وأنه نال السيادة بقوة ساعديه ونابيه بعد أن قهر الخصوم، وجرّعها المنون حتى لم يبق له مزاحم ولا منازع.
ولكن الأمر ليس كذلك في ما ذهب إليه علماء الزولوجيا، بل الزعامة في آجال الذئاب لأم الصغار، وزوجها يُعينها بافتراس الفرائس لأولادهما.
والذئب إذا مرض أو جُرح لم تثب عليه الذئاب لتفترسه، كما يفعل الناس بإخوانهم المستضعفين في الأرض، بل تجتمع حوله وتتحلق كأنها تقاسمه آلامه وترثي لبلواه، على نحو ما صور الشنفري في لاميته:
فأغضى وأغضت واتّسى واتّست به
مراميــل عــزاهــا وعزتــه مرمــلُ
وقد كان الشنفري يعرف من طباع الذئاب أكثر مما عرف الدميري، لأنه رآها مرأى العين، ودرس أفعالها وأطوارها.
والذئاب تحاول أولاً أن تعرف ما هو مصاب الجريح أو المريض، ومم شكواه، أما هو فيرى أن الشكوى لا تجديه غير التأسي فيخرج من بينها ويمضي، حتى إذا اشتد به الألم رفع رأسه وعوى فتجيبه عاوية مثله، لكنه يرى أن عواءها لا يجدي فيبقى سائراً إلى أن يجد كهفاً يلجأ إليه ويجلس فيلحس جُرحه كأنه يعلم أن الراحة خير دواء طبيعي. واللعاب أحسن علاج لميكروبات الفساد. وكأنها هي تعلم ذلك أيضاً لا تتبعه لتزعجه وتقلقه، بل تمضي لشأنها، تفتش عن طعامها وطعامه، فيعلم هو أين سارت. وكلما جاع اقتفى أثرها وأكل من الصيد الذي اصطادته لها وله.
صورة الذئب في المتخيل الإبداعي
الناظر في المشهد الإبداعي يتراءى أمام باصرته وصف الفرزدق للذئب وقد عاهده على ألا يخونه فكان وفياً. ووصف الشريف الرضي ذئباً أصبح غرضاً لقسي نوازع، وطعمة لرهط جائع، أما البحتري فقد وصف ذئباً هزيلاً سدّد إليه نصالاً أوردته منهل الردى. وفي الأدب الفرنسي نطالع قصيدة «موت الذئب» La mort du Loup وفي الأدب الإنجليزي يطالعنا بايرد تيلر Bayard Talyer برائعته «ليلة مع الذئب»
A night with a Wolf.
في قصيدة الفرزدق نخلص من حديثه والذئب إلى أن الشاعر يريد أن يدلنا على ما عنده من كرم وسخاء وشجاعة عند اللقاء، لا يصرفه عن طعامه إقبال الذئب عليه ووقوفه بين يديه، فهو الذي قاسمه الزاد، وأناله منه ما أراد، مع أنه يعرف ما للذئب من طبيعة الفتك والغدر، ولكنه يعتمد على ساعد قوي وسيف باتر. فالخطاب هنا يؤكد تمدح الشاعر بالكرم والشجاعة، (سامي الدهان، «الرسالة»، 15 أغسطس 1933 ص 30).
أما قصيدة البحتري فتتجلى فيها فكرة صراع الإرادات وبقاء الأقوى، حيث أرانا ذئبه رؤية عين، في لونه الأطلس، ومتنه الأعوج المقوس، وجسمه المنهوك، وعظامه المقضقضة، حتى ملأ قلوبنا رهبة منه وخوفاً على صاحبه، ثم صوّر لنا المعركة التي نشبت بينهما حتى كأننا نراها، كما أنه أجاد في تصوير تلك المعركة وإبرازها إلينا محسوسة مشهودة، وفي استماتة كل منهما في الدفاع عن نفسه والإغارة على عدوّه وبدت الصورة الشعرية، مونقة تملأ بصر القارئ وتستيقظ بصائر ذوي التمييز في لطائف صور البحتري.
لكن الجامع بين كليهما يشي بثقافة مجتمع يحتفل بقيمة الشجاعة والكرم، وحين ننظر في نماذج من الصور الفنية في الآداب العالمية نجد صورة تكشف عن ثقافة مجتمع مغايرة للثقافة العربية.
في قصيدة «موت الذئب» La Mort du Loup للشاعر الفرنسي ألفرد دو فيني، وقد ترجمها سامي الدهان («الرسالة»، أول يوليو 1933) وإليك جانباً من المشهد:
«... وأقعى الذئب ومخالبه غائصة في الرمل، حين علم أنه هالك لا محالة، لأن عدوّه هاجمه وملك عليه سبيله، وأمسك بفمه الملتهب عنق أجرأ كلابنا، ولم يحوّل عنه فكيه الحديديين على الرغم من طلقاتنا النارية التي اخترقت جلده، وعلى الرغم من مُدانا الحادة التي مزّقت أحشاءه، ولكنه لمّا أحس أن فريسته فارقت الحياة قَبل أن يفارقها هو، أفلته من فكيه، ونظر إلينا مرة وأتبعها نظرة إلى جسمه فرأى المُدى غارقة في أحشائه، ورأى نفسه سابحاً في بحر دمائه، تحيط به البنادق فحدّق فينا ثانية واضطجع وهو يلعق ذنبه بفمه، ويلقف نزيف الدم من كلومه، ودون أن يجرّب أو يبحث كيف يموت أغمض عينيه الكبيرتين ومات دون أن يصرخ صرخة واحدة».
إن الدرس الذي نتعلمه نحن من هذا الحيوان: كيف نتسلح وفي صمت بإرادة الحياة وبإصرار على ألا نغادر الحياة ونحن مهزومون؟ لقد هُزم الذئب ولم ينهزم.
وعندما نقارن بين القصة الفرنسية الحديثة والقصة العربية القديمة نجد الفرق بينهما جلياً واضحاً، فالقصة العربية كل الغرض منها التمدح بالكرم والعطاء، والافتخار بالثبات عند اللقاء، وما هذه الصورة المخيفة التي صوّر بها الذئب إلا لينفذ منها الشاعر إلى ما يريد من مدح نفسه بالشجاعة.
وأما القصة الفرنسية فهي على وحدة موضوعها وصورة ذئبها التي ما تبرح مخيلة القارئ، فالغرض منها اجتماعي تربوي ذو شأن، فهو يريد أن ينبه القارئ إلى ما يجب عليه من إجابة دعوة القدر بهدوء وسكينة، وتلبية نداء الموت في سبيل الواجب برزانة وصمت، لأن الصمت هو العظمة، وبهذا فهي تقترب من المثل الأعلى، لأن العقلية غير العقلية والعصر غير العصر وثقافة «فني» غير ثقافة هؤلاء الشعراء. (سامي الدهان).
وفي قصة بايار تايلر Bayard Tayler تتجسد فكرة الوحدة بين الإنسان والكائنات حين تواجه بتحديات. فقد بات الشاعر ليلته، وقد هبط الظلام. فهذا البرد القارس والريح الصرصر دفعا بالذئب إلى أن يلاصق جسمه جسم الشاعر، بغية الدفء، فإذا سكنت العاصفة مضى كل إلى طريق.
وهذا هو الدرس الأخلاقي الذي يقدمه الفن حيث يأتلف الإنسان والحيوان الأعجم. وقد آنس كلاهما ما يفتقد من دفء.
الإنسان والذئب أو صراع الإرادات ...
قراءة في لوحات سردية
المشهد الأول – اللوحة الأولى
يلمس القارئ في قصة خالد الشايجي: «الذئب» وصفاً لتجربة مواجهة الإنسان لحيوان الصحراء (الذئب) وقد استثمر الفضاء الروائي بشكل جسّد هذه المواجهة، معتمداً على معجم الصحراء يمتح من مفرداته في رسم لوحات قلمية بدت في استدعاء «المشهد» بصورة بصرية ماثلة أمام القارئ؛ حيث وظَّف الحواس في محاولة لإحداث وحدة الانطباع؛ فيتآزر السمعي والبصري في تشكيل المشهد السردي. إن الذئب – بدافع الجوع – وربما بدافع استشعار توجس اعتداء الآخر: (الإنسان) على وطنه (الصحراء) يهتدي بحاسة الشم إلى توقع الخطر وشيكاً.
وشرع البطل جاسم يأخذ لنفسه وضعاً يحميه من الريح الباردة العاصفة، وساعده في ذلك وضع السيارة التي كانت وجهتها عندما توقفت إلى الجنوب الشرقي، على حين انحرفت مؤخرتها إلى الشمال الغربي.
ويتآزر في تشكيل الصورة الروائية – اللوحة السردية وتجسيدها شعرية المفردة «الريح». وهنا يستدعي المتلقي ويمتح من رصيده من الموروث الديني: {بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ} (الحاقة/ 6). و{الرِّيحَ الْعَقِيمَ} (الذاريات/ 41)، {فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ} (الكهف/ 45)، ما يفتح أمام مخيّلته «أفق التوقع».
في المشهد السابق يوظف الروائي الحواس في رسم أبعاد اللوحة السردية، معتمداً على حاستي السمع والبصر:
«ولما رأى الذئب أن جاسم لا يبدي حراكاً تشجع قليلاً وتقدَّم نحوه فلم يشعر به جاسم أول الأمر، لشدة صوت الريح ولصعوبة الرؤية التي لم تؤثر على حواس الذئب». (الرواية 50).
في هذا المشهد يتراءى للقارئ مدى انعدام الرؤية، بفعل هذه العاصفة الترابية، حيث يقف جاسم في مواجهة الذئب وهو قائم يتربص: «عندما وصل الحيوان إلى المكان المناسب له ليرى ويسمع بوضوح لم يكن جاسم يشعر به، وبعد أن توهّم أن الفريسة جاهزة للوليمة، هجم على جاسم الذي كان مستسلماً لألمه وخيبة أمله».
وهنا تتضافر حاستا السمع والبصر، حيث يتناهى إلى مسامعنا صوت الريح وهي تعوي في مقابل عواء الذئب، وكأننا في معزوفة تصدية الألحان Counter Point ترهص بشر وشيك الوقوع: «لم يشعر جاسم بخوف ورهبة كما شعر بهما في تلك اللحظة، خاصة بعد أن سمع ذلك العواء الغريب الذي يشبه نداء الموت، فأخذ بجريدة من تحت العجلة وقد نسي آلامه، ولكن تلك العجلة اللعينة كانت تحافظ على نفس الضغط كلما لانت الأرض تحتها من جراء محاولة جاسم إخراج يده».
هذا الجانب من المشهد أو قل: «الفخ» الذي وقع فيه جاسم يمثل نقطة ضعف، ليس على المستوى الإنساني، وإنما على مستوى المتخيل الإبداعي، ولاسيما أن المتلقي يساوره الريب في خبرة الروائي بمادته التي يشكل منها صورته الفنية.
التحدي والاستجابة
إن جاسم يدرك أنه وقع فريسة لحيوان ضارٍ جائع وكانت الريح العقيم له ظهيراً. وكان على جاسم أن يتغلب على هذا الحيوان وقد أحيط به في يوم عاصف.
ويلجأ الروائي إلى تقنية «المنولوج الداخلي» ليكشف عن الحال النفسي «أخذ جاسم يحدّث نفسه قائلاً: حسناً.. إنه ذئب.. فليكن ذئباً وأنا رجل معاق فيجب أن أتقيه بما بقي لديَّ من وسيلة.. ولكن أين تلك الوسيلة؟.. وما هي؟! ثم تنهد بألم وحسرة، وأخذ يجول بخاطره أنه سيموت، فتساءل كيف سيموت؟ وهل سيبدأ الذئب به من رجليه كما تفعل الضباع والذئاب بالبقرة الوحشية المريضة عندما تهاجمها وتبدأ بافتراسها من أرجلها وضرعها، فتموت وهي ترى دماءها تنزف وأوصالها تتقطع بالأنياب ولا تستطيع دفاعاً عن نفسها؟...» (ص 51).
«ولكني لست بقرة... قال ذلك وقد ضم رجليه وتصلبت عضلاته وعاودته طبيعة حب البقاء وطبيعة الحيوان في الدفاع عن نفسه» (ص 51).
وتقف الطبيعة ظهيراً للذئب. وقد شعرت بأن هذا «الإنسان» يهاجمها في فضائها. والذئب يتخذ من الطبيعة عضداً يواجه به جاسم. فالريح تَرْجُمه بِجَمَراتها وكأنها تُنزل به العقاب لجرأته على اقتحام فضائها وعالمها.
وتتآزر أفعال الحركة في تجسيد الصورة البصرية «وكانت أمواج البحر الهادرة ترتفع في صخب وتتابع مسرعة نحو الشاطئ، تضرب أطرافه وهي مزبدة؛ فتنبسط مياهها مغطية الرمال الناعمة وهي صاعدة في اندفاع، وكأنها تريد الهروب من البحر حتى إذا وهنت وفترت قوتها عادت متباطئة إلى البحر لترجع مرة أخرى موجة أخرى».
إن هذه «المناورة» التي نشاهدها والتي ينهض ببطولتها «الموج» تبدو في مخيلة المتلقي – وقد خلع عليها الحياة – وقد آزرت «الذئب» بقدر ما أَزْرَتْ بجاسم، فبدت الصحراء والأمواج وكأن بينهما تفاعلاً إيكولوجيًا – ليس بين الإنسان والبيئة – بقدر ما هو تفاعل إيكولوجي بين «الذئب» أو الحيوان والبيئة.
المشهد الثاني – اللوحة السردية الثانية
في هذه اللوحة يتراءى لنا المشهد وكأنه تصوير بطيء، وفيه «استعد الذئب للجولة التالية حيث شعر جاسم بحركة الذئب فأخذ يحدّق في الظلام وهو لا يكاد يفتح عينيه من شدّة الريح والرمال المتطايرة معها. وكانت يده تبحث بعصبية وبارتباك شديدين عن أي شيء يمكن أن يدافع به عن نفسه فوقعت على خشبة غليظة حوله فقبض عليها بشدة وبقي متحفزاً، وهو يحاول أن يتخذ له وضعاً يناسبه.. حيث إن يده العالقة بالعَجَل لا تسمح له بأي حركة أو تغيير في وضعه» (ص 56).
إن المتلقي يجتهد أن يقتنع بإمكانية هذه المواجهة والبطل مقيّد في الأصفاد، حيث غُلَّت يده وعلقت بعجَل السيارة؟! وهنا يتحول المشهد وكأنه عراك في غير معترك.
«وجاءت اللحظة التي ينتظرها الاثنان، فقد قفز الذئب المتربص به باتجاهه فرفع جاسم يده بالخشبة واستقبله بضربة أودعها كل ما يشعر به من قوة فأصابه، ولكن الضربة في ما يبدو لم تأتِ في مكان مؤثر. ولذا فقد قام الذئب من سقطته، ووثب على جاسم في إصرار على النيل منه، ولم يترك لـجاسم فرصة لالتقاط الخشبة من الأرض مرة أخرى، فعضَّ على يده التي علقت بالفخ، فغارت أسنانه في أعلى الساعد.
«وأحيل القارئ على ما أوردت من طباع هذا الحيوان وكيف أن قوته الفولاذية في شدقيه وأسنانه ليدرك ما في هذه الصورة السردية من ضعف التصوير».
هنا أحس جاسم بالألم الشديد وكأنما قد أصاب يده حريق، فصرخ من شدة الألم، ورفع قبضة يده اليمنى وأهوى بها على رقبة الذئب، فلم يزد الذئب إلا إصراراً فكان يشد يد جاسم إليه يقطع منها ما يستطيع. ولما لم يستطع أخذ يمضغ ما في فمه منها، وهو يصدر صوتاً غليظاً متقطعاً، فقبض جاسم على رقبته وأنشب أصابعه بها بكل قوته وهو يحاول إبعاده عن يده، وبعد ثوانٍ بدا أن الذئب يحاول الخلاص والإفلات، وتخلى عن الإصرار على النيل من يد جاسم وأخذ يحاول النيل من أي جزء آخر لكي يخلص نفسه. وقد أحس جاسم بذلك بغريزته فقذفه بيده بكل ما تبقى له من قوة، فوقع غير بعيد عنه وهو يخرج أصواتاً تدل على الإنهاك، ووقعت يد جاسم على حجر قريب منه، فضربه به فنفر منه واختفى مرة أخرى في الظلام». (الرواية، 56، 57).
والسارد يناجي نفسه: «لم يكن جاسم خائفاً من هذا الحيوان لأنه ذئب، بل كان خائفاً لأنه هو مقيّد والذئب طليق، وهو ضعيف أنهكته جراحه والذئب سليم معافى». (الرواية، 71).
لا ملجأ لجاسم سوى «الإيمان» ومن خبر الصحراء يدرك أنها ليست رمزاً للعقم بقدر ما هي نبع للإيمان، حيث يقف المرء في هذا الفضاء اللانهائي، فيشعر أنه أقرب إلى الله عزَّ وجل.
وقد كشفت المواجهة الأخيرة عن إرادة الحياة، وقد لاح الأمل عندما انطلقت تلك الرصاصة التي أخذها من ابنه محمد لتستقر في جسد الذئب فيسقط جثة هامدة بلا حراك (الرواية، 92).
إن هذه اللوحات السردية التي تشكل البيئة الرئيسة لهذا النص السردي (الذئب) لـ «خالد الشايجي» تطرح في خطابها قضية «الوجود» الذي يسعى إليه الإنسان والحيوان و«العدم» الذي يتربص بكليهما، فكلاهما حريص على الوجود: الإنسان بإرادته وإيمانه وعقله والحيوان بغريزته.. فالذئب يقاتل في ضراوة، وعناد، وإصرار ليوفر لنفسه «حياة»، مؤكداً أنه «لا شيء يعدل الوطن» وبالنسبة إليه هنا فوطنه الصحارى.
إن القارئ، مع إعجابه بإرادة جاسم/ الإنسان، فإننا، وبالقدر نفسه، نتعلم من الذئب درساً: كيف يكون الإصرار على تحقيق الهدف بعزيمة لا تلين، والدفاع عن الوطن حتى الموت.. ذلك الوطن الذي يحيا فينا وبه نحيا ■

