نــزار قبَّـانــي علامةٌ ناتئةٌ في عناقِ الشعرِ والموسيقى
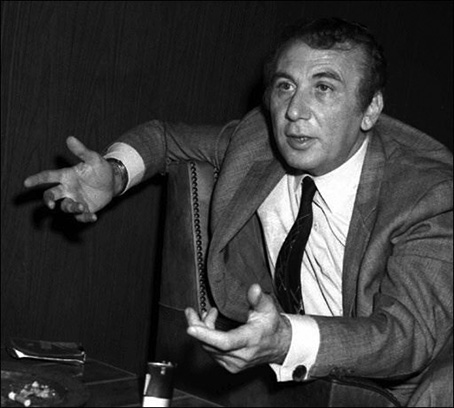
مزجَ رحيقَ العطرِ بماءِ النّارِ وأطلقَهُما في شرايينِ اللغةِ العربيّةِ، فتحوّلت أشعارُهُ إلى عصافيرَ تزغْردُ وتغرّدُ على أغصانِ الأيّامِ وفي حدائقِ الذكرياتِ الشجيّةِ التي لا تشيب!
نزار قبّاني، المُختلِفُ، والمُختلَفُ عليه، الاستثنائيُّ الذي حطّمَ أسوارَ المعاجمِ وفتحَ النوافذَ العتيقةَ لتقفزَ منها مفرداتُ اللغةِ مرتديةً أثوابًا عصريّةً تمرحُ بها في الشوارعِ والميادينِ العربيّة، ليشكّلَ - بمفردِهِ - خطًّا شعريًّا متفرِّدًا تلاشى كثيرونَ في ظلالِهِ، وتبعثروا على جانبي الطريقِ، وضاعت ملامحُ قصائدِهم الباهتةِ عندما حاولوا مجاراتِهِ أو استنساخَ ثورتِهِ الفائرةِ العفويّةِ التي ألهبت الأذهانَ والأرواحَ والعيونَ على مدارِ خمسينَ عامًا متوهّجةً في كِتابِ القرنِ العشرين.
كانَ نزار قبّاني ثائرًا شجاعًا على المستويين، العاطفي (الوجداني)، والسياسي المحفوفِ بالمخاطرِ والمكائدِ وألاعيبِ منتفعي كلّ عصر، وفي كلّ الأحوالِ ظلَّ متفرّدًا في تعاملِهِ مع القصيدةِ ليجبرَكَ على التصفيقِ الحارّ والحاد، حتى لو اختلفتَ معهُ حولَ المضمون، أو تألّمتَ من جرأتهِ وكسرهِ للقوانينِ الاجتماعيةِ، أو بسببِ بعضِ تجاوزاتِهِ في حقّ النحو والسياقاتِ اللغويّةِ وارتكابِهِ بعض المخالفاتِ التي لا تبرّرُها الضرورةُ الشعريّة.
كان نزار يكتبُ القصيدةَ للقصيدةِ وللشعرِ، لينشرَها صحفيًّا أو في دواوينَ أو يلقيها في مواجهةِ الجمهورِ في تفاعلٍ حيّ، ولم يضعْ في حُسبانِهِ أن يصدحَ المطربونَ بأشعارِهِ، غيرَ أنّهُ، وفي لحظةٍ استثنائيّةٍ مثله، أصبحَ علمًا على رءوسِ الأشهادِ في حقلِ الغناءِ بقصيدةٍ واحدةٍ خرجت من منصّاتِ الإذاعةِ المصريّةِ في ربيع العامِ 1960م.
كانت هناكَ تجربةٌ موءودةٌ لم نستطع الاهتداءَ إلى تسجيلٍ لها، تلكَ التي قام بها المطربُ والملحنُ المصري أحمد عبدالقادر عندما زارَ دمشقَ في منتصفَ خمسينياتِ القرنِ العشرين، فقد استهوتْهُ قصيدةٌ نزاريّةٌ عنوانها «كيفَ كان؟»، فلحّنها وغنّاها هناك، و..... ماتت تحتَ قدميهِ في ليلتِها، وعندما جاء العام 1960م، كان نزارُ يعملُ سفيرًا للجمهوريّةِ العربيّةِ المتحدةِ (مصر وسوريّة) لدى الصين، وهناكَ باغتتهُ قصيدة «أيظنُّ؟»، فكتبها، وعلى الرغم من أنّ نزارًا قد حكى قصّةَ القصيدةِ بنفسِهِ في مقالٍ له نشرتهُ جريدةُ «الحياة» في العدد 12904، الجمعة 3 يوليو 1998م في سلسلة المقالاتِ التي نشرتها له بعد وفاته، إلا أنّهُ لم يقُلْ لنا: كيفَ وصلت القصيدةُ إلى صوتِ نجاة الصغيرة؟ وقد تعدّدتِ الرواياتُ بين مَن يقولُ إنّ نزارًا أرسلَها إلى نجاة رأسًا، ومَن يقولُ إنه أرسلَها لصديقه كامل الشناوي الذي اقترحها على نجاة، ومَن يقولُ إنّ نجاة قرأتها منشورةً فالتمست من الشنّاوي أن يقنعَ الموسيقار محمد عبدالوهَّاب بتلحينها لها، وما يهمّنا هو النتيجةُ، فقد صدرت القصيدةُ / الأغنيةُ للمرة الأولى في مارس (آذار) من العام 1960م، فاشتعلت الحرائقُ في أثيرِ الإذاعةِ لكثرةِ ما أذيعت بناءً على طلبِ المستمعين، ثمّ كانت الطلبَ الأوّلَ لجمهور نجاة في حفلاتها التاليةِ المنقولةِ على الهواء، ما دفعَ أحدَ رسّامي الكاريكاتير إلى أن يرسمَ مذيعًا يقول: هُنا «إذاعة أيظنّ»!!
جاءت «أيظنُّ؟» مغايرةً بالفعلِ للطقوسِ الشعريّةِ المغنّاة، كانت هناك مئاتُ القصائدِ البديعةِ التي تملأُ الأثيرَ والذكرياتِ إلى الآن، لكنها كانت تسيرُ الخطوةَ المعتادةَ كجنودِ الأمنِ المركزيّ الملتزمين، أمّا موسيقار الأجيال محمد عبدالوهّاب، فكانَ مهمومًا بالشارعِ العامِ أكثرَ من همّهِ بالشعرِ أو بالصورِ الشعريّة، ولذلك جنحَ دائمًا إلى تطريزِ اللحنِ بالموسيقى الراقصةِ المتأججةِ حتى ولو كانت التجربةُ الشعوريّةُ في حالةِ شجنٍ أو ألمٍ أو بكاء، أي على النقيضِ - تمامًا - من مارد النغمِ وعملاقِ القصيدةِ العربيّةِ رياض السنباطي، كذلكَ لم يكن عبدالوهّاب مولعًا بالتغييرِ والتبديلِ في الكلمات، بل قال إن «بوسْعِهِ أن يلحّنَ صفحةً كاملةً من الجريدةِ، ولو كانت صفحة الحوادث»، وكانَ محقًّا في ذلك، بينما كانَ السنباطي ينهِكُ الشاعرَ معهُ من أجلِ تغييرِ مفردةً واحدةً في القصيدة، وكانَ دائمًا معنيًّا بالموضوعِ وبالفكرةِ ثمّ التعبيرِ والتصويرِ الشعري، وكم من قصائدَ رفضَ أنْ يلحّنها لأمّ كُلثوم، مُعللا ذلك بأنها - القصيدة - لم تحرّكْ فيهِ ساكنًا، وليس فيها من الشعرِ سوى الوزن.
جرأةُ عبدالوهّاب في صياغةِ اللحنِ كانت سببًا رئيساً في نجاح «أيظنُّ؟» وتحوّلها إلى حدث ضخمٍ وضعَ نجاة في قمّةٍ جديدة، وجعل من اسم نزار قبّاني نارًا على عَلَمٍ، كما قال الأجداد، ولفرط جرأةِ عبدالوهّاب فقد قام بإصدارِ الأغنيةِ بصوتِهِ على شريط كاسيت وبلا تغيير، فقال له أحدُهم: كيف ترضى لنفسكَ أن تقولَ: «حتّى فساتيني التي أهملتُها...؟»، فقال عبدالوهّاب: «لأنّ الشاعرَ أرادها هكذا، أم كنتَ تريدُ منّي أن أقولَ: حتى بناطيلي التي أهملتُها؟». انفعلَ نزار وتألّمَ لعدمِ استماعِه إلى قصيدتِهِ التي يتغنّى بها المحبّونَ في الوطنِ كلّه، بينما هو - الأبُ الشرعي للعمل - لم يظفرْ بلحظةٍ منه، فكتبَ رسالةً طويلةً إلى نجاة يحذّرها فيها بأنها لو تأخّرت في إرسال الشريط، فسوف يطلبُها في «بيت الطاعة»، وعندما سافرَ إلى القاهرةِ استُقبَلَ بحفاوة، واستقبلتْهُ نجاة استقبالَ الفاتحين، لتغنّي له بعد ذلكَ ثلاث بدائع أخرى كانت كلّها من ألحان محمد عبدالوهّاب وهي «ماذا أقولُ له؟»، «إلى حبيبي»، «أسألكَ الرحيلا»، والأخيرةُ جاءت في أخريات عبدالوهّاب وكانت في طليعةِ الألحان التي سقطت له، وأصابتْهُ بإحباطٍ شديد، فقد حاولَ أن يُجاري تلاميذه - وعلى رأسهم محمد الموجي - في تلحين الشعرِ الحُرّ، فوقعَ في الفخّ أو الكمين، ولم يستطع التعاملَ مع هذا النوعِ من «الكتابةِ القلقة» المختلفةِ تماما عن الشعرِ العمودي الذي يجيدُ السباحة في بحورِهِ وترقيصِ الكلماتِ الحزينةِ ومن ثمَّ الجمهور، ومن الأسرارِ التي لم تعدْ أسرارًا، أنَّ «أسألكَ الرحيلا» كانت بالفعلِ بينَ يديّ محمد الموجي، ولكنه فوجئَ بعبدالوهّاب يلحنّها، فذهبَ ليستفسرَ منه، فقال لهُ عبدالوهّاب: أبوكَ أعجبَه شيءٌ يخصّك، هل تستطيعُ الاعتراض؟ قال الموجي: لا، وانحنى أمامه، لكنّ عبدالوهّاب أصرَّ على أن يعطيهِ عشرة آلاف جنيه، كتعويضٍ عن الجهدِ الذي بذله مع القصيدة.
وإذا كانت «أيظن؟» قد فتحت الباب على مصراعيهِ أمامَ أشعار نزار لتقفزَ من الديوانِ المقروءِ إلى الديوانِ المسموعِ، فقد جاءت بعدها «ماذا أقولُ له؟»، وفيها تجاوزَ نزار سقفَ الوصفِ عندما قال:
ربّاهُ.. أشياؤهُ الصُّغرى تعذِّبُني
فكيفَ أنجو منَ الأشياءِ ربَّاهُ؟
هُنا جريدتُهُ في الرُّكنِ مُهْمَلَةٌ
هُنا كتابٌ معًا كنّا قرأناهُ
على المقاعدِ بعضٌ مِن سجائِرِهِ
وفي الزّوايا.. بقايا مِنْ بقاياهُ
كيفَ استطاعَ نزار أن يرصدَ هذهِ الدقائقَ التي لو تعاملْنا معَهَا بمنظورٍ نفسيٍّ لأصابتْنا بالاشمئزازِ، الإهمال / السجائر /البقايا المُلقاةُ بلا مبالاةٍ في الزوايا والأركان.... إلخ، لماذا رأينا ذلك كلّه جميلا بل وعبقريًّا؟.. لا أدري.
أمّا «إلى رجُل» التي أصبحت «إلى حبيبي»، فهي إحدى فرائدِ نزار المغناةِ على الإطلاق، وفيها تجرّأ عبدالوهّاب بإجراءِ تعديلينِ أو تبديلين، وجاءا في مكانهما بالفعل، فقد كان البيتُ الأوّلُ يقول:
متى ستعرفُ كم أهواكَ يا رَجُلا....
فأصبحَ:
متى ستعرفُ كم أهواكَ يا أملا....
كانت كلمة «رجُلا توحي بالغضبِ والخشونةِ وكأنّها سبٌّ أو شتيمة، بينما جاءت كلمة «أملاً» لتضيءَ استهلالَ القصيدةِ بذلكَ الضوءِ الذي لم ينطفئْ إلى هذهِ اللحظة. وأمّا التعديلُ الآخرُ فقد جاءَ في البيتِ السّابعِ الذي كانَ الشطرُ الأوّلُ منه:
يا مَنْ يدخّنُ في صمتٍ ويترُكُني....
فأصبحَ:
يا مَنْ يفكِّرُ في صمتٍ....
كما تمّ حذفُ البيتِ التالي له، الثامن، وكانَ جديرًا بأنْ يظلَّ فهو في صميمِ المعنى:
ألا تراني ببحرِ الحبِّ غارقةً
والموجُ يمضغُ آمالي ويرميها؟
وقد تجاوزَ نزار حدودَ التعبيرِ مرّةً أخرى عندما قال:
كفاكَ تلعبُ دَورَ العاشقينَ معي
وتنتقي كلماتٍ لستَ تعنيها
كم اخترعتُ مكاتيبًا سترسلُها
وأسعدتني ورودٌ سوفَ تُهديها
وكم ذهبتُ لوعدٍ لا وجودَ لهُ
وكم حلِمتُ بأثوابٍ سأشريها
وكم تمنّيتُ لو للرقصِ تطلبُني
وحيّرتْني ذراعي أين أُلقيها؟
الغريبُ أنَّ هذه القصائدَ التي غنتها نجاة من شعر نزار وألحان عبدالوهّاب، تتشابَهُ في المضمونِ والنهايةِ، غيرَ أننا لا نعبأُ بذلِك، إذ نستمتعُ بكلّ منها على انفراد أو «بالتجزئة».
المأزقُ الكُلْثومي
في العام 1966م، حاولَ نزار أن يضعَ أشعارَهُ على صوتِ أمّ كُلثوم، فأعطى عبدالوهّاب نصّ قصيدة «اغضَبْ»، وسارعَ عبدالوهّاب بنشرِ الخبرِ والقصيدةِ كاملةً على مساحةٍ كبيرةٍ مع صورٍ لثلاثتهم في جريدةِ الأهرام (21 يونيو 1966م )، وذهبَ عبدالوهّاب ونزار إلى السيدة أمّ كُلثوم، وكانَ ردّها قاسيًا وصادمًا وموجِعًا، إذ قالت لنزار: هل بعد كلّ الذي قدّمتُهُ لفنِّ الغناءِ والشعرِ الفصيحِ تريدُني أن أقفَ لأغنّي مثلَ هذا الكلام؟ أنا لستُ هذهِ المرأةَ التي في هذهِ القصيدة!
بلعَ نزار صدمتَهُ، لكنّهُ أضمرَ الحقدَ لأمّ كُلثوم وظلّ متربّصًا بها لينتقمَ منها في مقالٍ شديدِ القسوةِ في مجلة «الأسبوع العربي»، (عدد سبتمبر / أيلول 1974م )، عندما دخلت أمّ كُلثوم دوّامةَ مرضِ الموت، وبدأت وكالاتُ الأنباءِ تضعُها على رأسِ الأخبار، وعندها، أدركَ نزار أنها لن تقرأَ ما يكتبُ ولن تهتمَّ فقد فقدت قدرتَها على كلِّ شيءٍ، فعاجلها بمقالٍ مُهينٍ (ولم يكن نبيلا في ذلك)، ولم يشفعْ لأمّ كُلثوم أن غنّت له قصيدتين: «طريقٌ واحد» من ألحان عبدالوهّاب (1969م)، «رسالة إلى الزعيم» من ألحان السنباطي (1970م) في وداع عبدالناصر، ولأنّ نزارًا كان موعودًا بالعذابِ مع «اغْضَبْ»، فقد شاءت الأقدارُ أن تغنّيها الفنانة أصالة في بدايةِ مشوارِها بألحان حلمي بكر، وجاء تعليقُ نزار على هذا الحدثِ بقوله: لم أكرهْ في حياتي شيئًا لي مثلما حدثَ مع هذا اللحنِ وهذا الغناء، وقد كان من رحمةِ اللهِ لهُ أنْ توفّاهُ قبلَ أن يستمعَ إلى قصيدته «دمشق» بصوتِ أصالة أيضًا، فلو طالَ بهِ الأجلُ لماتَ بالسكتةِ من هولِ الصدمة!!
مع عبدالحليم حافظ
غنّى عبدالحليم حافظ قصيدتين من شعر نزار وألحان محمد الموجي وهما «رسالةٌ من تحتِ الماء» و«قارئةُ الفنجان»، وهما على رأسِ القصائدِ التي غنّاها حليم على الإطلاق، وجاء غناؤه لهما من بوابة نجاة أيضًا، إذ ترك نزار قصيدة «رسالةٌ من تحتِ الماء» للراحل مجدي العمروسي (مدير شركة «صوت الفنّ» التي كان عبدالوهاب وعبدالحليم شريكين فيها معه) آملا - نزار - أن تغنّيها نجاة، وبالصدفةِ مرّ عبدالحليم على الشركةِ فرأى القصيدةَ على مكتبِ العمروسي، وبعد أن قرأَها قال: سأغنّيها!! وهنا لا تستطيعُ نجاة أن تعترضَ أو تنطِقَ بحرفٍ واحدٍ، وكان عبدالحليم واعيًا إذ طلبَ من الموجي أن يقومَ بتلحينِها (وليس عبدالوهَّاب) بعد تعديلٍ طفيفٍ في قولِ نزار:
فأنا عاشقةٌ من رأسي حتّى قدمَيّ
ليصبحَ:
فأنا مفتونٌ من رأسي حتّى قدميّ
ونجحت القصيدةُ نجاحًا ساحقًا، أغراهم باستكمالِهِ في «قارئةِ الفنجان» التي أعتبرُها رأسَ قصائدِ نزار المغناةِ، وهي تعادلُ كلّ ما غنّاه حليم من الفصحى، وأراها تجسّدُ جزءًا كبيرًا من حياة عبدالحليم، وقد كادت تُحدِثُ شرخًا في علاقةِ عبدالحليم بنزار لقيام عبدالحليم بعملِ تعديلاتٍ كثيرةٍ (كانت واجبةً) فأغضبت نزارًا إلى حدٍّ بعيد.
الآخرون.. وكاظم السّاهر
كلهم دخلوا إلى أشعار نزار من بوابة نجاة الصغيرة، حتى أمّ كُلثوم وعبدالحليم، ومع هؤلاء نجدُ الكثيرينَ في ديوان نزار المسموع: فيروز، فايزة أحمد، ماجدة الرومي، لطيفة التونسيّة، إلهام المدفعي، أصالة، خالد الشيخ.. وصولا إلى غادة رجب، أمّا كاظم السّاهر فيغرّدُ وحدَهُ بعيدًا مُحطّمًا الأرقامَ القياسيّةَ ويغنّي ما يتجاوزُ مجموعَ ما غنّاهُ الآخرونَ من شعرِ نزار، اقترب كاظم من نزار كثيرًا، وأحبّهُ الشاعرُ الكبيرُ ودعمَهُ وشجّعهُ، وظلّ كاظم وفيّا له بعد رحيلِه إلى الدرجةِ التي لم يتركْ فيها قصيدةً تصلحُ للغناء في كلّ أشعار نزار، أي أنه أغلق البابَ تمامًا أمامَ الآخرين الذين لن يجدوا معنى منسيًا أو فكرةً صالحةً للغناءِ أو للبقاءِ ولم ينتبه إليها كاظم، وتأتي قصائد «اختاري، مدرسةُ الحزن، زيديني عشقًا، أشهدُ، قولي أحبّك، التحديات، الحبُّ المستحيل» في مقدمة القصائد التي ستعيشُ طويلا في تجربتِهما معًا، ونستطيعُ أنْ نقولَ إنَّ الساهرَ أعادَ الحياةَ إلى أشعار نزار المنسية، وجعلَهُ ينتفِضُ مرّةً أخرى ويتحمّسُ للكتابةِ في أخرياتِه، كذلك حرّض كاظم كثيرينَ على محاولةِ غناءِ أشعارِ نزار بعدَ النجاحِ الساحقِ الذي حقَّقهُ والذي دخلَ بهِ ذكرياتِ المحبّينَ على مدارِ خمسة عشر عامًا لم ينازعْهُ فيها أحدٌ على القمّةِ وظلَّ بمفردِهِ خطًّا متميّزًا إلى درجةِ التفرّد، فظنّ كثيرونَ أنَّ السببَ هو أشعار نزار، فتسابقوا إليها، ودخلوا التجربة، لكن لم يتركوا البصمةَ التي تركها كاظم، ولا الأثرَ الذي غزلَهُ في تكوينِ جيلٍ بأكملِه.
نزار قبّاني ( 21 مارس /آذار 1923م - 30 أبريل / نيسان 1998م ) - الذي أختلفُ معهُ كثيرًا في أعمالهِ السياسيةِ وأشبعتُهُ نقدًا موجِعًا في حياتِه - يظلّ علامةً ناتئةً في مسيرةِ الشعرِ العربيّ في القرنِ العشرين، ويظلّ ديوانُهُ المسموعُ مطرًا أخضرَ يهطلُ من زوايا الذكرياتِ ومن حنايا الأرواحِ التائقةِ إلى الانطلاق، ويبقى كلُّ ما تركهُ لنا، مدرسةً أبديةً تنتظرُ كلّ القادمينَ منَ الأجيالِ التي لم تولَدْ بعد، ليتعلّموا فيها مبادئَ الحبِّ والحريّة .

