المستشرقون الجدد... التمثُّلات ما بعد الحداثية للإسلام من فوكو إلى بودريار
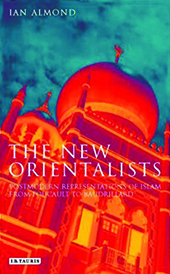
إذا كانت حركة الاستشراق قد بدأت تقريباً مع نهاية القرن التاسع عشر، وبلغت ذروتها في منتصف القرن العشرين، ثم خفت بريقها تدريجيًا بعد ذلك؛ فإن إيان إلموند يذهب في كتابه هذا إلى أن تيار الاستشراق لم ينقطع بعد. وهو يستمد مادته لإثبات هذه الفرضية من خلال الفحص المتعمق لأعمال نيتشه ودريدا وفوكو وجان بودريار وجوليا كريستيفا وسلافوتش زيزيتش، ورايات بورجيه ورشدي وباموك. ويحاول إلموند في هذا الكتاب توضيح أن نقاد الحداثة الذين اهتموا بالشرق الإسلامي ورموزه يمكنهم أن يمثلوا نوعًا جديدًا، بل ومترسخاً من الاستشراق. ودون أن يخوض المؤلف في الجدل الدائر حول تعريف مصطلح ما بعد الحداثة «المرتبك لدرجة مريبة» أو ترسيم ملامح الاستشراق أو التمركز الأوربي أو الإمبريالية، يقوم إلموند باستحضار تلك الأسماء التسعة ليس من منطلق كونهم نقادًا، ولكن من كون خطاباتهم تحمل صورًا من الشرق وعن الإسلام.
يرى إلموند أن هؤلاء المفكرين والكتاب- وهم يعيدون تقييم المنجزات الحداثية، بوصفهم ما بعد حداثيين – «يستحضرون شرقًا إسلاميًا/عربيًا»، ويجعل من الكشف عن الطبيعة المراوغة لذلك الاستحضار همه الرئيس. وهو يخلص بعد تحليل مفصل إلى أنه «بنقد الحداثة الأوربية، فإن اللعبة الأوربية لا تنتهي، بل هي قد انتقلت إلى مرحلة ثانية». وليس بالضرورة أن تكون هذه المرحلة الثانية نقدًا قاسيًا أو رفضًا للإسلام «سواء كان نيتشه البالغ من العمر عشرين عامًا وهو يخبر أخته كيف أن «المحمديين» مباركون أكثر من المسيحيين، أو كان فوكو الباريسي وهو يقر بأن التوانسة على سجيتهم مقارنة بالفرنسيين، فإن اللجوء إلى الإسلام والثقافات الإسلامية كوسيلة يمكن الاستفادة منها في تحقيق نوع من المساءلة النقدية للمجتمع، سيمثل لمحة مألوفة، حتى لو كانت على سبيل المقارنة بين الثقافات».
ينظُم إلموند تلك الأسماء التسعة في ثلاثة أقسام، القسم الأول هو «الإسلام ونقد الحداثة»، وفيه وضع نيتشه وفوكو ودريدا، حيث يبدي هؤلاء المفكرون تعاطفًا واضحًا تجاه الإسلام، وهو الأمر الذي يرى إلموند فيه أنه لم يكن حاضرًا بتلك الصورة لدى المستشرقين الأوائل. على أن هذا التعاطف كان في واقعه يحمل أهدافًا شخصية، فنجد مثلًا أن انبهار نيتشه بالإسلام، الذي رأى فيه تجسيدًا للقيم «الذكورية»، كان مرجعه المقارنة بينه وبين المسيحية، التي رأى فيها ترسيخًا للقيم «الأنثوية». فنيتشه، كما يقول إلموند، الذي لا نجد في كتاباته أي ذكر لآية قرآنية، يشعر - بوضوح - بوجود معنى التأكيد على أهمية الحياة في الإسلام. ومع أنه لا يلقي بالاً لدلالة كلمة «إسلام» (والتي تعني الخضوع)، فإنه قد نظر للإسلام بوصفه إيجابيًا، كونه عقيدة لا تدعو للانسحاب من الحياة ولا تخجل من الاعتراف بالغرائز «الذكورية»، بوصفها متأصلة في الطبيعة البشرية. كما أن قيماً كالجهاد ونشر الدين والقصاص فيها ترسيخ لمعاني الإيجابية، ولعل فلسفة نيتشه التي تقوم على فكرة إرادة القوة والإنسان الأعلى كانت هي الدافع وراء اتخاذه لهذا الموقف.
والشيء نفسه بالنسبة إلى فوكو، حيث هناك شرق خفي يكمن وراء الغرب الظاهر لديه. على أن إلموند يبدو حريصًا على ألا يكرر النقد الذي أفصح عنه سبيفاك وإدوارد سعيد وآخرون «إن تصورات فوكو لتلك الطاقة المجنونة لدى الإيرانيين، والطبيعة الواثقة لديانتهم، وحراكهم الثقافي الذي يعود لآلاف السنين، والسمة الجماعية المتناغمة المطلقة لديهم، هي جميعها تصورات لا تكمن اشتراطاتها الابستمولوجية في ما رآه فوكو في إيران بالفعل، بل في ما كان قد قرأه لنيتشه قبلًا ورآه في تونس من قبل حتى أن تطأ قدمه أرض إيران».
بينما نجد أن تناول دريدا للإسلام لم يكن على درجة وضوح هذا التناول نفسها لدى فوكو، بل كان مشوشًا بعض الشيء، و«يستند إلى خلفية أيديولوجية واضحة عن الإسلام». ومن خلال تلك الرؤية المشوشة يساعد «إسلام دريدا» على الفهم الذاتي لفكرة «نحن الأوربيون» في مواجهة «غير الأوربيين». لذا فإننا نلمس عند دريدا حضورًا للنزعة الاستشراقية القديمة «برفضه التعامل مع الإسلام كدين متفرد قائم بذاته، وهي فكرة غربية متأصلة، صار دريدا قادرًا على أن يستخلص منها أي هوية يريد. فإذا تطلب الأمر منه أن يقول شيئًا عامًا حول التضحية في عقيدة التوحيد، فهنا يكون الإسلام عقيدة إبراهيمية؛ وإذا كان الاستغلال الديني للتكنولوجيا هو الموضوع، فهنا يكون الإسلام خلفية «الإرهاب الكوني»؛ وإذا كانت العلاقة بين التحضر والبربرية هي القضية، فيكفي هنا استحضار المجازر التي وقعت في الجزائر»، وهذا موقف ينطوي، وفقا لإلموند، على سوء طوية واضح.
وينتقل إلموند من عالم الفلسفة إلى العالم الروائي ما بعد الحداثي لجورجي لوي بورجيه ورشدي وأورهان باموك، حيث يستخدم كل هؤلاء الكتاب مواقف وأجواء إسلامية متفاوتة تضفي ألوانًا وحكايا ضمنية غير مباشرة، فهناك ألف ليلة وليلة بالنسبة لبورجيه، والإسلام الصحيح وغير الصحيح لدى رشدي، والأجواء الصوفية الحزينة لدى باموك. ومع ذلك يقوم إلموند بالتفرقة بين هؤلاء الكتاب، بورجيه وبارت ورشدي وباموك:
«إذا لم يجد كتاب أمثال بورجيه وبارت في الإسلام سوى أداة (باليتة) علبة ألوان، فإن رشدي يقوم بوضع الإسلام في لب خطابه، وتظهر التصورات الغربية للحداثة وما بعد الحداثة كمداخل واستراتيجيات تساعدنا على فهم المعنى الحقيقي للإسلام، بالنسبة لهم. ولكوننا لا نجد ذلك في النصوص الغربية، فإن هذا القلب للأولويات – واستخدام ما بعد الحداثة لتوضيح الإسلام بدلًا من الاستعانة بالإسلام لتوضيح ما بعد الحداثة – يمثل وضع الهامشي في مقدمة الصورة، وهو الأمر الذي سنجده مرة أخرى لدى باموك، والذي يشكل الاختلاف الأهم بين نوعين من الكتاب».
سيكون من المهم أن نتبين من خلال هذا الكتاب الكيفية التي تصور بها إلموند كتّابًا من قبيل جوان جويتيسولو، الذي كان ينبغي أن يكون مع باموك ضمن هؤلاء الكتاب المختارين، حيث تستحضر بعض أعماله التيمة الغامضة نفسها، ومن ذلك «ابن عربي» في La Cuarentena.
أما القسم الثالث «الإسلام، النظرية وأوربا»، فيتناول جوليا كريستيفا وجان بودريار وسلافوتش زيزيتش، حيث يسمي إلموند مقاربة كريستيفا «رفض الإسلام» (ص 132)، بينما يقوم بتحليل تأييدها للنموذج الفرنسي للتعددية الثقافية واهتمامها بأزمة الذاتية الأوربية في السياق الأوسع نطاقاً للإسلام والنسوية. وقد انتقد إلموند كريستيفا كثيرًا مقارنة بغيرها من المنظرين. ومن بين المشكلات التي يضع يده عليها هنا خلطها الدائم بين الثقافة والدين، فهي تتخذ مما هو كائن أساسًا لتوجيه سهام النقد لما ينبغي أن يكون، وهذا موقف مغلوط بحسب إلموند.
بعدها ينتقل إلموند إلى بودريار، الذي يصفه بـ«قائد الفكر ما بعد الحداثي»، حيث ينظر للإسلام بوصفه «المعقل الأخير لمقاومة النظام العالمي أحادي القطب» (ص 173)، وبالإضافة لهذا توجد في كتابات بودريار إشارات إلى «العرب غير العقلانيين» أو «الملالي الهيستيريين» (ص 172). غير أن إلموند يركز على مبالغة بودريار في تركيزه على «التطرف» و«الآخر المسلم غير القابل للاختلاف» (ص 174). كما يشير إلى تحول موقف بودريار في كتاباته المتأخرة، حيث يصير الإسلام لديه «عرضًا من أعراض تدهور الغرب» (ص 173)، فالإسلام الفائق Hyper Islam، بتعبير بودريار، ليس سوى «تبعة من تبعات الغربة، ونتيجة منطقية لتعثر الحداثة» (ص 174).
ويختتم إلموند هذا الفصل بـ «زيزيتش» والأثر الهيجلي عليه، حيث يحاول كشف النقاب عن «نسخة قاتمة» (ص 182) لزيزيتش تختفي وراء نقد التمركز الأوربي حول الذات (ص 183). وفي القسم اللاحق يستفيض مع تحليلات هيجل وليس زيزيتش، ليركز على هذه التبعية، موضحًا أن زيزيتش لم تكن قادرة على الفكاك من أسر هيجل في تصوره للإسلام، كما كانت حال فوكو مع نيتشه.
يعد هذا الكتاب عملًا هائلًا في ما يتعلق بعرض ومناقشة آراء بعض من أهم أعلام ما بعد الحداثة في الفلسفة والأدب، وموقفهم من الإسلام. وتنبع قيمة هذا الكتاب في محاولته قراءة ما بين السطور بطريقة منهجية تنشد الموضوعية. كما يسلط الضوء على منطقة جديدة تماما من البحث، إذ إنه يحاول الكشف عن المسكوت عنه في نصوص بعض المفكرين والروائيين المنتمين إلى تيار ما بعد الحداثة، والذين لا يقدمون أنفسهم بوصفــــهم مستشـــرقين ■

