أدونيس المخاتل ثورة إبداعية على الثقافة العربية والنص الشعري
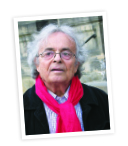
الحديث عن الشاعر السوري أدونيس يستدعي الإلمام بمسار شعري وبحثي متحوِّل، غير مستقر على حال، وذاك - في اعتقادي- مزيّة المبدع الخلّاق، السابر أغوار السؤال الثقافي في نسقٍ ميزته الثبات والسكونية، نسق الثقافة المحنّطة والمحتمية بخيمة الأسلاف. هذه الأخيرة أصابتها لعنة المتمرّدين على النصيّة العمودية، إنها لعنة البحث عن أساليب مستحدَثة في القول الشعري، والتفكير المتحرّر لبناء نص شعري بعد هضم المنجز الشعري السالف، وتحويله إلى طاقة لتخصيب النص الشعري المحتمل. والشاعر أدونيس في مشروعه هذا يحمل بذور خلق لأبجدية شعرية ثانية تتّسمُ بجرأة تعبيرية ورؤية مغايرة للذات والكون، وتصوّر تمكّن من النبش في أراضٍ أخرى، أراضي الشعر البِكْر.
هذه الأبجدية المنحوتة بإزميل المغايرة وبثقافة نابضة بالضياء الوجودي، وارتجاجات الباطن، بل يمكن اعتبارها «مغامرة أنطولوجية يدخل من خلالها الشاعر إلى عالم متعدد الأبعاد، تضحى فيه الذات تمارس كينونتها كامتداد لاستمرارية الوجود الإنساني كصيرورة تاريخية تعيد اكتشاف التشكلات والممارسات الخطابية (...)، ومن ثم فأدونيس يعيد قراءة التاريخ بواسطة أبجدية ثانية تحاور الذات والمكان والزمان واللاشعور وتضيء سراديب لغة طواها النسيان»، وبالتالي فهو لا يرتكن إلى القائم بقدر ما يميل إلى هذه المغامرة المنبثقة من عمق تصوري مترع بمرجعيات معرفية وثقافية، شعرية، فكرية وفلسفية، تزيد من شحن الإبداع بطاقة الاختلاف بدل الائتلاف المألوف في الثقافة العربية، فأدونيس من خلال مشروعه النقدي المحوري حول الثابت والمتحول في الشعرية العربية خلص إلى أن الذات العربية سِمَتُهَا التبعية والاحتذاء، ولتجاوز هذا الوضع إلى وضع يحفّز على التّأمّل والحفْر العميق والإسهام في تجديد الفكر الإنساني، قاد ثورة إبداعية على مستوى الثقافة العربية والإبداع الشعري، إذ كانت لديه الجرأة في التفكير جهرًا، لا مخاتلة في هذه الثقافة من خلال خلخلتها وتقويضها لبناء صرح جديد يحتفي بالعقل، ينتصر لتخطي التسييج الفقهي المعيق للخلق والإبداع.
وقد كان لعمله النقدي للتراث آثار إيجابية في إخراج العقل العربي من حالة الانتظار والتردّد إلى حالة المغامرة؛ مجترحًا بذلك رؤية جديدة، ومثيرًا لأسئلة عميقة بخصوص الصلة التي تربط بين التراث والحداثة، هذه العلاقة المتّسمة بالتوتّر والمفارقات، القصد منها تقليص الهوّة بينهما لتجديد الفكر وبلورة الثقافة العربية في أبعادها الإنسانية.
أما على مستوى المنجز الشعري، فالشاعر أدونيس قد قوّض هذا الثابت وصيّره متحوّلًا بنيةً ورؤى، ممّا شكّل انعطافة قوية في سيرورة الشعرية العربية وصيرورتها، من خلال خلق لغة ثانية، أي لغة مغايرة للغة القواميس والمعاجم، لغة مشحونة بالحلم والإشارة، بدل الحقيقة والإحالة، ومبدِعَة متخيّلًا شعريًا نابضًا بالديمومة. والمتأمل في قوله: «من الحكمة أن تظلّ غريبًا/ لكي تدخل تحت قبّة المعنى/ هكذا تلبسُ المصادفة/ وتتأصّل في ضربة نرد»، ففلسفة الشاعر محتدُها الغربة كمقام وجودي يفضي إلى المعنى، أي تحقيق الكينونة المحتملة والمغامرة نحو أفق شعري يبتكر خطابه الشعري المفارق والمغاير. هذه المغامرة تكتسي طابع الخرق اللغوي عبْر ابتداع لغة الإيحاء والترميز، وتنبثق من تصور متجدّد ومتغيّر لبنية النص الشعري السائد، ومؤمِن بضرورة الإتيان بالمختلف على مستوى التركيب والأسلوب. والمصاحب للمتن الشعري عند الشاعر سيلمس هذا المعطى المحطِّم للثابت في الشعرية العربية، يقول:
«وتلك هي الأبدية تتوسّد أعناق الكلمات»، فبالشعر تعيد الحياةُ ديمومتها وترتاد اللانهائي وتضيء الغامض بالحلم وسبر الأغوار السحيقة في الذات والأبدية، وهي سيرة الشاعر المبتلّ بـ «أنداء المعنى»، ليحتفي بالكتابة كهوية تقاوم الهاوية من أجل البقاء. ومن ثمّ فإن أدونيس لا ينتصر للشعر ولا للنثر، بقدر ما ينتصر للإبداع ولكتابة مفارقة ومناوئة للسائد، بالحفر عميقا في التربة الخام للإنصات إلى ارتجاجات الكون وتفاعل الذات، الشيء الذي جعل السؤال سبيل التقدم نحو منافي الكتابة الشعرية النابضة بالدهشة والافتتان كميسمين مختلفين عمّا هو كائن. فالممكن الشعري الذي يحتمله الشاعر مرتبط بالهشاشة والظن، وهما مقومان من مقومات إبداعية الشاعر. يقول: «أسأل وأتقدم- / كيف يمكن ألا أثق بالريح؟»، فالمضمر أن الشاعر لا يؤمن بالجواب، وإنما هو سليل السؤال، الذي يقود إلى بلوغ رؤية متجاوزة الواقع، والخالقة لعوالم شعرية منسوجة بالحدس والظن والمستحيل. يقول: «أكتب الظن والمستحيل ويملي عليّ الفضاء»، فالكتابة الشعرية لدى أدونيس مرتهنة بعدم الاطمئنان والثبات على هدي الأسلاف، وإنما مندغم مع الحياة في أبعادها ودلالاتها الإيحائية، انطلاقًا من كون الأبجدية/ اللغة تمارس المحو، أي الخلق، لتحقيق كينونة الإنسان عبْر الكشف عن الملتبس، وتمزيق حجب اليقين لإضاءة المعتم في الوجود والذات. يقول: « قل أنا الغريب وأتقن هندسة المنفى، قل خير لي أن أرقص مع هذا الغبار/ وقل سأكتب آخر قصائدي/ على آخر ورقة/ من هذا البرديّ الأخير»،
فالقول إحالة على الإفصاح عمّا تزخر به الذات من منافٍ داخلية لممارسة الفرح، وكتابة قصيدة التيه والعطش والإقامة في هاوية اللغة. يقول: «أنا الأسطورة والهواء جسدي الذي لا يبلى»، بقول كهذا يفصح الشاعر علي أحمد سعيد إسبر، عن كينونته المتجدّدة والمتحولة، الشيء الذي جعله يخلق أسطورته المعبّرة عن عبوره؛ مثقلًا بالظنون المحطمة لليقين والانسلاخ من الأنقاض كدلالة على الانبعاث والحياة، وتلك ميزة الشعراء العظام المهووسين باقتراف جنحة الخيال والاعتراف شعرًا عن جريرة الإبداع. ومادامت اللغة ملّة الشاعر وبطاقة هويته التي يشهرها في وجه الفراغ والعدم والتاريخ المزيّف، غير أنه يخلق تاريخ الشعر الممتد في جغرافيات المجهول، والمؤسس لتاريخ الكينونة من دون حروب ولا ذخيرة إلا ذخيرة الحدوس والتأملات المنبثقة من عمق التجربة في الحياة والإبداع.إن أدونيس في أبجديته الثانية يفتح أفق الكتابة على التاريخ الفردي والمشترك، الأول يشكل الذات والثاني يعبر عن المشترك الجمعي، لكن الشاعر لم يتعامل مع التاريخ كتأريخ؛ وإنما كطاقة متخيلة شحنها برؤاه المنفلتة من عقال التصوير المحاكاتي، وعليه فالجمال الشعري يتخلّق من رحم اللغة الشعرية التي ترتضي الإقامة في التخوم، والبحث عن الكينونة في بلاغة الاختلاف. فالأنا الشعرية تحفر مجراها الوجودي، وتستقي ماء الشعر من معين الظن والحلم؛ ولا ترتكن إلى اليقين، وهنا مكمن أسطورية شعرية أدونيس. وليس غريبا على قارئ أدونيس أن يتنبّه إلى القدرة الخارقة التي يمتلكها في صوغ القول الشعري، إذ الشاعر يبتدع تجربة لا تفكّر في الشكل بقدر ما تخلق الشكل المناسب للحظة الكتابة، ذلك الشكل المتخلق من عمق التصور واحتمالية المعنى وتنبّؤ الدلالة.
فحداثة أدونيس حداثة متحوّلة غير راسية على نمط معيّن، وإنما تعبّر عن هويتها الشعرية انطلاقًا من خلفية فلسفية كونية جوهرها تقويض الكائن لبناء الممكن / المحتمل، ومن ثمّ، فإن هذا التعدّد والاختلاف في هذه الحداثة نابع من الفهم المدرِك والواعي للشعر باعتباره نسيجًا متشابكًا ومتداخلًا، شرطه الأساس الانفتاح على التأويل. يقول : «أولوني/ جسدي رق- كتاب/ كتبته أبجديات نجوم وغيوم»، فالأنا كتاب مفتوح على أفق تأويلي مختلف ومتمرّد على الفهم السطحي، أفق التحوّل والإبدال كسمة من سمات إبداعية الطرح الحداثي عند الشاعر في كتابة نص شعري مختلف ومتعدد على المستوى القراءاتي/ التأويلي، وفي هذا إثراء للنص وتثوير للرؤى وشحن للبنى بدلالات أخرى.
والشاعر أدونيس، عبر مساره الشعري، لم يكن مهووسًا بالظاهر وإنما بالباطن في حواره مع الذات والكون، فكانت المغامرة كامنة في سبر أغوار الكون، من خلال أسطرة اللغة المترعة بخلفية تراثية وفكر حداثي، مما ثوّر رؤاه، وشرَع التجربة على ارتياد المجهول كمقصدية حاضرة في تاريخ أدونيس الإبداعي. ومن تجليات هذا التثوير اللغة الشعرية عنده، فهي وسيلة من وسائل اختراق العتمات لملء فجوات الذات والعالم، لغة شعرية ثانية تنهل من كل الروافد الثقافية والفلسفية التاريخية والأسطورية والتراثية والحداثية. هذا التنوع زاد من تطعيم التجربة بفائض القيمة الجمالية والفنية، ذلك أن اللغة أيضًا منحوتة بإزميل الترميز والإيحاء تارة، وبالغرابة والالتباس تارة أخرى. ولعل المتأمّل في قوله: «حاضنا سنبلة الوقت / ورأسي برج نار/ ما الدم الضارب في الرمل/ وما هذا الأفول/ قل لنا يا لهب الحاضر / ماذا سنقول/ مِزَقُ التاريخ في حنجرتي/ وعلى وجهي أمارات الضحية/ ما أمرّ اللغة الآن/ وما أضيق باب الأبجدية...»، لغة شعرية إيحائية تخصّب المعنى وتشحن الخطاب بطاقات تأويلية، وتفتح التأويل على مصراعيه، فهو يجعل علاقته بالوقت علاقة وجودية إنسانية، تبرز الحرائق المستوطنة هواجس الذات في مجابهة تاريخ عربي موسوم بالتمزّق، بالموت والأفول، مما جعل اللغة عاجزة عن احتواء هذه المرارة المستشرية في نسيج وطن عربي ممتد من الماء إلى الماء، فالصورة الكارثية للذات، للعالم وللهوية غايته الشعور بالكينونة، واختراق لهذا التاريخ الموسوم بالمفارقات والأعطاب.
إن التجربة الشعرية للشاعر أدونيس الشعرية والنقدية تتطلب وقفة تأملية طويلة، نظرًا للإبدالات التي أحدثها الشاعر في بنية النص الشعري، وكذا في خلخلة الثابت في الثقافة العربية، لكون أدونيس اختار المغامرة بدل الارتكان إلى الجاهز، مخترقًا الحدود، ومؤمنًا بمستقبل القصيدة العربية الخلّاق ■

